
كفر الزقازيق البحري
في القرن الثامن عشر انتقلت عشائر قبيلة عذرة القضاعية من سيناء إلى وادي الطميلات ومنها فرع يعرف باسم البركات تزعمه السيد أحمد زقزوق الكبير والذي ارتحل بهم إلى ولاية الشرقية فأسس قريتين هما كفر الزقازيق البحري بالقرب من القنايات وكفر الزقازيق القبلي بالقرب من منيا القمح ، وفي كتاب معجم قبائل مصر يقول الدكتور أيمن زغروت : ” وكذلك تنتشر قرى أسستها بنو زقزقة بن حرام بن ضنة بن عبيد بن كبير بن عذرة في كفر الزقازيق قبلي وبحري والزقازقة وكفر أبو جبل وكل هذه القرى تابعة اليوم لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية “.
وفي عام 1827 م. قرر محمد علي باشا إنشاء قناطر على بحر مويس بالقرب من قرية كفر الزقازيق البحري وتمت الاستعانة بأبناء القرية في أعمال البناء التي استغرقت خمس سنوات وعلى رأسهم الشيخ إبراهيم حفيد السيد أحمد زقزوق الكبير فقام بالمهمة خير قيام وكان ذلك هو سبب بناء مدينة الزقازيق التي صارت عاصمة جديدة لمديرية الشرقية ، وقرية كفر الزقازيق البحري هي التي تفرعت منها نزلة الزقازيق التي صارت نواة المدينة الناشئة التي عمرت في زمن قياسي وازدهرت سريعا حتى صارت القرية الأصلية من توابعها.
ويذكر محمد رمزي في القاموس الجغرافي أن قرية كفر الزقازيق البحري قد دخلت بعد ذلك في حيز المدينة مع احتفاظها بزمام زراعي مقيد في جداول المالية فيقول : ” كفر الزقازيق البحري أصله من الكفور التابعة لناحية هرية رزنة ثم فصل عنها في تاريخ سنة 1260 هـ وعرف بالبحري تمييزا له من كفر الزقازيق القبلي التابع لمركز منيا القمح ، وهذا الكفر لا يزال قائما بذاته بزمام خاص من الوجهة المالية وأما من الوجهة الإدارية فهو قسم من أقسام مدينة الزقازيق وتابع لها إداريا ”.
ويقول في موضع آخر : الزقازيق منسوبة إلى أسرة السيد أحمد زقزوق الكبير الذين أنشأوا كفر الزقازيق قبل مجيء محمد علي إلى مصر ثم إلى نزلة الزقازيق التي أنشأها إبراهيم زقزوق الكبير بجوار القناطر وهو من ذرية السيد أحمد زقزوق الكبير ، والأدلة على ذلك ورود اسم كفر الزقازيق بخريطة الوجه البحري رسم الحملة الفرنسية في سنة 1800 وقد ورد محرفا باسم كفر زجزي وهو بذاته كفر الزقازيق لوقوعه في مكانه الحالي بالقرب من مكان قناطر الزقازيق ، وأن أسرة زقزوق الذين أنشأوا قديما كفر الزقازيق وأنشأوا بعد ذلك نزلة الزقازيق التي هي نواة مدينة الزقازيق لا تزال موجودة إلى اليوم بمدينة الزقازيق ولها ذرية وأحفاد “.
وجاء في موسوعة القبائل العربية : لمحة عن بني عُذْرَة قُضَاعة : عُذْرَة بطن عظيم من أسْلُم وهو عُذرَة بن سعد بن هذيم بن زيد بن ليث بن سَوَّد بن أسلُم بن الحافي بن قُضَاعة .. وقد تفرَّعت منه أفخاذ كثيرة وكان منهم في اليمن وأغلبهم كان في شمال الحجاز والشام ، وعُذرة مشهورون بشدة العشق .. وقد قال سعيد بن عُقبة لأحد بني عُذْرة وهو لا يعرفه : ممن الرجل ؟ قال مجيبًا : من قوم إذا عشقوا ماتوا !! قال سعيد له عُذري ورب الكعبة. ثم سأله : ومم ذاك يا أخا عُذرة ؟ قال العُذري : لأن في نسائنا صباحة وملاحة وفي رجالنا جمال وعِفة.
وقال أبو عبيد : كان من عُذرة هؤلاء جميل بن عبد الله بن معمَّر وصاحبته بثينة بنت حِبا بن ثعلبة ، وذكر ابن حزم أن لحِبْا صحبة وقال : منهم عروة بن حزام وصاحبته عفراء وهو ابن عمها وقد اشتد عليهَا حُبًا حتى مات من هواها !! ، وقال الحمداني : أن من عُذرة جماعة بدمياط قرب ساحل البحر في الديار المصرية وكانوا حلفاء لسُنبُس (طيئ) القحطانية.
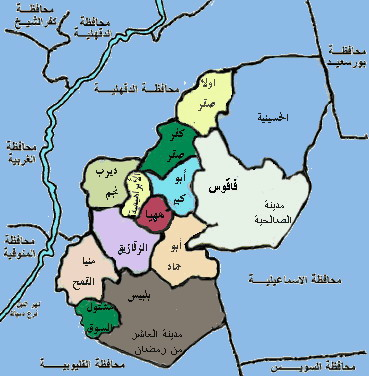
نزلة الزقازيق
يحكي محمد بك رمزي عن نزلة الزقازيق التي صارت نواة مدينة الزقازيق وذلك في كتاب القاموس الجغرافي حيث يقول : وفي سنة 1910 كنت منتدبا للتفتيش على الأعمال المالية بمديرية المنوفية وحدث أن زرت المرحوم عامر بك عبد البر أحد كبار باشمهندسي الري السابقين في داره ببلدة شنشور إحدى قرى مركز أشمون وكان في ذلك الوقت من المتقاعدين ، وقضيت معه نهار ذلك اليوم نتجاذب أطراف الحديث عن أعمال الري الكبرى في مصر إلى أن وصلنا في حديثنا إلى موضوع قناطر الزقازيق فسألته عن تاريخ مدينة الزقازيق وعلة تسميتها بهذا الاسم فقص علي رحمه الله ما أتذكره وهو :
إنه لما اتفق رأي رجال الري الذين قاموا بتحضير مشروع بناء قناطر الزقازيق اختاروا لها المكان الذي هي فيه لأنه كان يوجد سد قديم في بحر مويس لحجز المياه ، وتنفيذا لأمر محمد علي باشا وضع ديوان الهندسة التصميمات اللازمة لإنشاء ست قناطر في النقطة المذكورة أكبرها القنطرة التي تعرف بقناطر التسعة لأنها تتكون من تسع عيون وهذه على بحر مويس والخمس قناطر الأخرى تقع على أفمام (أفواه) خمس ترع أخرى تأخذ مياهها من أمام قناطر التسعة ، وفي سنة 1242 هـ / 1827 م ابتدأ العمل في إنشاء هذه القناطر تحت إشراف المرحوم أحمد أفندي البارودي باشمهندس ري مديرية الشرقية في ذلك الوقت.
ثم قال : ولما كان بناء هذه القناطر من الأعمال الجسيمة الكبرى التي تحتاج إلى عدد عظيم من العمال وإلى مدة من الزمن استحضر رجال الهندسة العدد اللازم من العمال وكان بعضهم من كفر الزقازيق الواقع في شمال مكان القناطر على بعد 400 متر منها ، وكان من بينهم رجل مقدام اسمه الشيخ إبراهيم زقزوق اختاره الباشمهندس رئيسا على جميع العمال وقد أنشأوا لهم وللباعة بجوار مكان القناطر مساكن لإقامتهم عرفت بين العمال وغيرهم باسم نزلة الزقازيق نسبة إلى أفراد عائلة زقزوق المذكور من جهة وإلى كفر الزقازيق موطنهم الأصلي الواقع بالقرب من القناطر من جهة أخرى.
ثم قال : ولما تم بناء القناطر في سنة 1248 هـ / 1832 م أصبح من الضروري تسمية هذه القناطر باسم معين تعرف به بين رجال الري وتذكر به في مكاتباتهم وجداول أعمالهم فاختار لها الباشمهندس رحمه الله اسم قناطر الزقازيق نسبة إلى نزلة الزقازيق لأنها كانت في ذلك الوقت أقرب مكان مسكون بجوار تلك القناطر.
هذه هي خلاصة رواية المرحوم عامر بك عبد البر وهو من معاصري المرحوم علي باشا مبارك ويعرف هذه الرواية من زملائه السابقين الذين باشروا عملية بناء هذه القناطر وكان رحمه الله معروفا بقوة ذاكرته وصدق روايته وتوفي في سنة 1920 بعد أن بلغ من العمر قرابة مائة سنة.
وأقول : إن نزلة الزقازيق المذكورة لا تزال موجودة وقد صارت فيما بعد قسما إداريا من أقسام مدينة الزقازيق يعرف بكفر الجامع نسبة إلى الجامع الذي أنشأه محمد علي باشا في هذه النزلة لأولئك العمال وهو أول مسجد أقيم في تلك البقعة التي تعتبر نواة في تكوين مدينة الزقازيق الحالية.
ومما ذكرنا يتبين لنا أن أسرة الشيخ إبراهيم زقزوق الكبير هي أول أسرة استعمرت هذه الجهة فنسبت إليهم وسميت البلد الزقازيق باسمهم ، ويقال إنه بعد أن تم بناء القناطر زارها محمد علي باشا فقدموا لسموه الشيخ إبراهيم زقزوق فأظهر له الباشا عظيم ارتياحه وشكره على المجهود الذي بذله هو ورجاله في بناء القناطر ولما علم أنها سميت قناطر الزقازيق نسبة إلى أسرة الشيخ إبراهيم زقزوق قال سموه : فلتكن الزقازيق على بركة الله ..

مدينة الزقازيق
جاء في القاموس الجغرافي : الزقازيق من المدن الكبيرة الواقعة على بحر مويس وهي قاعدة مديرية الشرقية ، ويرجع السبب في وجود هذه المدينة الحديثة إلى رغبة المغفور له محمد علي باشا الكبير في إنشاء الترع وتعميم طرق الري والصرف لأراضي مديرية الشرقية وذلك لإصلاح أراضيها الزراعية وتوسيع دائرة العمران فيها لزيادة إيرادات الحكومة من ضرائب الأطيان من جهة وزيادة ثروة السكان ورفاهيتهم من جهة أخرى.
وذكر محمد نشأة كفر الزقازيق البحري ثم نزلة الزقازيق المقامة بجوار قناطر الزقازيق والتي توسعت وتحولت إلى مدينة الزقازيق الحالية فقال : ومن سنة 1832 أخذ اسم الزقازيق في الظهور وحدث في ذلك الوقت أن طلب أحمد أفندي البارودي الباشمهندس نقل ديوان هندسة ري الشرقية من مدينة بلبيس التي كانت قاعدة المديرية يومئذ إلى جوار قناطر الزقازيق ليتمكن رجال الري من الإشراف على أعمال توزيع المياه منها فأجيب إلى طلبه.
بعد ذلك رأى محمد علي باشا أن تكون الزقازيق كذلك قاعدة لمديرية الشرقية بدلا من بلبيس وذلك لتوسطها بين بلاد المديرية فأصدر أمره في سنة 1833 بنقل ديوان المديرية والمصالح الأميرية الأخرى من بلبيس إلى الزقازيق ونزل الموظفون في مكاتب أعدت لهم مؤقتا ومن تلك السنة سميت البلدة رسميا الزقازيق ، وفي سنة 1836 تم بناء أول ديوان أقيم في الزقازيق لأعمال موظفي المديرية والمصالح الأميرية الأخرى ومستخدمبها على اختلاف أعمالهم.
ثم أخذت المدينة في الاتساع والعمران بسبب وجود المصالح الأميرية بها واتخاذ التجار وأرباب الحرف والصناعات إياها مقرا لأعمالهم لا سيما بعد إنشاء السكك الحديدية وتفرعها من محطة الزقازيق إلى القاهرة والمنصورة والسويس وبورسعيد.
ومن ثم أصبحت الزقازيق من كبريات المدن المصرية وكانت تابعة من الوجهة الإدارية إلى مركز القنايات ، ونظرا لاتساع دائرة الزقازيق وزيادة عدد سكانها وكثرة ما يقع فيها يوميا من حوادث المخالفات ضد اللوائح العامة المعمول بها في المدن علاوة على الأعمال الإدارية والمالية الكثيرة التي تتصل بسكان هذه المدينة وحاجتها إلى موظفين يقومون بتلك الأعمال أصدر ناظر الداخلية في سنة 1890 قرارا بفصل مدينة الزقازيق عن مركز القنايات وجعلها هي وملحقاتها مأمورية قائمة بذاتها يرأسها مأمور لإدارة أعمالها ومعه موظفون غير موظفي المركز.
وفي سنة 1896 أصدر ناظر الداخلية قرارا بنقل ديوان المركز من بلدة القنايات إلى مدينة الزقازيق لتوسطها بين بلاد المركز وتوافر المساكن بها ووقوعها على رأس السكك الحديدية المتفرعة منها وسممي مركز الزقازيق.
وليس للزقازيق زمام من الأراضي الزراعية مقيد باسمها كباقي المدن والقرى ، ومباني هذه المدينة قائمة على أجزاء متصلة في مكانها من أراضي خمس نواح وهي : كفر الزقازيق البحري الذي وإن كان قسما إداريا من أقسام مدينة الزقازيق إلا أنه لا يزال معتبرا وحدة مالية قائمة بذاتها ثم هرية رزنة وكفر النحال وكفر محمد حسين وبنايوس ، هذا هو تاريخ إنشاء مدينة الزقازيق.

القيراط وشوبك بسطة
عندما تأسست مدينة الزقازيق استقطعت أرضها من زمامات خمس قرى أقدم منهم وهي كل من كفر الزقازيق البحري وكفر النحال وكفر محمد حسين وهرية رزنة وبنايوس حيث كان الجزء الجنوبي منها تابعا لكل من القيراط (كفر النحال حاليا) والشوبك (شوبك بسطة حاليا) والتي تقع بالقرب من تل بسطة القديم ، وقد ذكر ابن الجيعان هذا الزمام في القرن التاسع الهجري في كتاب التحفة السنية فقال : القيراط والشوبك مساحتها 1944 فدان بها رزق 58 فدان عبرتها 5000 دينار كانت باسم الأمير بشتاك الناصري والآن باسم ديوان الدولة الشريفة.
وجاء في القاموس الجغرافي : كفر النحال هو من النواحي القديمة كان يسمى القيراط ورد في التحفة مع الشوبك (شوبك بسطة) من أعمال الشرقية وفي العهد العثماني عرف باسم وقف شمس الدين الخولي فورد باسمه المذكور في تاريخ سنة 1228 هـ ، وفي سنة 1903 وافقت نظارة الداخلية على تغيير اسم هذه الناحية وتسميتها كفر النحال بناء على طلب الشيخ عطية منصور سالم الذي كان عمدة لهذا الكفر في ذلك الوقت إحياء لذكرى جده الأعلى وهو النحال ، وبسبب تداخل مساكن هذا الكفر في مباني مدينة الزقازيق وإقامة كثير من المباني على أراضيه الزراعية أصدر مجلس مديرية الشرقية قرارا في 29 مارس سنة 1943 بحذف اسم هذه القرية من عداد النواحي الإدارية مع بقائه ناحية مالية من جهة الأطيان والضرائب.
كفر محمد حسين : أصله من توابع ناحية شرويده ثم فصل عنها في تاريخ سنة 1260 هـ ، شرويده أصلها من توابع ناحية الزنكلون ثم فصلت عنها في تاريخ سنة 1228 هـ واسمها عربي منتشر بين أسماء العرب أذكر منهم عواد شرويده من عرب العيايدة بمركز شبين القناطر.
شوبك بسطة : قرية قديمة اسمها الأصلي الشوبك وردت في قوانين ابن مماتي وفي تحفة الإرشاد الشوبك من كفور بسطة (تل بسطة) وفي التحفة وردت الشوبك مع القيراط (كفر النحال) من أعمال الشرقية وفي العهد العثماني عرفت باسم شوبك تل بسطة كما ورد في دفتر المقاطعات سنة 1079 هـ وذلك لمجاورتها لتل بسطة المخلف عن أطلال مدينة بسطة القديمة وفي تاريخ سنة 1228 هـ باسمها الحالي.
وجاء في الخطط التوفيقية عن كل من شوبك بسطة وتل بسطة القريب منها : شوبك بسطة قرية من مديرية الشرقية بمركز بلبيس ، شرقى بندر الزقازيق بنحو ألفين وخمسمائة متر ، وفى الشمال الغربى ناحية الغار بنحو ألف وسبعمائة متر ، وأغلب أبنيتها باللبن والآجر ، وبها مسجد وزوايا ، وتكسب أهلها من الزراعة وغيرها.
بسطة : ويقال لها بوبسطيس وبوباسط ، وهى مدينة كانت ذات شهرة وفخامة فى الأحقاب الخالية ، وقد عدمت ولم يبق منها إلا تلال تعرف بتلال بسطة شاهقة الارتفاع ، وتذكر كثيرا فى كتب الأقباط والجغرافيين ، وهى مقر العائلة الثانية والعشرين من الفراعنة ، وعدد ملوكها تسعة أولهم سيزونكيس وهو المسمى فى التوراة سيزاك ، وكان فى زمن سليمان عليه السلام.
وقال اتيين البيزنتى : إن كلمة بسطة من أسماء القط ، الذى هو الحيوان المعروف ، وتوقف فى ذلك كترمير لما رأى أن الصورة المرسومة على ميدالية هذه المدينة صورة طائر لا صورة قط ، وفى كتاب هيرودوط أن ملوك مصر كان لهم إعتناء زائد بهذه المدينة. ، وقد رفع سيزوستريس أرض مساكنها كما رفع أرض غيرها بالأسرى الذين حفر بهم الخلجان وأقام بهم الجسور ، وبقيت معتنى بها إلى استيلاء الحبشة على أرض مصر فرفع ملكهم سبقون أرضها زيادة.
قال : وكان بوسطها معبد شهير للمقدسة بوباسطيس المسماة عند اليونان ديان ، ارتفاع دهليزه عشرة أرجى (خمسة أقدام ونصف فرنساوى) مزين بتماثيل ارتفاعها ستة أذرع ، ويحيط به سور متين تكتنفه أشجار عالية من الداخل والخارج ، وهو مربع استادة من كل جهة ، ويحيط به الماء إلا عند مدخله ، وعلى جانبى المدخل ترعتان سعة كل مائة قدم ، تتجه كل منهما إلى جهة وتحفهما أشجار ، ولما ارتفعت أرض المدينة وبقى هو على أصله صار من يدور حوله يكشفه جميعه ، والطريق الموصلة إليه تقطع الميدان إلى جهة الشرق فتوصل إلى معبد مرقورا ، وطولها ثلاث غلوات فى سعة أربع بليترات ، وهى مبلطة ويحفها الشجر من الجانبين وفى داخل المعبد تمثال المقدسة المذكورة.

الزنكلون
جاء في التحفة السنية : سنكلون مساحتها 4400 فدان بها رزق 247 فدان كانت باسم الأمير صرغتمش الناصري والمقطعين والآن باسم الديوان المفرد ، وجاء في القاموس الجغرافي : الزنكلون هي من القرى القديمة اسمها الأصلي سنكلوم وردت به في قوانين ابن مماتي وفي تحفة الإرشاد وفي الانتصار من أعمال الشرقية ووردت في التحفة سنكلون من أعمال الشرقية ، وورد في مباهج الفكر وفي تاج العروس بأن اسمها على لسان العامة زنكلون وعرفت بالزنكلون في العهد العثماني فوردت به في دفتر المقاطعات سنة 1079 هـ وفي تاريخ سنة 1228 هـ.
وجاء في الخطط التوفيقية : الزنكلون قرية من مديرية الشرقية بقسم العزيزية فى جنوب القنيات بنحو خمسة آلاف متر وفى شرقى شرويدة بنحو ألفى متر وفى شمال السكة الحديد الواصلة من بنها إلى الزقازيق بنحو ألف متر ، وأبنيتها صالحة وبها منازل مشيدة لكبرائها وقصر جليل لسعادة إبراهيم باشا نجل المرحوم أحمد باشا أخى الخديوى إسماعيل وأنشأ بها مسجدا حسنا واسعا بمنارة تقام فيه الجمعة والجماعة ووقف عليه أطيانا يصرف عليه من ريعها.
وبها ورشة لإصلاح الآلات البخارية ومعمل فراريج وعدة بساتين ووابورات لحلج القطن ونقض الكتان وسقى المزروعات ويزرع بأرضها القطن والكتان وقصب السكر والأصناف المعتادة ، وبجوارها كفر صغير تابع لها به فوريقة لعصر القصب ولها سوق كل يوم أربعاء وأكثر أهلها مسلمون.
وإليها ينسب العلامة الشيخ مجد الدين أبو بكر الزنكلونى شارح التنبيه وله مصنفات وقبره بقرافة مصر ذكره السخاوى فى تحفة الأحباب وفى حسن المحاضرة للسيوطى أنه مجد الدين أبو بكر بن إسماعيل بن عبد العزيز الزنكلونى ، كان إماما فى الفقه أصوليا محدثا نحويا صالحا قانتا لله صاحب كرامات لا يتردد إلى أحد من الأمراء ويكره أن يأتوا إليه ملازما للاشتغال وله شرح التنبيه الذى عم نفعه ، وشرح المنهاج ولى مشيخة البيبرسية ودرس الحديث بها وبجامع الحاكم مات فى سنة أربعين وسبعمائة.
وذكره حاجي خليفة في سلم الوصول إلى طبقات الفحول فقال : الشيخ مجد الدين أبو بكر بن إسمعيل بن عبد العزيز السنكَلُومي الفقيه الشافعي المتوفى بالقاهرة في ربيع الأول سنة أربعين وسبعمائة عن نحو ستين سنة ، قدم القاهرة ولازم الشيخ عبد الرحيم وأخذ عن العلم العراقي وسمع الدمياطي وتولى مشيخة الرِّباط ثم درَّس بالفاضلية وانتفعوا به.
وكان فقيهاً محدثاً قانتاً لله منقطعاً وله كرامات ومؤلفات كمختصر شرح التنبيه لابن الرِّفعة وتحفة النبيه في شرح التنبيه (أربع مجلدات) لخَّصه من شرح الرافعي وابن الرِّفعة وكتاب اللمح العارضة فيما بين الرافعي والنووي من المعارضة (مجلد) وشرح مختصر التبريزي والواضح الوجيز في شرح التعجيز لابن يونس (ثمان مجلدات) وشرح منهاج النووي وأفرد زوائد البحر للروياني على شرح الرافعي. (ذكره السبكي).
وذكره الصفدي في الوافي بالوفيات فقال : الزنكلوني الشافعي أبو بكر بن إسماعيل بن عبد العزيز المصري الإمام البارع المفتي مجد الدين الزنكلوني الشافعي ؛ سنكلوم من أعمال بليس – وهي بالسين المهملة والنون والكاف واللام والميم – هذا هو الصحيح وإنما الناس غيروا ذلك وقالوا : الزنكلوني ، ولد سنة بضع وسبعين وست مائة وتفقه على جماعة وسمع من الأبرقوهي ومحمد بن عبد المنعم بن شهاب وعلي بن الصواف ويحيى بن أحمد الصواف وعدة ولازم الحافظ سعد الدين وسمع منه في المسند وبرع في المذهب وشارك في الأصول والعربية.
وأفتى ودرس وتخرج به الأصحاب وصنف التصانيف مع التقوى والعبادة والوقار والتصون ، درس بجامع الحاكم وبالبيبرسية وأعاد بأماكن في الحديث والفقه وعرض عليه قضاء قوص فامتنع ، ألف شرحا للتنبيه في خمسة أسفار وشرحا للتعجيز في ثمانية وشرحا للمنهاج لم يطوله واختصر الكفاية لابن الرفعة وخرج له تقي الدين بن رافع مشيخة وحدث بها ، أخذ عنه شمس الدين السروجي وابن القطب وأبو الخير الدهلي وآخرون ، وتوفي في سابع شهر ربيع الأول سنة أربعين وسبع مائة ودفن بالقرافة وكثر التأسف عليه.

الزقازيق في الخطط التوفيقية
جاء في الخطط التوفيقية : الزقازيق مدينة كبيرة فوق بحر مويس من الجانبين ، وهى مركز مديرية الشرقية بها ديوان المديرية مستوفيا والمجلس المحلى وديوان الهندسة وديوان الصحة ومجلس دعاوى ومجلس مشيخة ومجلس تنظيم ومدرسة على طرف الديوان لتعليم الشبان اللغات والهندسة والحساب ، ومحكمة شرعية كبرى مأذونة بالحكم فى عموم القضايا مثل البيوعات والرهونات والإسقاطات والأيلولات فيما يختص بالأطيان وخلافها لوجود السجل بها بخلاف باقى محاكم مراكز المديرية فإنها مأذونة بما عدا مواد الأطيان وهى ستة : محكمة منيا القمح ومحكمة بلبيس ومحكمة مركز الصوالح ومحلها بالعلاقمة ومحكمة القرين ومحكمة تفتيش الوادىومحلها التل الكبير.
وأصل إنشاء مدينة الزقازيق أنه لما صدر أمر العزيز محمد على باشا بعمل قناطر فى محل سدّ بحر مويس – المعد لرى أراضى تلك المديرية – ليسهل بها الرى وتصريف المياه وحضرت هناك العملة والمستخدمون ، أحدثوا بها عششا من الطين والأخصاص على جانبى بحر مويس لإقامتهم وتبعهم فى ذلك باعة المأكولات ونحوها وتكاثرت الناس شيئا فشيئا وازدادت الأبنية الخفيفة وكثر البيع والعمارة ، وبعد انتهاء عمل تلك القناطر فى سنة ١٢٤٨ هجرية بقيت تلك الأخصاص مسكونة عامرة وكل حين تزداد بها السكان إلى أن صدر الأمر بالبناء بهذا المحل وتجديد مسجد للصلاة على طرف الديوان.
فحصل التجديد شيئا فشيئا للأبنية الحسنة باللبن والآجر على جانبى النهر حتى كثرت وصارت مشتملة على منازل مفتخرة وقصور مشيدة بالمونة والبياض والشبابيك الشيش والزجاج وغير ذلك ، وجعلت رأس المديرية بعد أن كانت الشهرة لمدينة بلبيس – المعروفة قديما بمدينة ببسة ـ وجدد بها قصر للميرى لنزول العزيز به ، وجعل المسجد بأعمدة وسقوف بلدية ومنارة وأقيمت فيه الجمعة.
ثم جدد بها الأمير يوسف بيك مسجدا بالبر الغربى لبحر مويس بناه بالآجر والمونة ويعرف الآن بالمسجد الصغير ، ثم جدد بها أحد تجارها (العيدروس) مسجدا غربى ترعة السكة الحديد قبلى ترعة الوادى بناه بالأحجار والآجر وأعمدة الرخام وسقوف الخشب وجعل له منارة ومنبرا من الخشب المخروط وكذلك الشبابيك وجعل له صهريجا للماء ، وكذلك الحاج سليمان الشربينى -أحد التجار – بنى مسجدا على شاطئ ترعة عبد العزيز وجعل عمده من الحديد الزهر المصبوب ولم يجعل له منارة.
وحدث بها أيضا ثلاث كنائس : واحدة للأقباط غربى بحر مويس فى شمال البلد وكنيسة للشوام فى بحرى ديوان المديرية وكنيسة للأروام شرقى فرع السكة الحديد ، وبها عدة أسواق بدكاكين وخانات مشحونة بأنواع البضائع ، ووكائل لسكنى الأغراب.

وصف الزقازيق
جاء في الخطط التوفيقية : وبها بنوكات للتجارة ، وجملة وابورات بعضها لحلج القطن وبعضهم للطحين ولصناعة الثلج وغير ذلك، فمنها: وابور لشيخ تجارها فى غربى بحر مويس لحلج القطن وعصر الزيت ، وهو كامل الآلات قوته أربعة وعشرون حصانا ، وبه منزل مشيد بشبابيك الزجاج والخرط ، وبجواره حديقة ذات فواكه ورياحين.
ومنها: وابور لنخلة العوساطى وأخوته ، فى غربى بحر مويس لحلج القطن والطحين ، قوته أربعة وعشرون حصانا. وبجواره من جهة الجنوب وابور للخواجة براسيلى وشركائه للحلج أيضا، بقوة أربعة عشر حصانا. وبجواره فى الجنوب أيضا وابور للخواجة روحه كناكى، وهو وابور كبير به منازل لسكناه وسكنى مستخدميه للحلج أيضا ، وبه طاحون بخارية ومكبس قطن ، وفى بحريه جنينة حسنة ، وقوة ذلك الوابور خمسون حصانا.
وفى مقابلته على الشاطئ الشرقى لبحر مويس وابور للخواجة ابن هائم ، على شاطئ البحر الشرقى فى غربى خط السكة الحديد ، للحلج أيضا ، وبه منزل سكن وبداخله جنينة ، وقوته خمسة وعشرون حصانا. وفى قبليه وابوران ، قوة أحدهما عشرون وقوة الآخر اثنا عشر حصانا للحلج أيضا ، وبأحدهما طاحونة ووابور لصناعة الثلج، وبالآخر منزل بشبابيك الزجاج والخرط. وفى شمال هذين الوابورين وابور للخواجة خراقه للحلج وبه طاحون ومنزل سكنى.
وفى بحريه وابور على شاطئ البحر للخواجة فليكى وشركائه للحلج أيضا وفيه طاحون ومنزل سكنى، وهو بقوة اثنى عشر حصانا. وفى شماله وابور للخواجة أصلان على شاطئ البحر للحلج أيضا، قوته ستة عشر حصانا ، وبه منازل سكنى. وفى شماله وابور للدائرة السنية بجوار السكة الحديد من الجهة الغربية للحلج ، قوته خمسة وعشرون حصانا. وفى شماله على شاطئ بحر مويس غربى السكة الحديد وابور للخواجة بلنطة ، بقوة خمسة وعشرين حصانا للحلج ، وبه ورشة لتعمير الآلات الوابورية ومكبس للقطن ومنزل مشيد ، وفى شماله حديقة نضرة.
وبجوار السكة الحديد فى مقابلة وابور ابن هائم وابور للخواجة كوكله ، وبه طاحونة ومحل سكنى. وفى شماله وابور حلج للخواجة نيما ، بقوة خمسة عشر حصانا ، وبه ورشة لتعمير الآلات أيضا.وبجواره من بحرى وابور حلج أيضا للخواجة بايدويلى ، بقوة خمسة عشر حصانا ، وبه منزل مشيد.
وفى غربى ترعة السكة الحديد وابور قوته ستة عشر حصانا لحسن أفندى المدنى ، وبه منزل حسن. وعلى تلك الترعة أيضا وابور قوته عشرون حصانا للخواجة ويلكنسون ، كامل البناء ناقص الآلات ، وبه منزل مشيد ، وعليها أيضا وابور بقوة ستة عشر حصانا للخواجة ماريت معد للطحين. ووابور طحين للخواجة جاد اليهودى على ترعة المسلمية فى شمال المسكن الشرقى، قوته ثمانية حصن. ثم وابور طحين للخواجة يوسف ملطى قوته ستة حصن.
وفى تلك المدينة وحواليها جملة بساتين – غير ما مرّ – كبستان المعلم غالى حنه فى غربى السكة الحديد بجوار السكن. وبستان للحاج أحمد الحريرى على الشاطئ القبلى لترعة الوادى فى شرقى السكة الحديد، وقد بنى بجواره منزلا. وآخر للخواجة ديوه من الدول المتحابة غربى السكة الحديد، وبنى بداخله منزلا بالآجر. وآخر لأولاد الزند فى بحرى السكن إلى جهة الشرق على شاطئ الترعة المسلمية ، وبه ساقية معينة وحوله أربعة منازل مشيدة لسكناهم. وجنينة غربى البلد تعلق محمد أفندى مسلى بالبر القبلى لبحر مشتول، وبها منزل. وجنينة للخواجة أسير باكوكه من الدول المتحابة وبها ساقية معينة.
ولم تزل العمائر فى تلك المدينة آخذة فى الازدياد ، لا سيما بعد إنشاء السكة الحديد العمومية بها، يرد إليها الفرع الطوالى الآتى من الإسكندرية وفرع السويس وفرع المنصورة وفرع المحروسة المار على بلبيس. وفى سوقها الكبير الممتد من الجنوب إلى الشمال – كامتداد بحر مويس – جميع أصناف الملبوسات ، وفى وسط السكن حلقة معدة دائما لبيع القطن ، يجتمع فيها التجار وكثير من القبانية ، وحوالى الحلقة حوانيت وحواصل وفنادق لخزن القطن ، وبجوارها من الجهة البحرية ساحة لبيع الغلال والأبزار. وكافة أهل المدينة تجار وأرباب حرف. وبها مكاتب أهلية لتعليم القراءة والكتابة.
وفى شمال المدينة كفر الحصر ، أغلب أهله يصطنعون الحصر ، وبهذا الكفر تجار أيضا وأرباب حرف ، وهو على الشاطئ الغربى لبحر مويس ، وبه منازل مشيدة لقاضى المديرية سابقا ، المرحوم محمد أفندى جبر وأخوته ، ولهم فى بحرى هذه المنازل جنينة ذات فواكه وأزهار وساقية معينة ، وبه مكتب أهلى. وسوق المدينة العمومى كل يوم ثلاثاء. وفى جنوب المدينة الشرقى تل قديم يقال له تل بسطه فى بحرى السكة الحديد الموصلة إلى المحروسة ، بينه وبين السكة نحو خمسمائة متر ، يبلغ متوسط ارتفاعه نحو عشرين مترا ومساحته نحو ستمائة فدان وتأخذ منه الأهالى السباخ إلى الآن.

هرية رزنة وبني عامر
تحتفل محافظة الشرقية بعيدها القومي في التاسع من سبتمبر من كل عام إحياء لذكرى وقفة الزعيم أحمد عرابي ابن قرية هرية رزنة أمام الخديوي توفيق في مثل هذا اليوم عام 1881 م مطالبا بحقوق الشعب والعمل بالدستور ، وتقع هرية رزنة اليوم في مركز الزقازيق واسمها القديم هريا الغز نسبة لجماعات من الأتراك الأوغوز الذين سكنوها في العصر الأيوبي ثم منحت لقبائل بني عامر في أواخر العصر المملوكي مع كل من منية الذويب التي عرفت باسم بني عامر وهريا الغربية التي عرفت باسم هريا العرب (بنايوس الحالية والتي صارت من ضواحي الزقازيق).
وجاء تفصيل ذلك في كتاب التحفة السنية حيث يقول ابن الجيعان في القرن التاسع الهجري : ” هريا الشرقية وهي هريا الغز مساحتها 950 فدان بها رزق 7 أفدنة عبرتها 1800 دينار للعربان ، هريا الغربية مساحتها 1305 أفدنة بها رزق 13 فدانا كانت للمقطعين والآن باسمهم والعربان وأوقاف وأملاك ، منية الذؤيب مساحتها 1560 فدان بها رزق 58 فدان عيرتها كانت 2000 دينار ثم استقرت بحق النصف كانت باسم الأمير قرابغا الأحمدي والآن ملك أسنبغا الطياري “.
وجاء في القاموس الجغرافي : هرية رزنة قرية قديمة اسمها الأصلي هريا الشرقية وردت في قوانين ابن مماتي وفي المشترك لياقوت وفي تحفة الإرشاد ، وفي التحفة هريا الشرقية وهي هريا الغز لأن سميتها وهي هريا الغربية كانت تسمى هريا العرب وذلك لأنه نزل بالشرقية منها جماعة من الغز وهم الترك فعرفت بهم ونزل بالغربية جماعة من العرب فعرفت بهم ، ووردت في الانتصار هريا الشرقية العرب وفي تربيع سنة 933 هـ هريا الشرقية وهي هريا الغز ثم غير اسمها في العهد العثماني فوردت في دفتر المقاطعات سنة 1079 هـ باسم هرية الرزنة وفي تاريخ سنة 1228 هـ برسمها الحالي.
بني عامر : هي من القرى القديمة اسمها القديم منية الدويب وردت به في قوانين ابن مماتي وفي تحفة الإرشاد والانتصار من أعمال الشرقية وفي دفتر المقاطعات سنة 1079 هـ منية الدويب المعروفة ببني مصطفى وفي تاج العروس تجريدة عامر قرية بشرقية مصر وفي دليل سنة 1224 هـ منية الدويب وفي الأحباسي دويب ، وقد سميت بني عامر في العهد العثماني حيث وردت في خريطة الحملة وفي تاريخ سنة 1228 هـ وفي الخطط التوفيقية حماية دويب وهي بني عامر بقسم الزقازيق ، ويوجد بأراضي ناحية الشبانات المجاورة لهذه القرية حوض الدويبة نسبة إلى الاسم القديم لبني عامر هذه.
بنايوس : قرية قديمة اسمها الأصلي هريا الغربية وردت في قوانين ابن مماتي وفي تحفة الإرشاد وفي التحفة من أعمال الشرقية ووردت في المشترك لياقوت هريا القبلية بكورة الشرقية ، ووردت في الانتصار محرفة باسم هرتا الغربية العرب ، وفي تربيع سنة 933 هـ هريا الغربية وهي هريا العرب لتمييزها من هريا الشرقية وهي هريا الغز ، وفي تاريخ سنة 1228 هـ هريا العرب وهي كفر بنايوس إذ غير اسمها في التاريخ المذكور وسميت كفر بنيوس نسبة إلى كبير من أعيانها القبط في ذاك الوقت كان يسمى بنيوس ، وفي تاريخ سنة 1259 هـ باسمها الحالي وهو بنايوس بغير مضاف.
وفي الخطط التوفيقية : بنايوس قرية من مركز القنيات بمديرية الشرقية ، غربى الزقازيق إلى جهة بحرى بنحو ألف وخمسمائة متر ، واقعة على البر البحرى لبحر بهنباى ، وبها مجلسان للدعاوى والمشيخة ، ومسجد بمنارة وزوايا عامرة بالصلاة ، ومكاتب أهلية ، وبها ضريح ولى الله الشيخ عطية البندارى ، يزار ويعمل له مولد كل سنة ثمانية أيام ، وتنصب فيه الخيام وتذبح الذبائح ويكون البيع والشراء ، وتجعل هناك قيساريات بدكاكين بعضها ثابت وبعضها ينقل ، وأهلها يتسوقون سوق الزقازيق ، وأطيانها ألف وتسعة وخمسون فدانا وكسر ، وأهلها ألف وتسعمائة وسبع وثمانون نفسا.

الشبانات
جاء في القاموس الجغرافي : ” كان يوجد قرية قديمة تسمى معشوقة برغوت وردت في التحفة من أعمال الشرقية ولما أعيدت مساحة الأراضي المصرية في تربيع سنة 933 هـ لوحظ أن هذه القرية خربت فقيد الزمام التابع لها باسم الشبانات لأنها كانت أكبر توابع ناحية معشوقة برغوت في ذلك الوقت ، وورد في دليل سنة 1224 هـ معشوقة برغوت قال وتعرف بالشبانات بولاية الشرقية.
وأما معشوقة برغوت التي خربت فمكانها اليوم عزبة عثمان بك شكري من توابع ناحية الشبانات ، وأما الشبانات فهم جماعة من العرب ينسبون إلى عميد أسرتهم الذي يدعى شبانة مؤسس هذه القرية ” ، وذكر ابن الجيعان في القرن التاسع الهجري أنها لم تعد من إقطاعات المماليك وإنما من حصص القبائل العربية فقال : ” معشوقة برغوت مساحتها 2500 فدان بها رزق 84 فدان عبرتها 2100 دينار ، للعربان “.
وجاء في الخطط التوفيقية : الشبانات قرية من مديرية الشرقية بمركز العلاقمة ، فى غربى الزقازيق بنحو سبعة آلاف متر ، وفى جنوب بنى عامر بنحو ألفين وخمسمائة متر ، وسكة الحديد المارة من الزقازيق إلى أبى حماد فى جنوبها بنحو خمسمائة متر ، وبها جامع بلا منارة ، ويزرع فى أرضها القطن ، وللمرحوم محمود باشا الفلكى بها أطيان وفيها نخيل ، وليس لها سوق ، وأكثر أهلها مسلمون.
وقد نشأ من هذه القرية إبراهيم أفندى رمضان أحد معتمدى علماء الرياضة بمدرسة المهندسخانة ، تربى على يديه خلق كثيرون برعوا فى الرياضة وترقوا فى الرتب ، فمنهم الباشاوات والبيكوات ، ونحن أيضا أخذنا عنه ، وله علينا التربية والأستاذية ، توجه إلى البلاد الفرنساوية وحضر منها سنة ألف ومائتين وإحدى وخمسين ، وأقام نحو سنة فى مدرسة طرا بوظيفة معاون مع الأمير مظهر باشا ، وفى سنة اثنتين وخمسين وظف بالتدريس فى مدرسة المهندسخانة.
واستمر على ذلك مدة ، وتنقل الرتب ، وفى زمن المرحوم عباس باشا مدة نظارتنا على المهندسخانة أنعم عليه برتبة قائم مقام ، وفى زمن المرحوم سعيد باشا كان من ضمن مهندسى معيته ، وقد توفى سنة إحدى وثمانين وكان إنسانا سهلا الأخلاق لين العريكة حسن الإلقاء ، درس فى عدة فنون سيما الطبوغرافيا والجودوزية ، والعلوم الوصفية ، كالظل والنظر وقطع الأحجار والأخشاب والهندسة الوصفية ، وله فى ذلك مؤلفات مفيدة مستعملة فى المدارس.
وشهدت القرية مواجهات مع قوات الاحتلال البريطاني في يوم 25 مارس عام 1919 م حيث قتل جندي من الهنود فقام البريطانيون بإحراق منازل القرية كلها بعد أن نهبوها وأخرجوا الأهالي بالقوة إلى الحقول حيث توفيت إحدى السيدات ، وألقوا القبض على العمدة وخمسين شخصا من أعيان البلد وشيوخها ، واستمرت النار مشتعلة في القرية لمدة يومين واضطر جنود الاحتلال وقائدهم للانسحاب خفية في الليل خشية انتقام الأهالي منهم عندما تأتيهم إمدادات البلاد المجاورة ولم يعودوا إلى القرية بعد ذلك.

القنايات وأجوارها
جاء في القاموس الجغرافي : ” القنايات هي من القرى القديمة اسمها الأصلي القينيات وردت به في قوانين ابن مماتي وفي التحفة من أعمال الشرقية وفي تحفة الإرشاد محرفة باسم القنينات ، وفي تاريخ سنة 1228 هـ برسمها الحالي وفي الخطط التوفيقية القنيات ، وفي سنة 1860 قسمت هذه القرية من الوجهة الإدارية إلى ناحيتين وهما كفر محمد مباشر وكفر خليل إبراهيم وقد استمر هذا التقسيم إلى سنة 1892 وفيها صدر قرار بإلغائه وجعلها ناحية واحدة في الإدارة كما هي في المالية باسم القنايات.
وفي سنة 1864 ألغي قسم شيبة النكارية ونقل ديوان المركز إلى بلدة القنايات باسم قسم القنايات وكان مقره كفر محمد مباشر أحد الكفرين اللذين يتكون منهما سكن قرية القنايات ، وفي سنة 1884 نقل المركز إلى مدينة الزقازيق مع بقائه باسم مركز القنايات وفي سنة 1896 سمي مركز الزقازيق وبذلك ألغي مركز القنايات.
النكارية : هي من القرى القديمة اسمها الأصلي خربة النكارية وردت به في المشترك لياقوت وفي قوانين ابن مماتي وفي تحفة الإرشاد وفي الانتصار من أعمال الشرقية ، ووردت في التحفة باسم حوض النكارية ثم حذف صدر الاسم فوردت باسم النكارية في تاريخ سنة 1228 هـ وهو اسمها الحالي.
شيبة النكارية : قرية قديمة اسمها الأصلي شيبة شقارة وردت في قوانين ابن مماتي وفي تحفة الإرشاد من أعمال الشرقية وفي الانتصار شيبة سقارة من الأعمال المذكورة ، وفي تربيع سنة 933 هـ وردت باسم شيبة النكارية بسبب مجاورتها لناحية النكارية كما ورد في دفتر المقاطعات سنة 1079 هـ وفي تاريخ سنة 1228 هـ وهو اسمها الحالي.
بني إشبل : هي من القرى القديمة اسمها الأصلي بني شبل وردت به في قوانين ابن مماتي وفي تحفة الإرشاد وفي التحفة من أعمال الشرقية ووردت في تاريخ سنة 1228 هـ برسمها الحالي ، تل حوين : هي من القرى القديمة اسمها الأصلي كوم حيوين وردت به في قوانين ابن مماتي وفي تحفة الإرشاد من أعمال الشرقية ووردت في التحفة باسم تل حيوين من أعمال الشرقية وفي تاريخ سنة 1228 هـ برسمها الحالي “.
وجاء في الخطط التوفيقية : ” القنيات بلدة من بلاد الشرقية فى غربى مدينة الزقازيق بنحو ستة آلاف وأربعمائة متر ، وغربى بحر مويس ، وهى رأس مركز ، بها ديوان بمركز وضبطية ، وقاضى شرعى وحكيم ومهندس ، ومجلس دعاوى وآخر للمشيخة ، وفيها نخيل بكثرة ومساجد ومكاتب وأضرحة لبعض الأولياء ، وبها تجار فى القطن وغيره ، وأرباب حرف كنسج القطن والصوف ، ولها سوق عمومى كل يوم أحد تباع فيه المواشى وخلافها ، وعدد أهلها نحو خمسة آلاف نفس ، وقدر أطيانها أربعة آلاف وخمسمائة فدان ، والطريق التى بينها وبين الزقازيق على بر الترعة الإسماعيلية الجنوبى.
وقد نشأ من هذه القرية الحكيم الماهر الحاذق حضرة سالم باشا سالم ، وقد سألته عن ترجمته ، فكتب لى ما نصه : «إن أصل والدى من عائلة من الشرقية ، ببلدة تسمى بالقنيات ، قريبا من الزقازيق بنحو ساعة ، وحضر إلى المحروسة سنة ست وثلاثين تقريبا لطلب العلم بالأزهر ، وتلقى عن جملة مشايخ منهم : الشيخ حسن القويسنى ، والشيخ إبراهيم البيجورى ، والشيخ حسن العطار ، ومن ماثلهم من العلماء الفخام ، وتشرف بالخدمات الميرية بوظيفة واعظ بالألايات المصرية المتوجهة نحو الشام سنة ٤٨ ثمان وأربعين ، ففى غيبته هذه ولدت وسميت باسمه “.

البيوم
البيوم قرية تتبع مركز الزقازيق بالشرقية وكانت تتبع الدقهلية سابقا ، جاء عنها في الخطط التوفيقية : ” بيوم قرية من مديرية الدقهلية بمركز منية غمر بحرى سنبارة الميمونة بنحو ثلاثة آلاف متر ، وفى شرقى ناحية مسكه بنحو ثلاثة آلاف ومائتى متر ، وفى جنوب ناحية جصفا بنحو ألفين وخمسمائة متر ، بها مساجد وأنوال لنسج الأقمشة ، وفيها دوّار لأوسية المرحوم مظهر باشا وأكثر أهلها مسلمون.
وفيها محل يقال إنه خلوة الشيخ على البيومى فلذا لا يفتح إلا فى زمن مولده الذى يعمل بمصر ، وبجوارها ضريح ولىّ يقال له الشيخ حجازى ولعله هو والد الشيخ البيومى ، وإليه تنسب القنطرة الحجازية التى على ترعة هناك ، وعلى تلك الترعة جملة توابيت وقد ترجم الجبرتى الشيخ البيومى”.
جاء في تاريخ الجبرتي عن الشيخ البيومي : ” هو الولى الصالح المعتقد المجذوب العالم العامل الشيخ علىّ بن حجازى بن محمد البيومى الشافعى الخلوتى ثم الأحمدى ، ولد تقريبا سنة ثمان ومائة وألف وحفظ القرآن فى صغره ، ثم طلب العلم فحضر الأشياخ وسمع الحديث والمسلسلات على الشيخ عمر بن عبد السلام التطاونى.
وتلقن طريقة الخلوتية من السيد حسين الدمرداشى العادلى وسلك فيها مدة ثم أخذ طريقة الأحمدية من جماعة من الأفاضل ، ثم حصل له جذب ومالت إليه القلوب وصار للناس فيه اعتقاد عظيم ومشى كثير من الخلق على طريقته وأذكاره وصار له أتباع ومريدون.
وكان يسكن الحسينية ويعقد حلق الذكر فى مسجد الظاهر خارج الحسينية ، وكان يقيم به هو وجماعته لقربه من بيته ، وكان ذا واردات وفيوضات وأحوال غريبة وألف كتبا عديدة ، منها شرح على الجامع الصغير ، وشرح على الحكم لابن عطاء الله ، وشرح الإنسان الكامل للجيلى ، وله مؤلف فى طريق القوم خصوصا فى طريق الخلوتية الدمرداشية ، ألفه سنة أربع وأربعين ومائة وألف ، وشرح على الصيغة الأحمدية وعلى الصيغة المطلسمية وله كلام فى التصوف.
وكان إذا تكلم أفصح فى البيان وأتى بما يبهر الأعيان ، وكان يلبس قميصا أبيض وطاقية بيضاء ويعتم عليها بقطعة شملة حمراء لا يزيد على ذلك ولا ينقص شتاء ولا صيفا وكان لا يخرج من بيته إلا فى كل أسبوع مرة لزيارة المشهد الحسينى وهو على بغلته وأتباعه بين يديه يعلنون بالتوحيد والذكر وربما جلس شهورا لا يجتمع بأحد من الناس.
وكانت عليه مهابة الملوك وإذا ورد المشهد الحسينى يغلب عليه الوجد فى الذكر حتى يصير كالوحش النافر ، وإذا جلس بعد الذكر تراه فى غاية الضعف ، ولما كان بمصر الوزير مصطفى باشا مال إليه واعتقده وزاره فقال له إنك ستطلب إلى الصدارة فى الوقت الفلانى فكان كما قاله.
فلما ولى الصدارة بعث فى مصر وبنى له المسجد المعروف به بالحسينية وسبيلا ومكتبا وقبة وبداخلها مدفن للشيخ على يد الأمير عثمان أغا وكيل دار السعادة وكان موته فى سنة ثلاث وثمانين ومائة وألف ولما مات خرجوا بجنازته إلى الجامع الأزهر وصلى عليه هناك فى مشهد حافل ودفن بالقبر الذى بنى له بمسجده المعروف به “.

الطيبة وكفر السطوحية
المنطقة الشمالية من مركز الزقازيق حاليا كانت موزعة في العصور الإسلامية ما بين القبائل العربية المتوطنة في الحوف الشرقي وما بين الإقطاعات المملوكية المحدودة في المنطقة والتي تمتد من أول دويدة والطيبة غربا وحتى مشتول القاضي وميت ظافر شرقا ، وقد ذكر ابن الجيعان حدود هذه الزمامات في القرن التاسع الهجري حيث يقول في كتاب التحفة السنية :
” الطيبة وما معها من منشية بركة مساحتها 377 فدان بها رزق 7 أفدنة ونصف عبرتها 3700 دينار للعربان بكمالها ، أم رماد من حقوق الطيبة مساحتها 1503 أفدنة بها رزق 24 فدانا للعربان ، بهناية الغنم مساحتها 3168 فدان بها رزق 89 فدان عبرتها 3325 دينار للمقطعين والعربان ، مشتول القاضي مساحتها 1114 فدا بها رزق 74 فدان عبرتها 4000 دينار كانت للمقطعين والعربان والآن باسمهم ووقف وملك ، دويدة مساحتها 1137 فدان عبرتها 2000 دينار كانت باسم الأمير طشتمر العلائي والعربان والآن باسم الديوان المفرد والعربان ، خربة زافر مساحتها 606 أفدنة بها زق 31 فدانا عبرتها 1000 دينار كانت باسم الأمير أحمد بن أرغون شاه الأشرفي والآن باسم الأمير تانبك الجمالي “.
وجاء في القاموس الجغرافي تفصيل تأسيس هذه القرى ومسمياتها حيث يقول محمد بك رمزي : الطيبة هي من القرى القديمة وردت في المشترك لياقوت بكورة الشرقية وفي قوانين ابن مماتي وفي تحفة الإرشاد من أعمال الشرقية ووردت في التحفة وما معها من منشية بركة زوالصواب من منية بركة وفي الانتصار الطييبة ومنية شريك وصوابه منية بركة المذكورة وع الطيبة هي التي تعرف اليوم بكفر السطوحية مركز ههيا المجاور لناحية الطيبة هذه ، أم رماد هي من القرى القديمة وردت في التحفة مع الطيبة من أعمال الشرقية وفي الانتصار وردت منفصلة عنها.
كفر السطوحية هو من القرى القديمة كان يسمى منية بركة وردت في التحفة من أعمال الشرقية ووردت في التحفة في موضع آخر مع الطيبة المتاخمة لهذا الكفر باسم الطيبة وما معها من منشية بركة وكلمة منشية هنا محرفة صوابها منية بركة كما وردت في التحفة وفي الانتصار ، ولا يزال يوجد في زمام ناحية كفر السطوحية هذه حوض باسم حوض المنيا مجاور لسكن الكفر ويدل على اسمه القديم ، وورد في موضع آخر من الانتصار الطيبة ومنية شريك وصوابه منية بركة لأن جزءا من أطيانها كان مضافا على الطيبة كما ورد في التحفة.
وفي تاريخ سنة 1228 هـ أضيف إلى زمام منية بركة على ناحية الطيبة وألغيت وحدتها من عداد النواحي فعرفت بكفر السطوحية نسبة إلى جماعة الأحمدية السطوحية المقيمين فيه ، وفي تاريخ سنة 1273 هـ فصل باسمه الحالي عن ناحية الطيبة وبذلك أصبح ناحية قائمة بذاتها.
مشتول القاضي هي من القرى القديمة وردت بهذا الاسم في المشترك لياقوت بكورة الشرقية ووردت في قوانين ابن مماتي وفي تحفة الإرشاد باسم تل مشتول من أعمال الشرقية وفي التحفة باسمها الحالي من الشرقية ، دويدة هي من القرى القديمة وردت في قوانين ابن مماتي وفي تحفة الإرشاد وفي التحفة من أعمال الشرقية.
ميت زافر قرية قديمة اسمها الأصلي خربة زافر وردت به في المشترك لياقوت وفي قوانين ابن مماتي وفي تحفة الإرشاد وفي التحفة من أعمال الشرقية وقد استمرت بهذا الاسم إلى أن وردت به في دليل سنة 1224 هـ ثم استبدلت كلمة خربة باسم منية فوردت في تاريخ سنة 1228 هـ باسمها الحالي المحرف وفي الخطط التوفيقية وردت منية ظافر بمركز الإبراهيمية بمديرية الشرقية والصواب منية ظافر فهي قرية أخرى تعرف اليوم باسم ميت ضافر بمركز دكرنس بمديرية الدقهلية.
بهناباي هي من القرى القديمة وردت في قوانين ابن مماتي وفي امشترك لياقوت وفي تحفة الإرشاد باسم بهنيا الغنم من أعمال الشرقية لتمييزها من بهنيا قرية أخرى بالشرقية وفي التحفة بهناية الغنم وفي الانتصار بهنباية الغنم ومنها جاء اسمها الحالي وهو بهنباي الذي وردت به في تاريخ سنة 1228 هـ ثم برسمها الحالي من سنة 1259 هـ.



