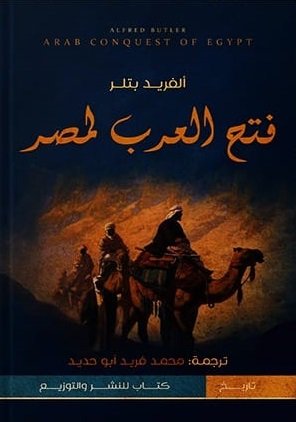
التاريخ المبكر
أول إشارة إلى المحلة الكبرى جاءت مبكرا من خلال المؤرخين المعاصرين للفتح الإسلامي حيث ذكرت بأوصاف عدة منها محلة أسفل الأرض ومدينة الريف ، ومن هذه الكتب تاريخ حنا النقيوسي الذي ذكر بالتفصيل المعركة التي دارت بالقرب من موضع المحلة قبل تأسيسها عندما وصفها بكلمة (مجمع الأقوام) أو في النص الأصلي (أرض الميليشيا) وتعني المنزل الذي حل فيه الجيش وأقام معسكره.
وتفصيل ذلك أنه في يناير عام 641 م وأثناء حصار حصن بابليون جاءت أخبار إلى عمرو بن العاص أن القائد العام للجيش الروماني تيودور قد خرج من الإسكندرية باتجاه وسط الدلتا فقرر التصدي له فترك قسما من الجيش على الحصار وتحرك باتجاه الشمال بمحاذاة فرع دمياط حيث طارد الحاميات الرومانية واستولى على كل من بنا وأبو صير بمعونة المصريين واستولوا على أموال الروم الفارين.
أرسل تيودور كتيبة بقيادة كابريوس وستفريوس لدخول سمنود والدفاع عنها لكن المفاجأة كانت من أهالي سمنود الذين أغلقوا أبواب المدينة ورفضوا التعاون مع الروم ، وهنا اضطر الروم للاشتباك مع الجيش العربي وباغتوه وألحقوا به خسائر كبيرة لكن في النهاية نجح العرب في صد الهجوم والاحتفاظ بمواقعهم ووضعوا حاميات في المنطقة بقيادة المقداد بن عمرو الكندي وعمير بن وهب الجمحي.
يقول حنا النقيوسي : ” وعندما وصل هؤلاء المسلمون مع المصريين الذين جحدوا عقيدة المسيحية وانضموا إلى عقيدة هذا المفترس احتاز الإسلام كل أموال المسيحيين الذين فروا وكانوا يدعون عبيد المسيح أعداء الله ، وترك عمرو كثيرا من آله في حصن بابليون بمصر وسار هو شرقا إلى تيودور الحاكم ناحية كلا النهرين الذي بقبري وستفري ليستوليا على مدينة سمنود وليقاتلا الإسلام (المسلمين).
وعندما بلغا (مجمع الأقوام) أبى جميع الأحزاب حرب الإسلام فجمع هذان أناسا وقتلوا كثيرا من المسلمين الذين كانوا معهم ولم يستطع المسلمون أن يلحقوا ضررا بالمدن التي تقع على كلا النهرين لأن المياه كانت حاجزا ولم تستطع الأفراس أن تدخل إليها لكثرة المياه التي تحيطهم فتركوها وساروا إلى (مدينة الريف) ، وجاءوا إلى مدينة بوصير فحصنوا المدينة والطرق التي استولوا عليها من قبل “.
وفي منتصف مدينة المحلة العربية القديمة يقبع مسجد العمرية وهو أول وأقدم مسجد في البلدة حيث يرجع إنشاؤه إلى عام 641 م الموافق 21 هـ في حي سوق اللبن حاليا ، وهو المسجد الذي وصفه المقدسي في كتابه أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم وحدد موضعه من البلدة وذلك قبل بناء بقية المساجد الأخرى مثل المتولي والغمري وأبي الفضل الوزيري والطريني والحريثي والحنفي وغيرهم والتي بنيت في عصور الفاطميين والمماليك.
وتقول الدكتورة سعاد ماهر في كتابها مساجد مصر وأولياؤها الصالحون أنه كان من عادة المسلمين في مصر تسمية أول مسجد في المدينة باسم العمري تيمنا بجامع عمرو بن العاص في الفسطاط ، لكن ربما كانت التسمية مرتبطة بالفعل بوجود عمرو بن العاص في المدينة وأجوارها حيث جاءت الإشارة إلى ذلك في كتابات المؤرخ المعاصر للأحداث يوحنا النقيوسي وهو واحد من أساقفة الكنيسة القبطية في القرن السابع الميلادي.
وقد فصل ألفريد بتلر في كتابه فتح العرب لمصر ما ذكره النقيوسي في كتابه من أن عمرو بن العاص قضى في الدلتا زمنا قدره اثني عشر شهرا أي عاما كاملا على فترتين ، المرة الأولى كانت أثناء حصار حصن بابليون كما سبق حيث اضطر الجيش الروماني للاصطدام في العراء مع الجيش الإسلامي في موضع أسماه النقيوسي مجمع الأقوام وفي النص الأصلي أرض الميليشيا أي المعسكر واستعمل لفظة مدينة الريف وهو المصطلح الذي عرفت به المحلة فيما بعد مثل الفسطاط مدينة مصر.
وإثر هذه المعركة تراجع عمرو ليحصن أبو صير بعد أن دفن الشهداء في موقع المعركة التي حدثت على تل عال غرب سمنود ، أما الحملة الثانية فكانت بعد حصار الإسكندرية عندما عبر عمرو بقواته إلى وسط الدلتا لإعادة استكشاف المنطقة واستغلال الشقاق الداخلي بين الرومان وسكان الدلتا حيث مر على سخا وطوخو وهي طوخ مزيد الحالية ودمسيس قبل أن يترك حامية صغيرة في غرب سمنود ويعود إلى الفسطاط للتفاوض.
وقد حفلت كتب السير والمغازي والحديث بذكر كثير من القادة الذين تعاقبوا على القيادة والولاية في المنطقة ، وأول من ذكر منهم هو الصحابي الجليل المقداد بن عمرو الكندي وكذلك فارس قريش المغوار عمير بن وهب الجمحي ، ثم تولى مسلمة بن مخلد الأنصاري فترة طويلة قبل أن يتم تعيينه واليا على مصر فاستخلف بعده عددا من مساعديه منهم رويفع بن ثابت الأنصاري وعبد الله بن أبي حذيفة العدوي وسعد بن قيس الأنصاري وهو سيدي سعد الدين المدفون في مسجده بالمحلة.
ومن القادة والولاة في زمن الأمويين حفص بن الوليد في ولاية الحر بن يوسف ثم فهد بن مهدي الحضرمي في ولاية حفص بن الوليد ، ومن القادة عبد الرحمن بن عتبة المعافري وعثمان بن أبي نسعة وعبد الجبار بن عبد الرحمن الأزدي ونصر بن حبيب المهلبي حيث كان دورهم جميعا قمع الثورات المحلية ، وفي نهاية القرن الثاني تولاها يزيد بن الخطاب الكلبي زعيم القبائل اليمانية التي انتقلت من شرق النيل وعرفت باسم عرب شرقيون حيث صارت المحلة مركز الأحداث السياسية.
ثم استولى عبد العزيز بن وزير الجروي الجذامي على المحلة وجعلها مقرا له حيث استقل عن الفسطاط فترة من الزمن ثم تولاها ابنه علي ثم أحمد بن السري بن الحكم ، وفي ثورة البشموريين استولى عليها عبد الله بن عبيدس الفهري لحساب الثوار يعاونه أبو ثور اللخمي لكنها سقطت بيد الأفشين بعد فشل الثورة ، وفي ثورة جابر بن الوليد المدلجي تولاها أبو حرملة النوبي وعبد الله بن الأرقط الطالبي ثم سقطت في يد محمد بن عبد الله الدبراني من قبل الوالي عبيد الله بن يزيد الشيباني.
وفي العصر الفاطمي تولاها ريان الصقلبي مولى الخليفة المعز لدين الله بعد أن حررها من القرامطة ، وقد عمرت وتوسعت المحلة في ذلك العهد بفضل جهود القاضي المسلم بن علي الرصعني والقاضي جلال الملك أبو الحجاج يوسف بن أيوب المغربي الأندلسي ، وفي الشدة العظمى استولى عليها الأمير ناصر الدولة بن حمدان التغلبي واستقل بها عن القاهرة ثم تكرر الأمر مع ولاتها مثل رضوان الولخشي وعباس الصنهاجي حيث الزحف منها إلى القاهرة والاستيلاء على الوزارة بالقوة.

سيدي سعد الأنصاري
كل مدينة عربية ارتبطت بشخص مؤسسها أو الشخصية الأهم في تاريخها أو صاحب المسجد الأشهر فيها مثل ارتباط الفسطاط بسيدنا عمرو بن العاص والقاهرة بالمعز الفاطمي والمنصورة بالملك الكامل وطنطا بالسيد البدوي ، وفي المحلة الكبرى كان الأمر مماثلا لذلك حيث الشخصية المركزية في البلدة هو سيدي سعد الأنصاري حيث يتكرر ذكره عند وصف أي معلم جغرافي في الكتب فيقال : ” بجوار سيدي سعد .. بخط (شارع) سيدي سعد .. مقابل مسجد الأنصاري .. إلخ “.
وقد عرف عند العامة في العصور الوسطى باسم سعد الدين الأنصاري حيث ظن البعض أنه من الصحابة وأنه القائد الذي فتح المحلة ورويت في ذلك الكثير من الروايات مثل مقاومة اليهود للجيش ، وهذه الروايات كلها غير دقيقة لأن مدينة المحلة لم تكن موجودة في العصر الروماني ليتم فتحها وإنما كانت هناك قرى متناثرة مثل هورين بهرمس شمالا بالقرب من محلة البرج حاليا وقرية داكالا جنوبا والتي عرفت قديما باسم ديدوسيا وأطلق عليها العرب اسم سندفا.
ووفقا لما جاء في كتابات حنا النقيوسي وأبي المكارم بن جرجس فقد قام العرب بتأسيس مدينة في التل الواقع بين بهرمس وسندفا وأطلقوا عليها اسم المحلة بمعنى منزل القوم لكن على الجانب الغربي من فرع النيل الذي يشق المنطقة ويفصل ذلك التل عن القريتين ، وعرفت المحلة في أول الأمر باسم مدينة الريف ومحلة أسفل الأرض ثم شرقيون ثم محلة الكبراء وبني فيها مسجد العمرية حيث كانت المحلة عبارة عن مقر إداري ولم يكن بها سكان من اليهود وقتها.
وقد رصد وجود عمرو بن العاص في المنطقة زمن الفتح ثم بعد ذلك تم تقسيم الدلتا إلى مناطق عسكرية وتولى قيادة الحامية العسكرية في المنطقة الصحابي عمير بن وهب الجمحي وهو من فرسان قريش المعدودين ، أما الضريح الموجود في المسجد المعروف باسم الأنصاري فهو ليس لأحد القادة الفاتحين وإنما هو لواحد من أبناء الصحابة وهو سيدنا سعد بن قيس بن سعد بن عبادة الساعدي الخزرجي الأنصاري حيث صارت المحلة مقرا لعشائر الأنصار منذ وقت مبكر.
ومن خلال استقراء مدونات الآثار المتاحة ومراجع التاريخ المعتمدة وكتب الأنساب ومرويات الصوفية وطبقات المحدثين يمكننا تتبع حركة قبائل الأنصار في مصر حيث كان عدد كبير منهم في جيش الفتح ضمن أهل الراية ومنهم من الصحابة قيس بن سعد بن عبادة صاحب شرطة رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن سيد الخزرج سعد بن عبادة والذي اختط دارا في الفسطاط عرفت باسم دار الفلفل وسكن بها بعض أولاده حيث تولى قيس فيما بعد ولاية مصر لفترة قصيرة.
الوجود الأكبر للأنصار في المحلة كان من خلال الصحابي مسلمة بن مخلد الساعدي الأنصاري الذي اختط دار الرمل بالفسطاط ثم بعد ذلك تولى ولاية مصر في عهد معاوية خمس عشرة سنة أعاد فيها بناء جميع المساجد في الفسطاط والإسكندرية والبهنسا وبلبيس والمحلة وأضاف لها المنائر ، وقد ولى على المحلة وأسفل الأرض الصحابي رويفع بن ثابت الأنصاري فضبط أمورها قبل أن ينتدب إلى برقة حيث يتفق ذلك التاريخ مع حادثة شديدة الأهمية أثرت على المنطقة.
ففي عام 53 هـ تعرضت السواحل المصرية الشمالية إلى هجوم روماني ضخم وكانت المفاجأة أن أسطول الروم لم يهاجم الإسكندرية التي كانت تتركز فيها غالبية الحامية العسكرية بل هاجم البرلس فانتدب لها القائد وردان مولى عمرو بن العاص حيث صد الهجوم واستشهد مع عدد من الصحابة ، وكانت مدينة سخا هي الأقرب بريا للبرلس لكن ظهرت أهمية وجود مراكز عسكرية أخرى مثل المحلة التي كانت متاحة للنقل البحري ثم صارت بعد ذلك من مراكز البريد الهامة.
ومنذ هذا التوقيت يبدأ ظهور الأنصار في الدلتا خاصة وقد كان الوالي مسلمة صهرا لآل سعد بن عبادة فكانت ابنته متزوجة من يحيى بن سعيد بن سعد بن عبادة وكان معروفا عنه الاستعانة بعشيرته من بني ساعدة ومن الأنصار عامة ، وقد وصفت حياة سعد بن قيس الأنصاري بالزهد والورع وكان ارتباط مسجده وضريحه بمسجد العمرية القريب منه يجعله شبيها بوضع عقبة بن عامر في القاهرة حيث أطلق عليه بعد مدة لقب سيدي سعد مثل سيدي عقبة في الفسطاط.
وقد تتابعت هجرات الأنصار إلى مصر بوتيرة عالية بعد معركة الحرة لكن العدد الأكبر ظل ممثلا في قبيلة بني ساعدة لأنها كانت قد خرجت مبكرا إلى مصر والشام ولم تتعرض للضرر في تلك الأحداث وانتشرت فروعها بشكل كبير ، ومن هذه الفروع سعد بن عبادة وأخويه سهل بن عبادة وعبادة بن عبادة وأولادهم ، ومن أولاد سعد بن عبادة رصد النسابون كل من ثابت وقيس وسعيد وسهل وعبد الله ومحمد وعبد الرحمن وإسحق وعدد من أولادهم وأحفادهم.
ومن أولاد قيس بن سعد كل من عبد الملك ويحيى وعبد الله وسالم وسعيد وسعد ومحمد وتمام ويعيش ، ومن أولاد سعيد بن عبادة كل من شرحبيل وخالد وإسماعيل وزكريا ومحمد وعبد الرحمن ويوسف ويحيى وعثمان وعبد العزيز ، وقد اهتم النسابون بذرية سعيد بن سعد بن عبادة لأنها كانت الأكبر عددا وتوزعت بشكل كبير في الشام ومصر والمغرب والأندلس حيث ذكرت بالتفصيل في كتاب أخبار قبائل الخزرج من تأليف الحافظ شرف الدين أبي محمد عبد المؤمن بن خلف الدمياطي.
وقد حظيت المحلة بمقام سيدي سعد بن قيس الأنصاري وقرابته وهم من دوحة جليلة فهم من أكرم بيت في الخزرج أصحاب سقيفة بني ساعدة وجده أحد السعدين من سادة الأنصار وأبوه قيس بن سعد من أهل الكرم والجود وحامل لواء النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة ، وكان مستقره بالقرب من مسجد العمرية ثم اتخذ لنفسه مكانا قريبا صار بعد ذلك موضع ضريحه حيث بنيت القبة في القرن الثاني الهجري في أعقاب زوال حكم الأمويين مباشرة.
وينتسب لسيدنا سعد بن قيس واحدة من أهم عشائر الأنصار في المحلة وأجوارها وهي عائلة سعادة التي انتشرت فروعها في العصور الوسطى وعرفت في العصر العثماني باسم عائلة سعاد والسعايدة والأسعاد وقد ذكرها المؤلف ياسر بن حميد آل عبد الوهاب الخزرجي في كتابه تاريخ قبائل الأنصار في سائر البلدان والأقطار ، ودعم ذلك برصد ميداني للأسر والعائلات الأنصارية في ربوع مصر وذكر اهتمامهم بضريح جدهم الذي جدد في القرن الخامس الهجري.
وكان العصر الفاطمي قد شهد اهتماما بأبناء وذرية قيس بن سعد بن عبادة لأنه في مذهب الشيعة من أتباع الإمام علي ، وقد بني المسجد في العصر الفاطمي بجوار القبة وأعيد بناؤه بواسطة محمد بك الكاشف في القرن التاسع عشر ويعرف اليوم باسم مسجد الكاشف ، وقد جاء ذكره في كتاب مستدركات علم رجال الحديث من تأليف الشيخ علي النمازي الشاهرودي وهو من مراجع الشيعة ووصف فيه بأنه من كبار التابعين ورؤسائهم ومن المعروفين بالزهد والورع.
وإلى هذا الفرع ينتسب الشيخ سلامة بن عامر دفين قرية صفط رزيق مركز ديرب نجم شرقية وهو والد المتصوف الكبير الشيخ غنيم بن سلامة السعدي مؤسس الطريقة الصوفية الغنيمية والمتوفي عام 503 هـ دفين قرية كوم حلين مركز منيا القمح شرقية وأولاده إدريس وعيسى ومحمد ويوسف ، ومن ذريتهم الإمام القاضي صاحب المؤلفات العلامة شهاب أحمد بن محمد بن علي الغنيمي الخزرجي الأنصاري المتوفي عام 1044 هـ وهو من قرية أبو عفل مركز الحسينية شرقية.
وفي أجوار المحلة أبناء عمومتهم من بني سعد بن عبادة والمعروفين باسم بني سعد في محلة أبي الهيثم (الهياتم حاليا) وسميت على اسم أبو الهيثم كثير مولى عقبة بن عامر حليف الأنصار ومن أبنائها الإمام ابن حجر الهيتمي السعدي الأنصاري ، وفي قرية بلقينة عشائر البقيرية والتي تشمل بني ساعدة وحلفائهم من الأنصار من فروع متعددة حيث تمتد منازلهم من أول محلة الداخل والعامرية والجابرية وحتى محافظة الشرقية ومنهم عائلات الفقي في محافظة الغربية والمنوفية.
وعرفت المحلة منذ بداية تأسيسها بأنها واحدة من المراكز الهامة لعشائر الأنصار وعلى رأسهم صاحب المسجد المعروف فيها سيدنا سعد بن قيس بن سعد بن عبادة (سيدي سعد الأنصاري) حتى صارت كتب السير والأعلام تقرن دائما بين لقبي الأنصاري والمحلي فصار كل من ينتسب إلى المحلة من الأنصار إلا إذا كان له نسب معروف لقبيلة أخرى ، وقد كانت مصر في العصر الأموي معبرا للكثير من الأنصار في طريقهم إلى المغرب ثم الأندلس حيث حظيت ذرية قيس بن سعد باهتمام المؤرخين بسبب انتساب عدد كبير من أعلام الأندلس لها ثم عودتهم إلى مصر تباعا.
ومن أشهر رجالات الأندلس من هذا الفرع الثائر المعروف الحسين بن يحيى بن سعيد بن قيس بن سعد الساعدي الخزرجي والمعروف بلقب العربي والذي قاد الثورة على حكم الأمويين في الأندلس عام 165 هـ ، ومنهم حفيده طبيب الأندلس الأشهر أبو الحسن علي بن عبد الرحمن بن يوسف العبادي الطليطلي ، ومن نفس الفرع ينحدر اثنان من أشهر أولياء الإسكندرية العائدين من الأندلس وهما سيدي أبو العباس المرسي وسيدي جابر بن إسحق أصحاب المساجد المعروفة في الثغر.
وأهم أسرة أندلسية من هذا الفرع هم ملوك غرناطة من آل الأحمر أحفاد نصر بن سعد بن علي بن يحيى بن سعد بن قيس بن سعد بن عبادة ومن ذريتهم قبيلة الزغل المشهورة التي عادت إلى مصر بعد سقوط الأندلس ومنها انتقلت إلى اليمن والأردن وترجع في نسبها إلى حاكم غرناطة قبل الأخير وهو أبو عبد الله محمد بن سعد بن الأحمر المعروف بلقب الزغل أي الشجاع والذي انتقل بعشيرته إلى تلمسان وعرفت ذريته هناك باسم بني سلطان الأندلس ومنها عادوا إلى المشرق.
وقد جاء في الموقع الرسمي لقبائل الزغل في الأردن : ” يعود تواجدهم في الأردن منذ أواخر القرن السادس عشر حيث ارتحل جدهم الشيخ مصطفى الخطيب بن الزغل من المغرب العربي مع أخيه حسن بن الزغل إلى المحلة الكبرى في مصر ثم بقي الجد حسن فيها ومن ذريتة عائلة كبيرة تدعى الزغل ، أما الجد مصطفى فقد توجه إلى العريش ومنها إلى الخليل فلسطين ثم إلى الكرك الأردن ، ومنهم من توجه إلى عنجرة جبل عجلون وقسم إلى سلوان القدس “.
أما الموجة الأخيرة فكانت من عشيرة الشوافعية وهي فرع من قبيلة المعابدة ذات الانتشار الواسع في صعيد مصر والإسكندرية وتنحدر من ذرية الشاعر الأندلسي الكبير أبي بكر عبادة بن عبد الله بن محمد المعروف بلقب ابن ماء السماء ، وقد انتقلت ذريته إلى مصر في أوائل العصر العثماني واستقر فرع منهم في المحلة الكبرى حيث أسسوا حي عرب الشوافعية وبنوا مسجدهم المعروف وقد عرفوا بالقوة والبأس حيث كان لهم الدور الأكبر في مقاومة الحملة الفرنسية أثناء ثورة المحلة.
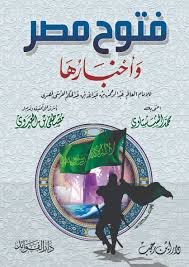
أهل الراية والتكوينات القبلية
في حي مصر القديمة بالقاهرة لا يزال الشارع المحيط بمسجد عمرو بن العاص يحمل حتى يومنا هذا اسم أهل الراية حيث عرف مركز الفسطاط بخطة أهل الراية وهم جماعة من قريش والأنصار وخزاعة وأسلم وغفار ومزينة وأشجع وجهينة وثقيف ودوس وعبس بن بغيض وجرش من بني كنانة وليث بن بكر لم يكن لكل منهم من العدد ما ينفرد به بدعوة من الديوان.
فجعل لهم عمرو بن العاص راية لم ينسبها إلى أحد وقال يكون وقوفكم تحتها فكانت لهم كالنسب الجامع وكان ديوانهم عليها فعرفوا بأهل الراية وانفردوا بخطة وحدهم كانت من أعظم الخطط وأوسعها وكانت عادة العرب أن يتجمعوا وفق التقسيم القبلي لذلك فإن خطة أهل الراية كانت مقسمة إلى حارات فرعية بحيث تسكن كل قبيلة في حارة خاصة بها.
وبمرور الوقت أصبح مصطلح أهل الراية يعني المهاجرين والأنصار من سكان الفسطاط وظل هذا اللقب معهم عندما نزحوا إلى الدلتا لأسباب متعددة منها نظام الارتباع المقصود به رعي الخيول في الريف وقد ذكر ابن عبد الحكم مواضع أهل الراية فيه ، ثم جاء الانتقال الثاني لأسباب سياسية بعد وقعة ابن الزبير عندما قام مروان بن محمد بنفي أنصاره من الفسطاط إلى مواضع عدة في الدلتا.
وقد دفن عدد من الصحابة والتابعين في المحلة وأجوارها منهم الصحابي الجليل عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي حليف بني سهم في قرية صفط تراب جنوب المحلة وقد عرف بلقب شيخ المصريين وفيها قبره معروف ، ومن التابعين أبو الهيثم كثير المصري مولى عقبة بن عامر الجهني حليف الأنصار حيث سميت به قرية محلة أبي الهيثم جنوب المحلة وهي قرية الهياتم حاليا وفيها قبره معروف.
ثم جاء الانتقال الكبير للقبائل العربية إلى الدلتا في عام 218 هـ عندما قرر الخليفة المعتصم بالله العباسي قطع العرب من ديوان الجند واستبدالهم بالأتراك فخرجت أعداد كبيرة من الفسطاط وتوطنت في وسط الدلتا وأسست عددا من القرى الجديدة منها القرشية والجعفرية وغيرها ، وفي العصر الفاطمي نزحت أعداد كبيرة منهم إلى مدينة المحلة الكبرى بعد عمرانها للعمل والتجارة والإقامة.
وظلت المحلة طوال العصور الإسلامية الأولى مركز عسكريا لإدارة العمليات الحربية في الدلتا ومقر للحكام العرب وشيوخ القبائل ولم يكن لها زمام زراعي وكانت من الناحية الجغرافية تقع مقابل قرية سندفا (ديدوسيا القديمة) وقرية بهرمس وكلاهما يتبع كورة سمنود وبنا وأبو صير ، وقد جاء في موقع تاريخ الاقباط تأكيد الطبيعة العسكرية للمدينة حيث يقول : ” وحينما أتت جحافل الغزاة العرب المسلمين لغزو مصر أقاموا على تل ديدوسيا القريب من المدينة وأسموها محلة الكبراء “.
المجموعات القبلية الأولى التي أسست المدينة كانت من أهل الراية وهو خليط من قريش والأنصار وخزاعة وكنانة وغيرهم ثم لحقت بهم هذيل بسبب نظام الارتباع حيث كانت منازلهم في الريف الممتد من بحر المحلة وحتى فرع دمياط ، وكانت الأكثرية من عشائر الأنصار حتى كان اللقب محلي عند كتاب السير الذاتية يعني الأنصاري والعكس وكانت منازلهم في الغرب باتجاه قرى أكبر العشائر الخزرجية وهي البقارية في العامرية والجابرية والدواخلية والمعتمدية حاليا.
وأسست العشائر العربية من هذيل وأهل الراية قرى محلة أبو علي ومحلة زياد ومحلة حسن ومحلة القصب في نهاية القرن الأول الهجري وفق العملات المكتشفة في بعض مساجدها وكذلك السجلات الرسمية للمسح الجغرافي المتعاقب وهي إحصاء الفاطميين ثم الروك الصلاحي والناصري والتربيع العثماني ، وفي القرن الثاني الهجري وفدت القبائل اليمانية وهم عرب شرقيون بسبب الاضطرابات السياسية في الحوف الشرقي وضمت أغلبية من جذام ولخم وكانت لهم الإمارة فترة طويلة.
بعد ذلك حدثت هجرة كبرى من شرق النيل تمثلت في القبائل القيسية التي استولت بالقوة على المحلة وأجوارها وانتشرت في منطقة البراري وتأسست عدد من القرى منها حامول العرب ، وفي الشدة المستنصرية هجمت قبيلة لواتة المغاربية خلف جيشها المقدر بأكثر من أربعين ألف مقاتل وسيطرت على الدلتا كله بالقوة وطردت منه قسما من القيسية إلى جزيرة إبيار (بني نصر) ناحية كفر الزيات الحالية ثم لحقتها قبيلة طيء واستقر لهما الأمر في عهد صلاح الدين بسبب مناصرتهم له ضد الفاطميين.
وتعددت أسماء المحلة بسبب تعدد المكونات القبلية لأنها عندما تأسست في القرن الأول الهجري وسكنتها عشائر متعددة من الأنصار وهذيل وكنانة عرفت لديهم أول الأمر باسم محلة أسفل الأرض حيث كان الدلتا قد قسم إلى الحوف الشرقي والحوف الغربي وأسفل الأرض وبطن الريف ، ثم أطلق عليها محلة دقلا نسبة لأقرب حوض زراعي لها في زمام قرية سندفا وكان ملكا لرجل يدعى ابن دقلا وهو دكالا في سجلات الرومان ، وفي القرن الثاني الهجري تتابعت هجرات العرب القيسية واليمانية إليها من الحوف الشرقي فعرفت باسم محلة شرقيون .
وكانت المدينة متوسطة الموقع وتطل على فرع كبير من النيل فسهل لها التواصل مع كافة أرجاء الدلتا وسهل ذلك التعامل السريع مع كافة المكونات السكانية الأقدم في المنطقة ، وكان العرب قد وصفوا من سبقهم من سكان مصر فأطلقوا اسم النوبة على سكان الجنوب عند أسوان وأطلقوا اسم الروم على من بقي من البيزنطيين في الإسكندرية وبعض مناطق شمال وغرب الدلتا وأطلقوا اسم النبطيين على الناطقين بالسريانية في شرق الدلتا ، أما الغالبية العظمى فقد عرفت بالاسم التاريخي وهو القبط.
لكنهم لسبب غير واضح قد قسموا القبط إلى أربعة أقسام ، ربما كان تقسيما جغرافيا أو لغويا أو مذهبيا فأطلقوا على أقباط الصعيد اسم المريس وميزوا بينهم وبين سائر الأقباط ، وأطلقوا على سكان شمال الدلتا في النطاق الساحلي اسم البشرود أوالبشموريين وربطوا بينهم وبين الروم بينما أطلقوا على غالبية القبط في وسط الدلتا والمنوفية والبحيرة اسم البلما ، وأطلقوا على قطاع من المسيحيين الناطقين بالعربية في شرق الدلتا اسم الحرسيين وهم مجموعات قبلية قديمة تنتشر في سيناء والنقب وبادية الشام والعراق.
وقد كانت للحرسيين قضية شهيرة في القرن الثاني الهجري حكم فيها القاضي عبد الرحمن العمري طالبوا فيها بإثبات نسبهم إلى فرع الحوتكة من قبيلة قضاعة ليدخلوا في ديوان الجند وثار بسببها الكثير من اللغط والتنابز المتبادل بالأشعار والهجاء ، وقد كان عدد من الحرسيين قد وصل إلى مناصب كبيرة في بغداد والشام وكان منهم أحد قادة ثورة جابر بن الوليد المدلجي الكناني وهو مساعده الأول جريج الحارسي ومعه عبد الله المريسي وأبو حرملة النوبي حيث استولوا على المحلة في عام 866 م بالقوة المسلحة.
ومن أعلام المحلة في عصر الولاة شيخ المصريين ، وهو اللقب الذي عرف به الصحابي الجليل سيدنا عبد الله بن الحارث الزبيدي رضي الله عنه والمتوفي في عام ست وثمانين للهجرة في قرية سفط القدور وهي صفط تراب الحالية مركز المحلة الكبرى ، شهد فتح مصر وسكنها وهو آخر الصحابة موتا فيها حيث عمر طويلا حتى عمي وهو من جملة أهل الصفة الزهاد وكان اسمه العاص فغيره النبي صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله.
واسمه كاملا هو أبو الحارث عبد الله بن الحارث بن جزء بن عبد يغوث بن معدي كرب بن عمرو بن عصم بن عمرو بن عويج بن عمرو بن زبيد الزبيدي المذحجي اليماني حليف بني سهم وهي عشيرة القائد عمرو بن العاص السهمي ، وكان أبوه حليف وصهر أبي وداعة الحارث بن صبرة السهمي القرشي وأمه أم جميل بنت أبي وداعة السهمي وأخواله الصحابيان المطلب والسائب ابنا أبي وداعة.
وهو ابن أخي الصحابي محمية بن جزء الزبيدي الذي كان علي المقاسم يوم بدر وهو من السابقين الأولين ومن مهاجرة الحبشة ومن قواد جيش الفتح حيث سكن الفسطاط وتوفي بها وهو والد زوجة الفضل بن العباس ، عرف عبد الله بالفروسية والشجاعة والورع والعلم والتقوى والزهد وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث وهو رفيق عبد الله بن عمرو بن العاص ، ومن أولاده في مصر الحارث والربيع.
نقل السيوطي في كتابه در السحابة فيمن دخل مصر من الصحابة أن أهل مصر رووا عنه عشرين حديثا ، تتلمذ على يديه من التابعين المصريين كل من عقبة بن مسلم التجيبي وعمرو بن جابر الحضرمي وعبيد بن ثمامة المرادي وعباس بن خليد الحجري وعبيد الله بن المغيرة وعبد الملك بن مليل البلوي وسليمان بن زياد الحضرمي وعتبة بن ثمامة ومسلم بن يزيد الصدفي ويزيد بن أبي حبيب.
وجاء في سير أعلام النبلاء : ” هو ابن أخي الصحابي محمية بن جزء الزبيدي وقد طال عمره وعمي ومات بقرية سفط القدور من أسفل مصر في سنة ست وثمانين .. وأشهر له رواية في سنن أبي داود وجامع أبي عيسى وسنن القزويني ” ، وقال عنه الذهبي في كتابه تاريخ الإسلام وَوَفيات المشاهير وَالأعلام : ” شهد فتح مصر واختط بها وسكنها وروي عنه أهلها وكان شيخ المصريين في زمنه وعالمهم “.

إمارة عبد العزيز الجروي
في القرن الثاني الهجري بدأت المحلة في الظهور على مسرح الأحداث السياسية بقوة من خلال ثورة عبد العزيز الجروي زعيم قبيلة جذام والذي كان سببا في إبراز موقع المدينة الحربي ولفت الأنظار إليها ، وهو عبد العزيز بن وزير بن ضابيء بن مالك بن عامر بن عدي من بني جري وهي أحد فروع جذام ، ولد في قرية الجروية التي أسستها قبيلته بجوار مدينة تنيس القديمة في الدلتا وانتقل في شبابه إلى الفسطاط لينخرط في سلك الجندية.
وفي عام 191 هـ كلف بأول مهمة حربية وهي قيادة حملة عسكرية للقضاء على ثورة قبيلة بلي في منطقة العقبة وأيلة في عهد الخليفة هارون الرشيد ، وفي عام 194 هـ قاد حملة عسكرية لإخماد اضطرابات العرب اليمانية في تمى الأمديد ، بعد ذلك حدث انقسام للقبائل في مصر بسبب الصراع بين الأمين والمأمون وقاد الجروي حملة أخرى إلى العرب القيسية في الحوف الشرقي وهناك اجتمع به زعماء اليمانية عام 197 هـ وحرضوه على التمرد.
وفي عام 198 هـ تولى منصب صاحب الشرطة للوالي المطلب بن عبد الله الخزاعي وقاد حملة عسكرية لمحاربة قبائل الدلتا التي اتحدت تحت قيادة يزيد بن الخطاب الكلبي زعيم اليمانية وربيعة بن قيس الجرشي زعيم القيسية فانتصر عليهم عند شطنوف وتمكن بالسياسة من الإيقاع بزعماء القيسية والقبض عليهم ، ثم اضطربت الأحوال في الفسطاط وبدأ زعماء القبائل في التنازع على المناصب القيادية فقرر الجروي المغادرة إلى ديار قومه بالحوف.
وفي عام 199 هـ أعلن الجروي الاستقلال بالدلتا وطرد عمال الوالي من مناطقه وسيطر على دمياط وتنيس وحشد قواته للتوغل في وسط الدلتا وبدأ في البحث عن مدينة تصلح لإدارة عملياته الحربية وتمكنه من إدارة حركة القوات ليبسط سلطته على الوجه البحري ، وتقدم إلى المحلة حيث كان عليه مواجهة حاكمها يزيد بن الخطاب وكذلك قائد الجيش القادم من الفسطاط السري بن الحكم فاستعمل الجروي المكر والخديعة وأوقع بالجميع في فخ المحلة وانتصر.
أعلن الجروي تحديه للوالي المطلب بن عبد الله الخزاعي من خلال مواجهة قائد الجيش السري بن الحكم بالإضافة إلى حاكم الدلتا يزيد بن الخطاب الكلبي ، وأدرك الجروي أن قوته لن تسمح له بالانتصار على كليهما فرتب فخا في مدينة المحلة وتظاهر بالدعوة إلى الصلح وقرر أن تكون المفاوضات مع قائد الجيش في النيل حيث كان الجروي قد سيطر على الجزء الجنوبي من البلدة وهو سندفا بينما كان السري ويزيد في شرقيون شمالا.
واتفق الطرفان على أن يلتقيا في مركبين متحاذيين في نهر النيل في منطقة بين البلدين ، وكان الجروي قد أعد حبالا معقودة في باطن مركبه حتى إذا اقترب منه مركب السري وبدأت المفاوضات قام أصحابه من تحت الماء بربط المركبين وسحبهما إلى معسكر الجروي في سندفا ، ونجحت الخطة وتمكن من الإيقاع بقائد الجيش السري بن الحكم واعتقله وأرسله إلى تنيس مقيدا وتفرغ بعدها للباقين فتمكن من السيطرة على مدينة شرقيون وهي المدينة العربية بالمحلة ومنها انطلق لإتمام السيطرة على الوجه البحري.
ويحكي القصة بالتفصيل المؤرخ أبو عمر محمد بن يوسف التجيبي الكندي في كتابه الولاة والقضاة فيقول : ” ثمَّ سار الجَرَوي فِي مراكبه حتى نزل شَطَنُوف فبعث إِلَيْهِ المُطَّلِب بالسَّريّ بْن الحكَم فِي جمع الجُند يسأَلونه الصُّلح فأجابهم إِلَيْهِ ثمَّ اجتهد فِي الغدر بهم فتيقَّظوا لَهُ فمضى راجعًا إلى بَنَا واتّبعوه فحاربوه ، ثمَّ عاد فدعاهم إلى الصُّلح ولاطف السَّريّ فخرج إِلَيْهِ فِي زَلَّاج وخرج الجَرَويّ فِي مِثله فالتقَيا وسط النيل مقابل سَنْدَفا والسَّريّ بشَرقيُون وقد أَعدّ الجَرَويّ فِي باطن زَلَّاجه الحِبال.
وأمر أصحابه بسَنْدَفا إذا لاصق بِزَلَّاج السَّريّ أن يجرّوا الحِبال إليهم فلصِق الجَرَويّ بزَلَّاج السَّري فربطه إلى زَلاجه وجرَّ الحِبالَ فأسروا السَّريّ ، ومضى بِهِ الجَرَويّ إلى تِنِّيس فسجنه بها وذلك فِي جمادى الأولى سنة تسع وتسعين ، ثمَّ كرّ الجَرَويّ عَلَى يزيد بْن خَطَّاب فقاتله فهزمه فعقد المُطَّلِب لابن عَبْد الغفَّار الجَمَحيّ وبعثه إلى الجَرَويّ وأيَّده بالرِّجال فلقِيَهم الجَرَويّ فهزمهم وأسر ابن عَبْد الغفَّار ووجوه أصحابه ، وكانت وقعتهم بسَفْط سَليط أوَّل يوم من رجب سنة تسع وتسعين ومائة “.
بعدها استقر عبد العزيز الجروي في المحلة وجعل منها مقر عملياته الحربية ومنها حشد جيوشه كثيفة العدد في عام 200 هـ للزحف على الفسطاط حيث دارت المعركة بينه وبين الوالي المطلب بن عبد الله الخزاعي وانتصر عليه عند الجيزة لكنه لم يستطع دخول الفسطاط ورجع إلى المحلة مرة أخرى ، ورأى بحسن تدبيره أن عرب الفسطاط لن يتبعوه بسبب ما فعله بزعماء القيسية واليمانية عندما كان صاحب الشرطة.
وقرر الجروي أن يطلق قائد الجيش السري بن الحكم من سجنه منافسا للمطلب حيث طلب منه أن يتولى الإمارة بدعم كامل منه على أن يترك له حكم الوجه البحري ووافق السري وحشد القوات وأذعن المطلب الخزاعي للأمر فطلب الأمان ورحل عائدا إلى الحجاز ، واستغل الجروي الفرصة فأرسل عمر بن هلال من قبله فسيطر على الإسكندرية وهكذا أصبح الحاكم الفعلي لمصر وأقر الخليفة المأمون مضطرا بهذا الوضع.
وعندما حدثت الثورة بالإسكندرية زحف الجروي من المحلة بقوات بلغت خمسين ألف مقاتل في عام 201 هـ وحاصرها واستغل السري بن الحكم الفرصة وبعث قواته لتهدد تنيس فاضطر الجروي للعودة وبدأت الوقيعة بينهما ، واستفحل الخلاف عندما رفض الجروي مبايعة علي الرضا وليا للعهد وناصر إبراهيم بن المهدي وأرسل ابنه علي الجروي فدخل الإسكندرية عام 202 هـ وأرسل سلامة بن عبد الملك الأزدي الطحاوي للصعيد.
وفي عام 203 هـ انتصر الجروي على خصومه عند شطنوف وهدد الفسطاط ثم حشد جيوشه باتجاه الإسكندرية بعد خروجها عن طاعته وقاد خمسين ألف مقاتل لكنه فوجىء بتحالف بني مدلج مع أقباط سخا لمنعه من ذلك وحشدهم ثمانين ألف مقاتل فاشتبك معهم وانتصر عليهم لكنه لم يتمكن من تحقيق هدفه وكانت علاقته بالأقباط في سخا سيئة لأنه كان يوالي أقباط سمنود ودميرة ونبروه وهم على خلاف كبير مع أقباط سخا.
وفي ذلك يقول الكندي في كتاب الولاة والقضاة : ” ثمَّ إنَّ الأَنْدَلُسيِّين أخرجوا عامل الجرَويّ من الإسكندريَّة وهو مُعاوية بْن عَبْد الواحد بْن محمد بْن عبد الرحمن بْن مُعاوية بْن حُديج وغلقوا الحِصن دونه وخلعوا الجَرَويّ ودعَوا إلى السريّ فسار إليهم الجرَويّ فِي شهر رمضان سنة ثلاث ومائتين فعارضته القِبْط بسَخا وأمدَّتهم بنو مُدْلِج وهم نحو من ثمانين ألف فخرج إليهم الجَرَويّ فهزمهم وهربت بنو مُدْلِج “.
وفي عام 815 م قرر الخليفة المأمون إقرار كل من عبد العزيز الجروي والسري بن الحكم على ما بأيديهما لأنهما من مناصريه فتولى الجروي الوجه البحري وتولى السري الفسطاط والصعيد ثم بدأت المنافسة بينهما للسيطرة على الإسكندرية حيث كان الصراع محتدما بين كل من قبائل لخم ومدلج وكذلك اللاجئين الأندلسيين الذين فروا من قرطبة بعد ثورة الربض.
وتصاعدت أحداث الثورة في المدينة وقتل حاكم الإسكندرية عمر بن هلال في قصره وانفلت الأمن وبدأت عمليات السلب والنهب وعجز والي مصر السري بن الحكم عن ضبط الأوضاع ، وقرر البابا أنبا مرقس الثاني الخروج من الإسكندرية في حماية عبد العزيز الجروي حيث كانت علاقته جيدة جدا بالأقباط في سمنود ونبروه ودميرة والذين ساعدوه في أكثر من موقف.
أرسل الجروي من المحلة قوة عسكرية تابعة له تمكنت من تأمين خروج البابا ومن معه من الإسكندرية والعبور بهم بأمان من مناطق الاضطراب في البحيرة ثم استضافه بنفسه وخيره ليذهب إلى المكان الذي يريده فاختار الذهاب إلى نبروه في ضيافة مقارة بن النبراوي حيث توجد كنيسة تابعة لكرسي سمنود فأنفذ معه الجند لحمايته طوال إقامته حتى تنيح هناك.
قال أسقف ساويرس : ” وخرجوا الخوارج على المملكة بمصر وجبوا الخراج لنفوسهم وكان من جملتهم رجل يسمى عبد العزيز الجروي أخذ من شطنوف إلى الفرما وشرقية مصر بلبيس وأعمالها ورجل اسمه السري بن الحكم أخذ من مصر إلى أسوان واستوليا على الخراج وقوم يسمون لخما وجذاما أخذوا غربي مصر وأعمال الإسكندرية ومريوط وملكوا البحيرة جميعا.
وكان الأرخن الدين مقارة بن النبراوي من كرسي سمنود فلما سمع ما جرى قام ومضى إلى عند عبد العزيز المتولي على المشرق وخاطبه بسبب الأب البطريرك أنبا مرقس وأن الأمم الذين تغلبوا على الإسكندرية نهبوا جميع ماله وترك كرسيه وجاء سكن تحت ظل الله وظلك فإن كنت قد ظفرت بنعمة أمامك فاكتب له كتابا باسمك ليتقوى بأمرك ليكون في موضعه آمنا.
حينئذ كتب له سجلا عظيما ثم أنفذ رسلا من عنده وسجل الأمير إلى الأب البطرك أن يأتي ويقيم في منزله فقام أبونا البطرك وصلى وسار إلى أن وصل إلى نبروه فخرج إليه ولقيه وكل من معه ثم مضى معه إلى البيعة بالقراءة أمامه كما يجب للبطاركة وجعله في موضع يشاكل رئاسته وهو موضع أعمره والداه على اسم القديس أبي مقار بوادي هبيب “.
انتهت حياة عبد العزيز الجروي على أسوار الإسكندرية بعد حياة حافلة ، وفي ذلك يقول الكندي : ” ثمَّ إن عَبْد العزيز الجَرَويّ سار إلى الإسكندريَّة مسيره الرابع فأغلق الأَنْدَلُسيّون حِصنا فحاصرهم الجَرَويّ أشدّ الحِصار ونصب عليهم المَنْجَنيقات وأَقام عَلَى ذَلكَ سبعة أشهُر من مستهلّ شعبان سنة أربع ومائتين إلى سلخ صفر سنة خمس فأصاب الجَرَويَّ فِلْقةٌ من حجَر مَنْجَنِيقَة فمات سلخ صفر سنة خمس ومائتين “.
وخلفه ابنه علي الجروي واقتسم البلاد بينه وبين أبي نصر بن السري كما يقول الكندي : ” فالذي كَانَ بيد أَبِي نَصر من أرض مِصر فُسطاطها وصعيدها وغربيّتُها وأمَّا أسفل الأرض كله فكان بيد عليّ بْن عَبْد العزيز الجَرَويّ مَعَ الحوف الشرقيّ ، ثمَّ سار أحدهما إلى صاحبه فِي النيل فالتقوا بشَطَنُوف فاقتتلوا وعلى جيش أَبِي نصر أخوه أحمد بْن السَّريّ فانهزم أحمد بْن السَّريّ وأحسن علي بن الجَرَويّ فِيهِ الظفَر فلم يتبعه “.
وظلت المناوشات قائمة طوال عامين حتى عام 207 هـ عندما قام عبيد الله بن السري بمهاجمة الدلتا عند بنا وبلقينا ودفرة ومحلة أبي الهيثم وبدأ الجروي في التراجع من بلد إلى بلد حتى انسحب إلى الفرما ثم العريش وتعرضت المحلة لهجوم شرس وتدمير كبير من قبل أحمد بن السري انتقاما من آل الجروي ، وفي ذلك يقول الكندي : ” ومضى أحمد بْن السَّري إلى مَحَلَّة شَرْقيُون فدخلها وأمر بنهبها فكان من أعظم ما أتاه “.
حاول علي الجروي مرة أخرى العودة إلى المحلة لكنه فشل وقتل في النهاية على يد عبد الله بن طاهر ، يقول الكندي : ” وأقبل عليّ بْن الجَرويّ أيضًا فِي المحرَّم سنة عشر ومائتين فدخل تِنِّيس ودِمْيَاط بغير قتال وأَتى مَحَلَّة شَرْقيُون ، فبعث عُبَيْد بمحمد بْن سُلَيْمَان بْن الحكَم فِي المراكب فنزل طُوخ فبعث إِلَيْهِ ابن الجَرَويّ بابن غُصَين السَّعديّ فقاتله فانهزم ابن غُصَين وبلغ ذَلكَ عليًّا فمضى إلى الهُورِين ثمَّ دخل منها إلى جَرجير “.
أما أخوه الأصغر الحسن فقد اعتزل السياسة واشتغل بطلب العلم حتى نبغ في الفقه والحديث وبلغ منزلة كبيرة في الزهد والورع وزار بغداد ودرس بها وعرفت ذريته من بعده بالصلاح وتوفي عام 257 هـ ، قال عنه الذهبي في سير أعلام النبلاء : ” الإِمَامُ الأَجَلُّ الصَّادِقُ أَبُو عَلِيٍّ الحَسَنُ بنُ عَبْدِ العَزِيْزِ بنِ وَزِيْرِ بنِ ضَابِئِ بنِ مَالِكِ بنِ عَامِرِ بنِ صَاحِبِ رَسُوْلِ اللهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ عَدِيِّ بنِ حمرسٍ الجُذَامِيُّ المِصْرِيُّ الجَرَوِيُّ “.
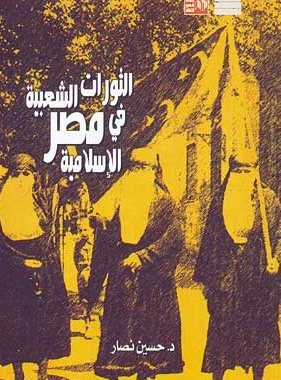
ثورات المحلة
يقول الكندي : ” ثمَّ انتقضت أسفل الأرض كلّها عربَها وقِبْطها فِي جمادى الأولى سنة ستّ عشرة ، وأخرجوا العُمَّال وخالفوا الطاعة وكان ذَلكَ لسُوء سيرة العُمَّال فيهم ” ، وهو يقصد بذلك ثورة الدلتا الكبرى التي اتحد فيها العرب والقبط ضد ظلم الولاة حيث لعبت مدينة المحلة وقتها دورا محوريا في الأحداث بسبب موقعها الذي يتوسط بين الفسطاط جنوبا والبشرود شمالا حيث اندلعت شرارتها هناك عام 831 م وعرفت في التاريخ باسم ثورة البشموريين.
وكانت الأحداث قد بدأت قبل ذلك بعامين عندما تم التعامل بقسوة بالغة مع انتفاضة عرب الحوف الشرقي وإعدام كل من عبد الله بْن حُلَيس الهلالي زعيم العرب القيسية وعبد السلام بْن أَبِي الماضي زعيم العرب اليمانية وظن الولاة أن الأمر استتب فبالغوا في الظلم حتى ضج الناس بالشكوى وقرروا إعلان العصيان وتوزيع السلاح على الجميع حيث بدأت الأحداث من البشموريين وهم سكان ساحل شمال الدلتا ثم انتقلت إلى أقباط سخا ثم القبائل العربية في الدلتا.
حشد الثوار جيشين أحدهما للدفاع عن غرب الدلتا بقيادة معاوية بن عبد الواحد حفيد القائد معاوية بن حديج والذي سيطر على الإسكندرية والجيش الآخر للدفاع عن وسط الدلتا بقيادة ابن عبيدس الفهري حفيد عقبة بن نافع يعاونه أبو ثور اللخمي حيث تمكن من السيطرة على المحلة وانطلق منها باتجاه الجنوب لمواجهة جيش الوالي عيسى بن منصور ، ودارت المعركة الطاحنة عند قرية أشليم بالقرب من قويسنا حيث هزم الثوار وتراجعوا باتجاه الغرب.
وإثر ذلك تقدم القائد التركي الأفشين باتجاه المحلة وضرب عليها حصارا قويا ثم استولى عليها بعد أن قتل أبو ثور اللخمي في معركة طاحنة استبسل فيها عند قرية محلة أبي الهيثم ، ومن هناك هزم الأقباط في دميرة وهاجم عيسى بن منصور العرب في تمى الأمديد وأصبح الطريق مفتوحا أمامهم إلى البشرود ، لكن الخليفة المأمون أرسل لهم بالتريث وأن يكسروا شوكة العرب أولا فقاموا بمهاجمة بني مدلج في خربتا ثم احتلوا الإسكندرية .
حضر المأمون بنفسه إلى مصر مصطحبا معه أسقف أنطاكيا ليساعد في تهدئة الثوار وعزل الوالي وووبخه قائلا : ” لم يكن هذا الحدَث العظيم إلَّا عَنْ فِعلك وفِعل عُمَّالك حمَّلتم الناس ما لا يُطيقون وكتمتوني الخَبر حتى تفاقم الأمر واضطربت البلد ” ، وطلب من الأنبا يوساب أسقف الإسكندرية أن يكتب للثوار فكتب رسائل متتابعة إلى أقباط سخا أن يسلموا سلاحهم ويتوقفوا عن مناصرة الخوارج ـ يقصد القبائل العربية ـ مقابل الأمان فاستجابوا ودخل المأمون إلى سخا.
رفض البشموريون تسليم سلاحهم وقرروا الاستمرار في المقاومة للنهاية وحدهم بعد هزيمة العرب فتحرك الأفشين عبر منطقة البراري والحامول شمالي المحلة مستعينا بأدلاء من طنطا وسنباط واستعمل سياسة الأرض المحروقة والعنف المفرط ، وفي سخا أعدم المأمون ابن عبيدس الفهري على مرأى من الناس ليكون عبرة للثوار ، وفي العام التالي تولى المعتصم الخلافة وأصدر أمره الشهير بإخراج العرب من ديوان الجند نهائيا واستبدالهم بالأتراك.
ومن أهم الأحداث الكبرى التي شهدتها مدينة المحلة الكبرى في القرن الثالث الهجري ثورة بني كنانة الكبرى التي عرفت باسم زعيمها جابر بن الوليد المدلجي ضد سلطة الولاة العباسيين في الفسطاط وذلك في رد فعل على إخراج العرب من ديوان الجند عقب ثورة البشموريين ، ولم تكن ثورة قبلية بل جمعت في زعامتها جابر بن الوليد وهو عربي من كنانة مع كل من عبد الله المريسي وجريج النصراني الحارسي وأبو حرملة النوبي.
وقد بدأت الأحداث في منازل كنانة في إقليم البحيرة ثم هاجموا الإسكندرية وعزلوها عن الدلتا ثم قام الثوار بالسيطرة على كل من الكريون مركز كفر الدوار حاليا وصا وهي صا الحجر مركز بسيون غربية ثم انطلقوا منها إلى المحلة ليتم لهم السيطرة على الدلتا كله وانضم إليهم واحد من آل البيت استطاع جذب مزيد من القبائل العربية تحت رايته وانضم إليهم كل من يومىء إليه بشدة ونجدة ، وفي ذلك يقول الكندي :
” خرج جابر بن الوليد المدلجي من بني الهجيم بن عثوارة بن عمرو ابن مدلج بأرض الإسكندرية في ربيع الآخر سنة اثنتين وخمسين واجتمع إليه كثير من بني مدلج الصلبية والموالي فبلغ ذلك والي الإسكندرية محمد بن عبيد الله بن يزيد بن مزيد الشيباني فبعث إليه برجل من أصحابه يقال نصر الطحاوي وعقد له على ثلاث مئة رجل فنزلوا الكريون وسأل عن جابر وأصحابه فأُخبر بأنهم بأرض صا فزحف إليهم فقاتلهم جابر “.
وعندما فشل حصارهم للإسكندرية قرروا الاستيلاء على المحلة واتخاذها مقرا للعمليات العسكرية لذلك أرسل جابر واحدا من قواده ومساعديه وهو أبو حرملة النوبي المعروف بالقوة والبأس فسيطر على وسط الدلتا كله واتخذ من المحلة (شرقيون) مقرا له فتحولت البلدة إلى مقر للثورة حيث دارت فيها معظم الحوادث والمعارك الكبرى وهو ما وصفه كتاب تاريخ الآباء البطاركة وكذلك الكندي الذي يقول :
” ولحق به أبو حرملة النوبي وكان رجلاً فاتكاً فعقد له جابر على سنهور وسخا وشرقيون وبنا فمضى أبو حرملة في جيش عظيم فضم هذه الأعمال وأخرج منها العمال وجبى خراجها ولحق به عبد الله بن أحمد ابن محمد بن إسماعيل بن محمد بن عبد الله بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب والذي يقال له ابن الأرقط فقوده أبو حرملة وضم إليه كثيراً من الأعراب ووجوه أصحابه وضم إليه ابن عسامة المعافري وولاه بنا وبوصير وسمنود وأبو حرملة مقيم بشرقيون “.
في البداية تعاملت الفسطاط مع ثورة بني مدلج الكنانية باعتبارها تمردا قبليا بسيطا مثل كافة انتفاضات العرب في الدلتا لكن قيام الثوار بغزو المحلة واتخاذها مقرا للثورة حول هذا التمرد البسيط إلى حركة استقلال بالوجه البحري خاصة مع مبايعة أبي حرملة النوبي لواحد من آل البيت وهو عبد الله بن الأرقط بالخلافة وهو ما ينذر بتكرار ثورة الجروي وابن عبيدس الفهري ولذا تحركت السلطات فورا وقررت بدء الهجوم على الدلتا لتحرير المحلة من الثوار وهي الخطوة التي أجهضت الثورة واضطرتهم آخر الأمر للتسليم بعد أن تعرضت المحلة للتدمير بقسميها شرقيون وسندفا.
يقول الكندي : ” فبعث يزيد بن عبد الله بأبي أحمد محمد بن عبد الله الدبراني في جمع كثير من الأتراك فنزل بدمسيس في جمادى الآخرة سنة اثنتين وخمسين ومائتين وبعث رجلاً من الترك يقال له غلبك ومعه محمد بن العباس بن مسلم بن السراج فلقي عبد الله بن الأرقط فيما بين بوصير وبنا فقتل ابن الأرقط من أصحاب غلبك نحواً من عشرين رجلاً وثبت غلبك ومحمد ريش فقاتلاه فهزماه سلخ جمادى الآخرة وقُتل من أصحاب ابن الأرقط مقتلة عظيمة وأُسر منهم كثير فبعث الدبراني بالأسرى والرؤوس إلى الفسطاط.
ومضى ابن الأرقط إلى شرقيون فلحق بأبي حرملة ونزل الدبراني مدينة بنا وترك عسكره فيما بينها وسمنود وأقبل أبو حرملة ومعه ابن الأرقط قاصداً من شرقيون إلى بنا وبعث أبو حرملة بكمين له فهجموا على عسكر الدبراني مع المغرب فحمل عليهم أصحاب الدبراني فانهزم أبو حرملة ومن معه إلى شرقيون ومضى الدبراني فنزل سندفا وضربها بالنار ونهب أهلها وانهزم أبو حرملة فيمن معه وتشاغل أصحاب الدبراني بالنهب فكر أبو حرملة فقتل أبا حامد الدبراني ورجع أصحاب الدبراني إلى سندفا.
وبُعث من العراق بمزاحم بن خاقان مُعيناً ليزيد بن عبد الله بن دينار فقدمها في جيش كثير يوم السبت لثلاث عشرة ليلة بقيت من رجب سنة اثنتين وخمسين ومئتين فبعث برسل من أصحابه إلى جابر بن الوليد يأمره بالرجوع إلى طاعة السلطان فاحتبس رسله أياماً ثم أجازهم بجوائز عظيمة وردهم وقدم وأخر في كتابه ولم يُجمع على أمر واحد ومضى الدبراني في طلب أبي حرملة لمستهل شعبان فالتقى مع أبي حرملة بسمنود فانهزم أبو حرملة وعاد إلى شرقيون ثم رجع إلى سندفا وأتاه الدبراني بسندفا فواقعه فتفرق عن أبي حرملة أكثر أصحابه ولحقوا بجابر بن الوليد “.
وقد احتلت المحلة الكبرى أهمية كبرى في كتابات مؤرخي العصور الوسطى بسبب الأحداث العديدة التي حدثت فيها أو بجوارها مثل الثورات والحروب ، وذلك في الوقت الذي كانت فيه مدن الدلتا الكبرى التي نعرفها الآن مختلفة عما هي عليه ، فقد كانت طنطا قرية صغيرة من توابع سبرباي قبل عصر السيد البدوي وكانت المنصورة لا تزال أرضا زراعية مقابل طلخا بينما كانت شبين الكوم وبنها وكفر الشيخ والزقازيق في عالم الغيب.
ومن الكتب التي تناولت عددا من الأحداث في العصور الإسلامية الأولى كتاب تاريخ الآباء البطاركة للأنبا ساويرس أسقف الأشمونين الذي ذكر دور المحلة في الثورات المختلفة وبعض القصص المرتبطة بها مثل النزاعات الدينية الداخلية في سمنود وسخا وانتقال المقر البابوي إلى دمرو فترة من الزمن واختفاء القديس بولس بن رجا في كنسية سندفا بالمحلة ، ويحكي عن مواجهة ثورة بني مدلج في عام 252 هـ وما تبعها من آثار مضيفا إليها مسحة وعظية فيقول :
” وكانوا بأعمال بنا وأبو صير من الوجه البحري من أرض مصر بين هاتين الناحيتين نزولا فقتل أكثرهم بالسيف وغرق في البحر كثير ومن هرب منهم وطلب الأسطول أخذوه الرجال الذين فيه وهم النفاطين أحرقوه بالنار بين سندفا والمحلة حتى إن من كثرة ما أحرقوه النفاطين بالنار احترق بعض حوانيت المحلة وفيها بضايع التجار وافتقر كثير من الأغنياء في ذلك اليوم ، وأباد الله أولئك الكفرة ومن فضل منهم وهرب التجأ إلى البحيرة ولم يقدر يعود لأن مراكب النفط كانت على المعادي نزولا على الخايض.
ولما كان هذا ظهر في يوم حريق المحلة وحوانيتها سر عجيب يجب أن تظهر للمؤمنين لعظم توكلهم على الله الذي يحفظ أصفياءه ولا يدعهم أن يروا الفساد وينجيهم في زمان الغضب ، كان في ذلك الموضع تاجرين متجاورين أحدهما له مال كثير ولم يكن يرحم المستورين والفقرا والآخر رحوم جيد وكل ما يربحه يدفعه للبيع والمستورين والأيتام فلما حاط النار بالحوانيت إلى مخازن التاجرين فأحرق جميعهم.
وإن الرب المتكلم على لسان داوود حيث يقول طوبى لمن يرحم الفقير والمسكين في يوم السوء ينجيه الرب ويقول أيضا لم أر صديقا قط رفضه الرب فنجا الرب جميع ما لهذا الرجل الرحوم من النار ولم يحترق له شيء بالجملة وأما الغني الذي كان ليس فيه رحمة تسلط النار على جميع ماله وصار غناه مثل التراب للريح وكل من نظر هذا الأمر العجيب مجد الله سبحانه حتى إن كثير جعلوا توكلهم في ذلك الوقت على الذي يخلص المتوكلين عليه “.
وفي عام 866 م اضطربت الأحوال في مصر بسبب ثورة جابر بن الوليد المدلجي زعيم بني كنانة ضد العباسيين الذي سيطر على أغلب الدلتا وقام بمحاصرة الإسكندرية فلما فشل في دخولها منع عنها الإمدادات ، واستقر الرأي على أن يخرج منها البابا أنبا شنودة الأول بسبب سوء الأوضاع وبدأ في البحث عن مكان يأوي إليه مع الآباء الأساقفة ليكون مقرا مؤقتا للبابوية حتى تنتهي الأحداث ، ووقع اختيار الأنبا شنودة على المحلة الكبرى فقام بمراسلة شيوخها ووافقوا على ذلك.
وكانت المحلة هي المدينة الوحيدة القادرة على حماية البابا ومن معه من الثوار وأيضا حمايته من السلطة في الفسطاط والتي كانت تقوم بمصادرة الأموال لتمويل الحرب ضد الثوار ، ورغم انطواء المسألة على خطورة كبيرة وتحدي لكل من الثوار والحكومة إلا أن البابا انتقل إلى المحلة وقضى فيها خمس سنوات حتى انتهت الأحداث وتمكن بمساعدة الأهالي من التواصل مع التجار وإمداد الكنائس في الإسكندرية باحتياجاتها ، وجاء تفصيل ذلك في كتاب تاريخ الآباء البطاركة كالتالي :
” وبتدبير الله تعالى الذي ينجي الفقير والمسكين عملوا ذلك وتحصنت المدينة وأمن أهلها من العدو ولم يقدروا هذه المحاصرة لها على فتحها وكان الأب حزين القلب لا يعلم في أي موضع يأوي إليه لأنهم نهبوا جميع المواضع الذي له وكان لا يقدر يظهر بفسطاط مصر لأجل ابن المدبر الظالم لأنه مع هذه البلايا كلها كان مطالبا بالخراج أعني خراج الأواسي ، وغير ذلك جميع من هرب من هذا العدو التجأ إلى مصر خوفا منه قبض هذا الرجل السو ابن المدبر عليه ورماه في السجن.
ومن هذا خاف أبونا من الدخول إلى فسطاط مصر من المطالبة بخراج الأواسي التي كانت للبيع ونهبت ، ولما علم أبونا بسكان المحلة الكبيرة وأمانتهم مشى إلى عندهم وأقام هناك داعيا لله أن ينجي بيعته وشعبه من هذا الضيق ، ولم يفارق البكا لأجل بيع الإسكندرية وأنه لا يمكن ينفذ شيئا إلى قومتها ليقوموا بقداسات ، وكان جميع من يسافر من موضع إلى موضع ومعه درهم واحد يؤخذ منه ويقتل لأجله وكان لا يسافر إنسان إلا وعليه ثياب خلقان وكراد لا منفعة فيه.
وفيما هذا الأمر يتزايد نظر الله جلت قدرته ما على قلب أبونا من أمر بيع الإسكندرية فهداه إلى أن كتب كتابا إلى التجار الذين بها مساعي الكتان في البلاد الشرقية أن يخرجوا إليه بغير شيء معهم فلما وصلوا إليه دفع لهم ما توجهوا عليهم وقال لهم ابتاعوا لكم تجاير من الريف وسلموا عوضا منه للأقنوم بالإسكندرية لصرفه فيما تحتاج إليه البيع ففرحوا بذلك وشكروا اهتمامه وأخذوا منه المال وربحوا في الطريق فاستقامت أحوال البيع والقلاية بالإسكندرية كالزمان الذي كان لها فيه أواسي “.
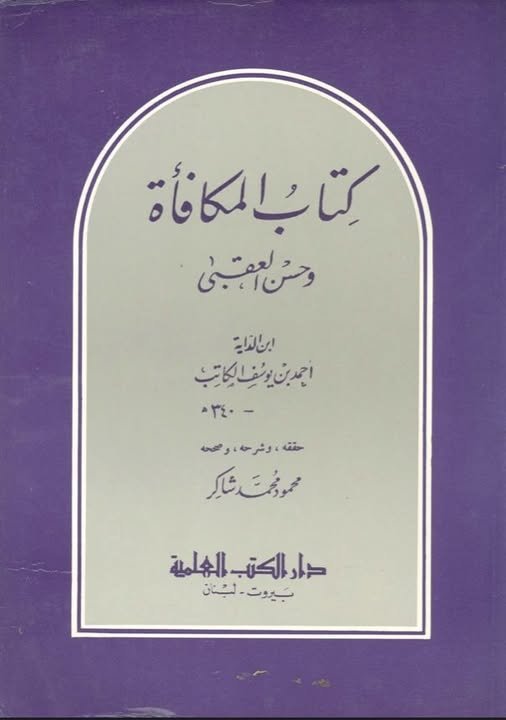
نهاية عصر الولاة
حاكم المحلة في عصر الطولونيين هو عالم الرياضيات والشاعر والمؤرخ أبو جعفر أحمد بن أبي يعقوب يوسف بن إبراهيم البغدادي الأصل ، كانت جدته مربية للأمير إبراهيم بن المهدي والخليفة المعتصم وتربى أبوه في قصور الخلافة ثم عمل كاتبا في سامراء وعرف بلقب ابن الداية ، وبعد اضطرابات سياسية رحل يوسف إلى الشام ثم إلى مصر حيث عمل كاتبا في عهد أحمد بن طولون وصار من أعيان الدولة.
ولد أحمد بن يوسف في القطائع ونبغ في علوم الرياضيات والفلك والطب وفي فنون الأدب والتاريخ وعمل كاتبا في ديوان الطولونيين وامتد به العمر حتى عهد الإخشيديين ، عاش في المحلة الكبرى التي كانت ضمن إقطاعه وعاصر كثيرا من الأحداث الهامة وتوفي عام 340 هـ ، وله عدد من المؤلفات منها كتاب المكافأة وحسن العقبى وسيرة أحمد بن طولون وأخبار الأطباء ومختصر المنطق وأخبار المنجمين.
وروى في كتبه أحداثا سياسية هامة كان شاهد عيان عليها منها واقعة القضاء على الطولونيين بواسطة جيش محمد بن سليمان الكاتب الذي هاجم الدلتا وكيف أن ضياعه وأملاكه قد نجت من الجنود بفضل علاقته بأحد الأمراء العباسيين كان قد أسدى له معروفا من قبل ، ويروي أيضا في كتبه كيف أن تاجرا من تنيس ذكر له صنيعه معه يوما في المحلة ورد له الجميل أثناء أزمة مرت بالكاتب ولم ينس معروفه.
وروى الكاتب تفصيل القصة في كتبه حيث كانت مرتبطة بحادثة غرق مركب تجارية كبيرة قبالة المحلة بعد تكسرها وكيف أنه خرج وهو ورجاله من الوكلاء والكتاب وعسكر على شاطىء النيل ليشرف على عملية الإنقاذ ثم أنزل الغواصين في بحر المحلة لاستخراج البضائع الغارقة وقام بعلاج المصابين ثم دفع لهم من ماله ما يعوضهم ويكفل لهم العودة السالمة إلى تنيس وأرسل إلى وكلائه هناك لمعونتهم.
قال عنه ياقوت الحموي : ” وذكره ابن زولاق الحسن بن إبراهيم فقال : كان أبو جعفر رحمه الله في غاية الافتنان أحد وجوه الكتاب الفصحاء والحساب والمنجمين مجسطي إقليدسي حسن المجالسة حسن الشعر ، وقال الحافظ ابن عساكر : أبو جعفر أحمد بن أبي يعقوب يوسف بن إبراهيم يعرف بابن الداية من فضلاء أهل مصر ومعروفيهم وممن له علوم كثيرة في الأدب والطب والنجامة والحساب وغير ذلك “.
وفي يوم السبت 21 جمادى الآخرة عام 322 هـ الموافق 7 يونيو سنة 934 م دارت في المحلة الكبرى معركة حربية شرسة بين القبائل المغربية من عرب وبربر يقودها أبو مالك حبشي بن أحمد السلمي ضد جيش الوالي محمد بن تكين بقيادة كل من حبكويه وأحمد بن بدر السميساطي ، احتشدت الجيوش في الأرض الفضاء الممتدة بين المحلة وبلقينة غربي بحر المحلة واقتتل الفريقان اقتتالا شديدا حسب وصف المؤرخين.
أسفرت نتيجة المعركة عن انتصار ساحق للمغاربة وسيطرتهم على المحلة واحتلال وسط الدلتا بينما مني جيش الوالي بخسائر فادحة في الأرواح وفر قادته مهزومين وخلفهم سرايا المغاربة تطاردهم حتى بلبيس شرقا وبولاق جنوبا على مشارف الفسطاط ، بعد ذلك قام المغاربة بأسر الوالي محمد بن تكين عند فاقوس وعزله من منصبه وعينوا بدلا منه أحمد بن كيغلغ المتحالف معهم وصار لهم الأمر فعليا.
كانت الأحداث الساخنة قد بدأت قبل ذلك بأعوام عندما سقطت الدولة الطولونية وبدأت محاولات الفاطميين لغزو مصر حيث أرسلت الحملة الأولى بقيادة حباسة بن يوسف فاحتل الإسكندرية لكنه فشل في دخول الفسطاط ، وأسفر ذلك عن قيام الولاة بقمع القبائل المغربية الموجودة في البحيرة بدعوى اتصالهم بالفاطميين كما قاموا بعمليات تهجير للقبائل من ليبيا ومراقية باتجاه الوادي لضمان السيطرة عليهم.
وبالتدريج بدأت القبائل المغربية تستعيد قوتها وتنتشر في مساحات واسعة في الفيوم والصعيد والجيزة وتتدخل في الصراعات بين الأمراء والولاة خاصة مع اضطراب الأوضاع في بغداد وتضارب القرارات ، وفي أعقاب معركة المحلة أرسل المغاربة إلى الفاطميين أن الأمور باتت ممهدة لإرسال حملة جديدة إلى مصر فتجهزت الجيوش قاصدة الإسكندرية فتم تكليف والي دمشق محمد بن طغج بالتحرك إلى مصر.
حشد المغاربة وحلفاؤهم ثلاثين ألف مقاتل لكنهم هزموا بعد أن حطم محمد بن طغج أسطولهم البحري في المنطقة المحصورة بين سمنود والمحلة وفتح الطريق أمام سفنه للوصول إلى الفسطاط ، ونتيجة لانتصاره على الفاطميين وإخضاع المغاربة مؤقتا حصل ابن طغج على لقب الإخشيد وتولى الحكم لكن بعد سنوات عاد المغاربة لصدارة المشهد ورفرفت في مصر الرايات الخضراء للخليفة المعز لدين الله الفاطمي.
وفي عام 363 هـ الموافق سنة 974 م شهدت المحلة الكبرى حدثا بالغ الخطورة ألا وهو هجوم القرامطة على المدينة بهدف احتلالها والانطلاق منها إلى سائر الدلتا والقاهرة ، وكانت الأمور في البلاد لم تستقر بعد للخليفة المعز لدين الله الفاطمي الذي كان قد حضر من تونس إلى القاهرة قبل ذلك بعام واحد تعرضت فيها البلاد لتهديدات القرامطة من جهة صحراء الشام.
وقد استغل القرامطة توزع الجيوش الفاطمية في الشام وتسللوا من الصحراء إلى بلبيس ومنها إلى تنيس ودمياط ثم قصدوا إلى المحلة حيث تصدى لهم الأهالي في شجاعة وقاوموا الحصار الخانق الذي استمر شهرا كاملا على المدينة ثم واجهوا القرامطة في استبسال وتضحية عندما حاولوا دخول البلدة حتى جاءت النجدة بقيادة الامير عبد الله بن الخليفة المعز وقائده ريان الصقلبي.
وفي كتاب المقريزي اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفا جاء تفصيل هذه الأحداث في موضعين أولهما عن الإشاعات التي بثها القرامطة في أجوار القاهرة عن غزواتهم للدلتا وانسحابهم الوهمي منها لإضعاف المعنويات : ” وفيه (شهر شعبان) كثر الإرجاف بالقرامطة ودخول مقدمتهم أرياف مصر وأطراف المحلة وأنهم نهبوا واستخرجوا الخراج ثم رجعوا إلى أعمال الشام “.
ثم جاء تفصيل أحداث الحرب وسرية ريان الصقلبي في قوله : ” وسار الحسن بن أحمد القرمطي بعد ذلك إلى مصر فنزل بعسكره بلبيس وبعث إلى الصعيد بعبد الله بن عبيد الله أخي الشريف مسلم وانبثت سراياه في أرض مصر فتأهب المعز وعرض عساكره في ثالث رجب سنة ثلاث وستين وثلاثمائة وأمر بتفرقة السلاح على الرجال ووسع عليهم في الأرزاق وسير معهم الأشراف والعرب.
وسير معهم المعز ابنه الأمير عبد الله فسار بمظلته وبين يديه الرجال والكراع والبنود وصناديق الأموال والخلع وسير معه أولاده وجميع أهله وجمعا من جند المصريين خلا الشريف مسلم فإنه أعفاه من ذلك ، وانبسطت سرية القرمطي في نواحي أسفل الأرض فأنفذ المعز عبده ريان الصقلبي في أربعة آلاف فأزال القرامطة عن المحلة ونواحيها وقتل وأسر “.



