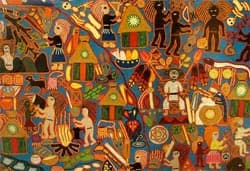
الفن الشعبي هو مرآة الحياة الاجتماعية خاصة في البيئة المحلية لأنه نابع من وجدان الناس ومرتبط بالموروث الثقافي والعادات والتقاليد .. وفي طول البلاد وعرضها سوف نلحظ أن كل منطقة صنعت لها الفن الخاص بها من أول النوبة والصعيد جنوبا إلى الإسكندرية والدلتا شمالا ومن سيناء والقناة شرقا إلى الواحات ومطروح غربا .. ما بين السامر السيناوي والأغاني النوبية وزفة العروسين في أفراح الفلاحين وموسيقى السمسمية وشاعر الربابة والإنشاد الصوفي ورقصة التحطيب والحجالة والبمبوطية والبورمية السيوية والتنورة..
ويعد زكريا الحجاوي من أهم رواد البحث في هذا الفرع من الفنون من خلال مؤلفه الكبير (موسوعة التراث الشعبي) وكذلك دوره في تقديم ذلك التراث من خلال الصحافة والتليفزيون وذلك بعد أن قام بعمل مسح شامل للقطر المصري لجمع الفنون الشعبية من مصادرها .. وقد سار على دربه عدد كبير من المبدعين مثل فاروق خورشيد الذي كتب سيرة سيف بن ذي يزن وعلي الزيبق والأميرة ذات الهمة وكذلك الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي الذي كتب السيرة الهلالية بعد أن قام بجمعها من أفواه شعراء الربابة ..
والسير الشعبية هي انعكاس للوجدان الجمعي للبسطاء الذين أضفوا هالات من البطولة على شخصيات تشبههم في نمط الحياة والمعيشة .. ولا بد أننا جميعا سمعنا بعضا من حكايات أيوب وناعسة وشفيقة ومتولي وياسين وبهية وحسن ونعيمة وأدهم الشرقاوي وخضرة الشريفة ، أو ربما صادفتنا في الإذاعة أو على اليوتيوب بعض أغاني محمد طه وأبو دراع وخضرة محمد خضر وجمالات شيحة .. لكن من المؤكد أننا سمعنا جميعا فاطمة عيد وهي تغني سلمولي عليه وكذلك الريس متقال وهو يغني على الربابة أغنيته الشهيرة الفراولة.
وهذا التراث الشعبي كنز من كنوز مصر الثقافية والمعرفية لأنه يحكي جزء غير مدون في تاريخ البلاد بعيدا عن السجلات الرسمية والتأثيرات الفوقية فهو من الناس وللناس ولهذا فهو ينال الحظوة وينعم بالشعبية وينتقل من جيل إلى جيل .. وأهم من ذلك كله أنه علامة دالة على التعددية الثقافية والاجتماعية في ربوع البلاد حيث إنه مرتبط بالبيئة المحلية وتراثها الحي وطقوسها اليومية ولهجاتها الدارجة .. أما التأثير الوجداني فهو يفوق أي شيء آخر لأنه يتمتع بالبساطة في التعبير والبلاغة في الأداء ولأنه أصدق عاطفة وأقوم قيلا ..
وفيما يلي عرض لأهم الفنون الشعبية المميزة في أقاليم مصر والتي تحمل طابعا محليا مميزا يرتبط بالحياة الاجتماعية والعادات والتقاليد ..

أغاني الشمال
جزء كبير من التراث الشعبي في مصر مرتبط بجماعات الغجر حيث كانت مشاركتهم في المناسبات الاجتماعية الريفية حاضرة ومؤثرة خاصة في الأفراح والموالد وسائر الاحتفالات .. وعرف عن الغجر حب الغناء والرقص بالإضافة إلى أعمال السحر والتنجيم وضرب الودع وقراءة الكف .. وحتى وقت قريب كان الغجر يحرصون على ارتداء ملابسهم المميزة والخاصة بهم لكن بمرور الوقت حدث اندماج مع المجتمع وبدأت حياتهم تتحول من البداوة إلى الحضر ..
ويتكلم الغجر بلهجة بدوية لكنهم فيما بينهم يملكون لغة قديمة هي خليط من العربية والفارسية والهندية وهي محكية وغير مكتوبة .. وترجع أصول الغجر إلى الهند التي خرجوا منها إلى بلاد الفرس بسبب الحروب ثم بدأ انتشارهم غربا في القرن السادس عشر الميلادي باتجاه أقاليم الدولة العثمانية في الأناضول والبلقان والعراق والشام ومصر على هيئة جماعات صغيرة دائمة الترحال .. وهم ينقسمون إلى مجموعتين الرومن في أوروبا والدومر في الشرق الأوسط ..
ومن أشهر فناني التراث الشعبي المصري من الغجر خضرة محمد خضر والريس متقال قناوي ولهم أعمال قيمة حفرت في الوجدان المصري وربطت الكلمات العامية بموسيقى الغجر المميزة .. وقد حفلت الأعمال السينمائية والدرامية بالكثير عن حياة الغجر حيث ارتبطت في غالبيتها بفكرة الغازية وهي الراقصة الغجرية ذات المواهب المتعددة وجمعها غوازي حيث كانت الغازية تغني وترقص في المناسبات مرتدية ذلك الزي المزركش المميز للنساء الغجريات ..
وفي مصر يوجد الغجر في الشرقية بقرية كفر الغجر مركز الزقازيق وفي كفر الشيخ عزبة الغجر مركز الحامول وشارع الغجر في سيدي سالم وفي القاهرة منطقة حوش الغجر بجوار سور مجرى العيون في حي مصر القديمة وفي الغربية قرية سنباط مركز زفتى وفي الدقهلية قرية طهواي مركز السنبلاوين وقرية العصيا مركز طلخا وفي الجيزة أبو النمرس وفي الإسكندرية حي غبريال بالإضافة إلى الظهير الصحراوي في البحيرة والفيوم ومناطق بالصعيد.
ويطلق عليهم في مصر مسميات عديدة منها النور في الوجه البحري والحلبية في الوجه القبلي وفي بادية الشام والعراق يطلق عليهم الزط والغربتي .. وبسبب التنافر بين ثقافتهم الخاصة وثقافة غيرهم ظلوا فترة طويلة في عزلة حيث كانت بعض جماعاتهم تحترف التسول والسرقة مما جعل كلمة غجري أو نوري مرادفة للهمجية والخديعة .. ولهذا يمكننا فهم صياح الجماهير المحتشدة في أحد الأفلام القديمة وهم يعترضون هاتفين : الغازية لازم ترحل.
وبعيدا عن الغجر فقد ساعدت جغرافية الدلتا واتساعه على تنوع الفنون الشعبية فيه فهو حلقة بين سيناء شرقا ومطروح غربا وبين الإسكندرية ودمياط شمالا والقاهرة والجيزة جنوبا فهو متاخم للصحراء والساحل والحواضر الكبرى معا ، وساهم في ذلك تنوع النشاط الاقتصادي ما بين الزراعة والصناعة والتجارة والرعي والصيد وهذه الطبيعة هي التي صنعت الحالة الفنية التي غيرت من طبيعة الشعر العربي باتجاه الأغنية أو الموال.
وأقدم أغنية عرفتها المنطقة مقتبسة من قصة عزيزة ويونس إحدى القصص الفرعية في السيرة الهلالية والتي أعاد بيرم التونسي إحياءها من خلال الأشعار واشتهرت منها أغنية : ” يا صلاة الزين على عزيزة يا صلاة الزين ” ، وتتميز أغاني الدلتا بأنها كلها من نوع الموال الطويل وليس الرباعيات القصيرة مثل الصعيد ومحورها الأساسي قصص العشق والغرام والهجر والبعاد مثل حال شعراء العصر الجاهلي.
وتكثر في أغنياتهم القصص الخيالية والأمثال الشعبية مغ خلفية سياسية تمجد الأبطال المدافعين عن الحق مثل موال أدهم الشرقاوي وهو من أبناء محافظة البحيرة أو تتغنى بمآسي الرجال في الغربة مثل موال : ” يا عزيز عيني وأنا نفسي أروح بلدي ” ، كما تكثر أغاني المناسبات المتعلقة بالحصاد والفيضان وتمني السلامة للصيادين أو الأغنيات ذات الطابع الشعري التي يؤديها العمال جماعيا أثناء العمل أو عند ذهاب النساء للترعة.
ومن التراث الغنائي أيضا أغاني المناسبات الاجتماعية مثل سبوع المولود والختان فضلا عن المئات من أغاني الأفراح وتنويعاتها المختلفة في الحنة وليلة الدخلة والصباحية ونقل الأثاث (العزال) وكلها من أشعار الفلاحين السريعة المبهجة التي تؤديها النساء على إيقاع الطبلة الدربوكة ، وأغاني الأفراح هي مستودع الوجدان الجمعي للأسرة الريفية وما تحمله من إيحاءات تخص العلاقة الزوجية وعلاقة الزوجين بالأهل.
وتأثير التصوف حاضر في المنطقة لارتباطها بالموالد وطقوسها منها موال : ” الله الله يا بدوي جاب اليسرى ” وهو مستوحى من حكايات السيد أحمد البدوي التي يتناقلها العوام بالإضافة إلى المدائح النبوية وجلسات الذكر والإنشاد الديني والابتهالات ، ولها موسيقى خاصة بها تتماشى مع الأجواء الاحتفالية ورقصة التنورة وحركات الذاكرين ومن أشهر تعبيراتهم في افتتاحية المناسبات المختلفة : ” الورد كان شوك من عرق النبي فتح “.
وفي أقصر شرق الدلتا نسمع صوت المقاومة الشعبية من خلال السمسمية ومن أشهر أغانيها : ” غني يا سمسمية .. لرصاص البندقية .. ولكل إيد قوية .. حاضنة زنودها المدافع .. غني للمدافع .. وللي وراها بيدافع .. ووصي عبد الشافع .. يضرب في الطلقة مية ” ، وهي أغنية شعبية تحمل الطابع الوطني والنضالي المميز لمنطقة قناة السويس التي شهدت حروب مصر الحديثة كلها وانتصاراتها وكان أبناؤها في الصفوف الأولى للمعارك وطليعة الأبطال للمقاومة الشعبية ..
ولعبت فرق السمسمية دورا وطنيا كبيرا في رفع الروح المعنوية للجنود والمواطنين بعد هزيمة 67 حيث قام الكابتن غزالى بتأسيس فرقة ولاد الأرض فى السويس والشاعر حافظ الصادق بتأسيس فرقة الصامدين فى الإسماعيلية والشاعر كامل عيد بتأسيس فرقة شباب النصر ببورسعيد ، وكانت فرق السمسمية تغنى للجنود فى الخنادق وتشد من أزرهم وتغنى للمُهَجَّرين فى معسكرات التهجير ..
والسمسمية آلة خماسية الأوتار انتقلت من النوبة أثناء حفر قناة السويس وهي تطوير لآلة الطنبورة النوبية المعروفة ، وانتشرت في حوض البحر الأحمر حيث نشأت أنواع مختلفة من العزف مثل السمسمية العقباوية نسبة لمدينة العقبة الأردنية والسمسمية الينبعاوية نسبة لمدينة ينبع السعودية والسمسمية الحضرمية نسبة إلى حضرموت باليمن ولكل منها أغانيها وألحانها المعبرة عن البحر وسكان السواحل ..
وارتبطت موسيقى السمسمية منذ حفر القناة برقصة البمبوطية الخاصة بالبحارة والعاملين في خدمة السفن وتجار البحر الذين يعملون على المراكب مع السفن العابرة في القناة واشتق اسمها من كلمة البمبوطية وهي إنجليزية الأصل (مان بوت) أو رجل القارب ، وكانت تؤدى للسمر والتسلية على شاطىء القناة في أوقات الفراغ وهي مميزة بملابسها المكونة من السروال العريض والصديري وطاقية البحر البيضاء ..
ومن أشهر أغانيها القديمة ما تغنى به البحارة في رحلتهم إلى سواحل اليمن : ” بالله عليك يا طير يا رمادي .. افرد جناحك ودينى بلادي .. عدن عدن ياللى عليك بحرين .. فيه الحليوة ليه شهرين ” ، ومن أشهر أغانيها : أبويا وصاني .. بتغني لمين يا حمام .. زارني المحبوب .. فجر الرجوع أهو لاح .. بلدي بلد الفدائيين .. احنا البمبوطية احنا ولاد المية ، وكذلك الأدوار الجداوية نسبة لمدينة جدة على شاطىء الحجاز ..
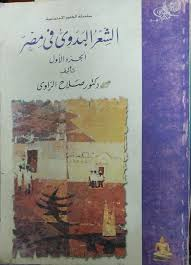
السامر البدوي
يحتل الشعر والغناء منزلة كبيرة في التراث الشعبي للقبائل العربية في سيناء والنقب ولديهم ثلاث آلات موسيقية أساسية هي الربابة المعروفة والشبابة وهي تشبه الناي والمقرونة وهي تشبه الزمارة ، وكل شعر في سيناء يغنى والشعر عندهم نوعان : الفردي ويشمل القصيد والمواليا وحداء الإبل ، والثاني الغناء الجماعي مع الرقص البدوي ويشمل الدحية والسامر والمشرقية وكلها مكونة من أبيات شعرية قصيرة تشبه الزجل ..
أما القصيد فينشد على الربابة في مناسبات المديح للشيوخ الكبار والضيوف وأما المواليا فهو الغناء على ظهور الإبل على مدى الصوت وأما حداء الإبل فهو الغناء للإبل وهي تسير أو تشرب ولكل قبيلة ألحان ومقاطيع في الحداء تختص بها ، ومن أمثلة المواليا قولهم : ” يا كم بنية نوبة .. قيلت أنا وياها .. والجذلة عشب ثريا .. قبل العرب ترعاها .. ولد يا راعي الشقرا .. ومن إيدها حفيانة .. يمك على عربنا .. يا مداوي الوجعانه ” ..
أما الدحية فهي صورة مبسطة من السامر حيث يجتمع البدو ويقف المغنون صفا واحدا وبينهم شاعر يدعى البداع وأمامهم فتاة ترقص بالسيف تدعى الحاشية ، ويبدأ الغناء بالتبادل بين الشاعر والمغنين الذين يرددون عبارات خاصة تسمى الردة (الرد على البداع) مع التصفيق وهز الرأس والجسد مع اللحن ثم يتحركون نحو الفتاة التي ترقص بالسيف مسافة ليجلس الجميع القرفصاء ويواصلون الغناء ثم يرجعون إلى مكانهم بنفس الترتيب ..
وقد يكون هناك أكثر من شاعر يتناوبون على الغناء وقد تكون هناك أكثر من فتاة تمسك كل منهم في يد الأخرى فإذا رقصت اثنتان حملت السيف الواقفة على اليمين وإذا كانوا ثلاثة حملت السيف الواقفة في المنتصف ، ومن أشعار الدحية قولهم : ” وإن جاني الخير عطشان .. ع المي ماني معييته .. وإن جاني الخير جيعان .. من غداي ما غديته .. وإن جاني الخير بردان .. بطرف القنعة ما غطيته .. وإن طلب مني الحبة .. والله ماني معطيته ” ..
أما السامر فهو تكرار لما يحدث في الدحية بشكل أكبر وهو نوعان أولهم الرزعة وفيه يقف الرجال فريقين في صف منحن على شكل هلال مقطوع من الوسط ويقف مع كل فريق شاعر بداع وفتاة ترقص بالسيف ويتنافس الفريقان في الغناء والترديد ، والنوع الثاني هو الخوجار وفيه تشارك النساء حيث يقفن على هيئة صف واحد بين صفي الرجال وفيه شاعرتان تغني كل منهما لفريق من فريقي الرجال لكن لا يتحركن من المكان ..
وأما المشرقية فهي نفس الرزعة لكن ينشدون فيها أبياتا أطول بألحان مختلفة لتناسب ذلك ، ومن أشعار السامر : ” يا طالعين البراري في سموم ورياح .. لا القلب ساكن هنا ولا شوقكم مرتاح .. يا طالعين الجبل والصيد في الوادي .. ومنقرشات الحنك بنات الأجواد ” ، ومن أشعار المشرقية : ” يا رويع يا البكرة ها النايفة .. خاطري عشرتك ومن أهيلي خايفة .. اطلع تنزه ليالي العز ما دامت .. يا أكحل العين ما أحلى دقة وشامك “.
وفي غرب النيل تضم الصحراء الغربية كلا من الساحل الشمالي والواحات وكذلك أطراف الدلتا في البحيرة وتخوم الصعيد في الفيوم ، وقد سكنتها العشائر البدوية منذ زمن طويل وصار لها تراثها الشعبي المميز لها سواء في الملابس أو الغناء أو الرقص أو اللهجة المحكية ، وهي تتشابه في عمومها مع مثيلاتها في الصحراء الليبية وساحلها وواحاتها المتناثرة ، ومن التراث الشعبي لهذه القبائل رقصة الحجالة التي تقام لها طقوس احتفالية خاصة ..
وقد اشتقت كلمة حجالة من الحجول وهو الخلخال الثقيل واشتق من لغة العرب حيث كان الحجال هو خباء المرأة من ملبس أو غطاء وأحيانا يعطي معنى السور المحيط بمضارب القبيلة ولذا كان يقال (ربات الحجال) ومنها اشتقت مشية الحجل أي على ساق واحدة تشبها بمن ترتدي ثقلا في ساقها ، ولا يطلق البدو على الحجالة اسم الراقصة لكنها (حجالة تحجل) وذلك حفظا لحيائها ومراعاة للتقاليد والأعراف البدوية ..
والمؤديات لرقصة الحجالة هن نساء من البدو يقمن بتغطية وجههن و الرقص على المجاريد والشتاوي وهي الأشعار والأغاني التي تقال في رقصة الحجاله ، وتبدأ الرقصة على أنغام الشتيوة وهي جملة واحدة متكونة من أربعة إلى ستة كلمات يتغنى بها الشاعر بالجزء الأول منها ومعه بعض الأفراد ثم تردد بقيه المجموعة جزءها الثاني والأخير بمصاحبة التصفيق الشديد بطريقه معينة مع إطلاق بعض الصيحات والتمايل أحيانا لإثارة الحمية ..
يلي ذلك أغنية العلم وهي عبارة عن شطرات قصيرة قد تكون من ثلاثة إلى أربع يغنيها الشاعر على ثلاث مرات وتفصل بين كل واحدة منها شتيوة جديدة وهي تؤدى بلحن مختلف حيث تكف المجموعة عن التصفيق والحركة كما تتوقف الحجاله عن الرقص ، بعد ذلك يبدأ في إلقاء المجرودة وهي العمود الرئيسي في الغناء وهي نوع من القصائد العربية تشبه الزجل ومعروفة عند العرب منذ القدم وقد تصل أبياتها إلى مائة بيت ..
والمجرودة تحكي بالشعر قصصا وموضوعات كثيرة يتغنى بها فتصف معركة حربية أو حسناء بدوية أو تشيد بإحدى البطولات أو الحياة الاجتماعية أو تدور كلماتها حول الغزل الرقيق ، ويبدأ الشاعر بترديد أبياتها بمفرده بلهجته البدوية بينما تأخذ المجموعة في التصفيق تصفيقا رتيبا على نغمة الإلقاء ويرددون معه نهاية كل مقطع من أبياتها ثم يشتد التصفيق شيئا فشيئا والرجال يتمايلون ويصيحون متحمسين ..
أثناء ذلك تتوقف الحجاله عن الرقص وتنصت للشاعر أثناء إلقائه ولا تصدر أية حركة سوى هزة خفيفة من وسطها وهي ممسكة في يدها بالعصا التي ترقص بها والتي أحيانا ما تومئ بها إلى أعلى بالتحية عندما تصادف بعض الأبيات الشعرية استحسانا في نفسها ثم يستمر الشاعر في غناء المجرودة ، وفي آخر الرقصة في الفجر يختم ذلك بكلمة هيا دام وهذا يعني دامت الأفراح ودامت رقصة الحجاله ودامت دياركم سالمة ..
أما سيوة فهي واحة السلام .. ففي شهر أكتوبر من كل عام يحتفل سكانها جميعا بمناسبة خاصة بهم تسمى عيد السلام وله أسماء عدة منها عيد الحصاد وعيد المصالحة وعيد السياحة (إسياحت باللغة الأمازيغية) ، ويرجع سبب ذلك إلى طبيعة التكوين السكاني للواحة منذ الزمن القديم حيث كانت مقسمة بين القبائل الأمازيغية التي تسكن الجزء الشرقي في جبل الدكرور والقبائل العربية التي تسكن الجزء الغربي في منطقة السهول ..
ظلت النزاعات والخلافات قائمة بينهما حتى تم الصلح أخيرا في عام 1825 م. على يد الشيخ محمد حسن المدني الظافر مؤسس الطريقة المدنية الشاذلية في سيوة ولذا يسمى عيد المصالحة رافعا شعار : ” كلنا سواسية في حب الله وترديد الذكر” ، والسياحة هنا صوفية لمدة ثلاثة أيام يتركون فيها بيوتهم ويتجمعون لتجديد العهد والميثاق على الوئام والعيش المشترك ونبذ الخلافات وذلك في الليالي القمرية التي تعقب حصاد التمر والزيتون ..
مراسم الاحتفالات تتلخص في إعداد الطعام في العراء ونحر الذبائح وتجهيز الساحات وأماكن الإقامة بين الحطب والنار ، وفي خلفية المشهد مؤثرات صوتية تردد الأذكار والتواشيح الدينية باللغتين العربية والأمازيغية ، بينما يتجمع كبار السن في حلقات للذكر ومدح الرسول لإضفاء لمسات من السلام الداخلي على النفوس في هذا اليوم ، وتحضر الفتيات الجزء النهاري فقط من الاحتفالات ثم يعودون إلى الواحة في المساء ..
والثقافة الشعبية في واحة سيوة خليط من التراث العربي والأمازيغي بحكم التكوين السكاني حيث يعد أهم عيد في الواحة هو احتفال (الناير) ويعني رأس السنة الأمازيغية (13 يناير من كل عام) حيث تحرص النساء على ارتداء الأزياء التقليدية للأمازيغ المميزة لفروع العشائر وهو المنحدر من قبيلة زناتة البربرية القديمة والموجودة في واحة سيوة في مصر وواحة الجغبوب في ليبيا والناطقين بلهجة (تاسيويت) الأمازيغية ..
والفنون الشعبية السيوية مختلطة بالتراث الصوفي بسبب تأثرها بالسنوسيين وغيرهم حيث تتشابه الرقصات الشعبية مع حركات المتصوفين عند الذكر ، ومن هذه الرقصات الزقالة التي يؤديها الرجال إما فرديا أو جماعيا أو النوعين معا حيث يجتمعون في دوائر كبيرة مزدحمة وينتظمون في دائرة متصلة كاملة ثم يبدأون في الدوران بصفة مستمرة بدون توقف ويوجد رجل بوسط نصف الدائرة يؤدي رقصة البورمية الفردية ..
ويتم ذلك مع آلات موسيقية خاصة بهم منها الطبلة السيوية المعروفة باسم طوبيل والدف (الطار) والستاوية والخمساوية وهي من آلات النفخ وكذلك الشبابة البدوية المعروفة التي تشبه الناي لكنهم يطلقون عليها في لغتهم اسم (تيجعبت / تشيبت) ، وهذه الألحان ذات السلم الخماسي تتشابه مع مثيلاتها في دول شمال أفريقيا وتضم في أغانيها الملالاه الاحتفالي وهو موال فردي أو جماعي يتخلله (القول) وهي حكم شعبية دارجة ..
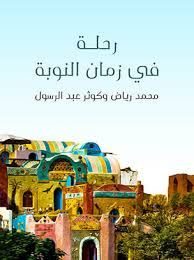
أفراح الجنوب
كل شيء في النوبة مزركش .. البيوت والملابس والحلي وزينة النساء وحتى الأغاني .. كل شيء فيها يوحي بالفرح والسرور ولذلك تميزت احتفالات الزواج فيها بهذا الطابع ، ومن أهم الرقصات الجماعية هي رقصة الأراجيد (وأصلها الأراقيد) والتي تشبه حركة موجات النيل وسعف النخيل عندما يتمايل الرجال على إيقاع الطار في حركة تشبه ما يفعله المتصوفة في حلقات الذكر وينشدون باللغة النوبية ذات اللكنة الجميلة والمحببة للنفس ..
وفي إنشادهم تختلط العربية بالنوبية حيث تسمعهم ينشدون : ” مقامي عالي زي السد .. في الشدة بمد اليد .. نوبيا أهم شيء بلدي .. أتباهى ببياض توبي .. أنا نوبي ” ، وقد يؤدي الرجال رقصات الأراجيد وحدهم أو في حضور النساء خاصة في مناسبات الأفراح المختلفة والتي تبدأ بيوم الحنة (اليوم الأول) وتنتهي بيوم السبوع (اليوم السابع) وبينهما الزفاف والصبحية وأيام كثيرة كلها احتفالات وولائم لأصدقاء العريس والعروس ..
والآلة الموسيقة الأساسية هي الدف التي يطلقون عليها اسم الطار ومعها آلة الطنبورة أو الكيسر (تحريف قيثارة) وهي آلة وترية نوبية تشبه السمسمية وتشتهر بالإيقاع الخماسي ، والإيقاعات الأساسية في الموسيقي النوبية التقليدية تشمل كلا من : الكومباش والكيتشاد ، ومنه (الله ليه لي) والذي يسمى أحيانا بـاسم الإيقاع الكنزي ، وأولن أرجيد أي رقصة الكف بالإضافة إلى إيقاعات أخرى مثل السكي وهل وفيزي ..
وهناك رقصة خاصة بالنساء عند وصولهم بيت العروسة وهم متشابكي الأيدي على هيئة نصف دائرة وتعرف باسم الشيلة ، وهناك رقصة فري حيث يتحلق الشباب والفتيات في نصفي دائرة متقابلين للاحتفال بالعروسين ، وهناك رقصة بلاجة وهي تؤدى على أنغام أغنية نوبية تراثية تحمل نفس الاسم وهي عبارة عن أشعار متبادلة بين العروسين ، وهناك رقصات الكف الجماعية مثل رقصة هولي هولي ورقصة التربالة الكرو ..
في رقصة هولي هولي يصطف الشباب والرجال على شكل مربع يؤدون خطوات موحدة مع التصفيق بالكفين وبينهم المنشدون الذين يؤدون الأغاني ويضربون على الدُف ويقف خمسة من ضاربي الدفوف لأداء الأغاني يتوسطهما حامل الجريدي ، وفي رقصة التربالة الكرو يبدأ والد العريس برفع سيفه وهزه في الهواء ويردد كلمات تشيد بالحسب والنسب وتزغرد النساء خلف الحلقة ويصدر الرجال همهمات تعبيرًا عن الفرحة والفخر ..
أما الرقص بآلات الحرب والصيد وتقليد حركات الحيوان خاصة الجمل فهي السمة المميزة لرقصة الهوسيت في حلايب وشلاتين وأم رماد وجنوب محافظة البحر الأحمر ، وهي من سمات ثقافة قبائل البجا الناطقة بلغة البداويت وأهمها قبيلة البشارية التي تشكل أغلبية السكان في المنطقة لكنها تأثرت بالعشائر العربية المجاورة مثل العبابدة والرشايدة حيث اختفى الرمح التقليدي من الرقصة وحل محله السيف العربي ، وحياتهم مرتبطة كثيرا بالإبل حيث يطلقون على الجمل اسم أوكام ويتخذونه شعارا لهم.
وتوجد أنوع مختلفة من الرقصات الشعبية عند قبائل البشارية وهي الواندوب والهوسيت والبيبوب وأوكل وكلها تؤدى عن طريق تحريك جميع أجزاء الجسم حيث تعتمد في حركاتها على القفز والوثب والحجل ، وكل رقصة منها لها إيقاعها المميز ومناسبتها الخاصة التي خصصت من أجلها حيث الأداء التمثيلي القائم على التقمص ومحاكاة الطبيعة وهي سمة عامة لكل الرقصات في قارة أفريقيا ..
وكلمة هوسيت في لغة البجا تعني الاستعداد ويقصد بها التأهب للحرب أو الصيد أو المبارزة وسط دق الأقدام على الأرض وضرب الكفوف من الحاضرين ويجب أن يبدأ أكبر القوم سنا أو أعلاهم مقاما حيث ينزل إلى الوسط مع بدء العزف ممسكا بالسيف والدرقة (الدرع الخاص بالبجا) ويجاوبه الجمهور بهمهمات مشجعة ثم تبدأ الرقصة على هيئة شخصين يتبارزان ثم يحل محلهم اثنان آخران وهكذا ..
والزي الخاص بها يتكون من سروال يسمى البوجا أو السربادوب وقميص يسمى العراقي وجلباب فوقه صديري يعرف باسم السواكني نسبة لمدينة سواكن السودانية ، ويستعمل فيها السيف (مأدد) والخنجر (شوتال) والعصا (أكوالي) والسوط (قرنتي) والدرع وهو دائري كبير ومنه ثلاثة أنواع وهي كربياي المصنوع من جلد الفيل وداشكاب من جلد التمساح وتاسنتياي من جلد فرس البحر ..
ويستعمل في العزف آلة وترية خاصة بهم تسمى باسنكوب مع إيقاع الطبول القوية وتصاحبها أحيانا بعض الأغاني التي تمجد القبيلة وبطولاتها ، وتقام الرقصة في الكثير من الاحتفالات والمناسبات الاجتماعية العامة والخاصة وفي جلسات الونسة وفي أوقات الفراغ عند ممارستهم لمهنة الرعي في الصحراء وأيضاً لتحية الضيوف أو التعبير عن الفرح والسعادة وهي كذلك وسيلة للتسلية والترويح عن النفس .. (المرجع : مجلة الثقافة الشعبية العدد 52 الباحث محمد أبو شنب).
ويجاور البشارية شمالا موطن العبابده وهي قبائل عربية انتشرت في كل من مصر والسودان جنوب الخط الذي يصل بين سفاجة وقنا شمالاً والبحر الأحمر شرقاً ووادي النيل غرباً وحتى الحدود الإدارية جنوباً ، وقد استقر العبابدة في قنا وقوص والأقصر وأرمنت شرق النيل وفي إسنا وإدفو وكوم امبو شرق النيل وفي أسوان وبلاد النوبة شرق النيل ، وقد خلط أكثر الباحثين بين قبائل العبابدة وقبائل البشارية الذين هم فرع من البجا نظراً لتجاور مناطقهم واختلاطهم أحياناً كثيرة في الصحراء الشرقية ..
وينقسم العبابده إلى أربع مجموعات قبلية هي : العشاباب ـ الفقرا والمليكاب ـ الشناطير والعبوديين ـ الجميلية ، والعبابدة الذين يسكنون شمال أسوان أغلبهم من العشاباب ولا توجد مناطق خاصة لقبيلة بعينها لأنه حسب طبيعة معيشتهم فإنهم غالباً ما ينزحون إلى مناطق سبقهم إليها عبابدة آخرون أياً كانت تبعيتهم القبلية ، ومن عادات العبابدة تقاليدهم الاحتفالية بولادة طفل والاحتفال بالزواج والختان حيث يذبحون الذبائح وبعد تناول العشاء يبدأ السامر بآلة الطنبورة فقط فهم لا يستخدمون آلات إيقاعية بل بدق الكف والرزم بالقدم على الأرض يؤدون به إيقاعهم الذى يلعبون عليه بالسيف والدرق في دور يسمى التربلة.
وتبدأ الاحتفالات عندهم بنوع من الموال الشعبي يدعى النميم يلقى باللغة العربية بينما يردد الجميع كلمة ” أبشر ” ، وبعد فترة من الغناء ودق الكف والرد على المغني وعازف الطنبورة يكون الجميع قد تهيأ واحتشد لأداء المرحلة الأولى من الاحتفالية الحركية وهي التربلة الجماعية حيث يصطف الشباب ثم يقف المغني والعازف على يمين الصف مع رد الشباب في الصف على المغني وأدائهم بدق الكف بإيقاع مميز بينما يدقون أقدامهم على الأرض بإيقاع آخر حيث يتم التناوب في التربلة الجماعية بين دق الكف مع رزم القدم على الأرض من الثبات أو دق القدم مع دق الكف مع الوثب الخفيف..
وبعد فترة يتم وضع السيف والدرقة أمام منتصف صف الشباب الذين يدقون الكف والرزم بالقدم ومع عزف الطنبورة (دون غناء) يخرج أحدهم من الصف ويمسك السيف والدرقة مؤدياً حركة الوثب الخفيف أو الحجل بالقدمين ويمر أمام الصف ذهاباً وإيابا بهذه الحركة شبه الواثبة وفي نفس الوقت يلعب بالدرقة والسيف عن طريق نطر السيف لأعلى فارداً الذراع تتلوها حركة أخرى عن طريق نطر الدرقة لأعلى فارداً ذراعه ، وعند انتهاء كل مشارك من دوره يقوم بضرب السيف على الدرقة معلناً اكتفاءه باللعب ثم يضعهما على الأرض ليخرج آخر ليأخذ دوره في اللعب .. (المرجع مجلة الثقافة الشعبية العدد التاسع الباحث سمير جابر).
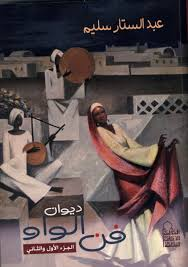
الصعيد .. البطولة والفروسية
التحطيب فن قديم وهو يجمع بين كونه لعبة ورقصة في نفس الوقت لكن تجلى حضوره في صعيد مصر تحديدا بسبب الموروث الثقافي حيث كانت المبارزة الفردية هي المشهد الأكثر شعبية في كل من السيرة الهلالية وسيرة سيف بن ذي يزن وأبي الفوارس عنترة والزير سالم وهي السير الشعبية التي انتشرت في ربوع الصعيد من شماله إلى جنوبه ويرى بعض المحطبين من حاملي الموروث بالفطرة أن التحطيب هو استخراج من حرب الهلالية ..
وغالبية القصص الشعبية والسير والملاحم التي تتغنى بمشاعر الحب والحنين والبطولة والشهامة والتأثر تقع حوادثها في هذه المنطقة ومن ثم فإن أشهر الفنانين الشعبيين من الشعراء وكتاب السيرة والقصص وفناني الموال والمداحين قد ولدوا في الصعيد ، والجلباب وغطاء الرأس الصعيدي المألوف والكوفية اللامعة هي الزي السائد للاعبي التحطيب وهو الذي يعطيها طابعها المميز ويضفي عليها صورتها الذهنية في الوجدان ..
ويحتل التحطيب مكانته في الموروث الصوفي الشعبي حيث كانت أهم حلقات التحطيب تتم في الموالد الكبيرة مثل مولد سيدي عبد الرحيم القناوي وسيدي أبي الحجاج الاقصري حيث يعلن عن رفع العصاية من بعد صلاة العصر حتى صلاة المغرب ولمدة أسبوع ويجتمع المحطبون من كل المحافظات حيث يدعو لاعبو المحافظة التي يقام فيها المولد لاعبي المحافظات الأخرى ويتنافس الجميع في مهرجان فني ورياضي له طابع شعبي وديني ..
والعصا هي العنصر الأساسي في رقصة التحطيب ، وكانوا قديماً يستخدمون الشوم الغليظ وتسمى العصا الغشيمة أو شوم محلب أي شومة شديدة مكسورة من الشجرة بالقوة وهذا غير مستخدم الآن لأنه يؤذي ويستخدمون بدلاً منها عصا من الخيزران ، وداخل المحافظة الواحدة يحدث اختلاف في مقدار عنف اللعبة تبعاً لقربها من الجبل أو بعدها عنه ، فكلما بعدنا عن نهر النيل باتجاه الجبل اتسم التحطيب بالعنف نظراً لقسوة الجبل وصعوبة العيش ..
ويتحول التحطيب إلى لعبة رياضية إذا كان التجمع بغرض التحدي أو بين الأقارب والأصدقاء أو للتسلية حيث يصير لها قواعد منظمة يراقبها الجمهور المتحمس ، أما في الاحتفالات والأعراس فإن الطابع الاستعراضي يكون هو الغالب تعبيرا عن السعادة والبهجة بالمولد أو العرس وهنا يتحول التحطيب إلى رقصة شعبية على أنغام الموسيقى لأن السياق الاجتماعي الذي تقدم فيه لا يفرض أن يتم الأداء من خلال القوانين الملزمة للعبة ..
ويتم استعراض التحطيب على وقع آلات موسيقية منها الناي والأرغول والمزمار البلدي (الآبا) والمزمار الصعيدي (الشلبية) والطبل البلدي (العلبة) ذي الوجهين والنقرزان ذي الوعاء النحاسي والطبلة الصغيرة (البازة) التي يستعملها المسحراتي ، أما الربابة فهي نوعان ذات الوترين وهي الشائعة وذات الوتر الواحد وهي خاصة بالشعراء الذين ينشدون الملاحم الشعبية لتكون خلفية درامية وفنية وحماسية لأبطال التحطيب (المرجع : مجلة الثقافة الشعبية العدد التاسع الباحث حسام محسب).
ولعلك سمعت يوما قولهم : ” ولا بد من يوم معلوم .. تترد فيه المظالم .. أبيض على كل مظلوم .. أسود على كل ظالم ” .. هذه الأبيات الشعرية المعروفة والتي جاءت في تتر مسلسل ذئاب الجبل هي في حقيقة الأمر أشهر رباعيات فن الواو المتوطن في محافظة قنا تحديدا حيث تقطن قبائل هوارة ، وتنسب الأبيات إلى شاعر شعبي متصوف يدعى ابن عروس وهو أحمد بن محمد بن عبد الله المزاتي من أبناء قرية مزاتة مركز قوص وسمي على اسم فتاته (عروس الهودج) ..
وفن الواو هو رباعيات أو مُربعات شعرية من بحر المُجتث الذي يتكون من التفعيلة (مستفعلن فاعلن) في كل شطر ويتكون كل مُربّع من أربع شطرات متبادلة القافية أي أن للبيت الأول والثالث قافية موحدة والثاني والرابع قافية موحدة ، وسُمي بـاسم فن الواو لأن من يُلقيه قد اعتاد أن يبدأه بـعبارة : ” وقال الشاعر ” ، و في رواية أخرى أنه كان شكلا من المباراة الشعرية التي يشترك فيها شاعران والثاني يبدأ مُربعه بـعبارة : ” وأزيدك ” ..
والغرض الشعرى لفن الواو كان الشكوى من الزمان وغِدر الخلّان وينطوى على حِكَم وغزليات وأفرزته جلسات أهل الصعيد الطويلة نهارا أو ليلا وبالأخص ليالى السّـمَـر القمرية فى الساحات والمنادِر وفى الأجران أو المساطيح (أرض فضاء تحت الشمس تُجفف فيها الذرة والبلح) ، ويطلق على شاعر الواو اسم المواوي أو القوال أو الراوي حيث يلقيها في أمسيات شعرية خاصة أو في المناسبات الاجتماعية في أجواء احتفالية ..
وفن الواو في جذوره مستمد من أشعار السيرة الهلالية التي كانت بعض أبياتها تأتي على هيئة رباعيات وهو أيضا مصدر شعر الرباعيات الذي اشتهر في العصور الحديثة وتطور على يد بيرم التونسي وصلاح جاهين وعلي النابي ، وقد نشأ هذا الفن في العصر المملوكي مع انتقال قبائل هوارة البربرية من البحيرة إلى الصعيد بأمر السلطان برقوق وتوليهم إمارة الإقليم وعمارته وزراعة القصب فيه طوال خمسة قرون كاملة ..
واشتهر من أشعارها في الغزل قول أحدهم مخاطبا قلة الشرب : ” خايف أقوله يقول لا .. والقلب مرعوب وخايف .. ابقي قوليله يا قلة .. حين توردي عالشفايف ” ، ومن أهم شعراء فن الواو في الزمن المعاصر الشاعر عبد الستار سليم الباحث في هذا الفن وله أبيات منها : ” بخت الخسيس اتعدل لما الزمن غلاه .. ورخص ابن الأصول وفي قدرته غلاه .. فردت قلعي عشان أرحل خانتني الريح .. ودرست جرني طلع تبني بلا غلاه ” ..
وأحيانا تمتزج الطقوس الاجتماعية بالشعر وكلماته والتعبير الأدبي الخيالي مثلما حدث في فن العدودة أو العديد وهو نوع من الرثاء الحزين للميت تتم بنغمات وطبقات صوتية تجمع بين الأداء الغنائي وبين التعبير عن العزاء والمواساة ومنها عبارة معروفة في الصعيد تقول : ” دخل الأطبة مدوا أياديهم .. قال الطبيب معيش دوا ليهم .. دخل الطبيب دخلت قدامه .. قال يا شقية خلصت أيامه ” وهو في حقيقته نواح على الميت يؤدى في صورة جماعية.
وتختص به النساء حيث تبدأ النائحة (العدودة) بالنصف الأول من الأبيات وهي مفتاح العدودة وتردد بعدها مجموعة النساء (الشلايات أو الندابات) النصف الثاني بصوت مبحوح ، ولغويا اشتق من ندَبَ الميت أي بكى عليه وعدد محاسنه : ” يندبه ندبا والاسم النُدبة بالضم وندب الميت بعد موته من غير أن يقيد ببكاء وهو من الندب للجراح والندب أن تدعو النادبة الميت بحسن الثناء في قولها وفي الحديث كل نادبة كاذبة إلا نادبة سعد “.
والإشْلاء هو الدعاء يقال أَشلْيت الشاة والناقة إذا دَعوتَهما بأسمائهما لتَحلبهما وتأتي أيضا بمعنى الإغراء ، وفي لسان العرب جاء : ” العِدادِ وهو وقت الوفاة وقال ابن السكيت : إِذا كان لأَهل الميت يوم أَو ليلة يُجْتَمع فيه للنياحة عليه فهو عِدادٌ لهم ” ، وينسب إلى فن الرثاء في الشعر الفصيح وهو غرض لها امتدادته ومدونته الواسعة في الشعر العربي منذ نشأته وفيه ألفاظ فصيحة تتداولها المعددات الأميات دون أن تعرف الواحدة منهن معنى الكلمة إلا إذا كانت في سياق كلام آخر.
وتتكون العدودة من عبارات قصيرة أو جمل متكررة متوازنة ذات إيقاع لكنها متوازنة ، ويتم التغيير في التقفية وهي تختلف عن نظام التقفية في القصيدة الفصحى التقليدية لأنها تعتمد على حركة الحروف وليس أصواتها فالمهم لدى الشاعر الشعبي هو الفتحة والكسرة والضمة وحروف المد ، فالقافية هي نسق من الفتح والضم والكسر للحروف الأخيرة تسمح بتناقل العدودة في سهولة ويسر وتتوافق مع حركات الجسم وتطويح النائحات.
ولكل مناسبة كلامها .. عدودة الفتاة التى ماتت في ريعان شبابها قبل الزواج تختلف عن عدودة الأم التى تموت تاركة خلفها أولادها الصغار عن عدودة الشاب الصغير الذى وافاه الأجل المحتوم عن الزوجة التى مات زوجها وكانت تراه ذا قدر عند قومه ، وأحيانا تشتق بعض العبارات النثرية للرثاء مثل قول المعددة وهي تصف جلسة المتوفي الفخمة أمام منزله وهي حي : ” يا أبو كوعة على المصطبة بعد العصر يا أخويا “.



