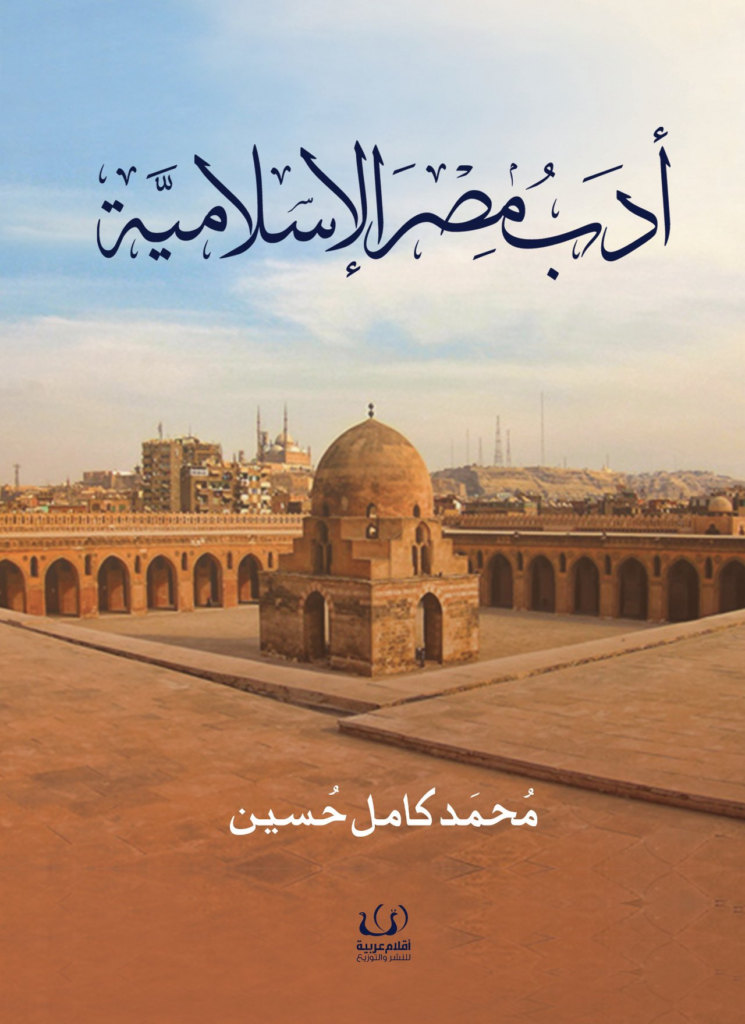
الكفور والنجوع والأدب العربي
في القرن الأول الهجري شهدت مصر اهتماما كبيرا بالشعر والشعراء وذلك بفضل الوالي عبد العزيز بن مروان الذي أنشأ مدينة حلوان جنوب الفسطاط وجعلها مقرا لديوانه فقصدها الشعراء وتغنوا بها في قصائدهم ، ومن أشهرهم عبد الله بن قيس الرقيات القرشي وجميل بن معمر العذري وكثير بن الأسود الخزاعي وأيمن بن خريم الأسدي ونصيب بن رباح الكناني وعبد الله بن الحجاج الباهلي.
وفي الفترة التالية صار جامع عمرو بالفسطاط ساحة للأدباء والشعراء المصريين من أمثال سعيد بن عفير الأنصاري والمعلي الطائي والحسين بن عبد السلام الجمل وأبي تمام حبيب بن أوس الطائي والإمام محمد بن إدريس الشافعي ، وفي زمن الطولونيين والإخشيديين شهدت مصر موجة أخرى من الشعراء أشهرهم المتنبي وابن جدار وابن الداية ومنصور الفقيه وابن طباطبا ومنصف بن خليفة الهذلي.
وتميزت العصور الإسلامية المتعاقبة بمساهمة فعالة من الأقاليم المصرية في مجال الأدب والشعر واللغة والتأليف والتي لم تقتصر على العاصمة ، على سبيل المثال لدينا من الإسكندرية تاج الدين ابن عطاء الله الجذامي السكندري مؤلف الحكم العطائية ومن برية البرلس شهاب الدين ابن فضل الله العمري مؤلف موسوعة مسالك الأبصار في ممالك الأمصار ومن دمياط الشاعر محيي الدين ابن النحاس الدمياطي.
ومن أبناء وسط الدلتا أحد أعلام الشعر والعروض وهو أمين الدين الأنصاري المحلي والشاعر ابن الرعاد العذري المحلي وأبو الحسن ابن جبارة التجيبي المحلي (نسبة للمحلة الكبرى) وزين الدين الطنتدائي (نسبة إلى طنطا) وشهاب الدين السلمي المنصوري (نسبة إلى المنصورة) وعلم الدين السخاوي (نسبة إلى سخا) وبهاء الدين الأبشيهي مؤلف كتاب المستطرف في كل فن مستظرف (نسبة إلى إبشواي الملق).
ومن الشرقية أبو الحسن الحوفي (نسبة إلى قرية شبرا النخلة في الحوف الشرقي) ومن القليوبية أبو العباس الفزاري القلقشندي مؤلف صبح الأعشى في صناعة الإنشا (نسبة إلى قرية قلقشندة) ومن المنوفية الأديب والمتصوف عبد الوهاب بن أحمد الأنصاري الشعراني (نسبة إلى منيل أبو شعرة) ومن البحيرة شمس الدين الدمنهوري (نسبة إلى دمنهور) ومن الجيزة الأديب والكاتب أبو البقاء الترسي (نسبة لقرية ترسا).
ومن بني سويف شاعر المديح النبوي شرف الدين الصنهاجي البوصيري صاحب قصيدة البردة (نسبة إلى أبو صير) وشهاب الدين النويري مؤلف موسوعة نهاية الأرب في فنون الأدب (نسبة إلى قرية النويرة) ، ومن الفيوم الكاتب والمصنف عبر البر بن عبد القادر الفيومي مؤلف كتاب حسن الصنيع في علم البديع ومن المنيا أبو جعفر الطحاوي (نسبة إلى طحا) وشهاب الدين القرافي البهنسي (نسبة إلى البهنسا).
ومن أسيوط جلال الدين السيوطي صاحب المؤلفات الغزيرة في مختلف الآداب والفنون ومن سوهاج أبو الفيض ثوبان بن إبراهيم الأخميمي المعروف بلقب ذي النون المصري (نسبة إلى أخميم) ومن قوص بمحافظة قنا كل من البهاء زهير وابن دقيق العيد ومن الأقصر بدر الدين الدماميني (نسبة إلى دمامين وهي المفرجية) ومن أسوان كمال الدين الإدفوي مؤلف الطالع السعيد الجامع أسماء نجباء الصعيد.
وفي القاهرة لعب ديوان الإنشاء دورا هاما في اكتشاف المواهب الأدبية واللغوية مثل القاضي الفاضل وفخر الدين ابن لقمان ومحيي الدين ابن عبد الظاهر والشاعر جمال الدين ابن مطروح وأبو الفضل محمد بن مكرم الأنصاري المعروف بلقب ابن منظور وهو مؤلف موسوعة لسان العرب والشاعر ابن سناء الملك الذي وضع قواعد الموشحات المصرية من خلال كتابه الهام (دار الطراز في عمل الموشحات).
واتسعت دائرة الأدب العربي في مصر لتشمل عددا كبيرا من المؤلفين الأقباط واليهود منهم ساويرس بن المقفع مؤلف كتاب تاريخ الآباء البطاركة وسعيد بن بطريق مؤلف كتاب التاريخ المجموع على التحقيق والتصديق والفيلسوف الكبير الرابي موسى بن ميمون (رامبام) مؤلف كتاب دلالة الحائرين والحاخام سعيد بن يوسف الفيومي (سعديا) مؤلف كتاب التاج ويضم شرحا عربيا للنص العبري للعهد القديم.
وإلى جانب كل هؤلاء لدينا كتاب السير الشعبية مثل الشيخ يوسف بن إسماعيل المصري كاتب سيرة عنترة بن شداد وابن الديناري وابن أيبك الدواداري مؤلفي سيرة الظاهر بيبرس والكامل الحافظ أحمد بن عبد الله المصري مؤلف كتاب (قصة المقدم علي الزيبق الذي تفرد بالشطارة والعياقة على جميع من تقدم وسبق) ومعهم مئات الشعراء الذين صاغوا السيرة الهلالية وسيرة سيف بن ذي يزن والزير سالم.
وربما تكون هناك حاجة لإعادة النظر في دور الكفور والنجوع والأقاليم المصرية في الحركة الفكرية والثقافية التي ازدهر فيها الأدب العربي في مصر وتطور باطراد من عهد الفتح الإسلامي وحتى الزمن المعاصر لأنها سوف تكشف عن الكثير من ملامح الحياة الاجتماعية للمصريين ونظرتهم للحياة وذلك من خلال الكتابات المتنوعة والغزيرة والتي يمكن أن نرصدها تحت عنوان جامع هو (تاريخ الأدب المصري).

السلطنة المصرية
يمتد عصر السلطنة المصرية ثلاثة قرون ونصف وذلك تحت حكم كل من الأيوبيين والمماليك البحرية والمماليك البرجية ، وشهدت تلك الحقبة الانتصارات التاريخية الكبرى على الصليبيين والمغول في كل من حطين وعين جالوت والمنصورة ومرج الصفر حتى صارت مصر دولة قوية مرهوبة الجانب وانتقلت إليها دار الخلافة ، وقد بلغت فيها مصر أوج توسعها الإمبراطوري في تاريخها كله حيث ضمت كلا من ليبيا والسودان واليمن والحجاز وبلاد الشام كلها وأعالي الفرات وأجزاء من العراق وجنوب شرق تركيا.
واشتهرت السلطنة المصرية بحكامها الذين جمعوا بين النجاح العسكري والدهاء السياسي وحسن الإدارة وعظمة العمران مثل الناصر صلاح الدين الأيوبي والملك العادل والملك الكامل والصالح نجم الدين أيوب وسيف الدين قطز والظاهر بيبرس والمنصور قلاوون والأشرف خليل بن قلاوون والناصر محمد بن قلاوون والظاهر برقوق والمؤيد شيخ والأشرف برسباي والظاهر جقمق والأشرف قايتباي ، كما تولت المرأة السلطنة لأول مرة حيث تولت شجر الدر في وقت عصيب فأدارت المعارك والمفاوضات بكفاءة واقتدار.
وقد تميزت السلطنة المصرية بوجود عدد كبير من الأدباء والشعراء في موقع الوزارة وإدارة شئون الدولة مثل القاضي الفاضل والعماد الكاتب وابن سناء الملك والأسعد بن مماتي والبهاء زهير وجمال الدين ابن مطروح وابن لقمان وابن عبد الظاهر ومحيي الدين ابن فضل الله والمقر بن الجيعان ، ومنهم أصحاب المؤلفات الموسوعية مثل ابن منظور مؤلف لسان العرب والقلقشندي مؤلف صبح الأعشى في صناعة الإنشا والنويري مؤلف نهاية الأرب في فنون الأدب وشهاب الدين ابن فضل الله مؤلف مسالك الأبصار في ممالك الأمصار.
وشهدت السلطنة المصرية نهضة كبرى في مجال الطب حيث تولى رئاسة الأطباء فيها ابن النفيس وموسى بن ميمون وابن أبي أصيبعة الخزرجي وشمس الدين ابن العفيف وابن الديري ومهذب الدين الدخوار ، وجعل السلطان البيمارستان للجندي والأمير والكبير والصغير والحر والعبد والذكور والإناث ورتب فيه الأطباء والأدوية وجعل فيه عدداً من الرجال والنساء لخدمة المرضى وقسمها قاعة لأمراض الجلد وقاعة للحميات وقاعة لأمراض المعدة وجعل المياه تجري فيه وأفرد مكاناً لخزن الأدوية ومكاناً لرئيس الأطباء لإلقاء دروس الطب.
وشهدت السلطنة المصرية ظهور أعلام التصوف المشهورين في البلاد ومنهم أبو الحسن الشاذلي وأبو العباس المرسي وابن عطاء الله السكندري وشرف الدين البوصيري وابن الفارض والسيد أحمد البدوي وإبراهيم الدسوقي وعبد الرحيم القنائي وأبو الحجاج الأقصري وأبو الفتح الواسطي والحنفي وابن عنان وأبو العباس الغمري وطلحة بن مدين التلمساني ، وحفلت البلاد بالخانقاوات الكبرى مثل خانقاه سعيد السعداء وفرج بن برقوق وبيبرس الجاشنكير والبندقداري والشيخونية وخانقاه الناصر محمد بن قلاوون (مدينة الخانكة الحالية).
وفي مجال التاريخ شهدت إسهامات كل من المقريزي وابن تغري بردي وبدر الدين العيني وابن إياس والصفدي وشمس الدين الذهبي وابن خلكان والسخاوي وابن الأثير وابن كثير ، ومن أبرز القضاة والشيوخ في وقتها كل من العز بن عبد السلام وتاج الدين ابن بنت الأعز وابن دقيق العيد وابن تيمية وتقي الدين السبكي وابن حجر العسقلاني وسراج الدين البلقيني والإمام جلال الدين المحلي وشيخ الإسلام زكريا الأنصاري وجلال الدين السيوطي وابن عقيل وابن سيد الناس وبدر الدين بن جماعة والحافظ المنذري وابن الملقن وابن خلدون.
وشهدت السلطنة المصرية نهضة معمارية ضمت مئات المساجد والمدارس والخانقاوات والأضرحة والأسبلة والبيمارستانات وتمتعت الدولة وقتها بازدهار اقتصادي كبير جعلها أغنى إمبراطورية في العصور الوسطى وأكثرها تأثيرا في حركة التجارة العالمية بين الشرق والغرب ، وقد وصفها ابن خلدون بقوله : ” حضرة الدنيا وبستان العالم ومحشر الأمم ومدرج الذر من البشر وإيوان الإسلام وكرسى الملك تلوح القصور والأواوين فى حجره وتزهر الخوانك والمدارس آفاقه وتضيء البدور والكواكب من علمائه “.
ووصفها ابن بطوطة بقوله : ” ثم وصلت إلى مدينة مصر هى أم البلاد وقرارة فرعون ذى الأوتاد ذات الأقاليم العريضة والبلاد الأريضة المتناهية فى كثرة العمارة المتباهية بالحسن والنضارة .. تموج موج البحر بسكانها وتكاد تضيق بهم على سعة مكانها وإمكانها شبابها يجد على طول العهد وكوكب تعديلها لا يبرح عن منزلها السعد قهرت قاهرتها الأمم وتمكنت ملوكها نواصى العرب والعجم ولها خصوصية النيل الذى أجل خطرها وأغناها عن أن يستمد القطر قطرها وأرضها مسيرة شهر لمجد السير كريمة التربة مؤنسة لذوى الغربة “.
وقال القاضي أبو القاسم البرجي عندما سُئل عن القاهرة : أقول فى العبارة عنها على سبيل الاختصار إن الذى يتخيله الإنسان فإنما يراه دون الصورة التى تخيلها لاتساع الخيال عن كل محسوس إلا القاهرة فإنها أوسع من كل ما يتخيل فيها ، ويستطرد ابن خلدون قائلا : وما زلنا نحَدِّث عن هذا البلد وبُعد مداه في العمران واتساع الأحوال ولقد اختلفت عبارات من لقيناه من شيوخنا وأصحابنا حاجّهم وتاجرهم بالحديث عنه ، سألت صاحبنا قاضي الجماعة بفاس وكبير العلماء بالمغرب أبا عبد الله المقرمي فقلت له كيف هذه القاهرة ؟ فقال من لم يرها لم يعرف عز الإسلام.

وزراء السلطان
اشتهر السلطان صلاح الدين الأيوبي بالانتصارات العسكرية والتفوق في السياسة والاقتصاد والعمران والإدارة وذلك بسبب حسن اختياره لوزرائه ومعاونيه من أهل الكفاية والفكر ومن أصحاب الرؤية والدراية ، فقد كان وزيره الأول ومدبر مملكته واحدا من أعلام الأدب العربي وهو أبو علي عبد الرحيم بن علي بن الحسن اللخمي البيساني المعروف بلقب (القاضي الفاضل) وهو كاتب وشاعر وسياسي تولى القضاء وعمل في ديوان الإنشاء وأشرف على دار الحكمة ثم ترأس الوزارة وقال عنه صلاح الدين : ” لا تظنوا أني فتحت البلاد بالسيوف إنما فتحتها بقلم القاضي الفاضل “.
أما الوزير المختص بديوان الإنشاء والمكاتبات في عهده فهو عماد الدين أبو حامد محمد بن محمد الأصفهاني المعروف بلقب (العماد الكاتب) وهو مؤرخ وشاعر وله عدد كبير من المؤلفات من أهمها كتاب خريدة القصر وجريدة العصر والذي تناول فيه بالنقد والتحليل شعراء عصره وكتب عنهم وعن أعمالهم الأدبية ، ويعاونه في الكتابة شاب نابه هو أبو القاسم هبة الله بن جعفر بن سناء الملك وهو شاعر وأديب له ديوان شعر كبير كما ألف كتاب دار الطرز في عمل الموشحات والذي وضع قواعد (الموشحات المصرية) ، وأما رئيس الأطباء في السلطنة وقتها فهو الفيلسوف اليهودي المعروف موسى بن ميمون مؤلف كتاب (دلالة الحائرين).
وأما الشئون الاقتصادية (ديوان المال) فقد عهد بها إلى واحد من أهم علماء الجغرافيا في تاريخ مصر وهو الوزير أبو المكارم الأسعد بن المُهذب بن مينا بن زكريا بن مَمّاتي مؤلف كتاب (قوانين الدواوين) وهو أول كتاب يحوي إحصائيات تفصيلية عن جميع القرى والبلدات المصرية ، وأما شئون البناء والتشييد (شاد العمارة) فقد عهد بها إلى الأمير بهاء الدين قراقوش بن عبد الله الأسدي الرومي الذي بنى قلعة الجبل والسور الكبير ، وأما الشئون الخارجية فكانت في عهدة الفقيه ضياء الدين أبي محمد عيسى بن محمد الطالبي الهكاري والذي أدار بنجاح العلاقات مع نور الدين محمود ثم الخليفة العباسي وسائر الأمراء حتى توحدت مصر والشام.
وأسند السلطان قضاء العسكر إلى واحد من أشهر المؤرخين وهو القاضي أَبُو اَلْمَحَاسِنْ بَهَاءْ اَلدِّينْ يُوسُفْ ابن شداد مؤلف كتاب (النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية) والمعرف باسم سيرة صلاح الدين ، وأما قاضي القضاة في مصر فكان واحدا من أعلام الفقه الشافعي في زمنه وهو الإمام الأوحد صدر الدين أبو القاسم عبد الملك بن سعيد بن درباس ، وفي الشام تولى القضاء الفقيه الشافعي شرف الدين أبو سعد عبد الله بن محمد بن أبي عصرون التميمي صاحب المؤلفات الفقهية المعروفة ، ويعاونه القاضي الشاب محيي الدين أبو المعالي محمد ابن الزكي الذي خطب أول جمعه في المسجد الأقصى بعد تحريره.
وفي عهده كان نقيب الأشراف هو السيد شريف الدين أبو علي محمد بن أسعد بن علي الجواني وهو مؤرخ ونسابة ومؤلف كتاب (الجوهرة المكنونة في ذكر القبائل والبطون) ، أما مشيخة الصوفية وقتها (شيخ الشيوخ) فكان مقرها في خانقاه سعيد السعداء وتولاها المتصوف الشيخ صدر الدين محمد بن حمويه الجويني ، وتولى مشيخة القراءات بالديار المصرية وقتها ناظر المدرسة الفاضلية الإمام أبو محمد القاسم بن فِيرُّهْ بن أحمد الشاطبي الرُّعَيني الأندلسي مؤلف متن الشاطبية في القراءات ، وشيخ الحنابلة في زمنه هو الإمام موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي مؤلف كتاب المغني في الفقه.
وفي المجال العسكري نبغ عدد كبير من القادة من العائلة الأيوبية ومواليها منهم أخو السلطان الأكبر تورانشاه بن أيوب مؤسس الأسرة الأيوبية في اليمن والملك العادل أبو بكر بن أيوب نائب السلطنة بالديار المصرية والأمير حسام الدين أبو الهيجاء الهذباني قائد الشرطة بالقاهرة والذي قضى على ثورة العبيد الفاطميين بزعامة مؤتمن الخلافة والأمير تقي الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب صاحب الانتصارات في الجزيرة الفراتية والأمير مظفر الدين كوكبري الذي وضع خطة الحرب في معركة حطين والأمير حسام الدين لؤلؤ قائد الأسطول والذي صد هجمات الصليبيين على المدينة المنورة وهزمهم عند مرفأ رابغ بالحجاز.
ومن النساء الفضليات اشتهرت السيدة عصمة الدين خاتون ابنة الأمير معين الدين أنر أتابك دمشق وكانت زوجة الملك العادل نور الدين محمود فلما توفي تزوجها صلاح الدين لما عرفت به من رجاحة العقل وسداد الرأي حيث ذكر الذهبي أن السلطان كان يصدر عن رأيها ويستشيرها في أمور السياسة والحرب ، وقد أسست المدرسة الخاتونية في دمشق لتدريس الفقه الحنفي وأنفقت الكثير من الأوقاف على المدارس والمشافي ودور رعاية الأيتام ورباط الصوفية وقال عنها العماد في كتاب الدارس في تاريخ المدارس : ” ولها أمر نافذ ومعروف وصدقات ورواتب للفقهاء وإدارات وبنت للفقهاء بدمشق مدرسة ورباطا وكلاهما ينسبان إليها “.
وهكذا فإن النجاح لا يأتي صدفة وإنما هو ناتج عن الحكمة في اختيار المعاونين والأصحاب وأهل المشورة والرأي ، فلم يكن صلاح الدين الأيوبي بطلا منفردا وإنما أحاط نفسه بكوكبة من رجال الفكر والأدب والعلم والتخصص ، ثم بعد ذلك كان موفقا في وضع كل واحد في المكان المناسب لطاقاته وقدراته ومنحه الصلاحيات اللازمة ، ورجل الدولة الناجح هو القادر على الجمع بين السياسة والثقافة لأن الجهل لا يقترن بالتوفيق والعمل لا يصدر إلا عن علم ، ولذلك فإن أشهر علامات التشريف التي عرفت بعد ذلك في العصور اللاحقة هي قولهم عن كبار الموظفين من أصحاب الرأي والتدبير عبارة (رب السيف والقلم).

كتابات مصرية .. قريبا على المدونة والصفحة
سلسلة مقالات بعنوان (كتابات مصرية) تتناول تاريخ الأدب العربي في مصر من خلال استعراض ألف كتاب تمت كتابتها في مصر منذ الفتح الإسلامي وحتى القرن العشرين ، نصفها في مجال الشعر والأدب والنقد واللغة والنصف الآخر متنوعة بين التاريخ والجغرافيا والفلسفة والطب والعلوم بالإضافة إلى نماذج من مكاتبات الدولة الرسمية وكذلك إصدارات أدباء الأقاليم في تلك الفترة والتي تنقسم إلى العصور التالية :
1 / عصر الولاة : ويشمل شعراء الفسطاط ودواوينهم بالتفصيل وأهم الكتب وقتها مثل تاريخ المصريين لابن يونس الصدفي والولاة والقضاة للكندي وكتابات ابن عبد الحكم وأحمد بن يوسف الكاتب وابن عبدكان وابن زولاق وكذلك كتابات الإمام الشافعي في الشعر.
2 / عصر الفاطميين : ويشمل المجالس والمسامرات في القاهرة المعزية بداية من ديوان الأمير تميم الفاطمي وحتى ابن قلاقس السكندري مرورا بكتابات الحسن بن الهيثم في العلوم وعلي بن رضوان في الطب وابن فاتك في الفلسفة والرسالة المصرية لابن أبي الصلت.
3 / عصر الأيوبيين : ويشمل كتابات القاضي الفاضل ورجال عصره مثل الأسعد ابن مماتي في الجغرافيا وابن سناء الملك في فن (الموشحات المصرية) وموسى بن ميمون في الطب وابن الفارض في التصوف وابن الطوير في التاريخ وابن أسعد الجواني في الأنساب.
4 / عصر المماليك البحرية : ويضم الموسوعات الكبرى مثل كتابات ابن النفيس في الطب وابن فضل الله في الجغرافيا والنويري في الأدب وابن منظور في اللغة ودواوين كل من الشاعر سراج الدين الوراق ومعاصريه مثل الجزار وابن الخيمي ونصير الدين الحمامي ومن يليهم.
5 / عصر المماليك البرجية : ويضم كتابات المؤرخين العظماء مثل ابن الملقن وابن دقماق وابن خلدون والقلقشندي وابن حجر العسقلاني وبدر الدين العيني وتقي الدين المقريزي وابن تغري بردي وابن الجيعان وابن إياس بالإضافة إلى دواوين الشعراء الشعبيين وقتها.
6 / عصر العثمانيين : ويشمل السير الشعبية والأدب الصوفي وكذلك كتابات ابن زنبل الرمال وابن حجر الهيتمي والشعراني وشهاب الدين الخفاجي والمرتضى الزبيدي وداود الأنطاكي وعبد الرحمن الجبرتي وأهم شعراء الأقاليم مثل الشبراوي والإدكاوي والفيومي ومن في زمنهم.
7 / عصر أسرة محمد علي : ويشمل مدرسة السيد رفاعة الطهطاوي وتلاميذه وإسهامهم في نهضة الفكر من خلال إصدارت قلم الترجمة وكتابات علي مبارك والنديم وقاسم أمين ولطفي السيد والمنفلوطي والرافعي والعقاد وطه حسين وأحمد شوقي وحافظ إبراهيم وغيرهم.
8 / العصر الجمهوري : ويشمل مختارات من أهم الكتب التي صدرت في العصر الحديث في المجالات المختلفة بالإضافة إلى مجموعة من أهم الروايات الأدبية التي عبرت عن الثقافة المصرية وشكلت المحطة الأخيرة في تاريخ الأدب العربي.
وسوف يشمل كل مقال مقتطفات من الكتاب أو ديوان الشعر مع سرد السيرة الذاتية للمؤلف وأهم العوامل المؤثرة في كتابته وآراء المعاصرين له والمؤرخين بعده في شخصه ونتاجه الأدبي ، وتهدف السلسلة لتتبع مراحل الكتابة والتأليف وتطور الأدب العربي في مصر من أول الشعر وحتى الرواية لأنه إذا كان الشعر ديوان العرب فإن الرواية هي مرآة العصر.
مرفق رابط المدونة



