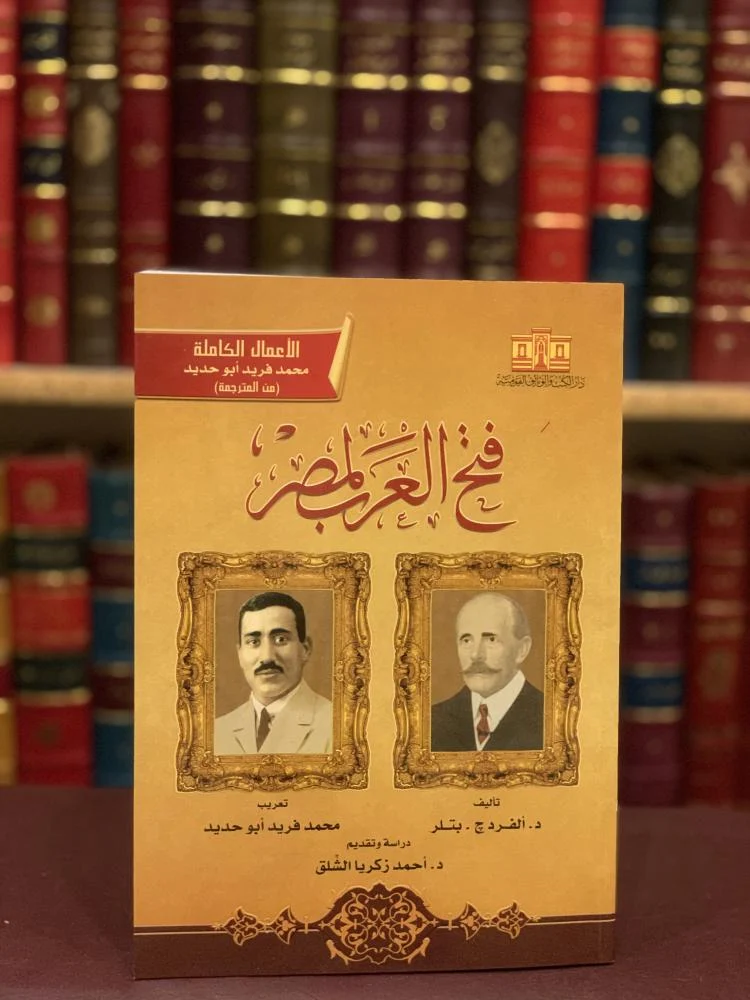
(أهل الراية) هو الاسم الذي أطلقه عمرو بن العاص على مركز مدينة الفسطاط حيث مقر قيادة الفتح الإسلامي لمصر ولازال هذا الحي يحمل نفس الاسم حتى الآن وهو اسم يتوافق مع بداية تلك الحقبة التي أعادت لمصر مكانتها العسكرية والاقتصادية بعد قرون طويلة من تبعيتها للإمبراطورية الرومانية ومن قبل تعرضها للغزو الفارسي والآشوري ، ومثلما حدث مع العالم اليوناني عندما كانت مصر جزءا منه في البداية ثم صارت الدولة (الهلنستية) الأهم في عهد البطالمة فإن الأمرر تكرر أيضا حيث صارت مصر جزءا من العالم الإسلامي الناشيء في البداية ثم صارت إحدى الدول المركزية فيه ثم صارت الدولة الأهم على الإطلاق قرابة ثلاثة قرون كما أنها استقلت مبكرا وأخذت الطابع الإمبراطوري قرابة ألف عام متصلة حيث كانت بلاد الشام والحجاز واليمن وبرقة والسودان العربي أقاليما تابعة لمصر تتم إدارتها من عاصمتها وحتى بعد الاحتلال العثماني كانت مفاتيح بعض هذه البلاد جميعا بيد والي القاهرة بحكم الموقع الجغرافي ، ولا نتجاوز الحقيقة حين نؤكد أنه قد حدثت تفاعلات كبيرة وتأثيرات متبادلة بين مصر بتاريخها الحضاري وتراثها الثقافي وبين العرب بما يحملوه من دين جديد وفكر مختلف وذلك على مدار ألف ومائتي عام تقريبا هي مدة سيادة الثقافة الإسلامية في وادي النيل رسميا ، فكما أثر الفاتحون في البلاد من ناحية اللغة والدين وإضافة عنصر سكاني جديد أثرت مصر أيضا في الحضارة الإسلامية وفي الدين الإسلامي بحيث أوجدت نمطا من التدين المرتبط بنفس الطريقة التي عرفها المصريون من قديم الأزل ، وإذا كانت هناك عملية (أسلمة وتعريب) تمت لمصر فإن هناك أيضا عملية (تمصير) تمت للإسلام والعروبة بحيث إن القبائل العربية التي استوطنت وادي النيل خلال هذه الحقبة التاريخية الطويلة قد صارت بمرور الوقت جزءا من نسيج اجتماعي جديد يجمع بين الثقافتين في إطار واحد مختلف كل الاختلاف عن كليهما وكأن عملية اندماج تمت بينهما لتصنع شيئا جديدا تماما وذلك كما هضمت مصر سابقا كلا من الإغريق والليبيين والنوبيين والآسيويين واليهود الذين وفدوا عليها في العصور القديمة وصاورا جزءا من تكوينها السكاني وأرومتها الاجتماعية.
كانت أول نقطة تماس بين العالمين عندما أرسل النبي (ص) رسالة إلى حاكم مصر ونائب الإمبراطور الروماني فيها (قيرس) والمعروف عند العرب باسم (المقوقس) والذي كان يتولى القيادة الدينية والسياسية للبلاد ، وحمل هذه الرسالة حاطب بن أبي بلتعة اللخمي وجاء فيها : ” بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله إلى المقوقس عظيم القبط سلام على من اتبع الهدى أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم أسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك إثم القبط يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون ” ، فقال المقوقس : ” أخبرني عن صاحبك أليس هو نبيا ؟ .. قال حاطب بل هو رسول الله .. فقال : ما باله لم يدع على قومه حيث أخرجوه من مكة .. فقال له حاطب : أفتشهد أن عيسى بن مريم رسول الله حيث أراد قومه قتله فلم يدع عليهم حتى رفعه الله إليه .. فقال له : أحسنت إنك حكيم جئت من عند حكيم .. فقال حاطب للمقوقس : إنه قد كان قبلك رجل يزعم أنه الرب الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى فانتقم به ثم انتقم منه فاعتبر بغيرك ولا يعتبر بك إن لنا ديناً لن ندعه إلا لما هو خير منه وهو الإسلام الكافي به الله فقد ما سواه إن هذا النبي دعا الناس فكان أشدهم عليه قريش وأعداهم له اليهود وأقربهم منه النصارى ولعمري ما بشارة موسى بعيسى بن مريم إلا كبشارة عيسى بمحمد وما دعاؤنا إياك إلى القرآن إلا كدعائك أهل التوارة إلى الإنجيل وكل نبي أدرك قوماً فهم من أمته فالحق عليهم أن يطيعوه فأنت ممن أدرك هذا النبي ولسنا ننهاك عن دين المسيح ولكنا نأمرك به ” ، فقال المقوقس : إني قد نظرت في أمر هذا النبي فوجدته لا يأمر بمزهود فيه ولا ينهى إلا عن مرغوب عنه ولم أجده بالساحر الضال ولا الكاهن الكاذب ووجدت معه آية النبوة بإخراج الخبيء والإخبار بالنجوى وسأنظر ” ، ثم أخذ كتاب النبي صلّى الله عليه وسلّم فجعله في حق من عاج وختم عليه ودفعه إلى جارية له ثم دعا كاتباً له يكتب بالعربية فكتب إلى النبي صلّى الله عليه وسلّم : ” لمحمد بن عبد الله من المقوقس عظيم القبط أما بعد فقد قرأت كتابك وفهمت ما ذكرت فيه وما تدعو إليه وقد علمت أن نبياً بقي وكنت أظن أنه يخرج بالشام وقد أكرمت رسولك وبعثت إليك بجاريتين لهما مكان في القبط عظيم وبكسوة وأهديت لك بغلة لتركبها والسلام عليك “.
لم يكن المقوقس هو الوحيد الذي تلقى رسالة النبي (ص) فقد تلقى مثلها كسرى وقيصر وأمراء الغساسنة في الشام والتي كانت ردود أفعالهم السلبية متوافقة مع طبيعة كل منهم ونظرته لهذا الرجل القابع في الصحراء والذي يخاطبهم ندا بند لكن المقوقس على ما يبدو كان أبعدهم نظرا وأكثرهم حكمة إذ احتفى بالرسالة وأكرم حاملها ورد بهدايا جليلة من المال والعسل والدواب بالإضافة إلى جاريتين صارت إحداهما زوجة للنبي وأما لولده ، وحاكم مصر لن يهادي شخصا مجهولا في الصحراء أو زعيما محليا يبعد عنه مسافة كبيرة ولا خطر منه على بلاده وقتذاك وإنما أدرك منذ هذه اللحظة أن ثمة تغيير كبير سوف يحدث في المنطقة ولعل ذلك كان سببا في ميله بعد ذلك إلى مصالحة الفاتحين العرب وتسليم مصر لهم وكأن الأمر قد بات قدرا مقدورا ، ولم تمض بضع سنوات على إرسال هذه الرسالة إلا وكان فرسان العرب يقفون على أعتاب كسرى وقيصر ترفرف راياتهم معلنة أن الإسلام قد لاحت بشائره ودقت ساعاته وأنه قد حان وقت التغيير الشامل في تلك البقعة من الأرض التي شهدت حضارات العالم القديم ، فقد ورث الإسلام البقعة الجغرافية التي قامت عليها حضارات الفراعنة في مصر والبابليين والآشوريين في بلاد الرافدين والفينيقيين والعبرانيين والكنعانيين والآراميين في الشام والحيثيين والبيزنطيين في الأناضول والإغريق والسلاف في البلقان والفرس في إيران والأمازيغ في المغرب والقوط في الأندلس والنوبة في السودان والطورانيين في آسيا الوسطى والهندوآريين في حوض نهر السند وحضارة هضبة الدكن في الهند وعددا من الثقافات المحلية في وسط وغرب أفريقيا وفي الملايو وجزر الهند الشرقية فضلا عن بلاد العرب التي خرجوا منها حاملين شعلة التغيير وكأنهم سيل جارف لا يبقي ولا يذر ، لذلك لم يكن من المستغرب أن تستولي كتيبة من الجند لا يتجاوز عددها اثني عشر ألف مقاتل على وادي النيل في أقل من عامين.
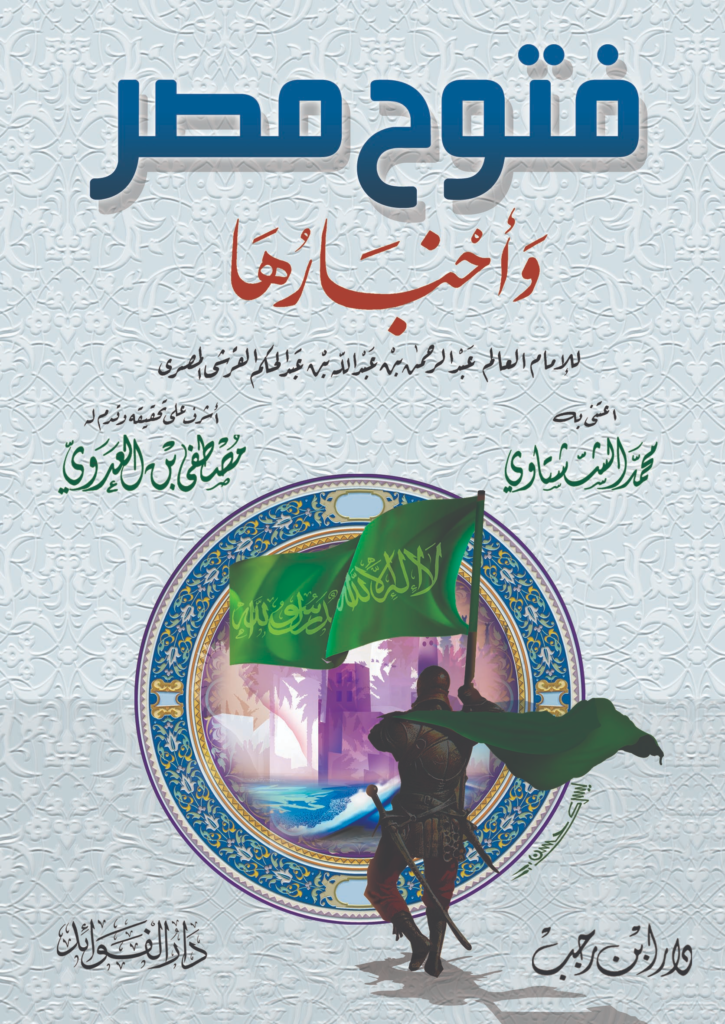
عندما وطأت أقدام العرب صحراء سيناء في طريقها إلى الوادي كانت البلاد وقتها مثخنة بآثار أحداث دامية تسبب فيها الانقلاب الدموي الذي قاده فوكاس ضد الإمبراطور موريس في القسطنطينية واعتلى على أثره عرش الإمبراطورية وراح يفتك بكبار رجال الدولة ويتعامل مع الرعية بغلظة وفظاظة مما جعل عددا كبيرا من النبلاء يخطط للثورة عليه حتى إذا لاحت الفرصة انطلق هرقل بالأسطول من قورينة (برقة حاليا) لاحتلال مدينة سالونيك في تراقية تمهيدا لضرب الحصار حول العاصمة بينما أرسل جيشا بريا بقيادة أفضل قواته نيكيتاس إلى مصر التي كانت وقتها أهم ولايات الإمبراطورية من الناحية الاقتصادية والعسكرية حيث دارت سلسلة من المعارك العنيفة والقاسية في الاسكندرية والدلتا انتهت بانتصار نيكيتاس على الحزب الموالي للإمبراطور ومن ثم منع القمح عن العاصمة واستولى على الأسطول البيزنطي الذي أرسل لمصر للدفاع عنها ، لكن المنتصرين لم يهنؤا كثيرا لأن ملك فارس خسرو برويز قرر استغلال تلك الحرب الأهلية وزحف بقواته فاستولى على الشام ودخل مصر حيث ظلت في حوزته قرابة السنوات السبع (وهي الحادثة التي ذكرت في مطلع سورة الروم والتي قصدها المقوقس عندما تكلم عن نبوءة القرآن بانتصار الروم مرة أخرى) وكانت فترة الاحتلال الفارسي قاسية على المصريين وكانت دلالتها الكبرى أن الدولة البيزنطية لم تعد قادرة على حماية البلاد كما تدعي حيث لم تكن تلك هي السابقة الأولى للفرس وإنما سبقتها غزوات تعرضت فيها البلاد للسلب والنهب وتدمير الكنائس والأديرة (وهذه الفترة الزمنية تشبه تماما أواخر حكم العثمانيين وتشبه كذلك الفوضى التي كانت في أواخر العصر الفرعوني قبل مقدم الاسكندر) ، وبعد جلاء الفرس عن مصر قرر الإمبراطور هرقل تولية قيرس على مصر سياسيا ودينيا وقد تفتق ذهنه عن مشروع فاشل يقضي بتوحيد المذهبين المسيحيين في مذهب واحد ، كانت مصر منقسمة على نفسها قبل ذلك إلى مذهبين هما المذهب المونوفيزي (الأقباط الأرثوذكس حاليا) الذي يعتنقه قسم من الأقباط وينتشر في الصعيد وجزء من الوجه البحري والمذهب الملكاني وهو المذهب الرسمي للدولة البيزنطية ويضم السكان الإغريق وقسم من الأقباط والحكام الرومان (الروم الأرثوذكس حاليا) وكان يتركز في الاسكندرية وأجزاء من الدلتا والفيوم وكان بين المذهبين عداوة شديدة وتبادل اتهامات بالهرطقة حيث تزعم كل طائفة امتلاكها للحقيقة المطلقة (لا تزال الكنيسة القبطية حتى اليوم تطلق على نفسها وصف ” كنيسة الله الوحيدة ” رغم أنها تشكل أقل من 1% من مجموع المسيحيين في العالم وتشبه في ذلك المذهب الشيعي في الإسلام الذي لا يعترف بكل ما عداه من المسلمين) وقد أسفر ذلك عن صراعات دموية من قتل لرجال الدين وتهديم للكنائس والأديرة وثورات لا تهدأ ضد البيزنطيين قابلتها حملات اضطهاد متعاقبة لإجبار الأقباط على اعتناق مذهب الدولة ، وعندما جاء قيرس بفكرة توحيد المذهبين تحت راية (المونوثيلية) وتعني وحدة الإرادة أي أن المسيح له مشيئة واحدة وهو الأمر الذي يمكنه استيعاب فكرة الطبيعة الواحدة والطبيعتين داخل إطاره لكن الأقباط اعتبروا هذا الأمر مزيدا من الهرطقة والتجديف بحق المسيح والسيدة العذراء ومن ثم زاد الاضطهاد الروماني وهرب الأنبا بنيامين إلى الصحراء.
وسوف ننقل هنا عن ألفريد بتلر في كتابه (فتح العرب لمصر) ما يصف الحالة العامة في تلك الفترة نقلا عن المؤرخين الأقباط أمثال حنا النقيوسي وساويرس بن المقفع وسعيد بن بطريق فيقول : ( فالحق أن أمور الدين في القرن السابع كانت في مصر أكبر خطرا عند الناس من أمور السياسة فلم تكن أمور الحكم هي التي قامت عليها الأحزاب واختلف بعضهم عن بعض فيها بل كان كل الاختلاف على أمور العقائد والديانة ولم يكن نظر الناس إلى الدين أنه المعين الذي يستمد منه الناس ما يعينهم على العمل الصالح بل كان الدين في نظرهم هو الاعتقاد المجرد في أصول معينة وكاد الناس لا يحسون بشيء اسمه حب الوطن وما كانت عداواتهم عند اختلاف الجنس والوطن لتثور ويتقد لهيبها إلا إذا اختلف معها المذهب الديني فكان اختلاف الناس ومناظراتهم العنيفة كلها على خيالات صورية من فروق دقيقة بين المعتقدات وكانوا يخاطرون بحياتهم في سبيل أمور لا قيمة لها وفي سبيل فروق في أصول الدين وفي فلسفة ما وراء الطبيعة يدق فهمها ويشق إدراكها فحق على مصر المسيحية قول الشاعر جوفينال إذ كان يصف ما كان بين قومه من النزاع والشقاق على أيهما أفضل في العبادة عبادة التماسيح أم عبادة القطط إذ قال : ” كان كل مكان يكره الآلهة التي يعبدها جيرانه ويعتقد أن الآلهة الحقيقية هي التي يعبدها هو ” لقد تغير الزمان ولكن الناس هم هم لم تتغير طباعهم ومنذ كانت الأحزاب ومناظراتها قائمة على ما كان في الدين من شيع وفرق كان جل آثار العصر وما تخلف من كتبه تراجم لحياة القديسين والبطارقة) ، وعلى الجانب الآخر كان تأثير العرب قويا في نفوس أتباع البلاد المفتوحة خاصة المسيحيين في مصر والشام فيقول عن ذلك : (ولعلنا نجد عذرا إذا نحن سقنا بعد ذلك رأيا آخر نمهد به مجملين وذلك أن فوز المسلمين كان له سبب آخر ألا وهو ما حل بالمسيحيين من الخذلان والوهن وهو يعدل في شدته ما كان عند المسلمين من إيمان وقوة ، قال قيدرينوس : ” على حين كانت الكنيسة تحتوشها الملوك ومن لا يخشون الله من القسوس خرج من الصحراء عملاق ليعاقبنا على ذنوبنا ” هذه كلماته التي ذكر فيها نشأة الإسلام وهي كلمات قليلة ولكنها تدل على أن المسيحيين كانوا يشعرون أن محمدا كان رسولا من عند الله أو هو على الأقل سوط من الله أرسله عليهم وهذا شعور يظهر كثيرا على لسان كثير ممن كتب من المسيحيين في ذلك الوقت ومنهم سيبيو الأرمني وإنه لأمر معروف أنه إذا نزلت بقوم نازلة من هزيمة قالوا إن ما أصابهم كان عقابا على ذنوبهم وإن من فكر وجد أن هذا القول لم يخطيء الصواب ولم يبعد عن الحقيقة ولكن يلوح لنا أن في قول هؤلاء الكتاب شيئا من الحزن المبرح أكثر مما نراه في مثل هذه الأحوال فإنهم يحسون أن النصارى قد وزنوا والعرب في كفتين فرجح العرب ومالت كفتهم وأن المسيحيين قد أصبحوا غير جديرين بأن يكونوا دون غيرهم هداة الناس إلى سبيل الله) .. وهذه الهزيمة النفسية عانى منها المسلمون بدورهم عندما انطفأت شعلة حضارتهم أمام توهج الحضارة الغربية في العصر الحديث وهذه هي طبيعة التحولات الثقافية الكبرى.
ولا يجب أن نغفل عن أمر بالغ الأهمية وهو سلوك العرب أنفسهم الذي كان أخاذا بالألباب حيث كانت سمعة انتصاراتهم تسبقهم وحكايات بطولاتهم تمهد لهم الطريق وفي هذا يقول بتلر نقلا عن ابن تغري بردي : (سمع قبطي مرة وهو يقول : ما أعجب أمر هؤلاء العرب فإنهم أتوا إلى مصر في قلة من الناس يريدون لقاء الروم في كتائبهم العظيمة ، فأجابه آخر من القبط : إن هؤلاء قوم لا يتوجهون إلى أحد إلا ظهروا عليه حتى يقتلوا عن آخرهم .. وتروي قصة أخرى أن الروم كانوا لا يقدمون على القتال ويقولون : ما لنا من حيلة في قوم غلبوا كسرى وهزموا قيصر في بلاد الشام) ، لذلك عندما كانت جيوش العرب تخوض في أراضي الدلتا وسط صعوبة الحركة في الفيضان قام الأقباط ببناء جسور لتسهيل حركة الجند وفي ذلك يقول حنا النقيوسي : (وأخذ الناس يساعدون المسلمين) ، وأثناء حصار حصن بابليون أرسل المقوقس رسلا يعرضون الصلح على العرب فأصر عمرو بن العاص على بقاء الرسل ثلاثة أيام لديه حتى يروا بأعينهم حال المسلمين فيقول في ذلك : (ولما جاء الرسل وقع في نفوسهم ما عند العرب من بساطة وإيمان فقالوا : رأينا قوما الموت أحب إلى أحدهم من الحياة والتواضع أحب إلى أحدهم من الرفعة ليس لأحدهم في الدنيا رغبة ولا نهمة إنما جلوسهم على التراب وأكلهم على ركبهم وأميرهم كواحد منهم ما يعرف رفيعهم من وضيعهم ولا السيد منهم من العبد وإذا حضرت الصلاة لم يتخلف عنها منهم أحد يغسلون أطرافهم بالماء ويخشعون في صلاتهم) ، وأثناء الحوار الذي تم بين المقوقس وعبادة بن الصامت الذي أرسله عمرو بن العاص مندوبا عنه في المفاوضات مالت نفوس القوم للصلح عندما قال لهم عبادة : (إنهم إن دفعوا الجزية كانوا آمنين على أنفسهم وأموالهم وذراريهم مسلطين في بلادهم على ما في أيديهم وما يتوارثونه فيما بينهم وحفظت لهم كنائسهم لا يتعرض أحد لهم في أمور دينهم) ، وقد وفى عمرو بوعده وكتب لأهل مصر عهدا بعد إتمام الفتح جاء في مقدمته : (هذا ما أعطى عمرو بن العاص أهل مصر من الأمان على أنفسهم وملتهم وأموالهم وكنائسهم وصلبهم وبرهم وبحرهم لا يدخل عليهم شيء من ذلك ولا ينتقص ولا تساكنهم النوبة … إلخ) ، وفي تفسيره لرضى أهل الإسكندرية تحديدا عن هذا العهد يقول بتلر نقلا عن ابن تغري بردي : (وذلك أنهم كانوا قد سئموا من كثرة ما أصابهم من الحدثان وكرهوا فساد الحكم الذي أثقل كواهلهم مدة أربعين عاما وقالوا في أنفسهم لعلنا نجد في حكم المسلمين قرارا واطمئنانا نأمن فيه على ديننا فلا نكره على شيء فيه وعلى أموالنا فلا نتحمل من الخراج والجزية إلا قدرا نطيقه ، ولعل أكبر ما حملهم على الرضى بحكم العرب رفع ما كان يبهظهم من الضرائب فقد كان الروم يجبون من مصر أموالا يتعذر علينا أن نعرف مقدارها ولكنها كانت بلا شك كثيرة الأنواع ثقيلة الوطأة شديدة الأذى فأحل العرب محلها الجزية وخراج الأرض ومهما يكن من مقدارها فقد كانت لها فضيلة البساطة وكانت ثابتة المقدار محدودة القصد وكانت أقل في جملتها مما يجبيه الروم).



