
جزيرة بني نصر
يقول المقريزي في كتاب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار : ” جزيرة بني نصر منسوبة إلى بني نصر بن معاوية بن بكر بن هوازن ، وذلك أن بني حماس بن ظالم بن جعيل بن عمرو بن درهمان بن نصر بن معاوية بن بكر بن هوازن كانت لهم شوكة شديدة بأرض مصر وكثروا حتى ملؤوا أسفل الأرض وغلبوا عليها حتى قويت عليهم قبيلة من البربر تعرف بلواتة ، ولواتة تزعم أنها من قيس فأجلت بني نصر وأسكنتها الجدار (أي تركوا الخيام وسكنوا البيوت) فصاروا أهل قرى في مكان عرف بهم وسط النيل وهي جزيرة بني نصر هذه ” ..
وكانت أرض مركز كفر الزيات الحالية تعرف أول الأمر باسم كورة الجزيرة لأنها محصورة بين فرع رشيد غربا وترعة الباجورية شرقا حيث تمتد من محلة اللبن مركز بسيون شمالا وحتى زاوية رزين مركز منوف جنوبا وضمت بعض قرى مركز طنطا والشهداء وتلا (64 قرية) ، وفي الفترة من عام 1090 م. وحتى عام 1524 م. ظلت إقليما منفصلا عن بقية الكور والأعمال تحت اسم جزيرة بني نصر (عصر الفاطميين والأيوبيين والمماليك) ثم قسمها العثمانيون بين ولايتي الغربية والمنوفية.
وكانت عاصمة الإقليم مدينة إبيار والتي نشأ حولها كل من قليب إبيار ومنية إبيار وحصة إبيار وذلك بعد هجرة بني نصر إليها في أعقاب الشدة المستنصرية واحتلال قبيلة لواتة لوسط الدلتا ، وقد وردت في معجم البلدان إبيار قرية بجزيرة بني نصر بين مصر والإسكندرية وفي قوانين ابن مماتي وفي تحفة الإرشاد إبيار من أعمال جزيرة بني نصر ، وفي الانتصار إبيار مدينة كبيرة في طرف جزيرة بني نصر بها أسواق وقياسر وحمامات وجامع ويعمل بها القماش الإبياري والأبراد الغريبة الغالية الثمن وفي التحفة السنية إبيار وهي مدينة أعمال جزيرة بني نصر.
أما مدينة كفر الزيات فقد نشأت على أنقاض قرية جريسان القديمة ، ويشرح ذلك محمد رمزي في القاموس الجغرافي فيقول : ” وفي القرن الحادي عشر الهجري طغى النيل على بلدة جريسان فأكل مساكنها عن آخرها فاضطر أهلها إلى السكنى في أراضيها الزراعية الواقعة في الجهة الشرقية من جريسان المندثرة ، وأنشأوا قرية جديدة عرفت باسم كفر الزيات نسبة إلى الحاج علي الزيات صاحب مصانع الزيت التي كانت بالكفر المذكور في ذلك الوقت ” ، وكانت تابعة لمركز بسيون حتى عام 1871 م. عندما نقل إليها ديوان المركز بسبب وقوعها على خط السكة الحديدية بين القاهرة والإسكندرية وقربها من نهر النيل.

الزبيرية وكفر حشاد
قرية كفر حشاد بالغربية نشأت على أنقاض قرية الزبيرية القديمة ، يقول محمد بك رمزي في القاموس الجغرافي : ” كفر حشاد : دلني البحث على أنه كان في إقليم الغربية بلدة قديمة تسمى الزبيرية نسبة إلى أنصار عبد الله بن الزبير بن العوام الذين كانوا مقيمين في الفسطاط وأخرجهم منها الخليفة مروان بن الحكم في سنة 65 هـ وأنزلهم بالغربية فأنشأوا هذه القرية في تلك السنة.
وفي القرن الحادي عشر الهجري طغى ماء النيل على مساكن قرية الزبيرية فأكلها واندثرت ، فاضطر أهلها أن ينشئوا مساكن جديدة في أراضي الزبيرية بدل القرية المندثرة ، وقد أنشأوا ثلاثة كفور وهي : كفر حشاد هذا نسبة إلى الشيخ عبد المنعم حشاد مؤسسه ، وكفر الهواشم وكفر شماخ ، مع استمرار زمامها مقيدا باسم الزبيرية “.
وفي الخطط التوفيقية : كفر حشاد قرية صغيرة من مديرية المنوفية بمركز تلا ، واقعة على الشاطئ الشرقى للبحر الغربى فى غربى ناحية الدلجمون بنحو أربعة آلاف متر ، وفى بحرى ناحية دلبشان بنحو ألف ومائتى متر. ، أبنيتها كمعتاد الأرياف ، وبها نحو ستمائة وخمسين نخلة، وتكسب أهلها من الزراعة.
وقد نشأ منها كما فى الجبرتى : العمدة المفضل الشيخ محمد عبد الفتاح المالكى، قدم الأزهر صغيرا وحضر على أشياخ الوقت ، ولازم الشيخ الأمير وتخرج به ومهر من المعقولات وأنجب ، ثم رجع إلى بلده وأقام بها يفيد ويفتى ويرجع إليه فى القضايا ، فيقضى بالحق ولا يقبل جعالة ولا هدية ، واشتهر ذكره بالأقاليم واعتقدوا فيه الصلاح والعفة ؛ فامتثلوا أوامره ، وإذا قضى قاض من قضاة البلدان بين خصمين رجعا إلى المترجم فإذا رأى القضاء صحيحا أمضاه وإلا رده.
ولم يزل على حالته حتى كان المولد المعتاد بطنتدا فذهب ابن الشيخ الأمير إلى هناك فأتى لزيارة ابن شيخه ونزل فى الدار التى هو نازل فيها ، فانهدمت الجهة التى هو بها وسقطت عليه فمات شهيدا مردوما ومعه ثلاثة أنفار من أهالى قرية العكرون ، وذلك فى أوائل شهر الحجة سنة اثنتين وعشرين ومائتين وألف.
وفى الجبرتى أيضا : أن هذه القرية وقعت بها حادثة فى شهر ربيع الثانى سنة خمس وثلاثين من القرن الثالث عشر هى : أن إفرنجيا من الإنكليز ورد من الإسكندرية وطلع إلى هذه البلدة ومشى بغيطانها يصطاد طيرا ، فضرب طيرا ببندقية فأصابت رجل رجل ، فرأى ذلك رجل من الأرنؤد بيده هراوة أو مسوقة ، فقال للفرنجى : أما تخشى أن يأتى إليك بعض الفلاحين ويضربك على رأسك هكذا وأشار بما بيده إلى رأسه لكونه لا يفهم كلامه ، فاغتاظ لذلك الإفرنجى وضرب الأرنؤدى برصاصة فقتله.
فاجتمع الفلاحون وقبضوا على الإفرنجى وحضروا به وبالمقتول إلى مصر ، وطلعوا إلى الكتخدا واجتمع كثير من الأرنؤد وقالوا : لابد من قتل الإفرنجى. ، فاستعظم الكتخدا ذلك ـ لمراعاتهم خواطر الإفرنج إلى الغاية ـ وقال : حتى نرسل للقناصل ليروا حكمهم فى ذلك ، وقد أخذت الأرنؤد الحمية وقالوا : لأى شئ تؤخر قتله إلى مشورة القناصل ، لابد أن يقتل حالا وإلا نزلنا إلى حارة الإفرنج ونهبناها وقتلنا كل من بها من الإفرنج ، فلم يسع الكتخدا إلا أن أمر بقتله ، فنزلوا به إلى الرميلة وقطعوا رأسه ، وطلع القناصل فى كبكبتهم وقد نفذوا الأمر ، وكان ذلك فى غيبة محمد على.

النحارية
كانت النحارية في بدء تكوينها ضيعة أنشأها نحرير الأرغلي الإخشيدي المعروف بابن الشوبزاني في القرن الرابع الهجري فعرفت بالنحريرية نسبة إليه ثم صارت أرضا تنتقل في أيدي المقطعين إلى أن صارت في إقطاع الأمير شمس الدين سنقر السعدي ثم تنازل عنها للسلطان محمد بن قلاوون الذي بالغ في عمارتها وجعلها مركزا لتوطين العرب وحثهم على الاستقرار .. وكانت من أغنى البلاد في خراجها وجودة مزروعاتها كما ذكر المقريزي .. ووردت في قوانين ابن مماتي وفي تحفة الإرشاد باسم النحريرية من أعمال الغربية وعلى لسان العامة يقال لها النحرارية ثم حرفت في الزمن الحاضر إلى النحارية مركز كفر الزيات غربية .. ومن أهم أبنائها الرئيس محمد نجيب ..
ذكرها ابن إياس في بدائع الزهور (ص 164 ج 1) فقال : ” وفي سنة 726 هـ عمرت القرية المعروفة بالنحريرية من أعمال الغربية وكان سبب إنشائها أن أرض هذه الضيعة كانت جارية في إقطاع الأمير شمس الدين سنقر السعدي نقيب الجيوش المنصورة فبنى بها جامعا وطاحونا وخانا ثم تزايدت العمارة حتى صارت بلدا كرسيا وسكن بها جماعة كثيرة من الفلاحين فبلغ خراجها في كل سنة 15000 دينار فبلغ ذلك الملك الناصر محمد بن قلاوون فأخذها من الأمير سنقر السعدي وصارت من جملة بلاد السلطان.
وذكرها المقريزي في خططه (ص 226 ج 1) فقال : ” النحريرية قرية من الأعمال الغربية أسس حكرها الأمير شمس الدين سنقر السعدي نقيب الجيش في أيام الملك الناصر محمد بن قلاوون وبالغ في عمارتها فبلغت في أيامه 10000 درهم فضة ثم خرج عنها للسلطان الناصر فعمرت واتسع أمرها حتى أنشىء فيها زيادة على ثلاثين بستانا ووصل حكرها لكثرة سكانها إلى ألف درهم فضة لكل فدان وصارت بلدا كبير العمل يبلغ في السنة ما بين خراجي وهلالي 300000 درهم فضة عنها 15000 دينار ذهب ومات سنقر السعدي في سنة 728 هـ.
وذكرها ابن دقماق في كتاب الانتصار (ص86 ج 5) فقال : ” النحريرية مساحتها 1270 فدانا وعبرتها ـ أي ما عليها من الخراج ـ ثلاثون ألف دينار وهي مدينة كبيرة ذات أسواق وقياسر وفنادق وجامع وبها تجار مياسير ، ووردت في قوانين ابن مماتي وفي تحفة الإرشاد وفي التحفة النحريرية من أعمال الغربية والظاهر أن النحريرية هو اسمها في الديوان وأما على لسان العامة فيقال لها النحرارية ، وقد ذكرها ابن بطوطة بهذا الاسم في رحلته إلى مصر سنة 726 هـ 1326 م. فقال بعد أن زار مدينة فوة : ” ثم رحلنا إلى مدينة النحرارية وهي رحبة الفناء حديثة البناء أسواقها حسنة الرواء وأميرها كبير القدر يعرف بالسعدي ” ، ووردت كذلك النحرارية في كتاب وقف السلطان قايتباي المحرر في سنة 879 هـ وفي دليل سنة 1224 هـ.
ووردت في الخطط التوفيقية النحرارية مضبوطة براءين مهملتين بينهما ألف وقال مبارك باشا : النحرارية : نون فحاء فراء مهملتين فألف فراء مهملة فمثناة تحتية فهاء تأنيث قرية من مديرية الغربية بمركز كفر الزيات على الشاطئ الشرقى لبحر الصهريج فى مقابلة قليب أبيار وفى غربى كفر محمد بنحو ألفى متر وفى شمال كفر المحروق بنحو ألف وخمسمائة متر وبها جامع بمنارة وتكسب أهلها من الزراعة وغيرها.
ورد في كتاب الروضة الزاهرة : أن البلد كانت مدينة عظيمة أنشأها الأمير سنقر نقيب الجيوش المنصورة في أيام الملك الناصر محمد بن قلاوون وبالغ في عمارتها فلما بلغ ذلك الناصر أخذها منه وصارت بلدة كبيرة من جملة بلاد السلطان ورغبت الناس في سكناها وبنوا بها الدور والقصور والأماكن وبنى بها السلطان الناصر جامعا وسماه المحمودية وكان به 350 عمودا ورتب فيه عشرين درسا وبنى حول المسجد الدكاكين والفنادق ووقفها عليه وجعل له كذلك مائة فدان طينا يؤخذ خراجها ويصرف على العلماء والمدرسين وكان بها 120 مسجدا كبارا وصغارا وعشرون حماما وستون معصرة للزيت وغير ذلك من الأسواق والدكاكين وكانت من أجل المدائن الإسلامية وهي آخر ما بني في مصر من المدائن والآن استولى عليها الخراب من ظلم الولاة والكشوفية.
ووردت في صفحة 402 من الجزء الثاني من كتاب السلوك للمقريزي طبع مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر سنة 1942 محرفة باسم النحراوية بواو بدل الراء الثانية وهذا التحريف منشأه الخطأ وقت طبع الكتاب وصوابه النحرارية براءين بينهما ألف وقد حرف اسم البلدة من النحريرية إلى النحرارية ثم حرف للمرة الثانية إلى النحارية وهو اسمها الحالي الذي وردت به في تاج العروس وتاريخ سنة 1228 هـ مما يدل على أن هذا التحريف وقع في العهد العثماني.
وفي الخطط المقريزية : مدينة النحريرية كانت أرضا مقطعة لعشرة من أجناد الحلقة من جملتهم، شمس الدين سنقرّ السعديّ، فأخذ قطعة من أراضي زراعتها، وجعلها اصطبلا لدوابه وخيله، فشكاه شركاؤه إلى السلطان الملك المنصور قلاون، فسأله عن ذلك فقال: أريد أن أجعله جامعا تقام فيه الخطبة، فأذن له السلطان في ذلك فابتدأ عمارته في أخريات سنة ثلاث وثمانين وستمائة، حتى كمل في سنة خمس وثمانين، فعمل له السلطان منبرا، وأقيمت به الجمعة، واستمرّت إلى يومنا هذا ، وأنشأ السعديّ حوانيت حول الجامع، فلم تزل بيده حتى مات،
وورثها ابناه: عز الدين خليل، وركن الدين، عمر، فباعاها بعد مدّة للأمير: شيخو العمريّ، فجعلها مما وقفه على الخانكاه والجامع اللذين أنشأهما بخط صليبة جامع ابن طولون خارج القاهرة، فعمرت هذه الأرض بعمارة الجامع، وسكنها الناس، فصارت مدينة من مدائن أراضي مصر بحيث بلغت أنوال القزازين فيها ، وترقى سنقر السعديّ في الخدم حتى صار من الأمراء، وولي نقيب المماليك السلطانية، وأنشأ المدرسة السعدية خارج القاهرة قريبا من حدرة البقر، فيما بين قلعة الجبل، وبركة الفيل في سنة خمس عشرة وسبعمائة، وبنى أيضا رباطا للنساء، وكان شديد الرغبة في العمائر محبا للزراعة كثير المال ظاهر الغنى، ثم إنه أخرج إلى طرابلس، وبها مات سنة ثمان وعشرين وسبعمائة.
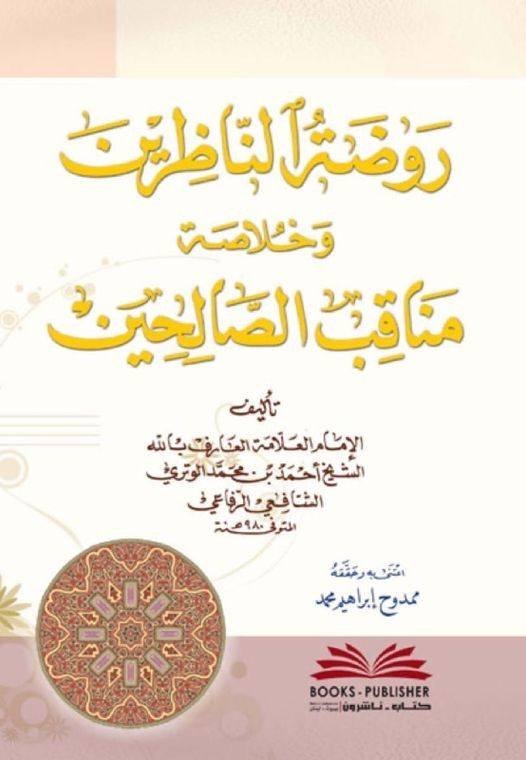
أعلام النحارية
حظيت النحارية باثنين من أعلام الطريقة الصوفية الرفاعية حيث جاءت تراجمهم في كتاب روضة الناظرين وخلاصة مناقب الصالحين من تأليف الإمام العلامة العارف بالله الشيخ أحمد بن محمد الوتري الشافعي الرفاعي (المتوفي سنة 980 هـ) فيقول :
(ومنهم الشيخ محمد النحراري الرفاعي الكبير قدس الله روحه لبس الخرقة من أبيه الشيخ زين وهو عن أبيه الشيخ محمد وهم وآل البديوي بالنحرارية يرجعون بخرقة الطريقة إلى القطب العارف الشيخ أبي الفتح الواسطي خليفة إمام القوم السيد أحمد الرفاعي رضي الله عنه وعنهم أجمعين.
قال الشيخ إبراهيم البقاعي في (عنوان الزمان) ما ملخصه : محمد بن زين بن محمد بن زين النحراري نسبة إلى بلد من غربية مصر الشافعي الصوفي الشيخ الإمام العالم الصالح الزاهد نزيل إيوان الريافة من جامع الأزهر بالقاهرة ينتسبون إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
ولد الشيخ شمس الدين بالنحرارية قبل سنة ستين وسبعمائة فنشأ وأخذ الفقه عن الشيخ بدر الدين الزركشي والشيخ كمال الدين الدميري والقراءة عن الشيخ فخر الدين إمام جامع الأزهر، توفي معمرا بعد الستين والثمانمائة وكراماته وأحواله مذكورة مشهورة نفعنا الله به.
، وقد ذكره الزركلي في الاعلام (6: 368) فقال : ” محمد بن الزين (760 – 845 ه) (1359 – 1441 م) محمد بن زين بن محمد بن زين بن محمد بن زين الطنتدائي الأصل النحراري الشافعي ويعرف بابن الزين (شمس الدين أبو عبد الله) مقرئ نحوي ناظم ولد قبل سنة 760 ه بالنحرارية من الغربية بمصر وتعلم بالقاهرة من آثاره : شرح منظومة ألفية ابن مالك في النحو منظومات في القراءات وديوان شعر كبير”.
ومن تلاميذه الشيخ برهان الدين إبراهيم العدوي .. يقول عنه المصنف : (ومنهم الشيخ الكبير العارف النحرير الشيخ برهان الدين إبراهيم ابن الشيخ شمس الدين محمد العدوي الرفاعي النحريري قدس سره) تتصل إجازته بحضرة الإمام الرفاعي رضي الله عنه من طريق والده حتى تنتهي إلى القطب الكبير الشيخ أبي الفتح الواسطي خليفة مولانا وسيدنا سلطان الرجال السيد أحمد الكبير الرفاعي رضي الله عنه.
وأثنى عليه البقاعي في (عنوان الزمان) وقال في ترجمته إبراهيم بن محمد بن علي بن أحمد بن أبي بكر بن شبل بن محمد بن خزيمة بن عنان بن محمد بن مدلج الشيخ الإمام العالم برهان الدين ابن الشيخ الإمام العلامة شمس الدين البديوي العدوي النحري الشافعي الرفاعي.
ولد بعد سنة ثمانين وسبعمائة بالنحرارية وقرأ به القرآن وصلى به وحفظ العمدة والتبريزي وألفية ابن مالك وأخبرني أنه عرضهم على السراجين البلقيني وابن الملقن وبحث في التبريزي والألفية على الشيخ نور الدين علي بن مسعود النحريري وولده.
وحج سنة خمس وعشرين وثمانمائة وتردد إلى القاهرة وإسكندرية مرارا ورحل إلى دمياط لزيارة الصالحين وعني بنظم الشعر وسنايا الطريقة الثابتة ففاق والده في ذلك وذكر أنه سمع كتاب (الشفا) للقاضي عياض بأقوال الجبرتي بالإجازة على قاضي النحرارية برهان الدين إبراهيم أحمد بن البزاز الأنصاري الشافعي قبل هذا القرن بيسير.
توفي الشيخ برهان الدين إبراهيم البديوي الرفاعي سنة أربع وستين وثمانمائة بالنحرارية وقبره مع آبائه برواقهم يزار ” ، وأضاف السخاوي في ترجمته : ” وعني بنظم الشعر وسلك طريق ابن نباتة ففاق والده في ذلك “.

مدينة كفر الزيات
تأسست مدينة كفر الزيات الحالية في العصر العثماني بجوار أنقاض قرية جريسان القديمة التي غرقت في فيضان القرن الحادي عشر ، وقد ذكرها ابن الجيعان في القرن التاسع الهجري في كتاب التحفة السنية ضمن أعمال جزيرة بني نصر فقال : جريسان بالوجه البحري مساحتها 2000 فدان عبرتها كانت 1500 دينار والآن 562 دينار للمقطعين وأملاك وأوقاف.
جاء في القاموس الجغرافي : كفر الزيات : قاعدة مركز كفر الزيات دلني البحث على أنه كان في إقليم الغربية قرية قديمة تسمى جريسان وردت في قوانين ابن مماتي من أعمال جزيرة بني نصر ثم وردت في تحفة الإرشاد محرفة باسم جريشان وفي التحفة جريسان وقال إنها في الوجه (القسم) البحري من جزيرة بني نصر ووردت في الانتصار محرفة باسم جزيسان وفي دليل سنة 1224 هـ جريشان.
وفي القرن الحادي عشر الهجري طغى النيل على بلدة جريسان فأكل مساكنها عن آخرها فاضطر أهلها إلى السكنى في أراضيها الزراعية الواقعة في الجهة الشرقية من جريسان المندثرة ، وأنشأوا قرية جديدة عرفت باسم كفر الزيات نسبة إلى الحاج علي الزيات صاحب مصانع الزيت التي كانت بالكفر المذكور في ذلك الوقت ، وكفر الزيات اليوم من أشهر مدن مصر فيها معامل لاستخراج الزيت والسمن الصناعي من بذرة القطن وفيها معامل لصنع الصابون ومحالج لحلج القطن.
وكانت كفر الزيات تابعة لمركز بسيون أحد مراكز مديرية الغربية سابقا ، ولوقوعها على السكة الحديدية الرئيسية وبها محطة للسكة الحديدية أصدر ناظر الداخلية في سنة 1871 قرارا بنقل ديوان المركز من بسيون ـ لبعدها عن السكة الحديدية في ذلك الوقت ـ إلى بلدة كفر الزيات ، وبذلك أصبحت هذه البلدة قاعدة له وسمي مركز كفر الزيات في جداول نظارة الداخلية ، وأما في نظارة المالية فبقي باسم مركز بسيون إلى أن صدر قرار في سنة 1896 بتسميته كذلك في دفاتر المالية باسم مركز كفر الزيات لتوحيد التسمية في المصالح الأميرية “.
وجاء في الخطط التوفيقية : ” كفر الزيات قرية كبيرة ، رأس مركز من مديرية الغربية على الشاطئ الشرقى لبحر رشيد ملاصقة لجسره. أبنيتها بالآجر واللبن منها ما هو على دور وما هو على دورين. وبها جامع عظيم بمنارة أنشأه المرحوم محمد على باشا. وبها محطة السكة الحديد الطوالى وحوانيت وقهاو وخمارات ، وبها ثلاثة بساتين. ولها سوق كل يوم أربعاء.
وعدد أهلها ذكورا وإناثا تسعمائة وسبع وخمسون نفسا غير المقيمين بها من الأوروباويين. ورىّ أرضها من بحر النيل ، وعندها مينا ترسو عليها المراكب الحادرة والمقلعة دائما. وعندها شونة لغلال الميرى وشونة لمصالح أخر للميرى مثل : الفحم الحجر للزوم الوابورات البرية والبحرية. ولها طريق إلى طنتدا على أكثر من ثلاث ساعات “.

أبيار
جاء في الخطط التوفيقية : ” أبيار : بلدة قديمة من مديرية الغربية بقسم محلة منوف ، واقعة على بحر سيف شرقى كفر الزيات بنحو ساعة ، أبنيتها من الآجر واللبن وفيها غرف كثيرة وقصور مشيدة منها أربعة للأمير أحمد بيك الشريف مفتش سخا ومسير وفيها مساجد بمنارات ومنابر تقام فيها الجمعة والجماعة.
منها جامع الشيخ خليفة قديم ، وقد جدده أحمد بيك المذكور سنة خمس وسبعين ومائتين وألف كما جدد زواية فى سنة خمس وثمانين ، ومنها جامع الشيخ بنهاج ، وجامع الشيخ قصود قديمان جددهما محمد أفندى الشريف سنة تسعين ، وفيها معمل دجاج وأنوال ومصابغ نيلة وسوق دائم بحوانيت وسوق عمومى كل يوم خميس ، وساقيتان وجنتان «ذواتا أفنان» ونخيل.
وبقربها على نحو سبعمائة متر تل قديم مساحته نحو خمسة أفدنة ، ويخرج منها طريقان أحدهما إلى طندتا على ثلاث ساعات يمر بشبرى النملة وكفر الجربجى ، والآخر إلى كفر الزيات يمر بناحية دلجمون ، وفيها عائلة مشهورة بالعلم والشرف من عدة أجيال.
ومن علمائها الحبر الهمام وفخر العلماء الأعلام الإمام الأريب واللوزعى الأديب الشاعر النائر الحافظ الماهر العلامة الشيخ عبد الهادى نجا ابن العلامة الشيخ رضوان الأبيارى الشافعى الأزهرى محط رحال الأدب وقاموس لسان العرب ، ومن شبيبته إلى شيبه لم يشغله عن التدريس والتأليف شاغل مع كثرة إقامته ببلده ، ولم يتول شيئا من الوظائف إلا تعليم أنجال الخديو إسماعيل باشا ، وله من المؤلفات ما ينيف عن أربعين كتابا “.
وجاء فى الضوء اللامع للسخاوى أن الشيخ محمد بن على بن أحمد بن عبد الواحد بن عبد المغيث الأبيارى ثم القاهرى الشافعى ولد بهذه البلدة سنة سبع وسبعين وسبعمائة ، قال : ” وكان يعرف بابن المغيربى بالتصغير نسبة لجده ؛ فإنه كان مغربيا فنشأ بأبيار وحفظ القرآن وبعض المنهاج الفرعى.
ثم قدم القاهرة فأكمله وألفية النحو والملحة والشذرة الذهبية والمقصورة الدريدية ، وبحث بأبيار ألفية ابن معطى على التاج القروى ، وبحث بالقاهرة المنهاج على الإبناسى ، ولازم البلقينى فى بحثه بل بحث العضد والتلخيص على قنبر ، وناب عن الصدر المناوى بالقاهرة وفى أبيار وعملها عن البلقينى ، ثم أعرض عن ذلك مع حلفه بالطلاق على عدم قبوله.
وكذا عرض عليه ضبط الشّون السلطانية فأبى تعففا مع كثرة تحصيل هذه الجهة ، وتكسب قبل ذلك بالشهادة ، وباشر الشهادة بالإسطبل. ، ولما تملك الظاهر جقمق اختص به فصار من ذوى الوجاهات ، وكذا اختص به ولده الناصرى مع مزيد رغبته فى التقلل من التردد إليهما ، وحج مرارا وجاور ، وكان خيرا دينا ساكتا منعزلا عن أكثر الناس حسن المحاضرة ، مات وقد أسن ليلة الأربعاء عاشر المحرم سنة تسع وستين وثمانمائة ودفن بحوش جوشن “.
وجاء في شجرة النور الزكية في طبقات المالكية لمحمد مخلوف : ” شمس الدين أبو الحسن علي بن إسماعيل بن علي بن عطية الصُّنهاجي الأبياري : أحد أئمة الإِسلام المحققين الأعلام الفقيه الأصولي المحدث المجاب الدعوة رحل الناس إليه أخذ عن القاضي عبد الرحمن بن سلامة وناب عنه في القضاء وتفقه بجماعة منهم أبو الطاهر بن عوف وعنه جماعة منهم ابن الحاجب وعبد الكريم بن عطاء الله.
له التصانيف الحسنة البديعة منها شرح البرهان لأبي المعالي في الأصول وسفينة النجاة على طريق الإحياء للغزالي في غاية الإتقان وبعضهم يقول هو أكثر إتقاناً من الأحياء وأحسن منه وشرح التهذيب وله تكملة الكتاب الجامع بين التبصرة والجامع لابن يونس والتعلقة للتونسي تكملة حسنة جداً تدل على قوة في الفقه وأصوله وبعض العلماء يفضله على الإِمام الفخر الرازي في الأصول ، مولده سنة 557 هـ وتوفي سنة 618 هـ / 1221 م “.

إبيار في القاموس الجغرافي (محمد رمزي):
قسم إبيار أنشئ في سنة 1827 وكان مقره بلدة إبيار ، وكانت في ذاك الوقت تابعة هى والبلاد المجاورة لها إلى مديرية المنوفية ، وكانت دائرة اختصاصه وقت إنشائه تشمل عدة بلاد من مديريتى الغربية والمنوفية ، وفى سنة 1836 ألغى قسم إبيار ، وأضيف عدد عظيم من بلاده إلى مركز تلا ، الذي أنشئ في تلك السنة ، وأضيف الباقى منها بما فيها إبيار إلى مركز بسيون (مركز كفر الزيات) مديرية الغربية.
إبيار هى من القرى القديمة ، وردت فى كشف الأبرشيات المحرر فى القرن الثاني الهجري باسمها الحالي ، ولما تكلم الإدريسي فى نزهة المشتاق على الخليجين النازلين من أبى يحنس (أبونشابـة) وطرنوت (الطرانة) إلى ببيج (أبيج) قال : إن هذين الخليجين يجتمعان عند ببيج ، وإن الجزيرة الواقعة بينهما هى جزيرة بيار ، ثم قال : إن الخليج الشرقي منهما يمر على نواحى منوف السفلى (والصواب مـنوف العليا) بدليل أنه ذكر بعد ذلك نواحى البندارية وفيشة وببيج ، وأن الخلجان فى مصر تسير كلها من الجنوب إلى الشمال.
وأما منوف السفلى (محلة منوف الآن) فهى فى شمال طنطا ولا علاقة لها بالخليج المذكور ، ولما كان الخليج الذى يحد جزيره إبيار وهى – جزيرة بنى نصر – من الجهة الشرقية يمر على نواحي منوف العليا وتتا والبندارية وفيشا سليم وإبيارة وقليب إبيار وينهى عند ببيج كما ورد فى كتاب المسالك لابن حوقل ، فانه علاوة على أن الإدريسي ذكر منوف السفلى (محلة منوف) بدلا من منوف العليا (منوف) وهذا خطأ فقد نقل النساخون ما كتبه من أسماء القرى الأخرى مشوها فكتبوا ثنا بدلا عن تتا ، وقبيشة بدلا عن فيشة ، والمنار بدلا من إبيار.
ومن هذا يتضح أن القرية التى وردت فى نزهة المشتاق بين البندارية وقليب العمال (قليب إبيار) باسم المنار هى بذاتها إبيار هذه وإن اسمها ورد مشوها بسبب سوء النقل من كتاب الى اخر ، ووردت فى معجم البلدان إبيار قرية بجزيرة بنى نصر بين مصر والإسكندرية وفى قوانين ابن مماتى وفى تحفة الإرشاد إبيار من أعمال جزيرة بنى نصر وفى الانتصار إبيار مدينة قديمة فى طرف جزيرة بنى نصر بها أسواق وقياسم وحمامات وجامع ويعمل بها القماش الإبيارى والأبراد الغريبة الغالية الثمن ، وفى التحفة إبيار وهى مدينة أعمال جزيرة بنى نصر.
وذكر أميلينو فى جغرافيته أن اسمها القبطى Hah Schii ومعناها عدة آبار قال : ولما دخل العرب مصر ترجموا الاسم إلى إبيار وهو جمع بئر ، وإنى لا أوافق أميلينو على ذلك فان العرب لم يترجموا الأسماء القبطية ولم يستبدلوها بما يقابلها من المعانى العربية بل الذى حصل هو العكس فان مطارنة القبط هم الذين ترجموا بعض أسماء البلاد القديمة والحديثة لما طلب منهم تحرير قائمة بأسماء الكنايس والابرشيات فى مصر لتقديمها إلى المجمع الديني الذى عقد بمدينة نيكيا (أزنيق) إحدى مدن آسيا الصغرى فى سنة171 هـ، 787 م.
وكان ذلك فى عهد خلافة هارون الرشيد وغرض المطارنة من ترجمة الأسماء إلى اللغة القبطية هو تقريب فهمها لأعضاء ذلك المجمع ، والذى يؤيد رأينا هو ورود مدينة الجيزة وقرية منية عقبة فى قائمة الكنائس المذكورة ، ومكتوب أمام الجيزة أن اسمها القبطى Tbersis وأمام منية عقبة Tmoni Oqba فى حين إنهما انشئتا بعد فتح العرب لمصر ، ومن هذا يتبين أن اسم إبيار هو مصري قديم لا علاقة بينه وبين إبيار التي هي جمع بئر بالعربية.
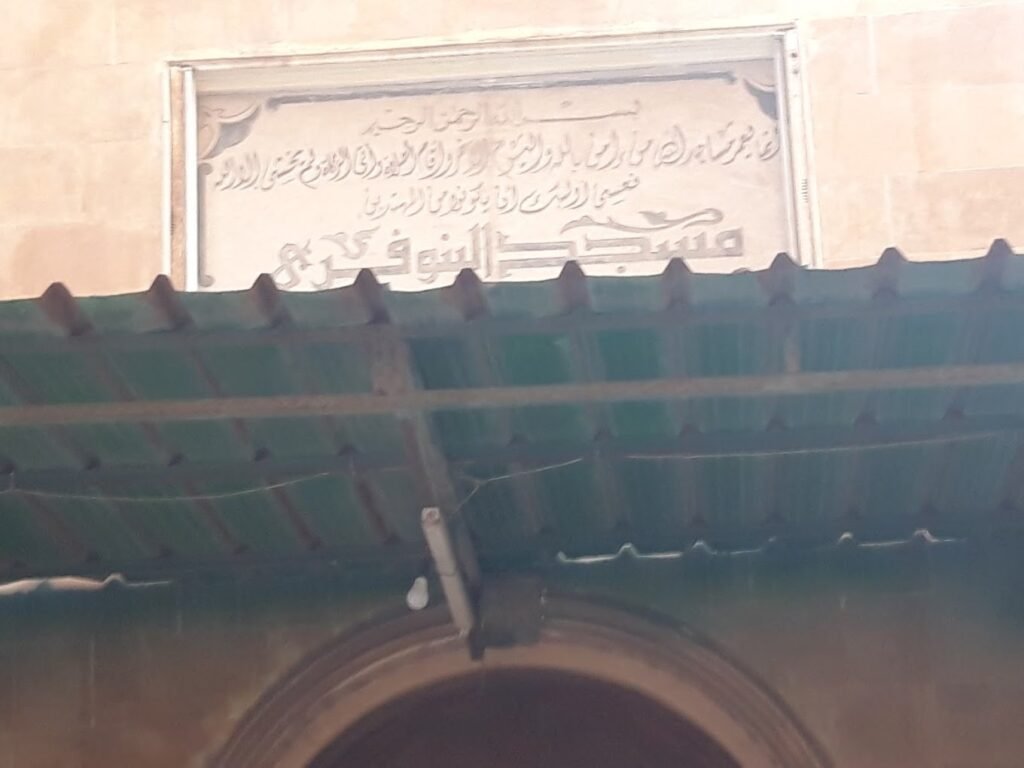
بنوفر
جاء في الخطط التوفيقية : ” بنوفر قرية من مديرية الغربية بمركز كفر الزيات ، موضوعة بجوار الشاطئ الشرقى لبحر رشيد ، غربى كفر الزيات بنحو ثلاثة أرباع ساعة ، فى مقابلة كفر مجاهد الذى على الشط الغربى للبحر ، وأبنيتها كمعتاد الأرياف ، وبها جامع من غير منارة ، وبها جملة من النخيل ، وتكسب أهلها من الزرع ، وينسب إليها كما فى ذيل الطبقات للشعرانى ، الإمام الصالح، الورع الزاهد الخاشع الناسك ، الشيخ محمد البنوفرى المالكى رضي الله عنه ، قال : صحبته سنين عديدة فرأيته على قدم عظيم فى هضم النفس وكثرة التواضع والتورع فى اللقمة ، لا يأكل لأحد طعاما إلا إن علم منه كثرة الورع فى كسبه ، وله تهجد عظيم فى الليل وحال مع الله رضي الله عنه “.
والمسجد المعروف باسم البنوفري في حي الجمرك بالإسكندرية كان في الأصل زاوية ورباطا لشيخ المذهب المالكي في القرن العاشر الهجري العلامة الإمام الفقيه أبي عبد الله محمد بن سلامة البنوفري العدوي ، وكان يرابط فيه أربعة أشهر من كل عام حيث يجلس إليه التلاميذ والمريدون فيستمعون إليه ، وقد غلب عليه لقب البنوفري تمييزا له عن الولي الأكرم سيدي محمد ضياء الدين أبي الجيوش بن عبد الوهاب العدوي (من رجال القرن السادس الهجري) صاحب الضريح القريب منه ناحية الشمال الغربي في امتداد منطقة الباب الأخضر قديما (شارع إسماعيل صبري حاليا) ..
وقد جاءت ترجمته في كتاب شجرة النور الزكية في طبقات المالكية لمحمد مخلوف فقال (أبو عبد الله محمد بن سلامة البنوفري به عرف المصري من أعيان فقهائها وفضلائها الإمام العمدة العالم المشهور بالصلاح والدين المتين تفرد برئاسة المذهب في مصر ، أخذ عن الناصر اللقاني والتاجوري وغيرهما وعنه الشيخ سالم السنهوري وبه تفقه وغيره ، توفي في حدود سنة 998 هـ / 1589 م) ، وذكر أحمد بابا التنبكتي في كتابه نيل الابتهاج بأنه مشهور بالدين والخير والورع والزهد والفقه ، وكتب عنه الإمام الغزي بالتفصيل في كتابه (الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة) فقال :
(الإمام العلامة شيخ الإسلام الورع الزاهد الخاشع الناسك العابد الشيخ شمس الدين البنوفري المالكي شيخ المالكية بمصر أخذ العلم عن جماعة منهم الشيخ ناصر الدين اللقاني والشيخ عبد الرحمن الأجهوري وكان يحبه ويثني عليه كثيراً ويصفه بالزهد ومنهم الشيخ فتح الله الدميري والشيخ نور الدين الديلمي وأجازوه بالإفتاء والتدريس .. وكان مكباً على العلم والعمل غير ملتفت إلى شيء من الدنيا طارحاً للتكلف مؤثراً للخمول وكان يقسم السنة ثلاثة أقسام أربعة أشهر يحج وأربعة أشهر يرابط وأربعة أشهر يقريء العلوم ويصلي وكانت وفاته أواخر القرن العاشر رحمه الله تعالى رحمة واسعة) ..
وقد اشتهر في السودان حيث تتلمذ على يديه فقهاء مملكة سنار الذين نشروا المذهب المالكي في عموم البلاد وقتها ومن أشهرهم الشيخ إبراهيم البولاد والشيخ علي ود عشيب والشيخ عبد الرحمن ولد جابر والشيخ إسماعيل الركابي وقد رحلوا إليه في أسيوط وتلقوا عنه دروس الفقه ونالوا منه إجازة التدرس والإفتاء ، ويرجع نسب الشيخ البنوفري إلى جده طه بن محمد بن أحمد بن علي بن العارف بالله الشيخ عبد الجواد المحسن العدوي دفين المعلاة بمكة المكرمة وهو من قرية بني عدي مركز منفلوط وهو جد الشيخ محمد الصغير المتوفي عام 1110 هـ وتنسب له عائلات معروفة حتى اليوم ..

قصر بغداد
في عام 1524 م. تقرر إنهاء الخصومة بين العرب والشراكسة بحيث يقتصر وجود المماليك في المدن بينما تسلم شيوخ العرب حكم الأرياف وهو ما عرف وقتها باسم (قانوني نامه مصر) وصارت لهم عدة قرى خاصة بإقامتهم ، وبعد إلغاء نظام الأعمال وتأسيس ولاية المنوفية تم توزيع شيوخ العرب من لواتة وبني نصر وبني سليم في نواحي الولاية والتي ألحق بها الجزء الجنوبي من أعمال جزيرة بني نصر القديمة.
ومن زعماء عرب المنوفية في هذه المنطقة عشيرة عرب ابن بغداد من القبائل القيسية والتي تتبع تحالف المرابطين بزعامة قبيلة الجويلي (والذي يضم بني سليم ولبيد وغيرهم) ، وقد سكنت في البلدة المعروفة باسم قصر بغداد (كانت تتبع المنوفية وحاليا تتبع كفر الزيات) وكانت لهم إمرة المنوفية في مناطق تلا والشهدا ، وقد جاء عنهم في موسوعة القبائل العربية : ” ابن بغداد : ذكر أميديه عرب ابن بغداد وقال : مقرهم في ولاية المنوفية بوسط الدلتا وفرسانهم ما بين 400 إلى 500 فارس عام 1798 “.
وكانت القرية في العصر المملوكي تسمى أخشا ومساحة زمامها الزراعي أربعة آلاف فدان تابعة للأمير إبراهيم بن السلطان الأشرف شعبان ثم خصصت للديوان السلطاني ثم شيوخ العرب وفق النظام الجديد ، واشتهر من عرب ابن بغداد الأمير عبد الله بن بغداد الذي بنى المسجد والمدرسة المعروفة بقرية محلة مرحوم مركز طنطا عام 967 هـ والأمير حسام بن بغداد الذي أنشأ قصره بجوار قرية أخشا القديمة والأمير حجازي بن بغداد شيخ عربان المنوفية وصاحب الإقطاعيات في مركز تلا والأمير منصور بن بغداد والأمير علام بن بغداد الذي حكم عشرة سنوات بأمر من سنان باشا الوالي.
جاء في القاموس الجغرافي : ” قصر بغداد : هي من القرى القديمة اسمها الأصلي إخشا وردت به في قوانين ابن مماتي وفي تحفة الإرشاد وفي التحفة من أعمال جزيرة بني نصر وفي الانتصار إخشى ، ولما نزل بها الأمير حسام الدين محمد بن بغداد من كبار أمراء القرن العاشر الهجري استهجن كلمة إخشا وسماها قصر بغداد ، فوردت في دليل سنة 1224 هـ إخشا وتعرف بقصر بغداد وفي تاريخ سنة 1228 هـ باسمها الحالي ، وورد في تاريخ أخبار الأول للإسحاقي : أن منصورا وعلاما ولدي ابن بغداد كانا أميرين على ولاية المنوفية من سنة 977 هـ إلى سنة 996 هـ “.
وجاء عنها في الخطط التوفيقية : ” قصر بغداد قرية بمديرية المنوفية من مركز تلا ، على الجانب الغربى لبحر سيف فى الجنوب الغربى للدلجمون بنحو أربعة آلاف متر ، وفى الشمال الشرقى لطنوب بنحو ثمانية آلاف متر ، أغلب أبنيتها من اللبن وبها جامع من الآجر، وتكسب أهلها من الزرع ، ومنها نشأ حضرة سليمان أفندى قبودان المعروف بحلاوة ، ولد بها فى سنة خمس وثلاثين ومائتين وألف “.

قليب إبيار
جاء في القاموس الجغرافي : قليب إبيار هي من القرى القديمة اسمها الأصلي قليب العمال وردت به في كتاب المسالك لابن حوقل بين محلة المحروم (محلة مرحوم) وبين بيبيج (أبيج) قال : وهي مدينة فيها جامع محمام ولها سلطان (نائب الوالي) وحاكم ولها كورة ذات ضياع وأسواق ، ووردت في قوانين ابن مماتي وفي تحفة الإرشاد وفي التحفة قليب من أعمال جزيرة بني نصر ، وفي العهد العثماني عرفت باسم قليب إبيار لقربها من إبيار وتمييزا لها من قليب نويش التي مكانها اليوم كفر أبو زيادة بمركز دسوق ، ووردت في تاريخ سنة 1228 هـ باسمها الحالي.
وجاء عنها في كتاب تاج العروس من جواهر القاموس للمرتضى الزبيدي : وقليب كأمير قرية بمصر منها الشيخ عبد السلام القليبي أحد من أخذ عن أبى الفتح الواسطى وحفيده الشمس محمد بن أحمد بن عبد الواحد بن عبد السلام كتب عنه الحافظ رضوان العقبي شيئا من شعره ، وذكرها ابن الجيعان في القرن التاسع الهجري في كتاب التحفة السنية ضمن أعمال جزيرة بني نصر فقال : قليب مساحتها نقا وخرس ومستبحر 1840 فدان عبرتها 3500 دينار كانت باسم الأمير حاج بن مغلطاي والآن باسم الأمير أزبك.
وفي القرن السابع الهجري اشتهرت قليب إبيار عندما نزل بها ولي الله تعالى الشيخ عبد السلام القليبي السلمي أحد أعلام الطريقة الصوفية الرفاعية ويرجع في نسبه إلى قبيلة بني سليم العربية ، وجاءت ترجمته في كتاب المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي حيث يقول جمال الدين أبو المحاسن ابن تغري بردي : عبد السلام القليبي : عبد السلام بن سلطان الشيخ الإمام العارف بالله القدوة الفقيه الفاضل الزاهد صاحب الكرامات تقي الدين أبو محمد المغربي الأصل والمولد القليبي الدار والوفاة المالكي ، قيل : إنه كان من ذرية العباس بن مرداس السلمي رضي الله عنه ، قدم من المغرب إلى القاهرة وسكنها مدة ثم انتقل إلى قليب بجزيرة بني نصر من الوجه البحري من أعمال القاهرة تجاه النحرارية.
وكان فقيهاً عالماً عارفاً بالله وله كرامات مشهورة عنه ، قرأت في كتاب مصباح الظلام في المستغيثين بخير الأنام في اليقظة والمنام تصنيف الشيخ الإمام القدوة شمس الدين أبي عبد الله محمد بن موسى بن النعمان المراكشي الهنتاني رحمه الله قال : سمعت الشيخ الفقيه الإمام العالم العامل العارف بالله تقي الدين أبا محمد عبد السلام القليبي يقول معنى لا لفظاً : كان أخي به خنازير في حلقه فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال : يا رسول الله ما ترى ما حل بي ؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : قد أجبت سؤالك ، فشفى منها ببركة النبي صلى الله عليه وسلم ، وكانت وفاة الشيخ عبد السلام بقليب في ثامن ذي الحجة سنة ثمان وخمسين وستمائة وقبره يزار بقليب رحمه الله تعالى.
وفي كتاب معجم أعلام شعراء المدح النبوي ذكر محمد درنيقة الشاعر محمد القليبي حفيد الشيخ عبد السلام القليبي فقال : محمد بن أحمد بن عبد الواحد القليبي اشتهر بالنظم ، حج عام 809 هـ/ 1406 م وألقى قصيدة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم بالحجرة الشريفة جاء فيها [من البسيط] :يا خيرة الله من كلّ الأنام ومن … له على الرّسل والأملاك مقدار .. روحي الفداء لأرض قد ثويت بها … بطيب مثواك طاب الكون والدار .. إنّي ظلوم لنفسي في اتّباع هوى … وقد تعاظمني ذنب وأوزار».
ومن أحفاد القليبي أيضا الشيخ جلال الدين أبو الفضل محمد بن قاسم السلمي المالكي المحلي السعودي ، ولد بالمحلة الكبرى عام 879 هـ وتوفي فيها عام 943 هـ ، ذكره نجم الدين الغزي في كتابه الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة فقال : ” محمد بن قاسم الشيخ الإمام شيخ الإسلام جلال الدين ابن قاسم المالكي قال الشعراوي : كان كثير المراقبة لله تعالى في أحواله وكانت أوقاته كلها معمورة بذكر الله تعالى ، شرح المختصر والرسالة وانتفع به خلائق لا يحصون ، ولاه السلطان الغوري القضاء مكرهاً وكان أكثر أيامه صائماً وكان حافظاً للسانه في حق أقرانه لا يسمع أحداً يذكرهم إلا يجلهم وكان حسن الاعتقاد في الصوفية رحمه الله تعالى “.



