
منوف والأعمال المنوفية
في أغسطس عام 640 م. تمكن عبد الله بن حذافة السهمي من فتح قلعة تراجان وهزيمة الحامية الرومانية ، وتنسب هذه القلعة إلى الإمبراطور الرومان تراجان حيث أنشأها لحماية مدينة بانوف ريس والسيطرة على جنوب الدلتا ، وأقامت الحامية العربية في أرض خالية جهة الشرق من القلعة حيث كانوا يأنفون من فكرة الحصون ، وفي هذه الضاحية الشرقية تأسست مدينة منوف الحالية بينما أهمل الحصن والقرية القديمة وبقيت منها عدة أطلال ثم دخلت في المدينة حديثا.
ذكرها القلقشندي في صبح الأعشى فقال : ” العمل الأول : المنوفية وأوله من الجنوب من القرية المعروفة بشطنوف على أول الفرقة الغربية من النيل ومقر ولايته مدينة منوف بضم الميم والنون وسكون الواو وفاء في الآخر ، وهي مدينة إسلامية بنيت بدلا من مدينة قديمة كانت هناك قد خربت الآن وبقيت آثارها كيمانا ، وولايتها من أنفس الولايات وقد أضيف إليها عمل أبيار وهو جزيرة بني نصر وهي مدينة حسنة ذات أسواق ومساجد ومسجد جليل للخطبة وحمّام وخانات “.
ووردت في قوانين ابن مماتي وفي تحفة الإرشاد منوف العليا من أعمال المنوفية ووردت في معجم البلدان منوف من قرى مصر القديمة بأسفل الأرض من بطن الريف ويقال لكورتها المنوفية ، ووردت في التحفة منوف العليا وهي مدينة الأعمال بالمنوفية وضبطها صاحب تاج العروس بفتح أولها ، وفي تاريخ سنة 1228 هـ منوف العلا وقد عرفت بالعليا لأنها تقع بقرب رأس الدلتا في مكان أعلى مما تقع فيه منوف السفلى التي تعرف اليوم باسم محلة منوف بمركز طنطا.
وفي كتاب المسالك وصفها ابن خرداذبه بأنها مدينة كبيرة بها حمامات وأسواق ويعمل أهلها بالفلاحة وأنهم أهل يسار وفيهم وجوه من الناس ولها إقليم عظيم وعمل يليه عامل كبير وقاض ، وقال عنها الإدريسي في كتاب نزهة المشتاق أنها قرية عامرة ولها إقليم معمور وبه غلات وخير كثير ، ويقول عنها علي باشا مبارك : ” وأكثر أبنيتها من الآجر وفيها ما هو على طبقتين وما هو على ثلاث وفيها ثلاث قيساريات بدكاكين توجد فيها أنواع الملبوسات وغيرها ودكاكين حرف “.
وشكلت منوف إحدى الكور الصغرى من إقليم بطن الريف في عصر الولاة ثم أضيفت لها مساحة جديدة في نظام الكور الكبرى حيث نشأت كورة المنوفية في العصر الفاطمي ثم صارت عاصمة الأعمال المنوفية في العصر المملوكي ثم عاصمة ولاية المنوفية في العصر العثماني ، ومع التحول إلى نظام المديريات ظلت عاصمة لمديرية المنوفية حتى عام 1826 م. عندما قرر محمد علي باشا نقل ديوان المديرية إلى مدينة شبين الكوم لتوسطها بين مراكز المنوفية.

القبائل المغربية في المنوفية
في عام 461 هـ / 1069 م. انتصر الأمير ناصر الدولة بن حمدان التغلبي على جيوش الخليفة المستنصر الفاطمي وقاد جموع قبائل طيء ولواتة من البحيرة إلى الغربية والمنوفية حيث اقتسمت القبائل مناطق وسط الدلتا فيما بينها ، واندفعت قبيلة لواتة المغربية خلف جيشها البالغ أربعين ألف فارس لتحكم السيطرة على منوف وأجوارها ثم دخلت في صدام مع الوزير بدر الجمالي ثم الصالح طلائع وفي النهاية تحالفت مع صلاح الدين الأيوبي وصارت من أكبر مناصريه.
وأسست لواتة والمغاربة عددا من القرى الجديدة حول منوف عاصمة الإقليم وأحاطتها من كل النواحي ، في شمال منوف تماما قرية بني يغمرين (نسبة لقبيلة بني يغمرين المغربية وهي غمرين حاليا) وإلواط (منشأة سلطان) وفي غربها منشأة غمرين ومنية جزي (جزي) وفي الجنوب كفر السنابسة (نسبة إلى حلفائها من سنبس الطائية) وعزبة كفر السنابسة وأسدود (سدود) والصوالح (كفر فيشا الكبرى) وفي الشرق منية ربيعة البيضاء (ميت ربيعة) وكفر الرماح (نسبة إلى رميح من طيء) والعامرة (خربة بشنوال) والحامول.
يقول القلقشندي عن إمارتهم : ” العمل الثاني : المنوفية والإمرة فيهم لأولاد نصير الدين من لواتة ولكن إمرتهم في معنى مشيخة العرب ، العمل الثالث : الغربية والإمرة فيه في أولاد يوسف من الخزاعلة من سنبس من طيء من كهلان القحطانية ومقرتهم مدينة سخا من الغربية ” ، ويقول المقريزي عن فروعهم : ” وفي المنوفية من لواتة بنو يحيى والوسوة وعبدة ومسلة وبنو مختار ومعهم في البلاد أحلاف من مزاتة وزنارة وهوارة وبني الشعرية في أقوام آخرين ، ومن زنارة مرديش وبنو صالح وبنو مسام وزمران وورديغة وعرمان ولقان “.
وفي سائر بلاد المنوفية تأسست كل من زنارة (نسبة لقبيلة زنارة) ومنى واهلة (مناوهلة نسبة لقبيلة واهلة وتشكل مع بني مغاغة أكبر فروع لواتة) وكفر مناوهلة والكتامية (نسبة لقبيلة كتامة) وبني غريان وكفر بني غريان وعزبة اللواتي والجريسات والأطارشة وتلوانة وعشما وشريحة وسلمون (بحري وقبلي) وسمدون (سماودن) وخلفون (شبرا خلفون) وجروان وشميرف (مشيرف) وشنوالي (شنوان) والبراغتة (طوخ البراغتة) والبرانقة والقرينين والمقاطع ومنية عفيف والرمالي وعرب الرمل وكفر العرب القبلي.
وقبيلة لواتة هي أول من تعرب وأسلم من قبائل المغرب فقد كانت تسكن في الأصل الصحراء الغربية من حافة الدلتا إلى برقة وشاركت تحت قيادة هلال بن ثروان اللواتي في حملة حسان بن النعمان الغساني سنة 693 م. ( 74هـ) لفتح المغرب ، واختلف المؤرخون في تصنيفها حيث ذكر ابن حزم أن نسابة البربر يزعمون أن سدراتة ولواتة ومزاتة من القبط بينما يؤكد ابن خلدون أنهم من بطون البربر البتر وذكر المقريزي أن لواتة تزعم أنها من العرب القيسية وزعم آخرون أنهم من الروم أو أنهم فرع من قبيلة لخم وانتقلوا قديما باتجاه الغرب من الشام إلى ليبيا وأكد بعضهم أنهم أحفاد شعب الليبو التاريخي.

مدينة منوف
في الخطط التوفيقية : بلدة قديمة تنسب إليها مديرية المنوفية التى مركزها الآن بلدة شبين الكوم ، ومنوف الآن رأس مركز من تلك المديرية واقعة فى شرقيها بقليل ترعة البطحية ، ويكتنفها من جهة الغرب والجنوب بحر الفرعونية ، وأكثر أبنيتها من الآجر ، وفيها ما هو على طبقتين ، وما هو على ثلاث ، وفيها ثلاث قيساريات بدكاكين ، توجد فيها أنواع الملبوسات وغيرها ، ودكاكين حرف ، وأربعة خانات للأوروباويين، ولهم بها ثلاث خمارات ، وبها جملة قهاو ، وأربعة معامل لاستخراج الكتاكيت ، وسبع معاصر للزيت ومصابغ نيلة كثيرة.
وفيها ديوان المركز ، ومحكمة شرعية مأذونة بفصل القضايا التى من شؤنها ، وكان عندها قشلة للميرى فوق الترعة الفرعونية ، صار بيعها للمرحوم حسن أفندى الشقنقيرى ، وهى الآن مهدمة العنابر قائمة الأسوار ، وبنى ورثتة بداخلها منازل ، وجعلوا فيها حديقة ذات فواكه ورياحين، ويزرع فيها أنواع من الخضر.
وفيها من جهة الجنوب الغربى تل كبير تحته حمام قديم مستعمل إلى الآن ، وفيها أرباب حرف كثيرة فينسج بها شدود الحرير والصوف ، وخرق القطن الأفرنجى ، والعباآت الحسينية ، والمناخل والغرابيل والحصر السمار الجيدة المتخذة من السمار المغراوى المجلوب من المغارة – وهى جهة على خمسة أيام بلياليها – ومن السمار الشرقاوى المجلوب من جهة الزقازيق ببلاد الشرقية وكذا من بلاد الدقهلية والسمار الواحى ، والسمار الرشيدى ، والسمار الدمياطى ، وسمار الوادى بمديرية البحيرة.
وفيها الشيخ حسن النحراوى وأولاده يصنعون مقصات الورق الجيدة ، ويعمل أيضا فيها الجبن أنواعا ، فيوضع المخيض أو اللبن الحليب فى أوعية حتى يجمد ، ثم يوضع فى حصر حتى يخلص من مائة المسمى بالشرش ، ويسمى فى بعض بلاد الصعيد بالميص ، ثم يقطع بسكينة قطعا ويوضع عليه الملح.
وبها الخيل الجياد والبغال والحمير والأنعام وأصناف من الطير، ولها سوق دائم يباع فيه العقاقير والثياب واللحم والخضر ونحو ذلك ، وسوق حافل كل يوم أحد يباع فيه غالب سلع القطر، حتى حمول العرب المنقوشة المتخذة من الصوف والوبر ومخالى الخيل ، والحقائب والقرب التى يمخض فيها اللبن والتى يستقى بها الماء ، وفيها حلقة لبيع السمك ، ووابور لحلج القطن وطحن الغلال لموسى أفندى الجندى.
وفيها حدائق ذات بهجة ، بها كثير من الرياحين والخضر وشجر الفاكهة كالبرتقال والخوج والعنب والرمان والتين والليمون بنوعيه والنارنج ، وبها إثنتا عشرة ساقية لسقى القطن والخضر ونحوهما ، ويزرع بها هذا الصنف كثيرا ، وأطيانها نحو أربعة آلاف فدان مأمونة الرى جيدة الزرع ، ويزرع فيها القمح والشعير والذرة وغير ذلك من الزرع المعتاد.
وأكثر أهلها مسلمون يفوقون عشرة آلاف نفس ، وترقى منها جماعة فى المناصب الميرية منهم موسى أفندى الجندى تربى فى المدارس فى ظل ساحة العائلة المحمدية ، وحصّل طرفا من المعارف وأحرز رتبة القائمقام ، ومحمد أفندى فهيم مهندس مديريتى الغربية والمنوفية برتبة بكباشى ، ومحمد أفندى قطورة برتبة يوزباشى ، وكذا غيرهم.

مساجد منوف التاريخية
يقول علي باشا مبارك في كتاب الخطط التوفيقية : وبالبلد جملة مساجد لبعضها منابر لخطبة الجمعة والعيد ، والبعض بلا منابر ، منها مسجد زوين زين الدين ، وهو مسجد جامع عتيق بمنارة ، وقد رم من ريع أوقافه سنة ١٢٣٠ مسجد الملاح عتيق بمنارة أيضا ، ورم من ريع وقفه سنة ١٢٧٠ مسجد عبد الله الإسرائيلى ، مسجد داود بن الرداد ، مسجد حسن المنسوب رم سنة ١٢٥٠ من طرف الأهالى ، مسجد الشيخ خليف ، مسجد سيدى محمد الجيوشى ، مسجد سيدى محمد الضرغامى بمنارة ، مسجد السيدة عائشة المخالصة.
وكل هذه المساجد جامعة ، وفيها أضرحة من نسبت إليهم ، وهم من أهل الصلاح معتقدون ويزارون ، مسجد عبد القادر أبى عقدة بجواره من الجانب الشرقى ضريح الشيخ أبى عقدة ، وفى شرقيه ضريح معتقد يقال له الجارحى.
مسجد سيدى مسعود العجمى ، مسجد سيدى على الرقاق ، مسجد الشيخ رفاعة حنحون فى جهتها الشرقية مسجد المتولي ، المسجد الجديد فى درب المعلم له منارة ، جدده على أفندى البرقى سنة ١٢٧٥ ، مسجد الملك بجهتها البحرية جدده على أفندى البرقى أيضا سنة ١٢٧٠ ، مسجد السيدة عائشة الأسبكية بمنارة جدده حجو بيك سنة ١٢٣٠ ، مسجد سيدى موسى بن عمران له منارة ، مسجد سيدى محمد الجيار بحارة الأمير يوسف له منارة ، مسجد الخضرى بسوق القهاوى له منارة ، مسجد البياضى بحارة المحلة الكبرى.
مسجد سيدى سعيد ، مسجد المتيم بدرب الأمير يوسف ، مسجد القراوى ، مسجد السبكى بدرب الجيزاوى ، مسجد الكردى بدرب الرحبة ، مسجد الفخرية بدرب المعلم ، مسجد الأربعين وهو الآن مهجور.
وبها أضرحة كثيرة بقباب لبعض الصالحين مثل الشيخ رمضان الأشعثى بالجبانة الغربية ، وسيدى حسن المقرى ، وأبى النفحات ، والشيخ النعمان ، وأبى الغارات ، والسادات أولاد ضرغام ، وسيدى سليمان المغربى ، وسيدى محمد الانجبى ، والشيخ العشماوى ، والسادات الأربعين ، وسيدى عبد السلام بالجبانة الشرقية ، والشيخ أبى علم ، وسيدى قائد والشيخ البغدادى ، وأبى النور على ، والمكسح ، وأبى النور حسن ، وحسن البراذعى وغيرهم.
ونشأ منها أفاضل وعلماء ، يرحل إليهم ، أجلهم القطب الشهير ، والعلم الكبير ، صاحب الكرامات الباهرة ، والأسرار الظاهرة ، الصالح العابد الزاهد أحد السبعة المتصرفين سيدى عبد الله المنوفى المالكى وعم ببركاته المسلمين ، مات سابع رمضان سنة ثمان وأربعين وسبعمائة، ودفن تجاه قبر السلطان قايتباى بالصحراء الكبرى ، وكان الناس فى ذاك النهار بالصحراء للدعاء برفع الوباء عنهم ، فحضر جنازته نحو من ثلاثين ألف رجل ، وقد أفرده بالترجمة تلميذه الشيخ خليل.
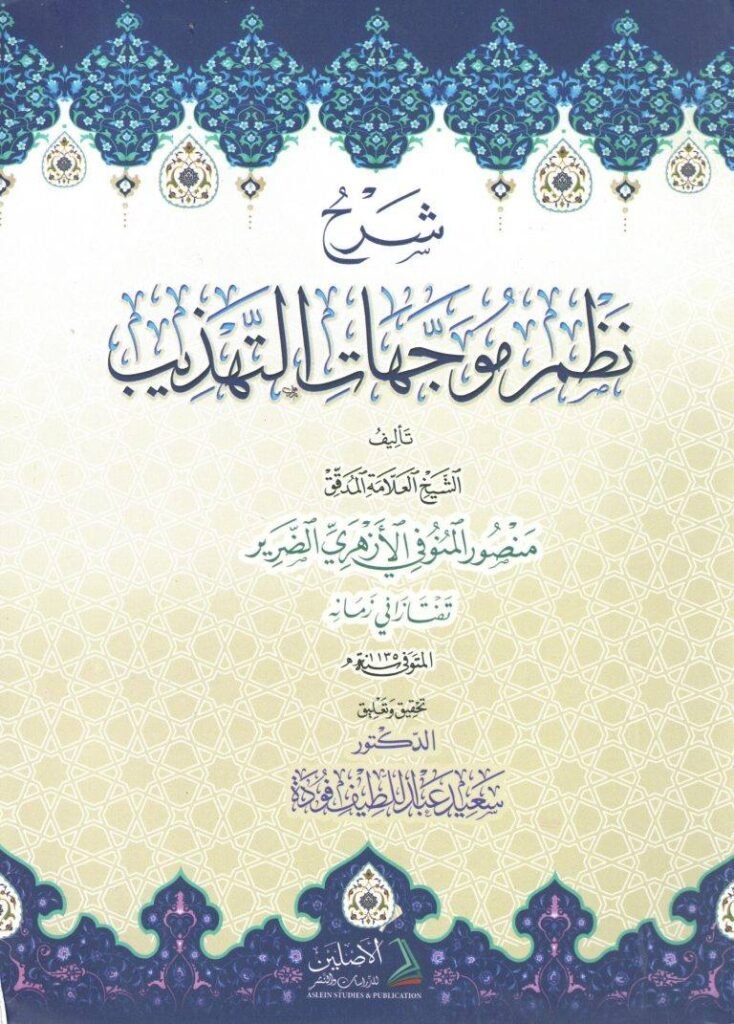

أعلام منوف
ذكر المحبى فى خلاصة الأثر أن منها عبد الجواد بن محمد بن أحمد المنوفى المكى الشافعى ، الأديب اللوذعى ، كان فاضلا أديبا حسن المذاكرة ، أخذ بمكة عن علمائها وولى بها مدرسة ، ثم لحق بالحرم المكى فتقدم عند الشريف وقد بلغ رتبة عالية ، وبينه وبين أهل عصره من المكيين وغيرهم مطارحات ومراسلات كثيرة ، وله فى الأشراف الحسينيين ملوك مكة مدائح خطيرة ، وذكر عبد البر الفيومى فى المنتزة أن له تآليف منها : شرح على الآجرومية وتحريراته ومنشآته كثيرة ، وله شعر فائق ونثر رائق ، توفى خامس شوال سنة ثمان وستين وألف بالطائف ، ودفن بقرب تربة ابن عباس رضي الله عنهما.
وفى حاشية العدوي على كفاية الطالب الربانى شرح رسالة ابن أبى زيد القيروانى فى فقه مالك : أن من مدينة منوف هذه ، العلامة أبا الحسن على بن محمد ابن خلف المنوفى بلدا ، المصرى مولدا ، ولد بالقاهرة بعد صلاة العصر ثالث شهر رمضان سنة سبع وخمسين وثمانمائة ولازم الجلال السيوطى وأخذ عنه ، توفى فى يوم السبت رابع عشر صفر سنة تسع وثلاثين وتسعمائة ، وصلى عليه بالجامع الأزهر ، ودفن بالقرب من باب الوزير ، وقد ألّف كتبا عديدة.
وفى الضوء اللامع للسخاوى : أن منها عبد الغنى بن على البهائى المنوفى الشافعى ، عرف بالبهائى لسكناه حارة بهاء الدين ، ولد بمنوف وتحول منها إلى القاهرة ، وتكسب بالشهادة وبرع فى معرفة الشروط ونحوها ، ولم يكن طلق اللسان ، وقد تصدر بجامع الحاكم والأشرفية القديمة وغيرهما ، وناب فى القضاء دهرا ، وتعلل مدة وأقعد حتى مات سنة ثمان وخمسين وثمانمائة ، ودفن خارج باب النصر.
ومنها محمد بن محمد بن عبد السلام بن موسى بن عبد الله العز الصنهاجى الأصل المنوفى ، ثم القاهرى الشافعى ، ويعرف بالعز بن عبد السلام ، قدم جد جدّه عبد الله من المغرب فقطن الخربة من عمل منوف ثم انتقل ابنه إلى منوف فقطنها وبها ولد العز ، وناب فى القضاء عن شيخه الجلال بعد امتناعه زمنا ، واستمر ينوب حتى صار من أجلّ النواب ، ولشريف أوصافه ظهرت بركتة وكراماته ، ومات بعد عصر يوم الإثنين رابع عشر ربيع الآخر سنة خمس وستين وثمانمائة ، وقد زاد على التسعين ممتعا بحواسة وقوته ودفن بالتربة المرجوشية.
وفيه أيضا أن منها محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن موسى بن سعيد بن على الشمس بن أبى السعود المنوفى ، ثم القاهرى الشافعى ، ويعرف بابن أبى السعود ، ولد فى سنة عشر وثمانمائة تقريبا بمنوف ونشأ بها ، واستقر أولا فى وظيفة والده التصوف بسعيد السعداء ثم أعرض عنها لأخيه ونزل فى صوفية الشيخونية ، وحج وجاور وداوم العبادة والتقنع باليسير والانعزال عن أكثر الناس واقتفى طريق الزهد والورع والتعفف الزائد والاحتياط لدينه ، وذكرت له كرامات وأحوال صالحة ، مات فى ربيع الآخر سنة ست وخمسين ، ودفن بحوش سعيد السعداء جوار الشيخ محمد ابن سلطان بالقرب من البدر البغدادى الحنبلى.
ومنها أيضا كما فى الجبرتى الفقيه المحدث الشيخ منصور بن على بن زين العابدين المنوفى البصير الشافعى ، ولد بمنوف ونشأ بها يتيما فى حجر والدته وكان بارا بها فكانت تدعو له فحفظ القرآن وعدة متون ، ثم ارتحل الى القاهرة وجاور بالأزهر واجتهد وبرع وتفنن فى العلوم العقلية والنقلية ، وكان إليه المنتهى فى الحذق والذكاء وقرة الاستحضار لدقائق العلوم ، سريع الإدراك لعويصات المسائل على وجه الحق ، نظم الموجهات وشرحها وانتفع بها الفضلاء وتخرج به النبلاء ، توفى فى الحادى والعشرين من جمادى الأولى سنة ١١٣٥ هـ ، وقد جاوز التسعين.

سرس الليان
نسبت قرية سرس القديمة بالمنوفية إلى ترعة الليانة التي تمر بها في دليل عام 1224 هـ وكانت تعرف قديما باسم سرس القثاء لاشتهارها بزراعته ، وجاء عنها في الخطط التوفيقية : سرس الليانة بلدة كبيرة من أعمال منوف بمديرية المنوفية ، لها شبه بالمدن ، واقعة شرقى ترعة السرساوية على نحو أربعة وعشرين مترا ، وأبنيتها بالآجر واللبن ومنازلها على دور ودورين وما على ثلاثة قليل جدا ، وأكثر أهلها مسلمون ، وبها من الأقباط نحو مائة نفس ، وبها جماعة من الإفرنج لهم فيها بنوكات ، وفيها مساجد كثيرة وبعضها جامع وبعضها غير جامع.
مسجد الأربعين هو جامع كبير بمنارة هدم وجدد سنة ١٢٤٥ ناظره «السيد أحمد نصار» ، مسجد سيدى عبد القادر الكردى بمنارة هدم وجدد سنة ١٢١٣ بمعرفة الشيخ عمر حسام الدين من أهلها ، جامع سيدى يوسف الكورانى بمنارة تخرب وجدد سنة ألف ومائتين وإحدى وسبعين ، جامع درب الفوله رمم سنة ١٢٧٥ وله منارة ، جامع درب السوق رمم سنة ١٢٨٠ ، جامع الزهارنة جدد سنة ١٢٤٠ بنظر الحاج سليم زهران الكبير من أهلها.
جامع الضرايبة بمنارة وهى فجدده حسين غراب وإخوته سنة ١٢٦٥ ، جامع التين بمنارة جدده حسين التين وأقاربه سنة ١٢٥٥ ، جامع سيدى محمد أبى البركات وهى فجدد سنة ١٢٨٠ ، جامع الأستاذ محمد بن أبى الروس بنى سنة ١٢٦٥ ، مسجد محمد الظاهر وهو زاوية بنيت سنة ١٢٨٥ ، مسجد حسام الدين وهو زاوية بنيت سنة ١٢٨٧ ، مسجد على الإبيارى وهو أيضا زاوية بناها إبراهيم خالد سنة ١٢٥٠ وفيها ضريحه.
وفى البلد خمس حدائق يشتمل أغلبها على أنواع الفواكه والرياحين والخضر ؛ مثل الليمون الحلو والمالح والبرتقال ويوسف أفندى ، والمشمش والنفاش والعنب البناتى والبلدى والرومى ، والموز والتين والزيتون والكباد والنخل ، والفلفل والورد والنعناع والسذاب ، منها جنينة على شاطئ الباجورية الشرقى ، وجنينة فى جهتها البحرية ، وجنينة فى جهتها الغربية ، وجنينة فى جهتها الشرقية ، وجنينة فى هذه الجهة أيضا.
وفيها سبع عشرة ساقية معينة كثيرة الماء العذب ، وأطيانها أربعة آلاف فدان وثلثمائة وأحد وعشرون فدانا وكسر ، جميعها مأمونة الرى جيدة المتحصل ، ويزرع فيها الزرع المعتاد والقطن وقصب السكر ، وأنواع الخضر مثل القلقاس والباذنجان بنوعيه ، وينسج فيها الثياب السرساوية من القطن الفرنجى والصوف الجيد، ولأهلها معرفة تامة بتربية دود الحرير.
وعدد أهلها ذكورا وإناثا ثمانية آلاف نفس واثنان وثلاثون نفسا ، ومنهم أرباب حرف كالنجار والحداد والحائك والتاجر ، وترقى منها فى المعارف والرتب الديوانية جماعة كثيرون ، منهم حسن أفندى رأفت يوزباشى فى هندسة الطوبجية ، ومثله محمد أفندى أنور ووالده إبراهيم أفندى على يوزباشى بوظيفة حكيم فى سلخانة مصر ، وإسماعيل أفندى فائز ، وفرج أفندى الملقب بالدكر دخل العسكرية البيادية وترقى إلى رتبة البيكباشى وسافر فى حرب الحبشة ورجع سالما وأقام بالآلايات.
ويقتنى فيها جياد الخيل والبغال والحمير والأنعام ، وفيها مقامات كثير من الأولياء كمقام سيدى محمد الأمير يقولون إنه وزير أمير الجيش السلطان محمد شبل ، ومقام أبى البركات صاحب الجامع المتقدم وسليمان الكورانى ويوسف الكورانى وسيدى محمد الظاهر وغيرهم ، ومنها جماعة من أفاضل العلماء منهم الشيخ موسي السرسى أحد أعضاء المجلس الكبير الذى كان رتبه بونابرت بمصر للنظر فى الدعاوى ، ومنها الشيخ محمد السرسى المشهور بالقراءات السبع فى الجامع الأزهر توفى سنة ثلاث وثمانين من القرن الثالث عشر.

كفر السنابسة
في العصر الفاطمي استقرت قبيلة سنبس في غرب الدلتا ثم انتقلت إلى وسط الدلتا على موجات متتابعة بدءا من أحداث الشدة المستنصرية وحتى ثورة القبائل ضد المماليك والتي انتهت بتشتت القبيلة وتأسيسها عدة قرى متفرقة ، وقد ذكرها عمر كحالة في معجم قبائل العرب فقال : السَّنابِسَة: بطن كان يقيم بالبحيرة من أعمال مصر، وينتسب الى لبيد بن سنبس بن معاوية بن جرول ابن ثعلبة بن عمرو بن الغوث بن طيء من كهلان من القحطانية. (نهاية الأرب للنويري ج ٢ ص ٣٠٠)
وجاء في القاموس الجغرافي : كفر السنابسة هذا الكفر تكون في العهد العثماني وذلك بفصله من زمام منوف وقد ورد في دليل سنة 1224 هـ وتاريخ سنة 1228 هـ ، وفي تاريخ سنة 1262 هـ فصل من هذا الكفر ناحية أخرى باسم عزبة كفر السنابسة وفي فك زمام مديرية المنوفية في سنة 1901 ألغيت وحدة هذه العزبة وأضيف زمامها كما كان إلى كفر السنابسة فصارتا ناحية واحدة باسم كفر السنابسة وعزبتها.
وفي كتاب نهاية الأرب في أنساب العرب ذكرها القلقشندي فقال : بنو سنبس ويقال لهم سنبس بأسم أبيهم بطن من طي من القحطانية وهم بنو سنبس بن معاوية بن جرول بن ثعل بن عمرو بن الغوث ابن طي ، وكان لسنبس من الولد زبيد وعمرو ومنهم بنو أبان بن عدي المذكور في حرف الألف وقد ذكر الحمداني منهم طائفة ببطائح العراق وطائفة بدمياط من الديار المصرية ، قال : وكان لهم شأن أيام الخلفاء الفاطميين بالأعمال الجيزية حول سقارة ، قلت : والأمرة الآن فيهم في الخزاعلة في بني يوسف ومقرهم في مدينة سخا من الأعمال الغربية.
وجاءت تفاصيل ذلك في موسوعة القبائل العربية حيث يقول محمد الطيب : طيء لم تكن من قبائل الفتح ولم تظهر في مصر إلا في أواسط القرن الثاني ونحن نعرف أن حميد بن قحطبة الطائي لما ولي مصر سنة ١٤٣ هـ دخلها في عشرين ألفا من الجند فأغلب الظن أن قبيلته كانت ممثلة في هذا الجيش ، والواقع أنها تظل ظاهرة على المسرح منذ ذلك التاريخ حتى القرن الثالث الذي تدل شواهد القبور على وجود هذه القبيلة بمصر في أثنائه.
وكل من ظهر من طيئ بمصر كانوا من الشخصيات البارزة فهناك بعد حميد بن قحطبة ويزيد بن عمران كان صاحب البريد سنة ١٧٤ هـ وفي سنة ١٩٥ هـ ولي مصر والٍ آخر من طيئ هو جابر بن الأشعب ومن المهم أن نعرف أن جابرا استخلف أحد أبناء قبيلته المقيمين بمصر (عبد الله بن إبراهيم) إلى أن جاء وشارك إبراهيم بن نافع باعتباره من وجوه مصر في السياسة المصرية مشاركة كلفته حياته سنة ١٩٩ هـ.
وكان معلى بن العلي الطائي – الشاعر الذي لا مبدأ له – من أظهر شخصيات طيئ في مصر في أواخر القرن الثاني وأوائل الثالث وكان هناك في الوقت نفسه الشاعر الناشي أبو تمام (ت ٢٣١ هـ) الذي قضى صدر حياته في مصر ثم تركها ليصبح أحد الشعراء الخالدين ،وكان في مصر من طيئ البطن الآتي : الغوث وكان منهم عمار بن مسلم بن عبد الله الذي ولي الشرطة عدة مرات فيما بين سنتي ١٦٥، ١٨١ هـ.
سُنْبُس – طيئ القحطانية : قال المقريزي إن هذه القبيلة من طيئ وإن من أفخاذها بنو لبيد وعمرو وعدي وأبان وجرم ومحصن وقنة ، وإلى قنة ينسب معالي بن فريج مقدم سنبس في الجيزة وكان له جرأة ومروءة وفيه كرم وشجاعة وقد قتل صبرا بالقاهرة ، وكانت سنبس تنزل بفلسطين والداروم قريبا من غزة وكثروا هناك واشتدت وطأتهم على الولاة وصعب أمرهم فبعث الوزير أبو محمد الحسن اليازوري وزير المستنصر الفاطمي (٥٢٧ – ٥٨٧ هـ) إليهم في سنة ٤٤٢ هـ يستدعيهم وأقطعهم الجيزة من أرض مصر وكانت يومئذ منازل بني قُرة من بطون خبيب بن جذام.
فأوطأهم الوزير ديار بني قُرة وأقطعهم ديارهم فاتسعت أحوالهم وفخم أمرهم وعظم في أيام الفاطميين شأنهم ، وحينما نادى المعز أيبك أول ملوك الترك بديار مصر سنة ٦٥١ هـ بنفسه ملكا على أنقاض الدولية الأيوبية أنفوا من تملكه لأنه مملوك فاجتمعوا هم وسائر العرب في مصر وبايعوا الشريف حصن الدولة ثعلب ابن الأمير الكبير نجم الدين علي ابن الأمير الشريف فخر الدين إسماعيل بن حصن الدين مجد العرب ثعلب الجعفري في سنة ٦٥١ هـ فقاتلهم المماليك الترك وقبضوا على الشريف وأصحابه ثم مضوا إلى ناحية سخا من الغربية وقد اجتمع فيها سنبس ولواتة ومن معهم فأوقعوا بهم وقعة شنيعة قتلوا فيها رجالهم وسبوا حريمهم ونهبوا أموالهم فذلت سنبس بعد ذلك وقلت وتفرقت بالغربية.
وكان من الحلفاء سنبس عذرة ومدلج ويجاورهم فرقة من كنانة بن خزيمة ويجاورهم كذلك فرقة من عدي بن كعب ورهط أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ومقدمهم خلف بن نصر بن منصور العمري ونزلوا بالبرلس وكانوا هم والكنانيون من ذوي الآثار المذكورة في نوبة دمياط ، وخلف هذا هو جد بني فضل الله بن المجلى بن عجاب بن خلف بن نصر وقد تولوا كتابة السر لملوك الترك بالقاهرة ودمشق نحو مائة سنة ، وفي سياق المقريزي إشارة إلى أرومات عربية متنوعة الأصول كانت حليفة لسنبس أو مجاورة لها ومنها ما يحتمل أن يكون جاء إلى مصر كفروع قبائل ومنها ما يحتمل أن يكون جاء كأسرة أو عشيرة ، والسياق يفيد كذلك أن ممن ذكرهم من كان صاحب مكانة وسلطان ومن كان يعيش عيشة حضرية ومن كان يتولى أعمالا حكومية في دولة المماليك (الترك).

غمرين
في العصر الفاطمي نزحت القبائل المغربية إلى وسط الدلتا وانتشرت في منطقة الأعمال المنوفية حيث أسسوا عدة قرى ظهرت في سجلات العصر المملوكي ومن أهمها غمرين ومنشأة غمرين نسبة إلى قبيلة بني يغمورين (غمارة المصمودية) ، وقد ذكرها ابن الجيعان في كتاب التحفة السنية في القرن التاسع الهجري فقال : الساحل من كفور منوف وهي منشأة غمرين مساحته 865 فدان عبرته كانت 2100 دينار والآن 1050 دينار كان للمقطعين والآن لهم وأملاك وأوقاف ، بني يغمرين من كفور البتنون مساحتها 663 فدان عبرتها 3000 دينار للمقطعين وأملاك وأوقاف.
وجاء في القاموس الجغرافي : غمرين قرية قديمة اسمها الأصلي بني يغمرين وردت في التحفة من أعمال المنوفية وقال إنها من كفور البتنون والصواب أنها من كفور منوف لأنها أقرب إليها من البتانون وفي تاريخ سنة 1228 هـ باسمها الحالي.
والذي يؤيد أن بني يغمرين هي غمرين هذه هو أولا : أنه ورد في التحفة قرية باسم الساحل من أعمال المنوفية قال وهي منشأة غمرين من كفور منوف وهذه لا تزال موجودة إلى اليوم بجوار غمرين ، ثانيا ورد في دليل سنة 1224 هـ أن الساحل من كفور منوف وتعرف بمنشية بني يغمورين لولاية المنوفية ، ثالثا ثبت من رواية هذين المصدرين أن غمرين أو بني يغمرين هي من كفور منوف وليست من كفور البتنون.
منشأة غمرين : قرية قديمة اسمها الأصلي الساحل ورد في التحفة قال وهو منشأة غمرين من كفور منوف من أعمال المنوفية وفي دليل سنة 1224 هـ الساحل من كفور منوف وتعرف بمنشية بني يغمورين بولاية المنوفية وفي تاريخ سنة 1228 هـ باسمها الحالي.
وفي الخطط التوفيقية : غمرين قرية من مديرية المنوفية بقسم منوف فى جنوب ناحية الواط بنحو ثلاثة آلاف متر وفى الشمال الغربى لمنوف بنحو ثلاثة آلاف وخمسمائة متر ، وبها جامع بناؤه باللبن وبها ضريح ولى يعرف بالشيخ منصور وعليه قبة ويعمل له ليلة كل سنة وبها أنوال لنسيج الثياب الصوف وزراعة أهلها كمعتاد الأرياف ، ويقال لها غبرين – بالباء الموحدة بدل الميم – والظاهر أنه ينسب إليها الشيخ الغمرينى المالكى المشهور.
وقد ذكر القلقشندي نسب قبيلة غمارة في كتاب نهاية الأرب في أنساب العرب فقال : بنو غمارة بطن من معمورة مصمودة من البرانس من البربر ، وهم بنو غمارة بن مسطاح بن قليل بن معمورة بن برنس بن بربر ، والبربر تقدم نسبهم في حرف الالف فيما يقال فيه بنو فلان في الالف واللام مع الباء الموحدة ، .قلت: ومن هذه القبيلة جدنا الشيخ عبد الله الغماري ، خادم سيدي أبي العباس البصير الخزرجي الاندلسي البلنسي ، وهو مدفون عنده ضريحه بقرافة مصر الصغرى ، نفع الله ببركتهما.
وجاء في موسوعة القبائل العربية : غمارة هم مصمودة الشمال ، ومن أشهر شعوب البربر وقبائلهم ، سموا باسم والدهم غمار بن مصمود ، وقيل غمار بن سطاف بن مليل بن مصمود ، وقيل غمار بن اصاد بن مصمود ، وتزعم العامة أنهم عرب غمروا في الجبال فسموا غمارة ، وهو مذهب عامي.
كانت مواطنهم تمتد على ساحل البحر المتوسط من حد بلاد الريف إلى المحيط الأطلسي ، ثم تمتد على السهول الساحلية حيث كان يسكن بنو حسان منهم قبل دخول العرب الهلاليين حتى تصل إلى تامسنا حيث مواطن قبائل برغواطة ، ثم حدثت تغيرات كثيرة في مساكن القبائل المصمودية منذ القرن السادس الهجري الذي غمرت فيه المغرب موجات من العرب الهلاليين والمنضافين إليهم فزاحموا قبائل البربر ، ومنهم غمارة بالسهول وألجأوها إلى الجبال واضطر من بقي منها في غير الجبل إلى التعرب والاندماج فيهم ، وقد تضاءلت المنطقة التي تسكنها القبائل المسماة اليوم غمارة وهي واقعة إلى الجنوب الشرقي من تطوان على ساحل البحر ، ولكن قبائل غمارة المعروفة بأسمائها الفرعية ما زالت تعمر منطقة أوسع وأكبر ، كما أن قبائل أخرى معروفة بالاسم الأصلي أو الأسماء الفرعية انتقلت من مواطنها الأولى إلى مواطن جديدة بالمغرب الأقصى والمغرب الأوسط.

شبرا بلولة
في الخطط التوفيقية قرية من مديرية المنوفية بمركز سبك ، واقعة على شاطئ الباجورية الشرقى ، فوق تل صغير بقرب منوف ، أبنيتها باللبن والآجر ، وبها مسجدان ، أحدهما فى جهتها البحرية والآخر فى الجهة القبلية ، لكل مسجد قوم يختصون به ، لأن أهلها قديما كانوا على طرفى نقيض مفترقين فرقتين سعد وحرام ، لايتزاورون ، ولا يجتمعان فى محفل واحد ، ولا تتعدى إحداهما على الأخرى ، ولكل فرقة باب فى جهتها يغلق عليها ، وعلى وجه كل باب مزاغل لضرب البارود.
وكانت تقع بينهم مناوشات وحروب انقطعت الآن ، وبها معامل دجاج وجنائن وسواق معينة ، ووابوران على ترعة الباجورية لسقى مزروعات الصيف والشتاء ، ويتبعها قرية صغيرة يقال لها كفر شبرى بلولة فى قبليها ، على نحو سدس ساعة على شاطئ الباجورية الشرقى ، ويعمل فيها كل سنة ليلة لسيدى إبراهيم الدسوقى ، وبها مقام لولى يسمى الشيخ على الوقوح ، ومنها على أفندى خلف الله ، تربى بالمدارس ، ثم جعل مهندس تنظيم بالمحروسة وأعطى رتبة ملازم ، ثم جعل معاون تفتيش هندسة المنوفية والغربية ، ثم باشمهندس المنوفية ، ثم معاون تفتيش وجه قبلى ، والآن هو بديوان الأشغال برتبة بكباشى.
وذكر المحبى فى كتابه «خلاصة الأثر» أن منها الشيخ حسن بن عمار بن على أبا الإخلاص المصرى الشرنبلالى ، الفقيه الحنفى الوفائى ، كان من أعيان الفقهاء وفضلاء عصره ، وممن سار ذكره فانتشر أمره ، وهو أحسن المتأخرين ملكة فى الفقه وأعرفهم بنصوصه وقواعده ، وأنداهم قلما فى التحرير والتصنيف ، وكان المعول عليه فى الفتاوى فى عصره ، قرأ فى صباه على الشيخ محمد الحموى والشيخ عبد الرحمن المسيرى ، وتفقه على الإمام عبد الله النحريرى والعلامة محمد المحبى ، وسنده فى الفقه عن هذين الإمامين وعن الشيخ الإمام على بن غانم المقدسى مشهور ومستفيض ، ودرس بالجامع الأزهر وتعين بالقاهرة ، وتقدم عند أرباب الدولة ، واشتغل عليه خلق كثير وانتفعوا به.
وصنف كتبا كثيرة فى المذهب ، وأجلها «حاشية على كتاب الدرر والغرر لمنلا خسرو» ، واشتهرت فى حياته وانتفع الناس بها ، وهى أكبر دليل على ملكته الراسخة وتبحره ، وشرح «منظومة ابن وهبان» فى مجلدين ، وله متن فى الفقه ورسائل وتحريرات وافرة متداولة.
وقدم المسجد الأقصى فى سنة خمس وثلاثين وألف صحبة الأستاذ أبى الإسعاد يوسف بن وفا ، وكان خصيصا به فى حياته ، وكانت وفاته يوم الجمعة ، بعد صلاة العصر فى الحادى والعشرين من شهر رمضان سنة تسع وستين وألف عن نحو خمس وسبعين سنة ، ودفن بتربة المجاورين.
والشرنبلالى، بضم الشين المعجمة مع الراء وسكون النون وضم الباء الموحدة ثم لام ألف وبعدها لام ؛ نسبة لشبرى بلولة على غير قياس ، والأصل شبرى بلولى وهى تجاه منوف العلى بإقليم المنوفية بوادى مصر ، جاء بالمترجم والده منها إلى مصر وسنه يقرب من ست سنين، فحفظ القرآن وأخذ فى الاشتغال ، رحمه الله تعالى.
وينسب إليها كما فى الجبرتى العلامة حسن بن حسن بن عمار الشرنبلالى الحنفى أبو محفوظ حفيد أبى الإخلاص ، شيخ الجماعة ووالد الشيخ عبد الرحمن ، كان فقيها فاضلا محققا ، ذا تؤدة فى البحث ، عارفا بالأصول والفروع ، رأيت له رسالة سماها غاية التحقيق فى أحكام كى الحمصة ، توفى سنة تسع وثلاثين ومائة وألف.
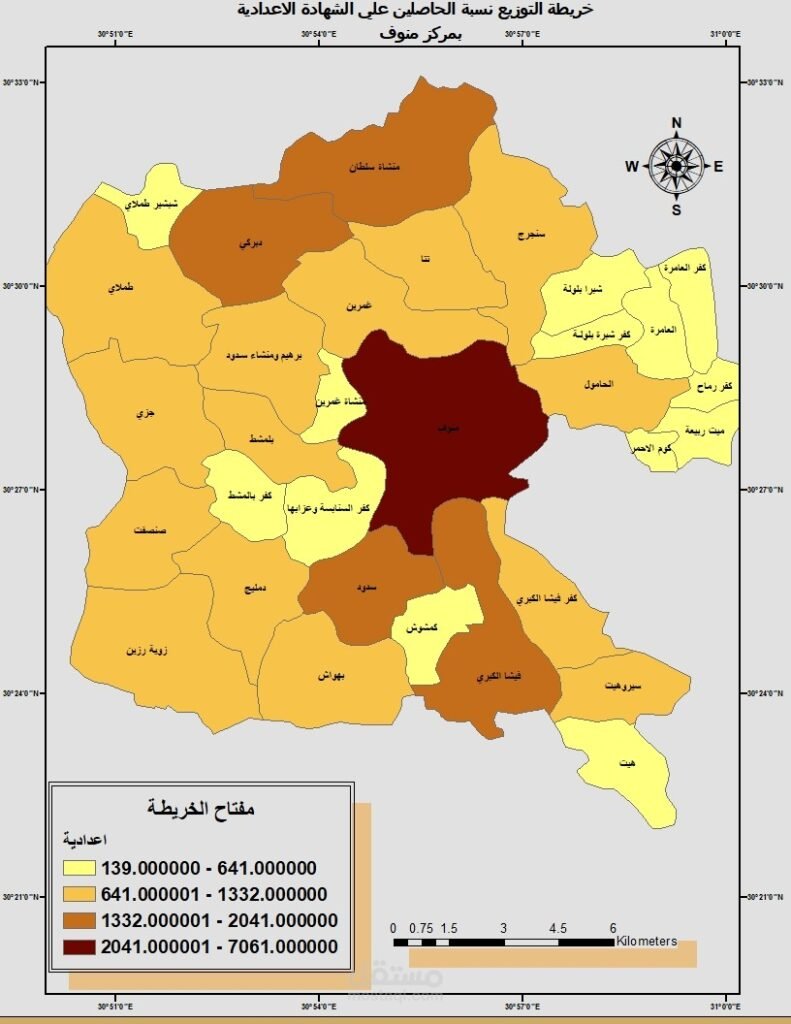
بلمشط وزاوية رزين
جاء في الخطط التوفيقية : ” أبو المشط : قرية من مديرية المنوفية بقسم منوف واقعة بين ترعة النعناعية وبحرى الفرعونية فى الشمال الغربى لمدينة منوف ، وبها ثلاثة مساجد ومنزل ضيافة لعمدتها أحمد أغا الجنزورى ، وله بها أيضا بستان ذو فواكه ووابور على ترعة النعناعية ، وبها أيضا معمل دجاج وأبراج حمام ، وفى بحريها بالقرب من ترعة النعناعية قنطرة بثلاث عيون تعرف بقنطرة الجبن ، ورى أطيانها من الترعة المذكورة وبها سواق معينة لسقى المزروعات الصيفية ، وتكسب أهلها من الزرع وغيره.
وإلى هذه القرية ينسب كما فى الضوء اللامع للسّخاوى : خالد بن أيوب بن خالد الزين المنوفى ثم القاهرى الأزهرى الشافعى ، ولد بعد القرن بيسير فى أبى المشط من جزيرة بنى نصر الداخلة فى أعمال المنوفية ، وانتقل منها إلى منوف فقرأ القرآن والعمدة.
ثم قدم القاهرة فقطن بالجامع الأزهر وحفظ فيه المنهاج الفرعى والأصلى وألفية النحو واشتغل بالفقه على الشمس بن النصار المقدسى ، وكذا أخذ عن الشمس البرماوى وغيره ولازم القاياتى حتى كان جل انتفاعه به ، وقرأ فى المنطق والمعانى على الشمّنى وغيره وتصدى لنفع الطلبة ، فأخذ عنه جماعة.
وحج وولى مشيخة سعيد السّعداء بعد ابن حسان ، وكان خيّرا متواضعا كثير التلاوة والعبادة ملازما للصمت مع الفضل والمشاركة فى كل فن ، مات فى ثانى شوّال سنة سبعين وثمانمائة ودفن بتربة طشتمر حمص أخضر رحمه الله تعالى وإيانا انتهى.
زاوية رزين : قرية من مديرية المنوفية بقسم سبك موضوعة على تل قديم يعرف بكوم دقيانوس بينها وبين البر الغربى نحو ألف متر فى مقابلة ناحية الأخماس بمديرية البحيرة ومساحة ذلك التل تقرب من ثلثمائة فدان وبه قطع أعمدة من الحجر الأملس وبعض آثار قديمة وبها ثلاث زوايا للصلاة وفى بحريها مقام ولي يقال له سيدى منصور ..
وقد انتقلت أهالى هذه الناحية إلى هذا الكوم سنة إحدى وثمانين ومائتين بعد الألف لتسلط البحر على البلد القديمة فصارت على الشاطئ الشرقى للبحر الغربى وفى الجنوب الغربى لناحية بهواش بنحو ثلاثة آلاف متر وفى جنوب ناحية جزىّ بنحو خمسة آلاف متر ورىّ أرضها من النعناعية وغيرها وأكثر أهلها مسلمون وتكسبهم من الزرع وغيره “.

شبشير طملاي
في الخطط التوفيقية قرية من مديرية المنوفية بمركز أشمون جريس ، ويقال لها شبشير طملاى ، واقعة بقرب الزاوية الحادثة من تقاطع بحر الفرعونية مع البحر الغربى عند مصب الفرعونية. وفى كتب الفرانساوية أنها كانت من المدن القديمة الصغيرة ، وكان فيها كنيسة باسم مارى منجمان ، وكان يسكنها مارى مارقور الأكبر.
ويقابلها فى البر الثانى لبحر الفرعونية ناحية نادر من مركز منوف ، بينها وبين منوف نحو ساعة ونصف ، وبناحية شبشير سواق على البحر ، وأهلها يتسوّقون من سوق منوف ، ورى أرضها من النيل وترعة النعناعية ، ويزرع بأرض بحر الفرعونية الدخان والمقاثئ ، وأكثر أهلها مسلمون ، ومنها علماء وأفاضل.
وفى «خلاصة الأثر» أن منها الشيخ سالم بن حسن الشبشيرى نزيل مصر ، الشافعى الحجة ، شيخ وقته وأعلم أهل عصره ، كان فى الفقه بحرا لا يجارى ، وفى بقية العلوم قدره مشهور ، أخذ الفقه عن الشمس الرملى وغيره من أكابر عصره وتكمل بالنور الزيادى ولازمه سنين عديدة ، وكان من أجلّ طلبته وممن فنى فى محبته ، وكان يطالع لجماعة الزيادى درسه ، على عادة مشايخ الأزهر أن أفضل الطلبة يطالع لطلبة الشيخ درسه مطالعة بحث وتدقيق ، حتى يأتوا إلى الشيخ وهم متهيئون لما يلقيه.
وكانت جماعة الزيادى مع ما هم عليه من العلم والفهم الثاقب ملازمين لدروسه الفرعية ، وممن لازمه منهم الشمس الشوبرى ، والنور الحلبى ، والشهاب القليوبى ، وعامر الشبراوى ، وخضر الشوبرى ، وعبد البر الأجهورى ، ومحمد البابلى ، والنور الشبراملسى ، والشيخ سلطان المزاحى ، وكان يسميه وتد درسه ويفضله على شيخه الزيادى ، ويقول : ما رأيت أفقه منه.
وكان آية من آيات الله تعالى فى استحضار مسائل الفقه وتصويرها ومعرفة الفرق والجمع بينها ، والاطلاع على النقول ، والإحاطة بالفروع والأصول ، وكان مع كونه فقيها خالصا من أكابر الأولياء ، له كرامات خارقة وأحوال باهرة.
ولم يزل منهمكا على بث العلم ونشره حتى توفى بمصر ، يوم السبت السابع والعشرين من ذى الحجة سنة تسع عشرة وألف ، وحكى البشبيشى عن شيخه الشيخ سلطان أنه توفى فى سنة ثمان عشرة وألف ، وصلى عليه بالجامع الأزهر ، وكان الإمام بالناس فى الصلاة عليه شيخه النور الزيادى ، ولم يجزع علماء مصر على أحد من العلماء مثل ما جزعوا عليه ، رحمه الله تعالى.

طملاي
جاء في الخطط التوفيقية : طملوها ويقال لها: طملاى ، قرية من قسم منوف بمديرية المنوفية ، واقعة فى منتصف الزاوية الحاصلة من تلاقى بحر الفرعونية مع بحر رشيد ، وفى شمال هذه القرية ناحية شبشير المسماة عندهم بشبشير طملاى ، وعلى نصف ساعة من قبليها ناحية (جزى) ، وفى جهتها الشرقية على نصف ساعة ناحية منوف العلا ، وأرضها منحصرة بين أرض العزب والفرعونية ، وريها من ترعة النعناعية التى فمها من الرياح، ومصبها فى بحر الفرعونية.
وفى سنة ثمان وثمانين ومائتين وألف صار امتداد النعناعية وسقوطها فى ترعة السرساوية من جهة ناحية (نادر) ، ومن طملوها (على أفندى حسنين شروده) كان مهندس قسم فى مديرية بنى سويف، وهو ممن تربى بمدرسة المهندسخانة ببولاق.
وفى الجبرتى أن (مراد بيك) ذهب إلى طملوها فى سنة ألف ومائتين ، وطالب أهلها (برسلان) و (باشا النجار) وكان كل منهما شيخ عصبة من المفسدين وقطاع الطريق ، وقال لهم : إنهم يأوون عندكم فتنكروا ذلك ، فأمر بنهب القرية فنهبت وسلبت أموال أهلها ، وسبيت نساؤهم وأولادهم ، ثم أمر بهدمها وحرقها عن آخرها ، ولم يزل ناصبا وطاقه عليها حتى أتى على آخرها هدما وحرقا ، وجرفها بالجراريف حتى محا أثرها وسواها بالأرض ، وفرق كشافه فى البلاد فى مدة إقامته عليها لجبى الأموال ، وقرر على القرى ما سوّلت له نفسه ، ومنع من الشفاعة وبث المعينين لطلب الكلف الخارجة عما يطاف ، فإذا استوفوها طلبوا حق طريقهم فإذا استوفوه طلبوا المقرر ، وهكذا فإن امتثل الناس وإلاّ أحرقوا البلد ونهبوها.
ثم ذهب إلى مدينة رشيد فقرر على أهلها جملة كبيرة من الأموال ، فهرب غالب أهلها ، وعين على الإسكندرية (صالحا أغا) كتخدا الجاوشية ، وقرر له حق طريقه خمسة آلاف ريال ، وأمر بهدم الكنائس وطلب مائة ألف ريال من أهل البلد ، فلما وصلها هربت تجارها إلى المراكب ، ولما رجع (مراد بيك) إلى ناحية (جميجمون) من قرى الغربية ، هدمها وهدم أيضا كفر دسوق وبلادا كثيرة ، وأتلف كثيرا من الزرع ، وكل ذلك بسبب (رسلان) و (باشا النجار) ، انتهى.
أخبار رسلان ، وباشا النجار : وقد أخبرنى الحاذق الماهر السيد أحمد أفندى خليل أحد رجال ديوان الأشغال برتبة بيكباشى ، نقلا عن بعض أسلافه بشئ من أخبار هذين الشيخين لمجاورة بلدته البتنون لبلدتيهما ، ولنوع مصاهرة بينه وبين الشيخ رسلان ، فقال : أما (رسلان) فهو من قرية تعرف (بتلا) من قرى المنوفية ، وكان شيخ نصف سعد ، وأما (باشا النجار) فهو من كفر السكرية من بلاد المنوفية أيضا ، وكان عمدة نصف حرام ، وكان لكل منهما عصبة ومنصر ، يقطعون الطريق ويفسدون فى الأرض ، ويحارب بعضهم بعضا ..
ولما جدّ (مراد بيك) فى طلبهما هربا واختفى كل منهما فى بيت شيخ العرب (الحفناوى جبير) عمدة نصف سعد بناحية البتنون ، وبقيا عنده سنة كاملة لا يعلم أحدهما بالآخر ، ولما حصل العفو عنهما ، صنع شيخ العرب الحفناوى وليمة عظيمة جمع فيها مشايخ العرب ، مثل (أيوب فوده) و (ابن حبيب) وغيرهما ، وحضر فيها رسلان وباشا النجار وسلم أحدهما على الآخر ، وهنؤهما بالسلامة ، وأكل الجميع على سماط واحد ، وسأل (رسلان) (باشا النجار) أين كنت هذه المدة ؟ فقال : فى بيت شيخ العرب الحفناوى ، فقال الآخر : وأنا كذلك ، فتعجب الحاضرون من حسن تدبير شيخ العرب الحفناوى ، ولما مات رسلان ترك ذرية اشتهر منهم ابنه (أبو العمائم) ، ثم مات أبو العمائم وترك ابنه رسلان وهو الآن مأمور ضبطية مديرية المنوفية وكان قبل ذلك ناظر قسم ، انتهى.



