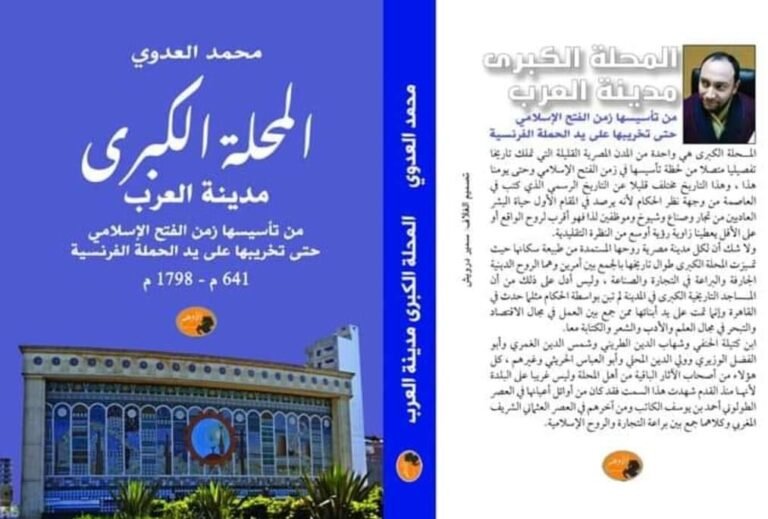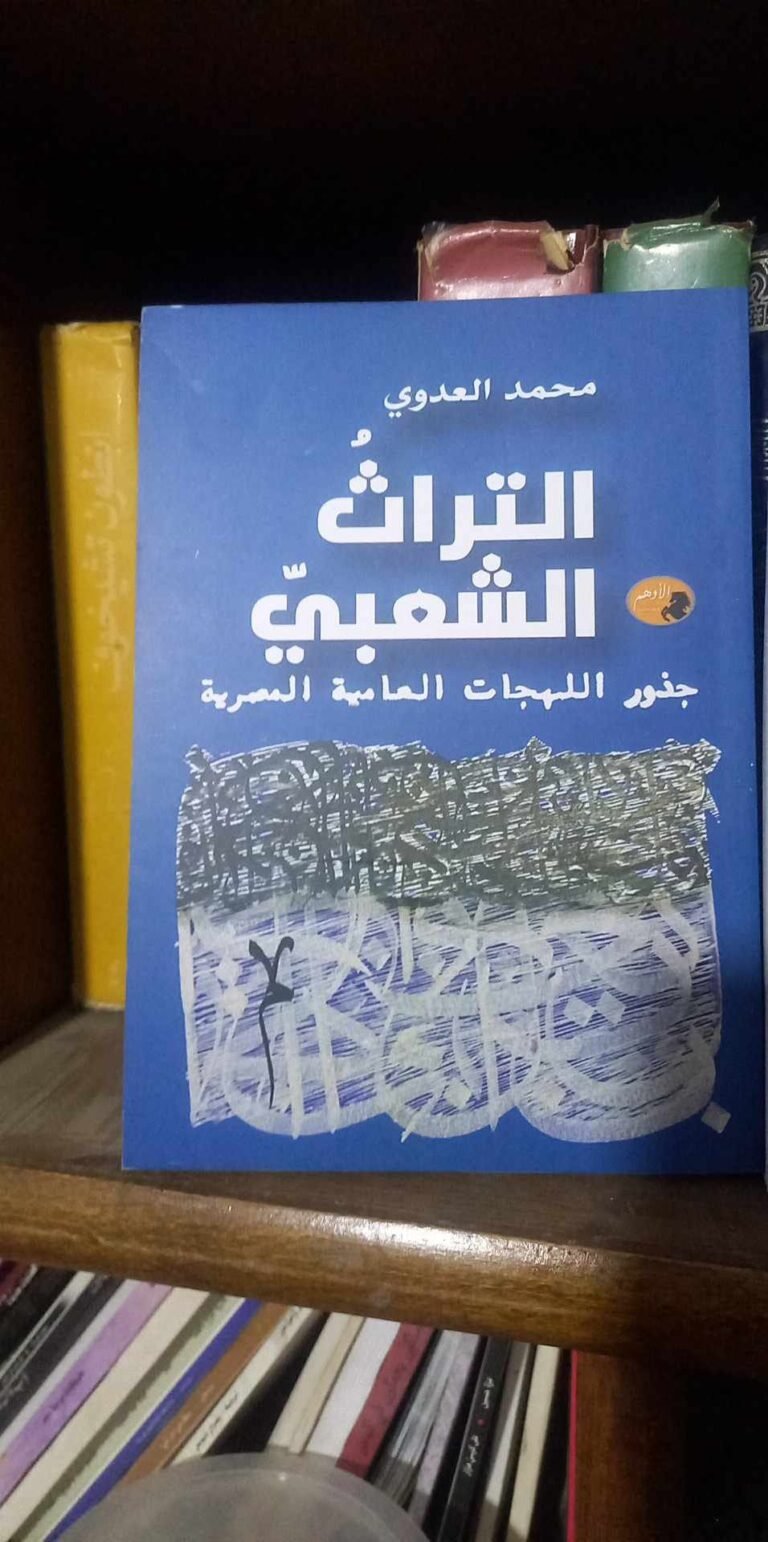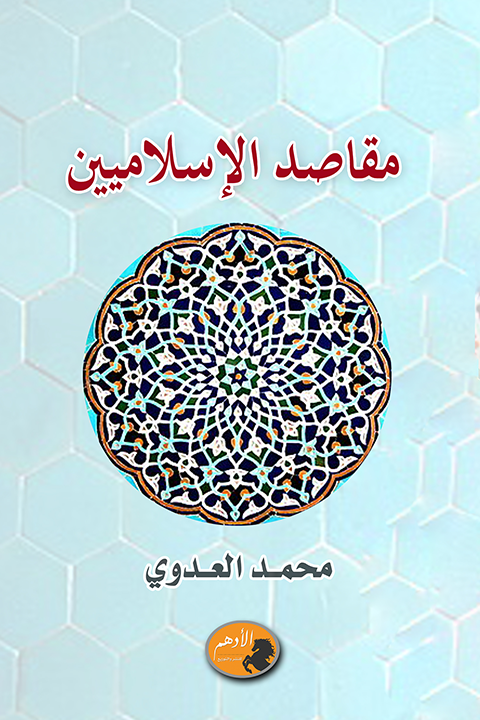
تجديد الفكر الإسلامي .. نظرية أم تطبيق
الكلام حول تجديد الخطاب الديني سهل جدا ويحسنه كل الناس حيث المجال مفتوح لكل من هب ودب أن يطرح ما يشاء من أفكار مهما بدت غريبة أو تافهة أو سطحية أو دعائية ، لكن من رحمة الله بنا أن أكثرهم يكتفي بالكلام ولا يستطيع تحويل هذه الأفكار إلى واقع عملي لأن التغيير الحقيقي على أرض الواقع يتطلب جهد أولي العزم من الرجال .. وفي سبيل الوصول إلى ذلك لا بد من إدراك النقاط التالية :
أولا / لا يمكن أن يكون التجديد المنشود للإسلام عبارة عن أبحاث نظرية أو كتب ثقافية أو برامج في الإعلام ووسائل التواصل وإلا صار كلاما في الهواء وإنما التجديد الحقيقي يتمثل في تبني أفكار التجديد بواسطة طليعة قيادية مفكرة قادرة على إنشاء تجمع بشري منظم تتمثل فيه هذه الأفكار بصورة عملية.
ثانيا / التجديد المنشود يجب أن يكون مختلفا كليا وجزئيا ظاهرا وباطنا عن كل التيارات الإسلامية السائدة وذلك في أصول الدين أولا ثم نظرتها في مجالات الإصلاح والدعوة والتربية والسياسة لأن جميع هذه التيارات هي محض اجتهادات في أزمنة سابقة وأحدث جماعة فيها عمرها يكاد يقترب من مائة عام.
ثالثا / لا بد لتيار التجديد الإسلامي من امتلاك رؤية شاملة في كل ما يتعلق بالعلاقة بين الدين والحياة في الزمن الحاضر وأن يكون قادرا على تلبية احتياجات المسلمين فيما يخص مستجدات العصر ومتطلبات الحداثة وهو ما يعني أننا بحاجة إلى (فلسفة إسلامية متكاملة جديدة) وليس مجرد فتاوى فقهية تعالج بعض الجزئيات.
رابعا / لنجاح تيار التجديد الإسلامي يجب عليه أن يمتلك رؤية تفصيلية للإصلاح في المجتمعات وأن تكون هذه الرؤية قابلة للتطبيق العملي بسهولة ويسر وأن تظهر آثارها الإصلاحية على الفرد والأسرة بشكل سريع وفعال في المجالات الإيمانية والأخلاقية والتشريعية في ظل ثقافة التسامح والتعايش المشترك وقبول الآخر.
خامسا / نجاح مهمة التجديد يحتاج إلى فهم طبيعة المجتمع ودراسة أحوال الناس وما يؤثر عليها من مؤثرات ثقافية متنوعة خاصة المجتمع المصري الذي لا يمكن اعتباره مجتمعا واحدا وإنما هو في الحقيقة عدد كبير من (المجتمعات الصغيرة) المتباينة والمتصلة في نفس الوقت ولكل منها طبيعته الخاصة وصفاته المميزة.
سادسا / أهم نقطة على الإطلاق أن يهدف تيار التجديد للبناء وأن ينشغل بالعمل ولا يلتفت لسهام النقد أو يشغل نفسه بالرد على المهاترات فيدخل في صراعات جانبية غير ذات جدوى مع غيره من الإسلاميين الذين يفزعون من فكرة التجديد أو مع فئات المتثاقفين الذين يعيشون على نقد سلبيات التيارات الإسلامية القديمة.
وبعد كل ذلك فالأمر ليس سهلا والطريق ليس ممهدا لكن النظرة الواعية المتفحصة توحي بحاجة المجتمع إلى التجديد بل وتبشر بقبوله في الأجيال الصاعدة ، ولا نتجاوز حين نقول إن صحوة إسلامية تجديدية توشك على الظهور في العقود القادمة لكن لا أحد يعرف متى تنطلق .. ” ويقولون متى هو .. قل عسى أن يكون قريبا “.
وقد وصلنا لمرحلة يمكنك فيها انتقاد الذات الإلهية وأشخاص الأنبياء لكنك لا تستطيع انتقاد رئيس الجمهورية أو المؤسسة العسكرية وكأن الدين صار (الحيطة المايلة) وظهر قوم يريدون تجديد الدين على طريقة قبيلة ثقيف عندما اشترطوا على النبي (ص) خمسة شروط ليدخلوا في الإسلام أولها أن يبيح لهم الخمر لأنهم لا يطيقون فراقها وثانيا أن يسمح لهم بالزنا لأن أسفارهم كثيرة وثالثا ألا يحرم عليهم الربا لأن تجارتهم قائمة عليه ورابعا أن يضع عنهم الصلاة لمشقتها عليهم وخامسا أن يترك لهم صنمهم اللات لارتباط أفراد القبيلة الشديد به وظلوا أياما كثيرة يجادلون النبي في ذلك رغم أنهم كانوا آخر القبائل إسلاما.
وهؤلاء لا يعجبهم الإخوان بسبب برنامجهم السياسي وشعاراتهم متناسين أن الإخوان وصلوا للرئاسة والبرلمان بانتخابات حرة وليس بالقوة ولا يعجبهم السلفيون لأنهم متشددون رغم أن السلفيين يعيشون في أحضان النظام ولا يعجبهم الأزهر بزعم الرجعية وهو أمر مخالف للدستور المستفتى عليه والذي جعل للأزهر مركزا قانونيا واضحا ولا يعجبهم الطرق الصوفية لأنها دروشة وخرافة رغم أن الصوفية في المجال العام (لا بتهش ولا بتنش) ولا يعجبهم الدعاة الجدد من الشباب بحجة أنهم يتاجرون بالدين في الإعلام ولا يعجبهم الأئمة المستقلون من علماء الأمة من أمثال الشعراوي والغزالي والقرضاوي .. فمن إذن ؟؟
تجديد الدين لن يكون على يد العلمانيين والملحدين وإنما هو أمر منوط بعلماء الأمة الثقات من المتخصصين في علوم الإسلام المختلفة جنبا إلى جنب مع أصحاب الفكر والنظر والاطلاع والدراسة ممن لهم قدرة على الرصد والتحليل وكذلك أبناء التيار الإسلامي من أهل التجربة الميدانية والجهد الدعوي لأن التجديد لا يعني بأي حال من الأحوال إخراج الدين من المجال العام السياسي والاجتماعي وإلا فقد الدين مضمونه الإصلاحي وإنما التجديد هو إعادة لفتح باب الاجتهاد لصناعة (بنية فكرية متكاملة) تترجم إلى برامج إصلاحية قابلة للتنفيذ بما يحقق أهداف الدين الأساسية في الإصلاح والهداية والتزكية والتقويم.
والتجديد المنشود للفكر الإسلامي ليس نابعا من روح انهزامية أمام تيار التغريب الثقافي وليس ردة فعل على نكبات الحركات الإسلامية وإخفاقها في الوصول للحكم وليس استجابة لدعوات الخطاب الديني الانبطاحية وليس محاولة تلفيق بين تعاليم الإسلام وأي قيم مغايرة له وليس إيثارا للسلامة تحت ضغط الظروف الحالية وليس تغييرا لمجرد التغيير ومخالفة ما هو سائد .. لكن السبب الحقيقي هو وجود حاجة فعلية للتجديد بغض النظر عن كل ما سبق وهذا الأمر ليس جديدا وإنما التفت له المخلصون منذ عقود حيث دقوا ناقوس الخطر لكن لم يسمع لصوتهم بسبب علو صوت التيارات الإسلامية التقليدية والتي كانت في قمة عنفوانها في زمن الصحوة.
ويطيب لي في هذا الصدد أن أكتب كلمات في الوسطية الإسلامية ومعانيها .. هذا المصطلح الذي لاكته الألسن بالسخرية والاستهزاء من بعض الإسلاميين وبعض العلمانيين حيث تكررت لديهم كلمات من قبيل (الإسلام الوسطي الجميل) أو (المسلم الوسطي الكيوت) في محاولة لفرض رؤيتهم (التي هي أقلية من الطرفين) على الجمهور الكبير من المسلمين ..
والحقيقة أن مذهب التوسط قديم في الفكر الإسلامي ويعني أنه في موضع بين المعتزلة والظاهرية أي بين العقل والنقل وله ضوابط محددة وأصول معروفة .. وهو مرتبط في الفقه بمذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان (إمام أهل الرأي) ومرتبط في العقيدة بمذهب أبي منصور محمد الماتريدي (إمام الهدى) والإمام أبي الحسن الأشعري (إمام أهل السنة والجماعة) ..
والمذهب الماتريدي يميل إلى العقل وهو المنتشر في عالمنا المعاصر حيث الماتريدية في كل من شبه القارة الهندية وآسيا الوسطى وتركيا وروسيا والقوقاز والبلقان وجزء من جنوب شرق آسيا و ويمثل ذلك ما يقارب 60 % من المسلمين في العالم .. أما المذهب الأشعري فهو يميل إلى النص وينتشر في الوطن العربي وأفريقيا ويمثل 25 % من المسلمين في العالم ..
والمذهب الماتريدي مرتبط بالتصوف البعيد عن الخرافة والمتقيد بالكتاب والسنة وينتمي له كل شخصيات الحضارة الإسلامية الذين نفخر بهم في كل المحافل بسبب قدرته على استيعاب الفلسفة والعلوم وهو المذهب الذي تمكن من التعايش أكثر من ألف عام مع الأديان الأخرى في المشرق (البوذية والهندوسية وغيرها) ولم يشهد عبر تاريخه ظهور أي حركات متشددة أو عنيفة وهو القادر أيضا في الزمن المعاصر على استيعاب المتغيرات الثقافية والعلمية ..
وهذا المذهب غائب عن الوطن العربي الذي لم يعرف الكثيرون فيه إلا المدرسة الظاهرية ويظنها هي وحدها الإسلام متغافلا عن مذهب أغلبية المسلمين فلا يصدق أن هناك مذهبا مخالفا له حيث يرى الماتريدية أن الإيمان شأن قلبي وأنه لا يلزم إعلانه باللسان وأنه لا علاقة بين الايمان والعمل وأن الايمان لا يزيد ولا ينقص وأن معرفة الله واجبة بالعقل وأن الأشياء لها حسن ذاتي وأنه يفتح باب التأويل في نصوص القرآن ويرد أحاديث الآحاد ..
ومذهب الماتريدي قريب في العقائد من مذهب الأزهر الشريف (الأشاعرة) لكنه يختلف عنه في الفقه مع الوضع في الاعتبار أن الأزهر يدرس جميع المذاهب العقدية والفقهية لأنه قلعة الوسطية في العصر الحديث .. ومذهب التوسط ليس قرين التساهل ولا الميوعة كما يردد بعض الجهلاء ولكنه يحمل منهج التيسير في الفقه والتزكية في الخلق وذلك بالموازنة بين العقل والنقل والفهم المقاصدي للنصوص الشرعية ..
وهذا المذهب بالطبع لا يعجب كارهي الإسلام الذين يتعيشون على النماذج المشوهة من الدين فهو سيبطل حجتهم بقدرته على التسامح مع المختلفين في الدين والمذهب والرأي وكذلك قدرته على التعايش وتجديد روح الإسلام في العقائد والعبادات والشرائع والأخلاق مع الإيمان بحق البشر في مواجهة الظلم والدفاع عن الحقوق ..
ومنذ انطلقت الدعوات لتجديد الخطاب الديني وحتى الآن لم تتضح معالم هذا التجديد فضلا عن معرفة النوايا الحقيقة للمطالبين به والتي تظهر عرضا من بين السطور .. ولذلك أرى أنه من حقي أن أسأل مجموعة من الأسئلة المشروعة حول هذا الأمر لمحاولة تبين الأمور وفهم الأفكار :
هل ينطلق هذا التجديد من الإيمان بوجود الله وفق العقيدة الإسلامية أم أن أرضية الانطلاق علمانية محضة يستوي عندها الإيمان به من عدمه ؟
هل ينطلق هذا التجديد من الإيمان بالوحي الإلهي ونبوة محمد (ص) أم سيكون من نتيجة التجديد النهائية اعتباره شخصية تاريخية عظيمة مثل مؤسسي الدول فقط ؟
هل يشمل التجديد الإيمان بالغيب والآخرة وفق ما جاءت في نصوص القرآن أو ستكون نتيجة التجديد متمثلة في إنتاج دين دنيوي مثل المذاهب الوضعية ؟
هل المقصود من التجديد هو إحياء الإسلام في قلوب الناس وهدايتهم له أم أن الغرض هو إضعافه وصرف الناس عنه تحت مسمى التجديد ؟
هل سيتم التعامل مع النص القرآني بالتأويل وفق الضوابط الشرعية لمزيد من الفهم والاستيعاب أم أن الغرض النهائي هو تعطيل النص تعطيلا مطلقا ؟
هل التجديد المنشود يشمل دراسة السنة النبوية بشكل منهجي للاستفادة منها أم سينتهي الأمر بالطعن فيها وإنكار حجيتها في التكاليف والتشريعات ؟
هل يسعى التجديد المنشود لبث الإيجابية في صفوف المتدينيين للمشاركة الفاعلة في الحياة العامة أم يسعى لتكريس الانزواء والدروشة وترك الدنيا لأهلها ؟
هل سيتم التعامل بموضوعية عند دراسة السيرة النبوية والتاريخ الإسلامي أم سيكون المسيطر هو الهجوم والتشنيع والقراءة الانتقائية للسلبيات دون الإيجابيات ؟
هل سيؤدي التجديد إلى خلع الدين من حياة الناس واقتصاره على المناسك التعبدية أم هناك اجتهاد فقهي جديد يضمنه في الأخلاق والتشريعات وقيم المجتمع ؟
هل سيؤدي التجديد إلى تكريس أخلاقيات النفاق والسكوت عن الطغيان والاستبداد أم الغرض منه الدعوة لإحقاق الحق ودفع الظلم وإقامة العدل ؟
هل سيؤدي التجديد إلى الانهزامية والتخلي عن القضية الفلسطينية وغيرها من قضايا المسلمين أم سيؤدي إلى مزيد من التمسك بها والدفاع عنها ؟
هل الهدف من التجديد هو التعايش بين القيم الدينية وقيم الحداثة أم أن المطلوب هو التغريب الكامل والتبعية الاقتصادية المطلقة والاستسلام التام للغرب ؟
هل سيؤدي التجديد إلى الحرية السياسية والاستقلال الاقتصادي أم سيؤدي إلى الاكتفاء بالحرية الجنسية والترويج للسفور والشذوذ والإباحية والزنا ؟
هل يسعى التجديد المنشود لغرس قيم التسامح والتعايش المشترك ونبذ العنف أم تكون مهمته هي إثارة المشكلات الفرعية والشحن الطائفي والقضايا الخلافية ؟
هل يهدف التجديد لدعم وإصلاح المؤسسات الدينية ذات التأثير العالمي مثل الأزهر أم يسعى لتفكيك هذه المؤسسات وتدجينها بحجة الرجعية والجمود ؟
هل يهدف التجديد لتهذيب الحركات الإسلامية ودفعها نحو الوسطية والاعتدال والسلمية والعقلانية أم الهدف الحقيقي هو القضاء عليها وإخماد صوتها للأبد ؟
أعتقد أن الإجابة عن هذه الأسئلة المشروعة سوف تكون الخطوة الأولى في رسم ملامح التجديد المنشود للخطاب الديني إذا كانت النية حسنة ومعرفة الدوافع الخفية وراء الإلحاح عليه إذا كانت النية سيئة .. وإن غدا لناظره قريب.

أدبيات الحركة الإسلامية
كل العاملين في الحقل الإسلامي يعرفون بالطبع كتاب (الدعوة الإسلامية فريضة شرعية وضرورة بشرية) والذي كان متداولا بين منتسبي الحركات الإسلامية لدى التحاقهم بالعمل الدعوي لأنه يتحدث عن شروط الجماعة الواجب الالتحاق بها وهو من تأليف الشهيد عبد الله عزام لكنه استعمل اسما مستعارا وهو (صادق أمين) ، والكتاب جيد ولا شك لأنه يستعرض كافة الجماعات العاملة للإسلام حتى يصل إلى جماعة الإخوان التي يعتبرها الجماعة المثالية الخالية من السلبيات بينما يركز على قصور الأداء عند الصوفية والسلفية والتبليغ لكنه في الحقيقة كان يهدف لشن هجوم شرس على كيان إسلامي ناشيء هو (حزب التحرير الإسلامي) لأنه أفرد له فصلا كاملا عكس كل الجماعات السابقة.
وحزب التحرير لم يدع أنه جماعة دعوية وإنما كيان سياسي يسعى للتغيير عن طريق التثقيف الفكري والمشاركة السياسية وتحريك المجتمع وإزالة الأنظمة العميلة وأفكاره في مجملها رجعية جدا وساذجة للغاية لكنه وضع تفاصيل لكيفية إقامة حكم إسلامي من دستور وقوانين وخلافه لأول مرة في تاريخ الحركات الإسلامية ، وكانت أبرز نقاط الهجوم على الحزب هو سماحه للنساء وغير المسلمين بالترشح لعضوية المجالس الشورية إلى جانب نقد الأصول العقائدية والفقهية التي يستمد منها الحزب أفكاره خاصة فيما يتعلق بالموقف من الحكام والمشاركة في العملية السياسية في الدول العلمانية.
ورغم أن الرؤية السياسية قد تختلف من شخص لآخر ومن جماعة لأخرى ومن زمن لآخر (وهو ما حدث مع الإخوان أنفسهم بتغير المواقف السياسية على مدار سنوات وهو الأمر الطبيعي) إلا أن الكتاب اعتبر حزب التحرير خارجا عن المنهج الصحيح حيث يختتم الفصل الخاص به بقول الكاتب : ” فإلى الله المشتكى مما يقوله حزب التحرير وغيره ممن هو مثله ويسير على طريقه ولا حول ولا قوة إلا بالله وحسبنا الله ونعم الوكيل “.
وكل الإسلاميين يعرفون كتاب (المتساقطون على طريق الدعوة) لمؤلفه الأستاذ فتحي يكن الأمين العام للجماعة الإسلامية في لبنان وهو كتاب متمم لكتابه الأول (أبجديات التصور الحركي) حيث سعى في الكتابين لتكريس فكرة أحادية العمل الإسلامي (أي وجود جماعة واحدة تعمل للإسلام) وازدراء أي اجتهاد آخر داخل الصف أو خارجه.
ولغة الكتابين حادة جدا في نقد أي محاولة للاجتهاد وجعل مفارقة الجماعة العاملة بمثابة تساقط ونكوص حيث اتهام كل من يفعل ذلك بأنه ضعيف الإيمان أو له تطلعات شخصية أو شغلته الدنيا عن الدين أو تسللت الشبهات إلى قلبه فلم يقبل عذر أحد ولا احتمالية وجود اجتهاد مخالف مقبول بل رفض رفضا قاطعا أي محاولة لتأسيس أي كيان آخر للعمل للإسلام وعدد في ذلك الأمثلة حتى يظن القارىء أنه لا أحد يثبت على دعوته مكرسا للعبارة التقليدية (الدعوة تنفي خبثها).
والكتاب لا يعني بالمتساقطين هؤلاء الذين يتكاسلون أو تشغلهم الدنيا من عوام المنتسبين للحركة الإسلامية ولكنه يقصد كل من بدر منه اجتهاد ما دعوي أو سياسي خاصة من قادة العمل الإسلامي ويكون مخالفا لما عليه توجه الجماعة وذلك خوفا من حدوث انشقاقات أو فتن داخلية حيث جعل التساقط مرادفا للردة المعنوية وكأن المخالف صار مرتدا ، والمؤلف كاتب مثقف موسوعي لا شك وظل زمنا طويلا من قيادات الحركة الإسلامية العالمية وكلمته مسموعة ورأيه نافذ حتى حدث خلاف سياسي في لبنان حيث تبنى المؤلف موقفا وطنيا بمناصرة حزب الله في حربه ضد إسرائيل وهو ما كان مخالفا لما عليه جمهور الإسلاميين السنة في لبنان فخرج من الجماعة وأسس (جبهة العمل الإسلامي).
ولو طبقنا المعايير التي وضعها في كتابه على ما حدث له فإنه بذلك يكون من كبار المتساقطين على طريق الدعوة وهو ما لا يجوز بحق قامة كبيرة مثله فلا يرضاها أحد له أو لغيره وإنما من الأوفق أن نؤمن جميعا بمبدأ (تعدد الصواب).
ومن أهم الكتب التي رصدت معالم الحركة الإسلامية في العصر الحديث كتاب (المسار) لمؤلفه عبد المنعم صالح العلي المعروف باسم مستعار هو محمد أحمد الراشد وهو أكبر كتبه وأهمها على الإطلاق لكنه لم يلق شهرة كتبه الأخرى مثل (المنطلق) أو (العوائق) حيث رصد في هذا الكتاب أهم عوامل نجاح الحركات الإسلامية أو فشلها من خلال التشريح الدقيق للمهام الدعوية والسياسية والاجتماعية والتربوية.
في هذا الكتاب فصل كامل بعنوان (عوامل الجدية الجماعية) والذي يناقش مسألة شديدة الأهمية وهي قابلية أفراد الدعوة لتطويع نمط حياتهم ليتوافق مع متطلبات العمل الدعوي واحتياجات المجتمع وكيفية ضبط أولويات العمل وضرب مثالين على ذلك تحت عنوان (تلهي الدعاة) .. أحدهما كان متعلقا بإصرار الدعاة في بلد ما على أن يتم تنظيمهم وفق المهنة (الأطباء مع بعضهم والمهندسون سويا وكذلك الطلاب وهكذا … إلخ) ورفضهم الشديد للانتظام على هيئة وحدات جغرافية تجمع كل وحدة جميع من يسكن في نطاقها وكان من نتيجة ذلك حدوث ازدواج تنظيمي أضعف العمل سنوات طويلة.
المثال الثاني كان متعلقا بدولة أخرى حيث اعتادت الحركة الإسلامية فيها إرسال مبعوثين من أبنائها إلى أوروبا للدراسات العليا حتى يعودوا فيشكلوا قوة دعوية في بلادهم لكن عندما يسافرون ويلتقون إخوانهم ممن سبقوهم هناك تسري بينهم قناعة أن العمل الدعوي في أوروبا لا يقل أهمية عن بلادهم فيتجه المبتعثون إلى الاستقرار في المهجر بناء على هذه القناعة خاصة إذا كان هناك عمل دعوي منظم يستوعب الطاقات وهو ما أضر بالعمل الدعوي في بلادهم الأصلية ضررا بليغا.
وقد حدث مثل ذلك في دولة أخرى كانت في أمس الحاجة إلى طاقات كل أبناء الدعوة في وقت الحرية النسبية للعمل الدعوي لكن مع ضغط الظروف الاقتصادية كان يقوم أبناؤها بالسفر لدول الخليج بضعة أعوام حتى تتحسن أحوالهم المادية ثم يعودون لكنهم في الحقيقة إذا سافروا لا يعودوا حيث تسري قناعة أن الدعوة هنا مثل الدعوة هناك خاصة مع وجود كيان يستوعب الطاقات ويكثر من النشاطات حتى صار المغتربون من أبناء الدعوة بالآلاف في البلد الواحد ويظنون واهمين أنهم يقومون بدور دعوي فقط لإرضاء ضمائرهم بينما هم في الحقيقة لا يفعلون أكثر من (الخروج للبر وأكل الكبسة) !!
ومن أهم الكتب المنظرة للحركة الإسلامية المعالم والمنطلق وأقصد أفكار كتاب معالم في الطريق للأستاذ سيد قطب وكذلك كتاب المنطلق للأستاذ الراشد الذي يعد شرحا وافيا وبليغا لأفكار القطبيين .. وقد عشت بضع سنين وأنا أضع هذه الافكار في مصاف النظريات القيمة حتى كان عام 2009 م. عندما بدأت أدرس علم أصول العقيدة وأصول الفقه والمذاهب الاسلامية على أيدي المتخصصين من علماء الازهر ، وعندها اكتشفت تدريجيا أن هناك من يقوم بجريمة بشعة ألا وهي زرع هذه الأفكار الشاذة والغريبة في عقول الناشئة والشباب.
لقد كان سيد قطب مفكرا كبيرا وأديبا حالما لكنه لم يكن يوما من العلماء أو الفقهاء أوالمشتغلين بقواعد الاستدلال وانما استقى رؤيته من شجون عاطفية وحماسة أدبية وظروف سجن أخذت طابع الملاحم والقصص ونحسبه من الشهداء الأبرار ، لكن الحقيقة أن آراءه جميعا خلت من كل قواعد الاستدلال المنهجية التي استقر عليها العلماء المقلدون والمجددون على السواء ولم تكن تصلح للتطبيق في زمنه فمن باب أولى عدم صلاحيتها لذلك بعد نصف قرن من ظروف كتابتها.
إلى جانب ملاحظة هامة وهي أن سيد قطب كان ضعيفا للغاية في السيرة النبوية لدرجة جعلتني أراجع كل كتب السيرة المعروفة وكتب الحديث الكبرى لأكتشف أنه يبدع بعض الآراء من قريحته ويخلص إلى استنتاجات لا يصح استخلاصها من واقع جزيرة العرب المعروف لكل دارسي التاريخ كما أنه متأثر بشكل كبير في كتابه (في ظلال القرآن) بنظرية وحدة الوجود (برجاء النظر إلى تفسير سورة الإخلاص وغيرها).
لقد أبدع مجموعة من المصطلحات التي صارت أدبيات مقدسة لدى الحركة الاسلامية الآن مثل (العزلة الشعورية) ، (استعلاء الإيمان) ، (جاهلية المجتمع) ، (الطلائع الموفقة) ، (مفاصلة المجتمع) ، كما لعب دورا حيويا مع المودودي في صياغة مفهوم (الحاكمية) الذي هو لب أفكار الكثير من الإسلاميين.
كما فتحت أفكاره الباب على مصراعيه لمنظري (التكفير) مما مهد الطريق أمام قليلي العلم والفقه لاستحلال قتل ومحاربة المسلمين باعتبارهم كفارا وهو ينافي ما هو معلوم من الدين بالضرورة .. وأخيرا فإن سيد قطب بالنسبة لي هو فقط جزء من التاريخ الفكري للإسلام مثله مثل حسن البنا والشيخ محمد بن عبد الوهاب والشوكاني والشاطبي وحجة الاسلام الغزالي وابن تيمية والأشعري وغيرهم .. أدرس أفكارهم بعناية وأستفيد منها وأتعلم من سيرتهم النضالية وقصة كفاحهم لكن لم يعد من المقبول بأي حال من الأحوال أن يكون واقعنا الحاضر مجالا لتطبيق أي من هذه الأفكار بصورة عملية ، وإنما واجبنا جميعا أن نسعى لتجديد الإسلام كما سعوا هم في أزمانهم خاصة ونحن نعيش في القرن الخامس عشر الهجري الذي أوشك ثلثه على الانقضاء ولا يزال بعضنا يريد أن يعيش في القرون الماضية ..
هناك فارق كبير بين التذوق الأدبي الذي يصنع استحسانا لفكرة أو استهجانا لرأي ويقف عند مستوى التفكير والشعور وبين أن يتحول ذلك إلى مذهب وعقيدة تبنى عليها آراء شرعية واجتهادات فقهية تتحول إلى سلوكيات عملية قد تصل إلى إزهاق الأرواح .. ورأي سيد قطب في الجهاد يتفق مع المذهب القائل بوجوب (جهاد الطلب) أي أننا مأمورون بقتال الناس حتى يسلموا ، وهو مذهب قديم حدث حوله جدل في تفسير معنى الجهاد وهل يكون بالقتال بالسيف أم يشتمل على جهاد الدعوة وجهاد القدوة وجهاد التعليم.
وسبب ذلك في تاريخ الفقه يعود عند الكثيرين إلى الخلط بين وسائل الدعوة إلى الله (التي هي فرض وغرضها البلاغ) وبين وسائل حماية الدعوة (والتي تعني حماية أرواح الدعاة وضمان سلامتهم وانسياب البلاغ للناس) ، ووسائل الحماية تلك (ومنها القتال) موقوتة عند علماء الأصول بظروف محددة وشروط مؤقتة ، كما أن مسألة وصف أي مجتمع بالجاهلية هي مسألة نسبية طالما تعددت المذاهب.
والمتمعن في التاريخ يكاد يقرر أن العصر الحالي من أفضل عصور المسلمين وأقلها في ظلم الحكام وابتداعهم وسفكهم للدماء وذلك بسبب القيم الإنسانية الحضارية مثل إلغاء الرق وتداول السلطة والحرية الفردية وغيرها مما كان المسلمون محرومين منه قرونا طويلة (عصرالمماليك ثم الملوك الدراويش العثمانيين والتيموريين) ، لكننا للأسف نقرأ من التاريخ ما يدعم قناعاتنا المسبقة وليس ما يصل بنا إلى الحقائق وهذه إحدى مشكلاتنا الكبرى.
وأنا من الذين يفرقون بين الجهاد والقتال ، الجهاد اسم جامع لكل جهد لخدمة الدين ، أما القتال فهو إحدى وسائل حماية الدعوة الاسلامية (وأعني بها حماية ارواح الدعاة من كل ما يهدد وصول رسالتهم الى الناس) ، وما دام لم يحل حائل بين الداعي والمدعو فلا حاجة البتة للقتال ، المشكلة الحقيقية عندما يختار المسلمون أكثر مذاهب دينهم تشددا وانغلاقا ويتبنى بعضهم فرضه على الآخرين فيحدث رفض لهذه الأفكار ويظن بعض الإسلاميين أنه رفض للدين ذاته (وهو مخطئ) ويرى أن الحل الوحيد هو فرض رأيه بالقوة.
لقد كانت الفتوحات في صدر الاسلام أمرا لازما لهذه الحماية بدليل أن كل قادة الجند كانوا يوصون بترك العباد في صوامعهم والرهبان في أديرتهم وهم على غير الاسلام (ومنهم اليهود والنصارى والصابئة بعقائدهم الحالية) ولم يرغمهم على الإسلام رغم أنهم أولى الناس بالقتال لو كان الهدف منه هو تغيير العقائد .. أما رد العدوان فهو ليس من جهاد الطلب المقصود ، وإذا كان القتال جائزا لصد المعتدي المسلم فمن باب أولى هو جائز لصد المعتدي غير المسلم.
لكن الأستاذ سيد قطب يرى في القتال الدفاعي نوعا من الانهزامية والاستسلام للغزو الفكري ويرى في أتباع المذاهب الأخرى الذين يدعون الى العقلانية والتسامح أنهم مجموعة من المفرطين في ثوابت الدين ويحتاجون إلى مراجعة إيمانهم ، وأضعف الإيمان أن نقول عمن تبعه أنه اجتهد في حدود المكان والزمان المحيطين به وأخطأ في الاجتهاد ، ولا يجوز تبرير هذا الخطأ أو تعميم التجارب الماضوية لأن المنهجية الفقهية والأصولية التي يتبعها بعضهم هي منهجية شديدة القدم ومعقدة ولا تصلح يقينا لزمننا .. الحقيقة أنني أرى كثيرا من أنصار الاسلام وكأنهم خارجون للتو من كهف عميق.