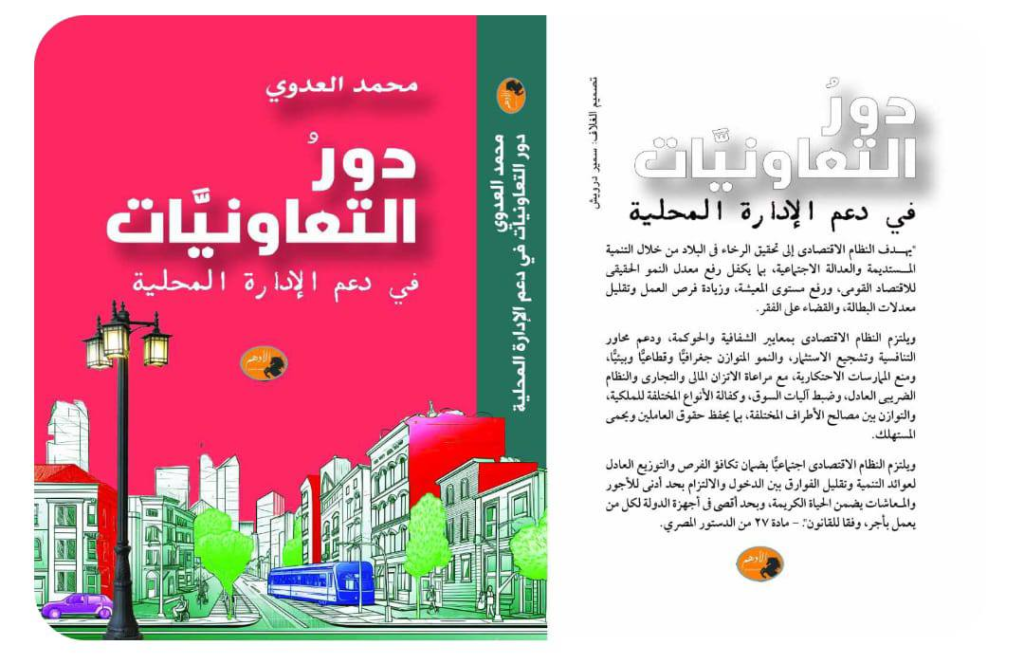
التعاونيات والإدارة المحلية
في عام 2008 م. اقترح علي بعض الأصدقاء والمعارف الترشح في انتخابات المحليات على مستوى محافظة الغربية ، وكانت وجهة نظرهم أن النجاح ممكن بسبب اتساع دائرة تواجدي في ثلاث من مراكز المحافظة لأنني وقتها كنت أعمل في كفر الزيات وأسكن في طنطا وأنا في الأصل من المحلة الكبرى مولدا ونشأة ، وكانت حجة الترشح هو السعي لوجود ممثل في المجلس قادم من القطاع الأهلي وفي نفس الوقت له إلمام بقضايا الصحة والتعليم في البيئة المحلية.
وقد اعتذرت وقتها عن المشاركة لسبب هام وهو أن القدرة على النجاح في الانتخابات لا تكفي وحدها للنجاح في المهمة بل يجب أن توجد رؤية متكاملة عند المرشح قبل كل شيء خاصة وأن هناك اختلافا كبيرا بين مجال العمل التطوعي والاجتماعي الذي يسير بوتيرة هادئة وسلسة وبين عمل المجالس الشعبية المحلية التي تشتبك بحكم الواقع مع مشكلات كبرى وتعقيدات روتينية فضلا عن مناخ الاحتقان السياسي وقتها والذي تسبب في تأجيل الانتخابات لمدة عامين.
والحقيقة أن المجالس الشعبية المحلية لم تكن تملك صلاحيات كبيرة وإنما يقتصر دورها على مراقبة عمل الإدارة المحلية (المحافظ ورؤساء المدن والأحياء والقرى) وتتحول اجتماعاتهم إلى مكلمة كبيرة ، ومنذ عام 2011 م. وحتى ساعة كتابة هذه السطور في عام 2024 م. لا يوجد في مصر مجالس محلية ولم تتم أي انتخابات لها ، وفي النظم الديموقراطية تلعب البلديات المنتخبة دورا كبيرا في إدارة المدن والمقاطعات وتسهم بفاعلية في إدارة التنمية المستدامة.
بالطبع نتمنى أن نصل إلى هذه الصورة المثالية وهي انتخاب المحافظين ورؤساء المدن لكن ما لا يدرك كله لا يترك جله كما يقول المثل العربي ، ولذا تساءلت دوما كيف يمكن للقطاع الأهلي أن يكون داعما للإدارة المحلية بوضعها الحالي خاصة مع الأزمات الاقتصادية المتصاعدة لاسيما وهناك إسهام كبير من الجمعيات الخيرية في تأسيس المدارس والمستشفيات ودور الرعاية الاجتماعية لكن يمكن تطوير هذا الأداء بالتنسيق مع الإدارة المحلية لتلبية حاجة المجتمع المحلي.
وقد يتعجب البعض من دعوتنا إلى قيام القطاع الأهلي بوظيفة هي من صلب عمل الجهاز الحكومي للدولة لكن هذا هو الواقع حيث تعجز الموازنة العامة للدولة عن توفير الاعتمادات اللازمة لقطاعات الخدمات العامة خاصة ما يتعلق بالثروة البشرية (الصحة والتعليم ومحو الأمية والرعاية الاجتماعية والثقافة الجماهيرية ورعاية الشباب والتوعية الدينية والتأهيل لسوق العمل وضمان التأمينات والمعاشات) وهو ما يستلزم معاونة جادة من القطاع الأهلي لسد هذا العجز.
وليس من المعقول أن يتم ذلك من خلال الموارد التقليدية للجمعيات التي تقوم على المنح والتبرعات وإنما كانت فكرتنا أن تتأسس جمعيات تعاونية تتبناها الإدارة المحلية وتدعم عملها وتوجهها إلى سد الثغرات في المجتمع المحلي وتلبية احتياجاته فتكمل بذلك عمل الحكومة من خلال خطة تنمية شاملة داخل الإطار الجغرافي ، والنظام التعاوني يضمن وجود تمويل دائم ومتجدد لكافة المشروعات المقترحة مع ضمان هامش ربح بسيط للمساهمين وخدمة جيدة للجمهور.
وقد نشأت المؤسسات التعاونية وتوسعت في بريطانيا في القرن الثامن عشر كمحاولة لكبح جماح الرأسمالية وبدأت في نطاق العمال ثم أصبحت جزء من النظام الغربي ومعترف بها دوليا وترعاها منظمات الأمم المتحدة ، وفي مصر حتى الآن أربع أنواع من التعاونيات .. الجمعية التعاونية الزراعية وتعاونيات الإسكان والجمعيات الاستهلاكية والتعاونيات الإنتاجية التابعة لوزارة التضامن ويمكن لها أن تتوسع في المستقبل.
ونص الدستور المصري الحالي في المادة 37 على ما يلي : ” الملكية التعاونية مصونة وترعى الدولة التعاونيات ويكفل القانون حمايتها ودعمها ويضمن استقلالها ، ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي ” ، ونص في في مادة 33 على ما يلي : ” تحمى الدولة الملكية بأنواعها الثلاثة الملكية العامة والملكية الخاصة والملكية التعاونية “.
والعالم الغربي يقسم النشاط العام إلى ثلاث قطاعات : السلطة السياسية ووحدة العمل فيها الأحزاب حكومة ومعارضة ، السوق ووحدة العمل فيه الشركات ، العمل الاجتماعي ويطلق عليه القطاع الثالث ويشمل كلا من الجمعيات الأهلية التي تقدم خدمة مباشرة غير هادفة للربح والنوادي ذات النشاط المتعدد بأنواعها ومنظمات المجتمع المدني (حقوقية أو بيئية أو تثقيفية) والتعاونيات وهي مؤسسات تجمع بين النشاط الاقتصادي والاجتماعي.
وفي ظل الأزمات الاقتصادية المتصاعدة في البلدان النامية ومن بينها مصر قد يكون المجال التعاوني قادرا على حل جزء من مشكلة الغلاء وارتفاع أسعار السلع والخدمات وذلك عن طريق قيام المجتمع المحلي في المدن والقرى بتأسيس الجمعيات التعاونية متعددة المهام ، وفي ظل انعدام فرص الإصلاح الاقتصادي وانسداد أفق التغيير السياسي سوف يكون دور القطاع الأهلي هاما وحيويا للخروج من الأزمة بحلول عملية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
وفي الماضي القريب كانت مدينة المحلة الكبرى من المدن الرائدة في مجال التعاونيات من خلال مشروعات تعاون غزل المحلة والتي كانت تقدم منتجات النسيج والقطنيات بأسعار مناسبة للجميع ، وكانت المشروعات التعاونية قادرة على إمداد الأسرة المصرية باحتياجاتها الأساسية من الملابس والمفروشات مما يخفف العبء الاقتصادي على المجتمع مع ضمان الجودة في المنتج ، والتعاونيات في الأصل نشاط اقتصادي له بعد اجتماعي.
وجاء في تعريف التعاونيات لدى الأمم المتحدة : ” يُعرف للتعاونيات أهميتها بوصفها رابطات ومؤسسات يستطيع المواطنون من خلالها تحسين حياتهم فعلاً فيما يساهمون في النهوض بمجتمعهم وأمتهم اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وسياسياً ، وبات من المُسلَم به أنها واحدة من الأطراف المؤثرة المتميزة والرئيسية في الشؤون الوطنية والدولية.
كما بات من المُسلَم به كذلك أن الحركة التعاونية تتسم بقدر كبير من الديمقراطية وبأنها مستقلة محلياً ولكنها متكاملة دولياً وبأنها شكل من أشكال تنظيم الرابطات والمؤسسات يعتمد المواطنون أنفسهم من خلاله على العون الذاتي وعلى مسؤوليتهم الذاتية في تحقيق غايات لا تشمل أهدافاً اقتصادية فسحب ولكن تشمل أيضا أهدافاً اجتماعية وبيئية من قبيل القضاء على الفقر وكفالة العمالة المنتجة وتشجيع الاندماج الاجتماعي.
تتيح العضوية المفتوحة للتعاونيات إمكانية تكوين ثروة والقضاء على الفقر ، وينتج ذلك عن المبدأ التعاوني المتصل بالمشاركة الاقتصادية للأعضاء حيث يسهم الأعضاء إسهاما متساويا ومنصفا وديمقراطيا في التحكم برأس مال التعاونية ، ولأن التعاونيات ترتكز على المحور الإنساني وليس المحور المادي فإنها لا تعمد ولا تُسرع مسألة تكدس رأس المال بل إنها تعمد إلى توزيع الثروة توزيعا أعدل.
كما تعزز التعاونيات كذلك المساواة في خارج إطارها حيث أنها قائمة على فكرة المجتمع ، فهي بالتالي ملتزمة بالتنمية المستدامة لمجتمعاتها في المجالات البيئية والاجتماعية والاقتصادية ، ويثبت هذا الالتزام نفسه في دعم الأنشطة المجتمعية وتوفير المصادر المحلية للإمدادات مما يعود بالنفع على الاقتصاد المحلي فضلا عن دعمها عملية اتخاذ القرارات التي تراعي الأثر على مجتمعاتها المحلية “.
وتعاني الخدمة الصحية والدوائية في مصر من تدني في المستوى خاصة المستشفيات الحكومية (المفروض أنها مجانية) لكنها تقتصر الآن على حالات الطوارىء ، وتعوض الدولة ذلك بمنظومة التأمين الصحي لكن تغطيتها محدودة جغرافيا وماليا ، يبقى القطاع الخاص وتكاليفه الكبيرة والتي تشكل عبئا على المواطنين وكذلك القطاع الأهلي (العمل الخيري) وهذا يغطي بعض الخدمات وفي بعض الأماكن والتخصصات وليس شاملا ويعاني من ضعف التمويل بسبب المشكلة الاقتصادية المتصاعدة.
الخدمات التعاونية تشكل الطريق الوسط بين القطاع الخاص والقطاع الخيري .. لو أن هناك خدمة طبية تكلفتها ألف جنيه مثلا في القطاع الخاص يمكن أن تنخفض للنصف في القطاع التعاوني (طبعا القطاع الخيري يمكن له أن يقدمها مجانا من أعمال الزكاة والبر لكن ذلك ليس مضمونا على الدوام) ، وبالتالي يمكن حل نصف المشكلة وتخفيف العبء على الأسرة المصرية وفي نفس الوقت يتم تجنب مشكلات القطاع الخيري الذي يتهدده فقدان التمويل في أي لحظة وذلك عن طريق التعاون بين مقدم الخدمة والمتلقي.
في النظام التعاوني يحدث نوع من أنواع التوافق بين الطرفين حيث يرضى المتلقي (المنتفع) بدفع مبلغ مناسب مقابل الخدمة ويرضى مقدم الخدمة بهذا المبلغ القليل بهدف خدمة المجتمع مع تحقيق هامش ربح بسيط ، وتكون المشاركة بين أعضاء الجمعية بالتساوي في الأسهم حيث لا يهدف المشروع لتراكم رأس المال وإنما فقط لتغطية ما يلزم لاستمرار النشاط ، ويمكن بعد ذلك أن يحدث التوسع الأفقي (تأسيس فروع في المدن الأخرى) والتوسع النوعي (تعدد الخدمات مثل الأنشطة التعليمية والبيئية وتوفير بعض السلع والمرافق).
والفكرة ليست جديدة وإنما كانت مزدهرة في الستينات زمن المد الاشتراكي وكانت الجمعيات التعاونية منتشرة في كافة المدن بدعم من الدولة وتقدم خدمة جيدة جدا للأسرة المصرية ، لكن في السبعينات بدأت تتقلص بسبب الانفتاح الاقتصادي وأفرغت من مضمونها وصارت محل سخرية من تدني مستوى الخدمة بها خاصة في بيع الدجاج المستورد (فراخ الجمعية).

التعاونيات والجهود الذاتية
الفكرة التعاونية راسخة في المجتمع وكذلك فكرة التكاتف ضد السلطة لكن في صور أخرى مثل جمعيات الفلوس والتشارك في سرقة الكهرباء المخالفة ووصلة النت ووصلة الدش وتحذير بعضهم البعض من البلدية وشرطة المرافق (كان عدد من الباعة الجائلين يحافظون على اللافتات الإعلانية لعيادتي من البلدية وفي المقابل يخفون بضائعهم في بير السلم عندي عندما تأتي شرطة المرافق .. وهكذا).
وبقي من التعاونيات القديمة الجمعية الزراعية وتعاونيات الإسكان والبناء أما الجمعيات الاستهلاكية والإنتاجية التابعة لوزارة التضامن فإن حضورها باهت وتأثيرها ضعيف ، والفكرة أيضا موجودة في المجتمع بصورة قريبة مثل المعارض التي تنظمها النقابات المهنية في مجال السلع المعمرة وغيرها من المستلزمات وكذلك مشروعات الجهود الذاتية في القرى لإدخال مرافق مثل الصرف الصحي أو رصف الطرق أو غيرها من المشروعات.
ومنذ سنوات احتفل سكان إحدى القرى بإتمام مشروع الصرف الصحي في القرية بالجهود الذاتية وعلمت وقتها أنها ليست أول مرة بل سبق ذلك إنشاء مسجد ومدرسة ابتدائي ومركز طبي .. والعملية ليست سهلة لأن كل البيوت دفعت وهناك من تولى الإشراف على المشروع وتم الحفر في مسارات محددة ثم عمل بيارة وتفتيش ومصرف عمومي تحت الأرض ..
هذا يعني ببساطة أن سكان القرية قاموا بتأسيس (مجلس محلي بديل) قام بتنفيذ العمليات بنجاح لدرجة أنهم كانوا يخططون في المستقبل لعمل طريق مرصوف يربطهم بالطريق الزراعي العمومي ، ووقتها قلت في نفسي (على سبيل الخيال والمجاز) لو أنهم امتلكوا ألواح طاقة شمسية للكهرباء وأنشأوا محطة تنقية مياه (مرشحة) فهم لم يعودوا في حاجة إلى حكومة جمهورية مصر العربية الشقيقة !!
جدير بالذكر أن القرية منتجة ونشاطها زراعي ومعروفة بإنتاج الفواكه يعني أنها لا تعيش عالة على الدولة بل العكس هو الصحيح حيث تدفع الضرائب وكافة الرسوم (المفروض أن تقوم الدولة بواجبها نحو القرية وتتكفل بمرافقها وبل وتتيح لها التمثيل النيابي العادل) ، لكن الحكومات كانت توافق على مشروعات الجهود الذاتية بشرط ألا يكون لها توجه سياسي ولا أن تتلامس مع أي حزب أو تيار سياسي.
والمستبد دوما يريد أن يكون هناك حالة انفصام تام بين حركات الاحتجاج السياسية وحركات الاحتجاج الاجتماعية لأن التقاءهم خطر داهم عليه ، تخيل معي أن هذه القرية قررت في وقت ما تحت ضغوط ما ولسبب ما أن تتوقف عن دفع الضرائب والرسوم الحكومية وانتقلت العدوى إلى قرى أخرى ، والضرائب هي أعلى مصادر تمويل الموازنة والريف يشكل أكثر من 57 % من سكان مصر أي أكثر من النصف بقليل.
في نفس هذه الفترة شهدت إحدى المدن تأسيس (النقابة المستقلة لعمال النظافة غير المثبتين) وهو ما يعني تفويض الأعضاء المشتركين لمجموعة منهم لتجمع اشتراكات العضوية وإنشاء صندوق للرعاية الصحية وضمان التأمينات والمعاشات ، بعد ذلك قامت الحكومة في عام 2017 م. باستيعاب بعض هذه النقابات داخل الاتحاد العام الرسمي وحلت البعض الآخر وحولت البعض إلى جمعيات.
حاول أن تذهب إلى القرية أو إلى عمال النظافة وتحدثهم عن قضايا سياسية عامة سوف يقتنعون بكلامك لحظيا بداعي المجاملة لكن لن ينضم أحد منهم إليك .. فقط نقاباتهم ومحلياتهم وهم محقون في ذلك لأن السياسة الحقيقية هي التي تحقق مصالح الناس المباشرة وليس التحليق بهم في عالم الأفكار النظرية والرؤى الفلسفية.
وتنظيم المجتمعات المحلية هام جدا في محاربة النظم التي تجمع بين الاستبداد والرأسمالية ، والتعاونيات توفر مؤسسة بديلة في حالة عجز المؤسسات الحكومية كما أنها نظام يجمع بين النشاط الاقتصادي والاجتماعي فيوفر التمويل ويسهم في خدمة المجتمع ويساعد السياسيين على كسب أرضية جماهيرية وسط دوائرهم كما أنها تعوض الضعف المتوقع للعمل الخيري بسبب الظروف الاقتصادية وتوفر فرص عمل مع اتساع المشروعات.
ومن الطبيعي أن تكون حاضرة في مجال الخدمات العامة ويقصد بها الخدمات الطبيعية التي تقدمها الدولة والقطاع الخاص للمواطن مثل الخدمات الصحية والتعليمية والترفيهية والبيئية ، ويمكن التوسع في خدمة توفير السلع التموينية أو وسائل النقل أو الاتصالات (هناك مشروعات توصيل طلاب الجامعات وهي قائمة بالفعل في بعض المدن) ، وربما تتوسع مثلا في مجال توفير ألواح الطاقة الشمسية ..
ومع الأوضاع الاقتصادية المتوقعة يمكن التوسع في مجالات أخرى ، وهناك تغيرات حدثت حاليا لم تكن قابلة للتخيل في الماضي القريب بادرت بها الدولة نفسها مثل إنشاء شركات الأمن الخاصة أو اللجوء للقضاء العرفي في بعض المناطق بدلا من إنفاذ القانون وكذلك موافقتها الضمنية على توصيل المرافق بالجهود الذاتية في القرى !!
والتعاونيات هي واحدة من المؤسسات الوسيطة التي تشكل حلقة الوصل بين المواطن الفرد والدولة وهي التجمعات الطبيعية (الاجتماعية والسياسية) التي ينتظم فيها الأفراد بحكم نشاطهم في العمل العام أو بسبب الانتماء المهني أو التوجه الثقافي والديني ، والأحزاب والجماعات (بما في ذلك التيارات الإسلامية) تندرج تحت هذا التوصيف حيث حازت قدرا كبيرا من الشعبية والانتشار في طبقات المجتمع المختلفة.
ويندرج تحت هذا التوصيف أيضا كل من النقابات المهنية والاتحادات العمالية ونقابة الفلاحين والجمعيات الأهلية والمنظمات الحقوقية والبيئية والغرف التجارية ونوادي أعضاء هيئات التدريس ومجالس القبائل والعائلات والطرق الصوفية ونقابة الأشراف والنوادي الاجتماعية والرياضية (بما في ذلك نوادي الروتاري والليونز) والألتراس ومراكز الشباب والحركة الكشفية والاتحادات الطلابية ومنظمات المجتمع المدني واتحاد الكتاب وروابط الأدباء في الأقاليم وفروع الهيئات الدولية غير الحكومية العاملة في خدمة المجتمع والمؤسسات الدينية المستقلة وروابط المصريين في الخارج وغيرها من أوجه العمل العام.
ومن ذلك المشروعات أو المبادرات المؤقتة أو الدائمة التي يقوم بها السياسيون لخدمة النشاط العام بهدف التواجد وسط أبناء الدائرة الانتخابية ، وتضيف إلى العمل السياسي حضورا اجتماعيا يسهم في عملية التغيير والإصلاح بصورة مستدامة.
بالطبع هناك بوابات أخرى للدخول في عالم السياسة مثل ترشيح شخص مشهور إعلاميا والاعتماد على شعبيته أو رجل أعمال يدخل المجال معتمدا على أمواله أو حتى سياسي مستقل أو حزبي يقدم نفسه للجمهور بصورة مباشرة أو داعية محلي يعتمد على تأثيره الديني ، لكن كل ذلك يندرج تحت باب الفردانية ولا يشكل جهدا منظما مستمرا أما المؤسسات الاجتماعية فتتميز بالديمومة إذا نظمت في هيئة عمل مؤسسي مستدام لا يعتمد على فرد بعينه وإنما على الجهود الجماعية والتعاون المشترك بين السياسيين والدائرة الاجتماعية القريبة.
ويجدر الإشارة إلى أن المؤسسات الوسيطة قد تلعب دورا حيويا في الأوضاع الاستثنائية ، واللجان الشعبية التي نشأت أثناء الربيع العربي هي إفراز طبيعي للظروف ويمكن إدراجها تحت هذا البند حيث يمكن اعتبارها مؤسسات وسيطة محايدة أو مساندة إذا نالت الاهتمام الكافي من السياسيين.
وتحاول مراكز الدراسات السياسية والإستراتيجية أن تتنبأ بالأحداث المستقبلية وتتخيل السيناريوهات المختلفة المتوقع حدوثها ، وذلك عندما تكون هناك احتمالات متعددة في مسار الحاضر والمستقبل ، لكن ليس هناك جدوى من فعل ذلك إذا كانت الأمور تسير في خط مستقيم باتجاه مصير معروف سلفا خاصة إذا تشابهت البدايات وحدث استسلام قدري لما سوف تأتي به الأيام ..
في الشدة المستنصرية لم يكن الفقر هو السبب الأول لكل ما حدث بل العكس هو الصحيح حيث امتلك الناس كميات هائلة من الذهب والفضة خاصة ما تم نهبه من القصور ، لكن المشكلة كانت في غياب السلع الأساسية من غذاء وكساء ودواء بسبب عزل القاهرة عن مصادر السلع في كل من الدلتا والصعيد فكانت النتيجة أن تباع حفنة من الشعير بألف دينار في مشهد مأسوي ..
وعندما تكون النقود المتداولة أكثر من السلع المعروضة تفقد النقود قيمتها تدريجيا حتى تصل الأوضاع إلى مرحلة ما بعد التضخم والتي تعني ندرة السلع المطلوبة ثم اختفائها خاصة إذا كان الاعتماد الأكبر في معظمها على الاستيراد ، ويشبه ذلك ما حدث في الشدة المستنصرية عندما تملك في جيبك مليون جنيه لكن لا توجد سلع لتشتريها فتصبح النقود معدومة القيمة مثل أوراق الأشجار ..
ومع اختفاء السلع لن يكون هناك قيمة للذهب ولا للدولار في أيدي الأفراد حيث لا يمكن مقايضتها بأي سلعة أو خدمة إلا عن طريق المؤسسات المالية (البنوك وشركات الصرافة) والتي ربما يكون من أولوياتها جمع العملة الصعبة والذهب لتسديد الديون المستحقة أو الإنفاق على مجالات محددة تشكل أولوية مثل رواتب الجهات السيادية وبالطبع يكون ذلك على حساب السلع الأساسية ..
والحقيقة أن الفكاك من مصير الشدة المستنصرية يصبح في غاية الصعوبة مثل القطار الذي انطلق بسرعته القصوى دون كوابح في طريقه إلى الهاوية أو الثور الهائج الذي يندفع في قوة غاشمة حتى يصطدم بحائط سد ، وفي هذا الحالة ربما يحدث انهيار في مؤسسات الدولة مع العجز التام عن دفع الرواتب وتوفير الاحتياجات الأساسية وعندها لا بد من وجود مؤسسات بديلة تنقذ مما يمكن إنقاذه.

التعاونيات وتنظيم المجتمع المحلي
هناك أسباب كثيرة تعوق عملية التنمية المستدامة وعلى رأسها الاستبداد السياسي الذي يحتكر السلطة والثروة ولا يتيح للمواطن في المجتمع المحلي أن يشارك في إدارة المقدرات بحجة الحفاظ على أمن الوطن ، وهو شبيه بما حدث في دول أمريكا اللاتينية التي عانت كثيرا حتى خرجت من ذلك الأفق المسدود.
ومن متابعة التاريخ القريب والأحداث المعاصرة يتبين أن الصراع في المنطقة العربية كان بين تيار سياسي حكومي أنشأته النظم القمعية وتعددت مسمياته حسب كل دولة وبين معارضة إسلامية واعدة وصاعدة تقدم نفسها بديلا عن النظم القديمة وحققت نجاحات نسبية على أرض الواقع مع إخفاقات أحيانا في بعض الدول.
ومصير التيارات السياسية الحكومية إلى زوال بحكم تغير الزمن وعدم مواكبتها للمستجدات ، لكن أيضا التيارات الإسلامية رغم تفوق شعبيتها حدث لها إنهاك من جولات الصراع الممتدة سواء بإجراءات قمعية (مصر وتونس) أو هزائم انتخابية طبيعية (المغرب والأردن) أو الدخول في حروب أهلية (ليبيا وسوريا).
واتساقا مع حركة التاريخ واستقراء الواقع برزت الحاجة إلى وجود حراك اجتماعي يحل محل المعارضة التي من المفروض أن تكون واعدة وصاعدة ، يقول جرامتشي : ” تتجلى الأزمة تحديدا في أن القديم آيل الى الزوال بينما لا يستطيع الجديد أن يولد ، وفي فترة التريث هذه يبرز عدد كبير من الأعراض المرضية “.
هذا التطوير ليس انقلابا على القديم ولكن إكمال لمسيرته في ثوب جديد أكثر حداثة وعصرانية واحترافية وتخصصية ، وذلك لمعالجة الآثار الكارثية للسياسات الاقتصادية التي أودت بنا إلى حافة الهاوية وجعلت مصر عالة على غيرها تعيش على المنح والقروض والمعونات حتى صار المواطن عايش شحاتة.
وعايش شحاتة هو اسم محمد صبحي في مسرحية ماما أمريكا (ويرمز إلى مصر) .. وللمصادفة البحتة كانت كل النظم العسكرية في أمريكا اللاتينية فاشلة اقتصاديا وهي نقطة الضعف الأهم حيث تكون عرضة للتأثر بوسائل الاحتجاج التي تضرب على هذا الوتر مثل العصيان المدني والإضراب العام والامتناع عن سداد الضرائب والرسوم والتخلي مؤقتا عن مرافق الدولة.
ويحكي التاريخ أنه أثناء ذروة الثورة الإيرانية كان عمال الكهرباء في أرجاء إيران يقومون بقطع الكهرباء أثناء خطاب شاه إيران فكان الرجل يكلم نفسه ولا يسمعه أحد .. المشكلة في أمريكا اللاتينية كانت ضعف الأحزاب ولذا قامت المؤسسات الوسيطة (النقابات والاتحادات وغيرها) بالقيام بهذا الدور واختارت قيادات منها لتقود الحراك.
وقد تطلب منهم هناك معرفة دقيقة بطبيعة النظام وتفكيك العناصر المؤيدة له ثم التفاوض معه على حلول انتقالية .. ويظن البعض أن التحول الديموقراطي يحدث بين يوم وليلة لكن الحقيقة أنه يستغرق وقتا ويمر بمراحل انتقالية فالهدف المرحلي قد يكون إتاحة الفرصة للمشاركة في صناعة القرار وليس إقامة نظام ديموقراطي متكامل على النمط الغربي لأنه لن يتم إلا بعد ضبط مصادر الدخل القومي وإقامة توازن بين السلطات.
وقد رأينا كيف رفض قائد شرطة لندن تنفيذ أوامر وزيرة الداخلية وقال إنه يتلقى أوامره من عمدة لندن المنتخب .. وهذا مثال على الفصل بين الصلاحيات داخل السلطة الواحدة .. رئيس الولايات المتحدة لا يملك صلاحية عزل حاكم ولاية ولا حل البرلمان لأنهم هم من يدفعون راتبه وليسوا رعايا عنده يهتفون : (المنحة يا ريس) ..
وفي مرحلة سابقة من تاريخ أعرق الديموقراطيات (أمريكا) كان النظام الجمهوري يتيح للمواطنين المشاركة في حكم بلدهم .. لكنه أيضا كان دينيا متطرفا ويحرق الساحرات ويقنن العبودية ويبيد الهنود الحمر ، وهناك دول أوروبية لم تسمح للمرأة بالمشاركة السياسية إلا في النصف الثاني من القرن العشرين ثم تطورت مع الزمن.
ويرى البعض أن مسار الإصلاح الاجتماعي طويل ويسرح بخياله في اتجاه حسم التغيير بالقوة لكن المشكلة أنك لست وحدك في هذا العالم حيث يفتح العنف باب التدخل الخارجي (أمثلة حفتر وحميدتي والحوثيين حيث تنتهي الأمور إلى تقسيم البلد نصفين أو حكم الميليشيات وهو ما يجعل الأمور أسوأ ويفقد المواطنين الثقة في الإصلاح بل يدفع الشعب للترحم على زمن المستبدين) .. والهدف الأصلي للتغيير هو نهضة البلد وليس إضعافها وتفتتها وليس هناك إصلاح من دون الحذر من التدخلات الخارجية.
وقديما في إحدى حصص الفيزياء درسنا معادلة انشطار الذرة واستمعنا إلى المدرس وهو يشرح (السر الخطير) وهو أنه يتم قذف نواة الذرة في العنصر المشع بواسطة نيترون فتبدأ سلسلة التفاعل الانشطاري ، وكان تخيلنا الساذج أن الأمر سهل لكن المدرس أخبرنا أنه بفرض أننا حصلنا على اليورانيوم (من عند العطار مثلا) وأحضرنا نيترون فإننا لا نستطيع تصويبه على الذرة بواسطة النبلة فوق سطح البيت ، لكن الأمر يحتاج إلى وسط مناسب للمعادلة الكيميائية وأجهزة تتم فيها العملية (المفاعل النووي).
نفس الشيء يحدث في مجال الإصلاح السياسي .. حجم هائل من الأفكار والرؤى والمعلومات النظرية وتصورات جميلة جدا للدستور والقوانين وبرامج ممتازة للتنمية الاقتصادية مع الإيمان بوجوب التغيير والقضاء على الاستبداد وإقامة دولة المؤسسات والمواطنة والعدالة الاجتماعية ، وكل هذا أمر طيب لكن السؤال الهام : كيف يمكن تنفيذ ذلك أي تغيير الوضع الحالي وإزاحة المستبد ؟
طبعا النسخة الأخيرة من التغيير والتي لا زالت مطبوعة في خلفية تفكير الجميع هي (المظاهرات) التي تحولت إلى مليونيات بناء على دعوات على وسائل التواصل وأسقطت النظام (وأيضا الطرف الآخر يتحسب لذلك ويواجهها بالعنف المفرط) لكن هذه الطريقة في التغيير كانت مرتبطة بمرحلة زمنية محددة ومتغيرات محلية ودولية وقتها ، ويصر البعض على أنها وسيلة التغيير الوحيدة قياسا على ما سبق رغم أنه قبل يناير لم يكن متوقعا أن تنتهي الأمور بهذه الطريقة ..
قبل يناير كان العاملون في الحياة السياسية لا يعرفون متى ولا كيف سيحدث التغيير وكان المتوقع أنه قادم مع (السر الإلهي) حيث يتولى شخص جديد من نفس النظام لكن بمرونة أكبر ، وكانت التوقعات تنصب على فكرة احتفاظ الرئيس (ذي الخلفية العسكرية) بالوزارات السيادية الأربعة الدفاع والداخلية والخارجية والعدل ويقتصر دوره على ملفات السياسة الخارجية والمعاهدات والأمن القومي ثم تحدث انتخابات برلمانية حقيقية تفرز حكومة أغلبية تتولى الملفات الاقتصادية والمرافق والخدمات على نحو قريب من وضع الأردن والمغرب وتركيا في بعض المراحل الانتقالية (مرحلة من مراحل التحول الديموقراطي وتؤخذ في الاعتبار حتى يومنا هذا لأنها قد تكون محطة بين عهدين).
والهدف الأكبر لمسار الحركة الإصلاحية في أمريكا اللاتينية كان تنظيم القوى الاجتماعية المختلفة بواسطة رموز سياسية تكون موضع ثقتهم وتملك رؤية واضحة وفهم للأوضاع والمتغيرات وتقودهم إلى التفاوض مع النظم العسكرية بعد خلخلة التحالفات المكونة لداعمي النظام.
وكانت النظم العسكرية في أمريكا اللاتينية تعتمد على تحالف العصابات الكبرى ورجال الأعمال مع التيارات اليمينية المحافظة ورجال الدين حيث إن القارة كلها كاثوليكية وتحتل الكنيسة فيها مكانة مميزة ، ولذا كانت الخطوة الأهم هي قيام عدد من رجال الدين المصلحين والمؤثرين بإعادة صياغة للمفاهيم الدينية التقليدية التي تكرس للدكتاتورية والتعصب واستبدالها بآراء مجددة تميل ناحية اليسار وتتبنى مواقف حقوق الإنسان والحريات وتدعو للثورة على الظلم وهو ما عرف باسم (لاهوت التحرير).
الخطوة الثانية هي تقديم بديل سياسي معقول ومقبول محليا ودوليا وقادر على التواصل مع منظمات المجتمع المدني الحر ودوائر التأثير وجماعات الضغط في الدول الكبرى (أيدت أمريكا الربيع العربي بهدف خلق أنظمة ديموقراطية أو شبه ديموقراطية تتوافق مع المصالح الغربية ولا تكون صدامية والمحيط الدولي والإقليمي ليس على استعداد لقبول نظم صدامية) .. وهي خطوة انتقالية على كل حال ولن يمنع ذلك أيضا محاولات التدخل الدولي والإقليمي ، ومن تقييم تجربة التيارات الإسلامية تبين أنها كانت بارعة في إدارة الانتخابات فقط ولم تكن قادرة على استيعاب كافة مكونات المجتمع التي سحبت منها بقليل من الزخم الإعلامي لأن جمهور السياسة كان مشابها لجمهور النادي الأهلي (يمشي مع الرايجة ويشجع الكسبان).
في أمريكا اللاتينية أيضا حدثت التغيرات في جميع دول القارة متعاقبة (مثل أحجار الدومينو) وهو وضع مشابه لحالة بلادنا ويجب أن يوضع في الاعتبار وهو نموذج للاسترشاد وليس للتقليد حيث يجب مراعاة عامل الزمن والتغيرات التي حدثت .. ويجب البحث عن المؤسسات الاجتماعية الفاعلة أو صناعتها وخلق حالة تجديد فكري على مستوى القناعات والممارسات .. وفي نفس الوقت يلزم وجود راية سياسية واضحة يلتف المجتمع حولها .. فاونسا في بولندا ودي سيلفا في البرازيل هم قيادات نقابية ، وفي تونس لعب اتحاد الشغل دورا هاما في كبح جماح الحكومات وصنع نوعا من التوازن في ظل غياب القوى السياسية ، وفي بعض البلاد مثل اليمن والعراق وبعض الدول الأفريقية كانت القبائل حائط صد ضد تغول السلطة واستبدادها ، وفي بعض البلاد تحولت القوى الاجتماعية إلى قوة اقتصادية ضاغطة (دول آسيان).

التعاونيات والإصلاح السياسي
يمكن للتعاونيات أن تكون وسيلة المجتمعات للإصلاح السياسي وذلك من خلال عمل مؤسسي قائم على المنفعة العامة في مقابل عدد من المؤسسات التي تتبناها النظم الحاكمة لتثبيت هيمنتها على المجتمع واحتكار المجال العام ، وسوف تحقق نجاحا فعليا لأنها خرجت من بين الناس تحمل رؤيتهم والحلول العملية لمشكلاتهم ولها شعبية وتواصل مع الجمهور وفي نفس الوقت هي مؤسسات قانونية تعمل وفق الدستور ، وقد يرى البعض أنها تقوم بدور الأحزاب السياسية لكن أوضاعنا غير طبيعية على مستوى كافة المؤسسات الحكومية والشعبية.
ألم تر كيف صار اتحاد القبائل العربية هو الترند الأكبر في كل الصفحات وظهرت علامات الدهشة والتعجب والاستنكار من وجود مؤسسة تحمل هذا الاسم وتقوم بدور سياسي علني ، لكن الحقيقة أن الجميع في مصر يعمل في غير تخصصه بما في ذلك كل المؤسسات ، لماذا لا نتعجب من قيام مستشفى الدمرداش الجامعي بعمل إعلان مدفوع الأجر في الفضائيات تطلب فيها تبرعات لشراء أجهزة حيوية في أقسام الطوارىء ، بينما الجمعيات الأهلية منشغلة بدعم الحملات الانتخابية الرئاسية والأحزاب السياسية تنظم مسابقات في تحفيظ القرآن ودورات في الشطرنج والأندية الرياضية تحولت إلى شركات عابرة للقارات ..
لماذا لا نتعجب من وجود منافذ لوزارة الدفاع تبيع اللحوم والمواد الغذائية والجمبري بينما تنظم وزارة الداخلية الحج والعمرة ، الأزهر والكنيسة وهي مؤسسات دينية حاضرة في المشهد السياسي حتى اليوم وشيوخ الطرق الصوفية المفترض فيهم الزهد والبعد عن الدنيا يحتلون المواقع المتقدمة في الأحزاب والبرلمان بينما أعضاء البرلمان غير متاح لهم الرقابة والتشريع ويقوم كل منهم في دائرته بوظيفة المجلس المحلي من رصف الطرق وإصلاح المجاري ، والحكومة نفسها كانت تشتري الدولار من السوق السوداء والجامعات تحولت إلى مدارس ثانوي وتم عزلها عن أي مشاركة في العمل العام ..
والنقابات المهنية فقدت دورها وتحولت إلى مقاهي وانحدرت لدرجة أن نقابة الأطباء والمفترض فيها استقلالية الرأي قد عجزت عن نشر نعي وعزاء محترم لأحد كوادرها والذي توفي في المعتقل وذلك بسبب الخوف من أجهزة الأمن ونفاق بعض أعضاء مجلسها ، وبالتالي فإن ما حدث في إعلان اتحاد القبائل العربية هو أمر متماشي مع الفوضى الحالية لأن القبائل هي كيانات اجتماعية طبيعية موجودة في معظم محافظات مصر وأسست جمعيات واتحادات وروابط تابعة لوزارة التضامن لرعاية أبنائها لكن ما حدث هو توظيف في غير محله أثار التخوف من العودة للفكرة القبلية وتحولها إلى ميليشيات ..
وكل ما سبق مجرد أعراض ظاهرية للمرض ، أما التشخيص الحقيقي فهو متمثل في نظم سياسية قررت التشبث بمقاعدها ومقاومة رياح التغيير بكل وسيلة ممكنة ، في الماضي كان الصراع يدور في الساحة الانتخابية لمقاومة المعارضة الإسلامية التي تهيمن على النقابات والجامعات فكانت الحكومة تحشد في مواجهتها كل الكيانات الأخرى الممكنة مثل الطرق الصوفية ونقابة الأشراف واتحادات العمال ونقابة الفلاحين وأندية الروتاري والليونز وفي القلب منها القبائل والعائلات والتي خرج منها أعضاء البرلمان الموالين للنظام في أرياف الدلتا والصعيد خلال الخمسين سنة الأخيرة ..
وفي كل الانقلابات العسكرية في العالم يخرج ضابط أو مجموعة ضباط يعلن البيان رقم واحد ، لكن في مصر كان بيان 3 يوليو أشمل من ذلك فكان يحضره مع العسكريين كل من رئيس مجلس القضاء الأعلى وشيخ الأزهر وبابا الكنيسة ومندوبين عن كل من التيار السلفي وجبهة الإنقاذ والأدباء والفنانين وحركة تمرد (وهي كيان مصطنع اكتسب حضورا مؤقتا) وكل ذلك لكي يوحي بوجود (تمثيل مؤسسي للمجتمع) وهو مشهد لا ينسى.
مع الأخذ في الاعتبار دور الإعلام في التخديم على هذا المشهد عن طريق الإخراج السينمائي فلم يكن مسارا تقليديا كما تفعل القنوات الإخبارية لكنه حولها إلى (حالة فنية) استنفر فيها كل القدرات السينمائية وكرس لفكرة (ثقافة اللقطة) التي سادت بعد ذلك ، وعلى أرض الواقع تحركت باقي المؤسسات لحشد الناس بالمال أو تهييج الرأي العام ومنها روابط العائلات والطرق الصوفية والجمعيات الزراعية والنوادي وغيرها.
وقديما كنت أتساءل عن سر اهتمام نظام مبارك بأندية الروتاري والليونز واتحاد القبائل العربية وغيرها وتحويل انتخابات النقابات المهنية إلى معركة حقيقية مع احتكار النقابات العمالية ونقابة الفلاحين بشكل حصري ، وسبب ذلك هو طبيعة العالم من حولنا الذي يحترم المؤسسة حتى لو كانت (شلة على القهوة) ولا يحترم الفرد مهما كانت عبقريته ونبوغه لأن الفرد في النهاية زائل بالوفاة أو السفر أو غيره لكن المؤسسة باقية ، واليوم يتم إعادة تدوير ذلك من خلال نخب مدنية مطبلة ودعم تيارات الشعوبيين الجدد وجيوش البلطجية وغيرها.
والنظم الديكتاتورية لا تخشى من (النجوم) التي تسطع في سماء السياسة أو الإعلام في لحظة ما ثم يخبو بريقها مع الزمن ، ولكنه يتوجس من أي عمل مؤسسي لأن ذلك يعني تجميع القدرات البشرية والمالية وضمان الاستمرارية والانتشار ، وقد رأيت بعيني أهمية الانتخابات العمالية في المحلة والتي كانت في وقت ما أهم من البرلمان وكان إعلان الإضراب في المصانع أزمة سياسية كبرى كما أنه يحتكر المحليات ولا يسمح بدخول المعارضة فيها لقدراتها على التمثيل الفعلي للمجتمع المحلي ، مجال العمل الاجتماعي المنظم سوف يكون في مرحلة ما نقطة الصراع والاشتباك في مسيرة الإصلاح.
وبعد يناير اندفع الجميع لمنصات الإعلام حيث حلم الشهرة السريع في الهواء وعدم الالتفات للعمل على الأرض (وقد نصحت وقتها التيارات الشبابية بالتركيز على البناء القاعدي لكن محدش عايز يتعب) ، وهذا الأمر يحتاج إلى دراسة التحولات الديموقراطية في دول (عالم الجنوب) التي تتشابه ظروفها مع واقعنا (أمريكا اللاتينية وأفريقيا جنوب الصحراء وجنوب شرق آسيا) حيث مواجهة نظم شمولية شرسة ومؤسسات فاسدة مهترئة ..
وهناك بالطبع طرق عديدة للتغيير منها الحلول الجذرية مثلما فعل الشيوعيون في الاتحاد السوفييتي وفي الصين الشعبية وكوبا وفيتنام وكوريا الشمالية ولاوس لكن ذلك نتج عنه نظم أكثر دكتاتورية (حكم الحزب الواحد) ، وفي البلاد العربية حدث أمر مماثل في حالة حزب البعث والاتحاد الاشتراكي (الناصري) وغيره وهو النموذج الذي أرسى دعائم الاستبداد والقمع حتى اليوم.
لكن رؤيتنا هي المبادرة بالمشاركة في النضال السلمي ضد الاستبداد وهو طريق (عالم الجنوب) حيث قامت الأحزاب السياسية بإعادة تنظيم المجتمعات وتوظيفها في الحراك ، وقد يبدو ظاهريا وقتها أن الأمر يسير في فلك الإصلاح الاجتماعي لكنه كان الخطوة الأساسية للتغيير ، وفكرة التعاونيات مثال جاد وفعال مع تعدد الوسائل مثل المنظمات الحقوقية والجمعيات الأهلية والنقابات وكافة المؤسسات الوسيطة ، ويمكننا ملاحظة هذا التغير من خلال مواقف بعض الدول مثل كولومبيا وبوليفيا وشيلي التي طردت السفير الإسرائيلي حيث عانت هذه الدول طويلا من دعم أمريكا للمستبدين.
والتاريخ هو أكبر دراما حية تتكرر وقائعها كل يوم ، وتكاد تكون مصائر الأبطال في عالم السياسية وعالم الأدب متقاربة حيث يقدر للبعض منهم أن يكون نجما لامعا متوهجا في أول الأحداث عندما يطلق شرارة البداية ثم يأفل ويخفت عندما ينتهي دوره الدرامي وتنتهي الظروف التي دفعته للصدارة بطريق الصدفة إذ لا يشترط أن يكتب هو كلمة النهاية التي سوف يكتبها أشخاص آخرون ..
وفي ملحمة الإلياذة كان أخيلوس هو بطلها الذي صنع بداية الحدث بما يمتلك من قوة وشباب واندفاع وجرأة وغضب ورغبة في التغيير الجذري لكن نهاية الأحداث كانت على يد نقيضه الأقرب للأشخاص العاديين وهو أوديسوس الأكبر سنا والأكثر حكمة والأكثر مهارة في الدبلوماسية والأقدر على تحمل الصعاب وبث الأمل وهو صاحب فكرة حصان طروادة الذي حسم المعركة في نهاية الأمر ..
وقدر لصاحب الحكمة أن يكمل هو المسيرة ويصبح بطل الجزء الثاني من الملحمة (الأوديسا) وهو ما تكرر كثيرا في وقائع التاريخ قديما وحديثا عندما تتأمل قيام الدول ثم توسعها ثم انهيارها وكيف بدأ الحدث الكبير بفكرة صغيرة تبناها شخص ثم أكملها الآخرون بعده ، ولا شك أن جمهور الناس في أول الأمر يتعلق بالنجوم ويرى فيهم الأمل والرمز لكن النجاح على أرض الواقع له مسار مختلف ..
ربما تحتاج البداية إلى فورة العاطفة وحماسة الشباب لكن النهاية تحتاج إلى العقل والبصيرة وامتلاك أدوات التغيير ومراعاة عامل الوقت لأن لكل زمن رجاله ولكل عصر رموزه ولكل مرحلة مفرداتها ولكل حقبة ظروفها ، ويستوي في ذلك الحروب الكبرى والأحداث الجسام ومنها الربيع العربي الذي كتبت كلمات البداية فيه بواسطة نجوم لمعوا وتألقوا على الساحة ثم انتهى دورهم مع تغير الزمن ..
وسبب اختلاف البدايات عن النهايات هو توقف الزمن لدى البعض عند مرحلة محددة أو حدث بعينه لا يتجاوزه ولا يراعي أنه قد أصبح من الماضي ويصر على استحضار مشاهده في كل مناسبة ولا يتصور أن تسير الأحداث بغير النمط الذي يعشش في عقله ، والحقيقة أن التاريخ لا يعيد نفسه وإذا حدث وتكررت وقائع معينة فيه فإنها كما يقول كارل ماركس تكون في الأولى مأساة وفي الثانية ملهاة ..

إدارة التنمية المستدامة
الجيوش وحدها لا تكفي لحفظ كيان الدولة لأن الصراعات في العصر الحديث ليست في المجال العسكري وحده وإنما يجب أن يساندها اقتصاد قوي بل إن الحرب الاقتصادية أحيانا تكون أشد في تأثيرها من استعمال القوة المسلحة وربما تؤدي إلى تركيع الدول وإذلال الأنظمة الحاكمة خاصة تلك التي تعيش على المنح والقروض وتعتمد على الاستثمار الأجنبي في قطاعات غير إنتاجية ..
والاقتصاد القوي يعني الإنتاج الصناعي الذي يفتح الباب للصادرات ولا يشترط أن يكون في مجال محدد مثل الغرب حيث الصناعات الثقيلة أو التقنية وإنما يكفي أن تكون الدولة متميزة في قطاع معين يشكل أهمية للعالم لا يمكن الاستغناء عنه مثل صناعة الملابس أو الأثاث أو الصناعات الكيماوية أو غيرها من المجالات التقليدية فيعتدل الميزان التجاري عندها ..
ولا يمكن أن تنهض أي دولة اقتصاديا طالما كانت غالبية القوة العاملة فيها مقتصرة على القطاعات الخدمية مثل مجالات الأمن والمرافق والترفيه وغيرها لأنها جميعا غير إنتاجية حيث تتحول العمالة إلى جيوش من الموظفين وهو ما يشكل عبئا على موازنة الدولة حيث الإنفاق على الخدمات دون عائد إنتاجي يضمن مدخولات ثابتة من العملة الصعبة اللازمة ..
والقاعدة الصناعية تحتاج في المقام الأول إلى توجيه التعليم نحو خدمة سوق العمل والتركيز على المجالات الإنتاجية الصناعية والتوسع في التعليم التقني القائم على اكتساب الخبرة العملية التي تحتاجها الصناعة .. وهذه السياسة تحتاج إلى إدارة واعية لمقدرات الثروة البشرية ومن خلفها إرادة سياسية لتحقيق النجاح في هذه المنظومة المتكاملة التي تنهض بالاقتصاد ..
هذه الوصفة تمت تجربتها في عدد من الدول المتباينة في الثقافة مثل النمور الآسيوية وعدد من دول أفريقيا وأمريكا اللاتينية وحققت نجاحات لا بأس بها .. المشكلة ليست في المجتمعات وثقافتها كما يروج بعض المثقفين وإنما في فلسفة النظام الاقتصادي للدولة وقدرتها على صياغة منظومة متكاملة تبدأ عند التعليم التقني الجاد وتنتهي عند بوابات المصانع وموانىء التصدير ..
في منتصف القرن العشرين انقسمت شبه الجزيرة الكورية إلى دولتين حيث اختلف مصير كل منهما تبعا للنظام السياسي الحاكم في كل واحدة منهما رغم أنهما يضمان شعبا واحد يعيش على نفس الأرض ويملك نفس المقومات الاقتصادية ونفس الثقافة والعادات والتقاليد ونفس اللغة ونفس التاريخ المشترك وبالطبع نفس الجينات الوراثية ..
واحدة منهما صارت كوريا الجنوبية وهي دولة ديموقراطية رأسمالية على النمط الغربي والتي تميزت في مجال الصناعة والتقنية وحققت قفزة اقتصادية معروفة حتى صارت واحدة من النمور الآسيوية الأربعة واحتلت المرتبة الثانية عشر على مستوى العالم في الناتج القومي لكنها تحتاج إلى الحماية الأمريكية مثل معظم الدول الغربية ..
أما الثانية فقد صارت دولة كوريا الشمالية ذات النظام الشيوعي الديكتاتوري البوليسي الذي يقيد حريات الفرد وتنتقل فيه السلطة من الأب إلى الابن إلى الحفيد وهي متخلفة على الصعيد الاقتصادي سواء من ناحية الناتج الإجمالي أو مستوى دخل الفرد لكنها عوضا عن ذلك حققت تقدما في مجال التسليح وصارت إحدى الدول النووية الثمانية ..
ويعد ما حدث للدولتين مثال على تأثير النظام السياسي الحاكم على فئة من شعوب الأرض حيث سلك كل منهما طريقا مختلفا وفق الفلسفة التي تحكم أفكار كل منهما .. ولا شك أن دول قليلة في العالم هي التي حققت النجاح في التنمية والتسليح معا فجمعت بين القوة العسكرية والقوة الاقتصادية وهناك دول اكتفت بالنجاح في واحد منهما فقط ..
المهم في عالمنا المعاصر أن يكون لأي دولة إنجاز وتقدم في واحد منهما .. إما أن تكون من النمور الاقتصادية والصناعية والتقنية فتصل إلى مجلس إدارة العالم أو تكون من الدول النووية التي تفرض سطوتها في المحافل الدولية وتخرج بها من دائرة التبعية مثل زعيم كوريا الشمالية الذي يتحدى الدول الكبرى ويملي شروطه على الكل ..
ولا يشترط أن ترتبط التنمية والقوة بطبيعة النظام الحاكم فهناك الكثير من الدول الديموقراطية لم تحقق أي تقدم في الاقتصاد أو التسليح لكن على الأقل منحت الفرد الحرية والعدل .. المشكلة الكبرى عندما يوجد في بلد ما نظام عشوائي يجمع بين الديكتاتورية والفقر وليس له وزن على صعيد السياسة الدولية فيفقد تدريجيا مبررات وجوده ..
ويرى البعض أن ثقافتنا المحلية في الوطن العربي سبب لعدم التقدم واللحاق بركب الحضارة خاصة ما يتعلق ببعض الأفكار الدينية أو الاجتماعية .. وقد يكون في هذا الرأي بعض الصحة لكنه ليس العامل الأساسي أو الوحيد لأن كثيرا من دول العالم قد نهجت نهج العلمانية الكاملة سواء ديموقراطي أو شيوعي ولم تصل إلى مستوى متقدم .. مثال ذلك دول آسيوية مثل الفلبين وفيتنام وكمبوديا ودول أفريقية مثل زيمبابوي وناميبيا وبتسوانا ودول لاتينية مثل بوليفيا وبيرو وباراجواي ..
والحقيقة أن عددا قليلا من الدول الصناعية هو من وصل إلى درجة جيدة من التقدم التقني والمعرفي بينما عدد كبير من الدول الأوروبية يأتي متأخرا في كافة المؤشرات بعد كثير من الدول العربية مثل سلوفاكيا ولكسمبورج واليونان والتشيك ومولدوفا وليتوانيا ولولا دعم الاتحاد الأوروبي لكانت أوضاعهم مختلفة .. ولدينا مثال هام وهو دول العالم الجديد التي نشأت في أزمنة متقاربة نتيجة هجرة الأوروبيين إليها لكنها متفاوتة بشدة في مستويات التقدم بسبب الجغرافيا والمناخ ..
الولايات المتحدة صارت قوة عظمى عسكرية واقتصادية بينما كندا صارت من الدول الصناعية الكبرى لكنها لا تملك قوة مثل جارتها وحققت كل من أستراليا والمكسيك والبرازيل درجة عالية في المؤشرات الاقتصادية لكنها لم تصل إلى مرتبة الدول الصناعية السبع الكبرى ونيوزيلاندا تأتي بعدهم بدرجة كبيرة .. أما بقية دول أمريكا الوسطى والكاريبي فهي في مرتبة متأخرة رغم أن كل هذه الدول بدأت سويا وبنفس الثقافة لكنها كانت متفاوتة في الموارد الطبيعية بشكل كبير ..
ودولة مثل روسيا وصلت لما هي فيه بسبب اتساع مساحتها واحتلالها سيبيريا والقوقاز والأورال وامتلاكها لكل الموارد والمقومات اللازمة للتفوق بالإضافة إلى أرض زراعية وفيرة .. ودائما ما يضرب المثل بالتقدم الحاصل في اليابان وكيف أنها حققت معجزة بدون موارد لكن الحقيقة غير ذلك لأن الجغرافيا خدمتها حيث تعتمد على وارداتها من جيرانها من دول الآسيان القريبة ولذا فإنها احتلتهم جميعا أثناء الحرب العالمية الثانية وأطلقت عليهم اسم : منطقة الموارد الجنوبية ..
وتتنوع مصادر الدخل القومي من دولة لأخرى .. منها ما يعتمد على الصناعة مثل الدول الصناعية السبع الكبرى .. ومنها ما يعتمد على الصناعات الصغيرة وغزو الأسواق .. ومنها ما يعتمد على صناعة التقنية والبرمجيات .. ومنها ما يعتمد على الثروات المعدنية مثل الدول المصدرة للبترول أو التي تملك مخزونا هائلا من المعادن أو الثروة المحجرية ..
ومنها ما يعتمد على الإنتاج الزراعي فيملك سلعة استراتيجية لا غنى للعالم عنها مثل التوابل والشاي والبن والكاكاو .. ومنها ما يعتمد على موقعه الذي يسمح بجذب الاستثمار والتبادل التجاري .. ومنها ما يعتمد على السياحة وصناعة الترفيه ومنها ما يعتمد على الإنتاج الفني والدرامي والثقافي .. ومنها ما يعتمد على تقديم الخدمات المتنوعة واللوجستيات ..
كل منطقة من العالم عرفت نقطة تميزها وأدركت أن عليها الاستثمار في المجال الذي يدعم الناتج القومي لها ويضمن تحقيق النجاح الاقتصادي للدولة والوصول بشعبها إلى مستوى الرفاه أو على الأقل زيادة نصيبه من الناتج المحلي .. ومؤخرا بدأت دول منابع الأنهار تتحدث عن المياه بوصفها سلعة قابلة للبيع مثل الثروات المعدنية وأنها لن تكون مجانا في المستقبل ..
وقد يكون من الجيد أن تتعدد مصادر الدخل وألا تكون أي دولة معتمدة على مجال واحد بل من الأفضل وجود قدر من التنوع .. وربما ظهرت في المستقبل مصادر جديدة للدخل القومي مثل الطاقة الشمسية التي يمكن للبلاد الصحراوية في النطاق شبه المداري أن تحقق فيه نجاحا ملحوظا بسبب موقعها الجغرافي ومناخها الحار ومساحات أرضها الشاسعة ..
لكن مع كل ما سبق يظل العنصر البشري هو أساس كل ذلك لأنه لا يمكن لأي نشاط اقتصادي أن يتم بمعزل عن الإنسان المتعلم المدرب .. والاستثمار في الثروة البشرية ليس ترفا أو مسألة اختيارية وإنما أمر تحتمه متطلبات النهضة الحديثة .. وفي هذا العالم تستمد أي دولة قوتها الاقتصادية ومن ثم تأثيرها السياسي من نقطة تميزها التي يجب أن تكون معروفة ..
تبلغ مساحة الأرض المزروعة في مصر قرابة ثمانية ونصف مليون فدان وهو ما يعادل أربعة وثلاثين ألف كيلومتر مربع تقريبا ويشكل ذلك ثلاثة بالمائة من المساحة الكلية للبلاد .. وبذلك تأتي مصر في الترتيب الرابع والستين على مستوى العالم في مساحة الأرض الزراعية فيها والمركز الثامن على مستوى الدول العربية حيث يسبقها كل من السودان والمغرب والجزائر والعراق وسوريا وتونس والسعودية بالترتيب ..
وبذلك تتشابه مصر مع جيرانها في قلة مساحة الأرض المزروعة والتي تشكل في الوطن العربي نسبة أربعة عشر بالمائة فقط .. والسودان هي الدولة العربية الوحيدة التي تتجاوز فيها مساحة الأرض الزراعية مائة ألف كيلومتر أما باقي الدول التي تليها في الترتيب فهي أقل من ذلك .. بينما جيران العرب يختلفون عن ذلك حيث تتجاوز النيجر وأثيوبيا حاجز المائة ألف وكذلك تركيا وإيران تتجاوز المائتي ألف ..
وبالنظر إلى خريطة الوطن العربي نجد اللون الأصفر المميز للصحراء حيث تبدو وديان النيل والفرات كأنها واحات متناثرة في هذا الفضاء الصحراوي القاحل حيث تلعب الجغرافيا والمناخ الدور الأكبر في ثبات نسبة الأرض المزروعة .. ورغم تلقي إسرائيل مساعدات غربية تقنية عالية في مجال الزراعة إلا أنها لم تتجاوز حاجز الأربعة آلاف كيلومتر مربع الذي تملكه الأردن التي تجاورها وتملك نفس ظروفها ..
ولذا يصعب مقارنة الزراعة في الوطن العربي بغيرها من الدول سواء الجيران الأقربين في أفريقيا وآسيا وبالطبع لا مقارنة مع الدول الزراعية الكبرى مثل الصين والهند والولايات المتحدة وروسيا والتي تتخطى مساحة الأراضي المزروعة في كل دولة منها حاجز المليون كيلومتر مربع بينما الوطن العربي كله مجتمع يتجاوز بقليل رقم نصف مليون كيلومتر مربع وهو ما لا يفي باحتياجات الغذاء الأساسية للسكان ..
وفي مصر قرابة ثلاثين ألف كيلومتر أخرى صالحة للزراعة وغير مستغلة أي مقدار مقارب للأرض المزروعة فعليا وهي ما يعني أنها فرصة لإحداث تضاعف في المساحة الزراعية كما يوجد في الوطن العربي نفس النسبة والتي تبلغ قرابة ثلاثة عشر بالمائة من المساحة الكلية لكنها تحتاج للمياه .. لكن حتى مع الزيادة المرتقبة فإن حقائق الجغرافيا تخبرنا بوضوح أن كل سكان المنطقة هم فعليا أبناء الصحراء ..
والبشر يعيشون جميعا في كوكب واحد حيث تأتي قضية البيئة على رأس الأولويات .. ماذا لو قررت البرازيل إزالة الأشجار في الغابات المطيرة في حوض نهر الأمازون والاستفادة منها في تجارة الأخشاب .. يرى بعض العلماء أن هذا الأمر شديد الخطورة لأن هذه الغابات تمد كوكب الأرض بنسبة 16 % من الأوكسجين بينما يرى علماء آخرون أنها نسبة مبالغ فيها وأنها لا تتعدى 8 % فقط لكنهم يحذرون من أن تحذو دول أخرى مثل الكونغو وإندونيسيا نفس النهج مما يعني أن يفقد كوكب الأرض (رئة) هامة يتنفس بها ..
وفي أعقاب قمة الأرض في ريو دي جانيرو ألزمت الأمم المتحدة الدول الصناعية بخفض انبعاثات الغازات الضارة والبحث عن مصادر نظيفة للطاقة لأنها أدت إلى ارتفاع درجة حرارة الكوكب .. وتم إقرار ذلك بشكل عملي من خلال بروتوكول كيوتو ثم اتفاقية باريس للمناخ وتبع ذلك تعهد الدول الكبرى بمساعدة الدول النامية في مجال دعم تقنيات الحد من التلوث ومكافحة الأضرار البيئية وهو ما يعرف باسم (آلية التنمية النظيفة) ..
ويسعى العالم سعيا جادا للبحث عن الطاقة النظيفة ومنها الطاقة الشمسية وهو ما سيجعل الدول الصحراوية في النطاق شبه المداري ذات موقع استراتيجي في المستقبل بسبب مناخها الملائم .. ولم تعد المسألة ترفا بل ضرورة ملحة للحفاظ على سلامة الكوكب لأن حجم التلوث تجاوز حد الأمان وأصبح الضرر في كل مكان .. عوادم السيارات وأبخرة المصانع والنفايات الكيماوية وهي تلحق الضرر بالإنسان والغلاف الجوي معا ..
وقد تسببت حادثة واحدة في الإضرار بالعديد من البلدان عندما انفجر مفاعل تشيرنوبل النووي في أوكرانيا السوفيتية حيث تسببت الإشعاعات النووية في إلحاق الضرر المباشر بالإنسان والحيوان والنبات وتلوث الغذاء والمياه حيث مات ثمانية آلاف شخص وتعرض مئات الآلاف لآثار لاحقة منها الإصابة بالسرطان .. وقامت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إثر ذلك بعمل برامج إلزامية للإنذار المبكر والمساعدة في مجال السلامة النووية ..
وخلال أزمة كورونا تبين بوضوح أهمية التكاتف العالمي لأن مشكلة صغيرة في بلدة نائية في أقصى الشرق يمكنها أن تتسبب في موت مئات الآلاف في الغرب ولم يعد من الممكن أن تعيش دولة ما في عزلة عن الآخرين وإلا أدى ذلك إلى انهيار الاقتصاد القائم أساسا على التجارة المتبادلة وتدفق حركة السلع والخدمات .. ولهذا قامت الدول الغنية بإمداد الدول الفقيرة باللقاحات اللازمة بعد أن روج إعلام العالم الثالث أن كورونا مجرد دور برد !!

العلم ركيزة التنمية
الدولة القوية هي (دولة العلم) حيث تعتمد في إدارة مقدراتها ومواردها على البحث العلمي الحقيقي حيث يجب أن تكون مرتبات العلماء والباحثين على اختلاف تخصصاتهم هي أعلى مرتبات في الدولة قبل الوزراء والمحافظين لأن الهدف الحقيقي هو التخلص من ثقافة (الفهلوة) والتحول إلى ثقافة (المنطق) في التعاطي مع العلم.
وأول مقوم يجب توفره لتحقيق مناخ علمي جاد هو (الحرية) التي تشكل الأرضية التي ينمو فيها البحث العلمي الحقيقي إذ لا يوجد تقدم علمي من دون إتاحة الفرصة الكاملة للخيال والإبداع والتجديد والابتكار في كل المجالات دون قيود أو عوائق ، بعد ذلك يجب توفر (الإرادة) حيث يجب أن يكون البحث العلمي في بؤرة تفكير الدولة التي يجب أن توفر له الميزانية التي يستحقها وذلك في نطاق عمل جميع الوزارات حيث يجب أن تكون أحد أهم أولويات الحكومة.
بعد ذلك تأتي (الإدارة) والتي تعتمد على وجود رؤية واضحة لتنظيم العلاقة بين الإنتاج وسوق العمل والتعليم والبحث العلمي لأنها جميعا تعتمد على بعضها البعض لضمان نجاح منظومة التنمية الشاملة والمستدامة ، أما أهم المقومات على الإطلاق فهو (التعليم) لأنه الرافد الأساسي للبحث العلمي وحجر الزاوية الذي تعتمد عليه أي نهضة علمية ويجب أن يتم تطوير منظومة التعليم بصورة تسمح باكتشاف المواهب العلمية في سن مبكرة ورعاية الفائقين رعاية خاصة مثلما يفعل النحل عندما يقدم غذاء الملكات للأميرات الصغار.
والعلم الحديث هو الركيزة الأهم في الحضارة المعاصرة وكل فروع العلم التطبيقي هامة على صعيد التنمية الاقتصادية والحياة الاجتماعية للشعوب والدول ، لكن بعض العلوم سوف تكون حاضرة في المستقبل القريب أكثر من غيرها بما سوف تصنعه من تغييرات ملموسة وهو ما سيجعل المنافسة تحتدم للاستثمار في هذه المجالات دون غيرها وربما تتحدد مقاييس التقدم والتأخر للدول بناء على درجة مشاركتها في هذه المجالات ..
في مجال البيولوجي تأتي علوم الجينات والهندسة الوراثية لتفتح بابا واسعا لعلاج الكثير من الأمراض وعلى رأسها زراعة الأعضاء وأبحاث الخلايا الجذعية والاستنساخ بالإضافة إلى معرفة الخريطة الجينية للشعوب وارتباطها بالاستجابة للأدوية وتأثرها بالأوبئة ، وكذلك تطبيقاتها في مجال الزراعة والإنتاج الحيواني وهو ما يعني طفرة في مجال التغذية الصحية بالإضافة إلى زيادة القدرة على مقاومة الآفات وحماية البيئة ..
وفي مجال الفيزياء تأتي علوم الطاقة في المرتبة الأولى حيث تلعب الموجات الكهرومغناطيسية دورا حيويا في مجال الاتصالات وفي تطوير الملاحة الجوية والبحرية والبرية ، وعندما توجد حلول عملية لتخزين ونقل الطاقة بشكل فعال سوف تعمل كل السيارات ووسائل النقل بالكهرباء بدلا من البترول حيث يتم الاعتماد فيها على الطاقة الشمسية مما سيجعل البلاد الصحراوية الحارة مصدر الطاقة الأهم في العالم ..
وفي مجال الحاسبات سوف يحتل الذكاء الصناعي درجة متقدمة حيث الاعتماد الكبير عليه في معظم مجالات الحياة وهو ما ينذر بتغيرات كبرى في نمط الحياة والسلع والخدمات وتأثير ذلك على الوظائف حيث يقل الاعتماد على العمالة البشرية تدريجيا ، وسوف يلعب الذكاء الصناعي دورا كبيرا في عالم المال ورواد الأعمال والتخطيط الاستراتيجي للشركات والدول حيث المعركة الكبرى حول المعلومات والبيانات وتوظيفها ..
ورغم أن الكيمياء هي أم العلوم وأساس الصناعة إلا أن فرعا منها سوف يظل في الصدارة وهو الكيمياء النووية التي أثبتت فعاليتها في الاستخدامات السلمية لكن امتلاكها وتطويرها سوف يكون للأغراض العسكرية لأن السلاح النووي حتى الآن هو الأكثر فتكا والأشد ردعا ، ومن المتوقع أن تسعى دول كثيرة لامتلاك السلاح النووي للدفاع عن مقدراتها ومكتسباتها في ظل الصراع الشرس بين القوميات على الأرض والموارد ..
وكل مجالات البحث العلمي هامة سواء الطب أو الهندسة أو البيولوجيا أو العلوم الطبيعية أو العلوم الإنسانية حيث يتنافس العالم أجمع في هذا المضمار الذي هو أساس نهضة الأمم .. لكن في الدول النامية يجب أن تكون أولوية الإنفاق في مجال البحث العلمي موجهة إلى الجانب التطبيقي من العلم وذلك بهدف دعم الإنتاج وتحسين الخدمات والتنمية المستدامة ..
وهناك حاجة ملحة للاستفادة من تطبيقات البحث العلمي الجاد في مجال خلق الوظائف (الإنتاجية والخدمية) ثم في مجال دعم الصناعة وزيادة التصدير .. وليست العبرة بكثرة حاملي الشهادات المتخصصة (الماجستير والدكتوراه) والتي تحولت إلى مجرد مسوغات للتعيين والترقي في المؤسسات المختلفة لكن على أرض الواقع لا يوجد إسهام علمي تطبيقي ملموس ..
ومن المفترض أن تلعب الجامعات دورا حيويا في مجال البحث العلمي لكنها منفصلة عن الجانب التطبيقي العملي ويغلب عليها الأداء الروتيني والإنجازات الوهمية .. أما دور الجامعات في إعداد الخريج لسوق العمل فهو أيضا يحتاج إلى إعادة نظر من ناحية الكم والكيف .. بمعنى هل يوجد في سوق العمل احتياج لكل هؤلاء الجامعيين خاصة خريجي الكليات النظرية ..
هذا من ناحية الكم .. أما الكيف فهو يحتاج أيضا إلى الإجابة على تساؤل هام وهو مدى نجاح الجامعات في إعداد الخريج لوظيفته المستقبلية بفرض وجود فرص عمل متوافقة مع الدراسة .. وهناك مجالات عديدة أصبحت تتطلب إجادة اللغات الأجنبية وعدد من المهارات اللازمة للانخراط في سوق العمل وإلا صار التعليم الجامعي غير ذي جدوى ولا منفعة ..
وربما احتاج الأمر إلى نظرة موضوعية شاملة في منظومة التعليم الجامعي لتحديد الهدف منها بدقة ومعرفة المخرجات المطلوبة منها سواء في البحث العلمي أو إعداد الخريجين .. ولا بد أن تشمل هذه الرؤية إعادة النظر في منظومة التعليم الفني والارتقاء بها من ناحية الدراسة والتدريب لأنها مكملة لاحتياجات السوق الفعلية وأقرب إلى الأهداف الواقعية ..
في فيلم (قصة ممنوعة) يذهب القروي البسيط إلى قريبه المحامي (محمود المليجي) ليتوسط في إدخال ابنه الحاصل على شهادة الإعدادية إلى الجامعة فيخبره في سخرية أن هذه الشهادة لا تصلح لدخول الجامعة وإنما يمكن أن يتقدم بها إلى الخانكة وسوف تقبله هو وابنه معا ، وفي فيلم (درب الهوى) أيضا يذهب الأعيان إلى أحد الباشوات المسئولين (حسن عابدين) ليتوسط في تعيين ابنهم في وظيفة وكيل نيابة وعندما سألهم عن شهادة ليسانس الحقوق قالوا ببساطة : ” ما هو لو كان معاه شهادة مكناش جينا لك ” !!
ودائما ما يردد الفاشلون عبارة (بلد شهادات صحيح) التي أطلقها عادل إمام في مسرحية سيدتي الجميلة باعتبار أن أساس العلم هو الفهلوة والنصاحة وأن النجاح المهني معتمد على الخبرة واللباقة في دعوة صريحة للتقليل من قيمة الشهادة العلمية ، ويضرب بعضهم مثلا بعدد من كبار الأدباء والكتاب نجحوا واشتهروا دون الحصول على شهادات وهو الأمر الجائز في مجالات التعبير الأدبي والإبداع الفني والمرتبطة بالعلوم الإنسانية ذات الطابع النظري البحت حيث التباين الطبيعي في وجهات النظر ..
أما العلوم التطبيقية التي تعتمد نتائجها على التجربة العملية في المختبرات والمعامل ويتحدد على أساسها مخرجات عملية فهناك ضوابط تحكم ذلك منها التخصص والدراسة والحصول على شهادة مؤهلة حسب الدرجة العلمية وفق نظام صارم ومحدد ، ويعرف جميع الباحثين الجادين ماذا يعني ذلك عند التقدم للالتحاق بالجامعات الأمريكية والأوروبية حيث الأساس هو الشهادة التي تؤهلك لشهادة أعلى منها وهكذا خاصة إذا كان في مجال البحث العلمي وفي تخصصات تقنية وتجريبية ..
والمنتج البحثي يجب أن يكون نتاج جهد شخص متخصص يدرس ويجري تجاربه تحت إشراف مباشر من أساتذة وعلماء مؤهلين وفي مؤسسة بحثية أو تعليمية معروفة وينشر نتائج أبحاثه في مجلات علمية محكمة خاصة بكل مجال ، وكل ذلك بالطبع لا يوجد في موجة أبحاث الجينات الحالية التي يتنافس فيها نشطاء وسائل التواصل والذين يجرون تجاربهم المضحكة على أزرار الكيبورد وخلف شاشة الكمبيوتر ثم يعلنون في لهجة قاطعة لأتباعهم صحة قناعاتهم وأفكارهم المسبقة ..
أما على مستوى التخطيط بعيد المدى فإن الأفكار النظرية وحدها مهما بدت خلابة لا تصلح لبناء تنمية جادة وحقيقية ، وإذا ظلت هذه الأفكار بعيدة في برجها العاجي عن الواقع وتعقيداته فسوف تظل قابعة في خانة الشعارات وعقول الحالمين وخيال الأدباء وصفحات التواصل الاجتماعي ، وقد علمنا التاريخ أن التنمية قرينة السياسة التي هي فن التعامل مع الواقع والاشتباك مع الأحداث ومحاولة حل المشكلات وتغيير الحاضر إلى مستقبل أفضل من كافة النواحي وهو ما يطرح عدة أسئلة حتمية تحتاج إلى إجابات ..
ما هي الرؤية الاقتصادية لتحقيق المصالح المباشرة للمواطن وإدارة التنمية المستدامة على مستوى البيئة المحلية والدولة ككل ، وبصورة أبسط ما هو النموذج الذي يجب أن نسير عليه من بين نماذج الدول الناجحة التي تقاربنا في الظروف الاقتصادية والسياسية أو كانت تشبهنا في فترة ما ، وهل سيكون الهدف هو تطوير الصناعة التي هي عماد التقدم وما يتبعها من إجراءات حمائية أم نتحول إلى سوق استهلاكية ذات مظهر براق بدون إنتاج ..
ما هو الموقف من الحريات العامة والخاصة وهل هناك إيمان كامل بالحرية المطلقة ودور مؤسسات القطاع الأهلي أم ستكون الحرية انتقائية وفق الأهواء والمصالح والانتماءات الضيقة ، وهل سيكون هناك إقرار بالحريات السياسية مع وضع قيود على الحرية الفردية سواء حرية الاعتقاد أو حرية الرأي أو الملبس أو السلوك ، أم سيكون العكس حيث الإقرار بالحريات الاجتماعية لكن مع تقييد الحرية السياسية للمخالفين والقبول بقمعهم ..
ما هي النظرة إلى فكرة المواطنة ودولة القانون وما يتبعها من حقوق وواجبات متبادلة بين الأفراد مع الدولة وبعضهم مع بعض ، وذلك يعني بالتبعية التساؤل عن مدى الإيمان بدولة المؤسسات وما هو دور هذه المؤسسات بالتحديد ومدى موافقتها للتطور الحادث في العالم الحر ، ويلي ذلك التساؤل عن احترام الدستور والإيمان بحقوق الإنسان والديموقراطية والمساواة المطلقة للجميع أمام القانون وسيادة قيم العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية ..
ما هو مفهوم الهوية الوطنية التي تشكل الإطار العام للدولة والمجتمع وتحدد للوطن علاقاته وانتماءاته ودائرة الأمن القومي الخاصة به ، وما مدى اتساقها مع الثقافة المحلية السائدة في البلاد وتيارات الأغلبية الاجتماعية فيها وطبيعة النشاط الاقتصادي للسكان والتطور السياسي للدولة في تاريخها الحديث ومواقفها الوطنية المعروفة ، ويتبع ذلك التساؤل عن مدى الإيمان بالتنوع الثقافي والسكاني والقبول بفكرة التعايش المشترك تحت الهوية الجامعة ..
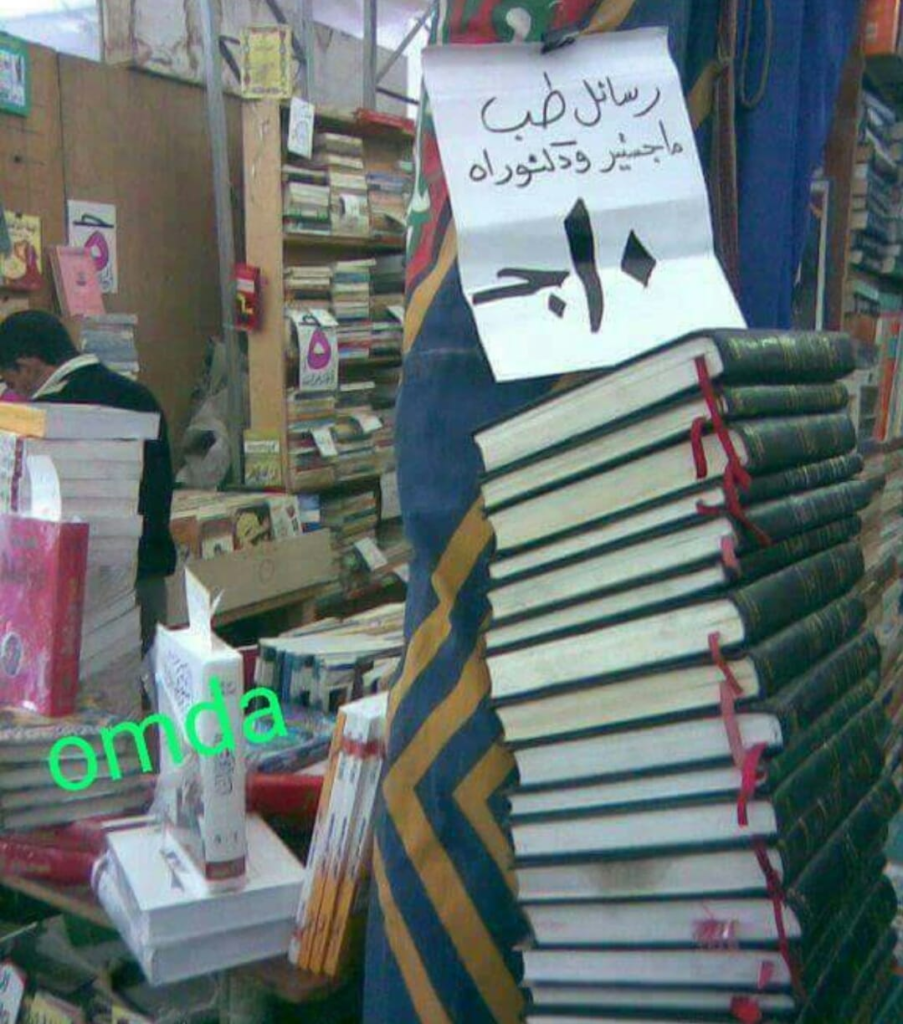
الصحة والتعليم
هل الصحة حق من حقوق المواطن أم هي خدمة تقدم بمقابل .. والسؤال بصيغة أخرى هل تمول الخدمة الصحية من الموازنة العامة بصورة تضامنية أم سيكون كل مواطن مسئولا عن تكلفة ذلك مباشرة أو عن طريق التأمين الطبي .. وبصيغة أخرى هل يكون الطب والعلاج مجاني ومتاح للجميع أم يتحول إلى سلعة تقدم لمن يدفع ويحرم منها غير القادر .. وبصيغة أخرى هل يحصل قسم من المجتمع على الخدمة الصحية في ظروف مثالية بشكل طبيعي ويحصل عليها قسم آخر عن طريق التبرعات والصدقات ونفقة الدولة ؟؟
السؤال صعب والإجابة عليه أصعب بسبب حساسية ملف الصحة والخدمة الطبية والدوائية وارتباطها بحياة المواطنين بشكل مباشر .. وقد علمتنا التجارب أن الضرر في المرض متنقل مثلما حدث في أزمة كورونا لذلك فإن علاج جارك هو علاج لك ومشاركة الغني في علاج الفقير من الناحية البراجماتية البحتة سوف يعود عليه بالنفع المباشر كما أن مكافحة التلوث فائدة للجميع لأن المجتمع يعيش في سفينة واحدة وأي ضرر في ناحية منها سوف يؤدي إلى عواقب وخيمة في بقية أجزائها ..
ولا يجب أن تتحول الخدمة الطبية إلى سلعة مدفوعة الأجر لكن في نفس الوقت يجب الإنفاق الجيد على التعليم الطبي ورواتب الكوادر الطبية والأدوية والمستلزمات ، العيادات الخاصة تظل فقط لمن يبحث عن الخصوصية والتميز ، وهناك مجالات يجب أن تكون الخدمة فيها حاضرة لحماية الحياة مثل الرعاية الأولية والطب الوقائي والعلاجي والطوارىء والخدمات المكملة والأدوية والمستلزمات مع ضمان الرقابة والجودة والتطوير الدائم في التعليم الطبي والبحث العلمي.
عند التخطيط بعيد المدى للتنمية المستدامة وسط عالم تتسارع فيه وتيرة اللحاق بالمنظومة الرأسمالية يجب أن نتوقف قليلا عند مجموعة من الأسئلة الهامة والمشروعة تتعلق بالصحة والتعليم والبحث العلمي والعمل الأهلي .. يجب أن تكون لدينا إجابات دقيقة وواضحة ومحددة .. هل نختار أن يتم تمويل الخدمة الطبية من خزينة الدولة والناتج القومي أم من خلال منظومة تأمين صحي تتحمل تكلفة العلاج ..
وهل التأمين سوف يكون مرتبطا بالعمالة المنتظمة أم سيشمل القطاعات الريفية والحرفية وماذا عن العمالة الموسمية والفئات التي لا تعمل والمرأة المعيلة ، ومن أين سيتم دعم المؤسسات الصحية الحكومية وما هو مصيرها المستقبلي وهل من المحتمل أن تدخل الخدمة الطبية كلها تحت جناح الخصخصة وبالتالي تحصل طبقات معينة على الخدمة بحكم مستواها المادي ولا يحصل عليها آخرون طبقا لمبدأ (اللي معهوش ميلزموش) !!
السؤال الثاني .. ما هي وظيفة التعليم الجامعي المتوقعة .. هل هي التأهيل لسوق العمل ، وإذا كانت الإجابة نعم فهذا يعني إعادة النظر في منظومة التعليم الجامعي من أساسها حيث يوجد عدد كبير من الكليات النظرية التي تدفع بآلاف الخريجين سنويا دون مراعاة الاحتياجات الحقيقية للاقتصاد ، ومن سيتحمل تمويل ورواتب الجامعات الحكومية المعنية بتخصصات لا تجد عملا بعد التخرج .. هل يرجع نظام الوقف أم تدعم من القطاع الأهلي ..
السؤال الثالث .. ما هي أولوية الإنفاق الحكومي على البحث العلمي .. قطعا الإجابة هي العلوم التطبيقية التي تسهم بشكل مباشر وعاجل في عملية التنمية لأن نصيب البحث العلمي من الموازنة أساسا قليل جدا فيجب توجيه الإنفاق نحو الأكثر فائدة في الجوانب العملية ، ولا شك أن البحث العلمي الحقيقي هو الذي يرتبط بمخرجات عملية يمكن تحويلها إلى سلعة أو خدمة أو تحسين جودة منتج معين وليست أبحاثا نظرية مجردة بعيدة عن الواقع ..
السؤال الأهم .. ما هو دور القطاع الأهلي في عملية التنمية .. وهل ستظل الصورة الذهنية له مرتبطة بالجمعيات الخيرية التي تأخذ من الغني وتعطي المحتاج ، هل يمكن أن نجد مؤسسات أهلية متخصصة في دعم الصادرات مثلا أو تأهيل شباب الخريجين ، وهل يمكن للتعاونيات أن تقوم بهذا الدور بعيدا عن ثقافة التسول التي طغت على كل شيء حتى إن كثيرا من المستشفيات الجامعية والعامة تعلن من فترة عن حاجتها لتبرعات وأصبح الجميع (عايش شحاتة) !!
وعندما يدور الحديث عن التعليم الجامعي وتأهيل الخريجين لسوق العمل فإن المقصد الأساسي هو القطاع الخاص وليس التوظيف الحكومي ، والسبب في ذلك أننا ندور الآن في فلك النظام الرأسمالي والذي تقتصر فيه دور الحكومات على التنظيم والإدارة وليس امتلاك أدوات الإنتاج ، ولازال لدينا فجوة في التفكير حيث السعي للتعيين في الوظيفة الحكومية ذات المرتب الثابت والمعاش المضمون والمستمرة للأبد بحكم قوانين النظم الشمولية القديمة ..
ومع النقلة الإجبارية للاقتصاد وما يصاحبها من آثار جانبية سوف يعاني الموظفون الحكوميون وأصحاب الدخول الثابتة من ارتفاع الأسعار ولا يمكن تعويض ذلك بزيادة الرواتب التي تلتهم موازنة الدولة (الباب الأول) الخاص بملايين العاملين في الدولة ، ولن يتوقف الأمر على ذلك لأن تخفيض الإنفاق الحكومي سوف يكون أمرا ملحا بالإضافة إلى التخلص من الهيكل الإداري المترهل للوزارات والأجهزة الحكومية ..
في الماضي كانت الدولة تحكم قبضتها على قطاع كبير من المواطنين الموظفين في الحكومة لكن غدا سوف يتغير هذا الوضع حيث يتم الاستغناء عن ملايين العاملين ولا يتبقى إلا أقل عدد ممكن يسمح بتسيير دولاب العمل في وزارات محددة ووفق أوضاع جديدة يتم فيها التعيين بصفة مؤقتة ويتم تقييم الموظف كل فترة ، ولن تكون وظيفة الدولة في المستقبل القريب منح وظائف للمواطنين وإنما تنظيم العلاقة بين القطاع الخاص والعاملين ..
سوف يخضع كل شيء لقانون العرض والطلب سواء الأسعار أو الرواتب وسوف يترتب عليه تغيير جذري في التفكير الجمعي للمواطنين وهو ما سيفرض أوضاعا جديدة في التعليم الجامعي الذي سيتحول إلى قطاع خاص مع تبنى الفائقين بالمنح والمزايا ، ويشترط لذلك أن تكون الدولة منتجة وأن يكون فيها خطط بعيدة المدى للتنمية المستدامة والاعتماد على المجالات الصناعية وفتح المجال بجدية للاستثمار المحلي والأجنبي.
في هذه المنظومة سوف تتحقق استقلالية الأزهر فلا يصبح مؤسسة حكومية حيث يجب أن تعود إليه أوقافه التي استولت عليها الدولة من قبل ، ويجب خصخصة مجالات الفنون والثقافة والصحافة والإعلام ويكون تمويلها من المستثمرين أو من القطاع الأهلي ، كل ذلك سوف يصنع تحولات كبرى في علاقة الدولة بالمواطن حيث ستنتهي الدولة الراعية وبدلا منه سوف يكون المواطن هو من ينفق على الحكومة أو يقطع عنها المصروف !!
قطار الخصخصة السريع سوف يلتهم قطاع التعليم العالي وهذا يعني أن عددا من الأقسام وربما كليات كاملة قد تغلق أبوابها لافتقادها مصادر التمويل إذ لا يعقل أن يتم دفع رواتب والإنفاق على مستلزمات لا تخدم سوق العمل فيصير التدريس فيها هدرا للأموال والمقدرات بالإضافة إلى أن البحث العلمي المنتج غير موجود حتى يجذب مصادر تمويل وبالتالي تنعدم أهمية هذا المجال ..
وسوف تكون مصادر التمويل المتوقعة معروفة ومحددة أولها الإنفاق الحكومي المحدود والذي سيذهب بالتبعية إلى القطاعات التي يحتاجها المجتمع بشكل عملي مثل الصحة والتعليم وغيره من المجالات التي لها تطبيق عملي ملموس ومباشر وتكون ملبية لمتطلبات العمل في الوزارات الخدمية وسوف يتم التحكم في هذا المسار بواسطة دافع الضرائب عن طريق ممثليه في المجالس النيابية ..
المصدر الثاني للتمويل هو الشركات ورجال الأعمال وسوف يكون الإنفاق فيها على مجالات تخدم الإنتاج وتحقق مزيدا من التقدم في الاقتصاد خاصة التطبيقات العملية في التقنية وستكون أعداد الخريجين فيه مناسبة لاحتياجات السوق الفعلية ، المصدر الثالث هو القطاع الأهلي ونظام الأوقاف حيث يقوم بتمويل مجالات التعليم الديني وكذلك مجالات الثقافة والإعلام والفنون والصحافة ..
ويظل هناك مصدر التمويل الخارجي مثل مجال دراسة اللغات المدعومة من دول أجنبية أو أن تكون الدراسة مدفوعة الأجر ، لكن حتى مع توفر التمويل لهذه المجالات سواء من القطاع الأهلي أو من المنح الخارجية فإنها لا تضمن للخريج فرصة عمل إلا إذا كان مجال التخصص مطلوبا ، وسوف ينتج عن ذلك فقدان قيمة شهادات التخرج بعد أن تتحول بعض الكليات العريقة إلى متاحف !!
مع خصخصة مجال التعليم العالي سوف يتم ضم قطاع التعليم الطبي إلى وزارة الصحة بحيث تصبح وزارة واحدة هي المسؤولة عن كافة الخدمات الصحية والعلاجية وما يخدمها من متطلبات بشرية ومادية وذلك ترشيدا للنفقات وضمانا للحوكمة ، وهذا سوف يعيدنا إلى السؤال الهام .. من يمول الخدمة الصحية بما فيها التعليم الطبي .. هل من موازنة الدولة أم من خلال نظام تأمين صحي شامل ؟؟
وهذا يحتاج إلى الإجابة على السؤال المتكرر .. من الذي يحدد هل الصحة حق من حقوق المواطن أم خدمة تقدم بمقابل مادي .. هذا يتوقف على رأي الممول وهو الشعب ممثلا في المجالس النيابية ، وعندما يتم الإنفاق الحكومي على قطاع التعليم الطبي بوصفه خدمة من الخدمات المكملة لقطاع الصحة سوف يكون هناك توقع لمردود هذا الإنفاق وهو ضمان المستوى الجيد للخريجين وتدريبهم بشكل جاد وفعال ..
ومن المنطقي حدوث تغييرات شاملة في مجال الدراسة الطبية حيث تصبح الأولوية هي الحصول على شهادة التخصص العملي (شهادة فنية مثل الزمالة) تسمح للطبيب بممارسة المهنة في التخصص المطلوب ، ويتم مراجعة هذه الشهادة كل فترة زمنية مع إمكانية الترقي إلى درجة الاستشاري بالحصول على مزيد من التدريب الدائم والخبرة العملية واجتياز عدد من الامتحانات المستمرة ..
أما الشهادات الأكاديمية مثل الماجستير والدكتوراة فسوف تكون مقتصرة على قطاعات البحث العلمي الممولة لغرض الاستفادة من مخرجات هذا البحث في التطبيقات العملية ولن تكون مسوغة لممارسة المهنة ، وبالتالي فإن الدرجات العلمية مثل مدرس وأستاذ سوف تكون مقتصرة على أعضاء هيئة التدريس المتفرغين للعمل في المستشفيات التعليمية وذلك ضمانا لجودة التدريس والتدريب ..
وسوف تكون الامتحانات الأساسية موحدة على مستوى البلاد لضمان المساواة وعدم تدخل الأهواء في نتائج الخريجين وطلاب الزمالة ، وسوف تكون جميع الوظائف مؤقتة ويتم تجديدها وفق رغبة الطرفين (الوزارة والعاملين) سواء في مجال الخدمة الطبية المباشرة أو التدريس أو البحث العلمي أو الإدارة وذلك وفق شروط محددة للتعاقد منها التفرغ التام والتقييم الجيد والالتزام الوظيفي ..



