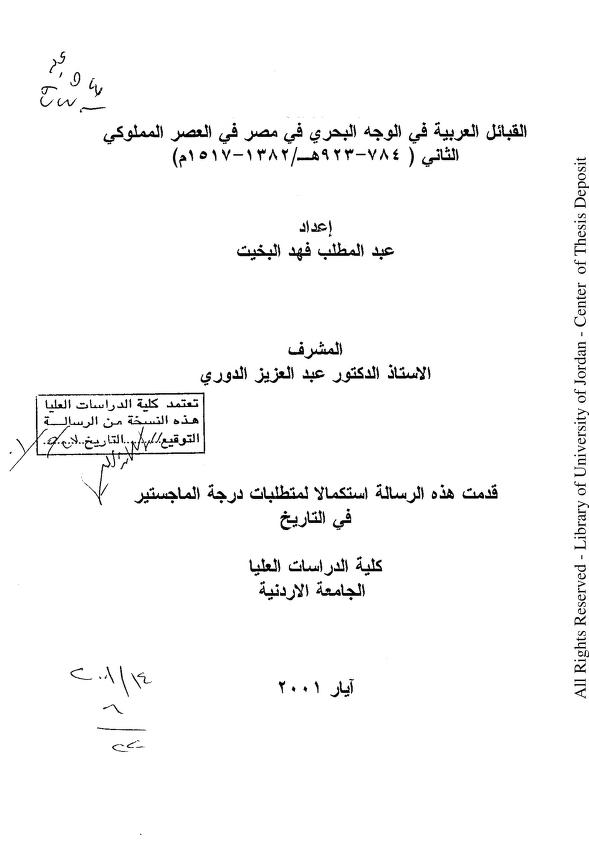
شهد القرن السابع الهجري تحولات خطيرة في العالم الإسلامي بأسره حيث توالت الهجمات من جهات ثلاث ففي المشرق اكتسح المغول ممالك خوارزم شاه في آسيا الوسطى وصارت على تخوم الهضبة الإيرانية وفي المغرب سقطت حاضرة الأندلس قرطبة في يد القشتاليين بعد انهيار دولة الموحدين وفي الوسط تعرضت مصر لحملات صليبية متتالية تصدى لها العرب والمماليك ببسالة فصارت أرض الكنانة محط النظر ومعقد الأمل ، وكان عرب مصر موالين للأيوبيين بسبب عطائهم في مجال الجهاد وما حققوه من انتصارات لكن هذا الموقف تغير مع اعتلاء المماليك سدة الحكم وهو ما فصله الدكتور محمود السيد في كتابه (تاريخ القبائل العربية في عصر الأيوبيين والمماليك) حيث يقول : ” ومن الجدير بالذكر أن العرب سايروا الدولة الأيوبية ولم يخرجوا عليها كما أنهم لم ينقلبوا على سلاطينها أو يثوروا عليهم وكانت سلاطين الدولة الأيوبية من جانبهم يبعثون برسائلهم إلى ولاة الأقاليم يدعونهم فيها إلى اتباع سياسة رشيدة عادلة إزاء جميع المواطنين بلا استثناء في حين افتقد العرب في عصر المماليك هذا النوع من العدالة والظاهر أن السبب في ذلك يرجع إلى أنه عندما أدرك العرب عزم الأمراء المماليك على الاستيلاء على الحكم في مصر أعلنوا معارضتهم لهذا المبدأ ورفضوا قبوله وطالبوا بأن يكون الحكم للعرب “.
وكانت الأحداث الساخنة قد بدأت عقب معركة المنصورة عندما قام المماليك بقتل المعظم تورانشاه الأيوبي وتنصيب شجر الدر ثم عز الدين أيبك حيث دب الصراع بينهم وبين الملوك الأيوبيين في الشام لمدة ثلاث سنوات وانتهى بوساطة الخليفة العباسي بينهما بحيث صارت الشام للأيوبيين ومصر للمماليك مع تنصيب أحد الأمراء الأيوبيين الصغار في منصب سلطان مصر صوريا وذلك لوجود حالة عامة من رفض تولي العبيد للحكم ، وتسببت تلك الصراعات في ضعف موارد الدولة فأقدم المماليك على مصادرة الأموال والماشية من العرب ونزع بعض إقطاعياتهم التي كانت ممنوحة لهم من قبل الأيوبيين وذلك لتعويض ما أنفقوه على المماليك وما دفعوه من رشاوي ليقبل الناس بهم حكاما وهو ما رفضه العرب وقرروا إعلان ثورتهم الكبرى ضد المماليك وقاموا بمراسلة الملوك الأيوبيين في الشام ، وقد تجاوبت القبائل العربية في الدلتا والصعيد لداعي الثورة حيث تجمعت الجيوش العربية في منطقتين إحداهما في الصعيد بالقرب من دهروط والثانية في الدلتا بالقرب من سخا وذلك تحت قيادة قبيلة قريش التي تزعمت هذه الحركة وأطلق على هذا الحلف اسم (الحلف القرشي) والذي ضم معظم قبائل العرب وكذلك عددا كبيرا من القبائل المغاربية الأمازيغية التي نالها ظلم المماليك.
وقد جاء في كتاب البيان والإعراب عما بأرض مصر من الأعراب تحقيق الدكتور عبد المجيد عابدين ما يلي : ” بدأت حركة المقاومة بزعامة الجعافرة الأشراف والتف حولهم عناصر عربية مختلفة ففي سنة 651هـ أي في أوائل حكم المماليك البحرية قاموا بحركة واسعة للمقاومة وفيها ثار العرب ببلاد الصعيد وأرض الوجه البحري وقام الشريف حصن الدين ثعلب بن الأمير الكبير نجم الدين علي بن الأمير الشريف فخر الدين إسماعيل بن حصن الدولة مجد العرب وقال نحن أصحاب البلاد ، ومنع الأجناد من تناول الخراج وصرح هو وأصحابه بأننا أحق بالملك من المماليك واجتمع العرب وهم يومئذ في كثرة من المال والخيل والرجال إلى الأمير حصن الدين ثعلب وهو بناحية دهروط صربان وأتوا من أقصى الصعيد وأطراف بلاد البحيرة والجيزة والفيوم وحلفوا لهم كلهم فبلغ عدد الفرسان اثنى عشر ألف فارس وتجاوزت عدة الرجالة الإحصاء لكثرتهم فجهز إليهم الملك المعز أيبك الأمير فارس الدين أقطاي الجمدار والأمير فارس الدين أقطاي المستعرب في خمسة آلاف فارس فساروا إلى ناحية ذروة فاقتتل الفريقان ، وانهزم حصن الدين واتجه المماليك إلى عرب الغربية والمنوفية من قبيلتي سنبس ولواتة وقد تجمعوا بناحية سخا وسنهور فأقعوا بهم وسبوا حريمهم وقتلوا الرجال وما زال الترك بحصن الدين حتى قبضوا عليه بحيلة انخدع بها وتفرقت سنبس بعد ذلك في الغربية وكان من حلفائها جماعات من بني مدلج وعذرة وقريش “.
ورغم هذا الانتصار إلا أن الأمور لم تصف للمماليك حيث دبت النزاعات بينهم وانتهى الأمر بمصرع أقطاي (كبير المماليك الصالحية) ثم مقتل أيبك وشجر الدر ومن ثم تولي نائب السلطنة وكبير المماليك المعزية المظفر سيف الدين قطز مقاليد الأمور وذلك في توقيت حرج حيث كان المغول قد اكتسحوا العراق وسقطت بيدهم بغداد عاصمة الخلافة الإسلامية ثم استولوا على الشام وأرسلوا رسلهم لتهديد مصر وقد سبقتهم روايات مخيفة عن مذابحهم ووحشيتهم ، ولم يكن أمام قطز إلا تهدئة الأوضاع مع القبائل العربية والمماليك الصالحية لضمان سلامة الجبهة الداخلية حيث تناسى الجميع خلافاتهم واستجابوا لنداء الجهاد في سبيل الله خاصة وقد كانت الفاجعة شديدة بفقد كرسي الخلافة وضياع وحدة المسلمين الرمزية وكانت هذه الحادثة فرصة أمام القبائل العربية لإثبات وجودها على الساحة العسكرية ، ويقول الدكتور محمود السيد : ” واجتمعت قبائل العرب من لخم وجذام وسنبس وبصفة خاصة عرب الشرقية والغربية لقربها من موقع المعركة فاجتمع من العساكر ما لا يحصى .. وفي 15 شعبان 658 هـ (1260 م.) خرجت جيوش المماليك ومن انضم إليهم من أجناد العرب من القاهرة يريدون الصالحية ثم بعثوا بطلائعهم بقيادة ركن الدين بيبرس البندقداري إلى غزة للاستطلاع ” .. وفي 25 رمضان التحمت الجيوش الإسلامية بجيوش المغول في ساحة عين جالوت وألحقت بها هزيمة ساحقة تحت شعار النصر (واإسلاماه).
وكان النصر ثمرة نبذ الفرقة والاتحاد تحت راية الجهاد حيث اعتدل سلوك المماليك وتوقفوا عن أعمال المصادرة والنهب التي اعتادوا عليها في زمن صراعهم مع العرب حيث كان المعز أيبك قد فرض عليهم بذل ما لا يطيقون من الأموال ليكسر شوكتهم في الوقت الذي كانت فيه قصور المماليك ترتع في الترف والنعيم وهو الأمر الذي كاد يوغر الصدور ويبعث الأحقاد الكامنة لولا توفيق الله العلي القدير ، ويرجع الفضل في إنقاذ هذا الموقف إلى رجل عربي أبي مهيب هو عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن حسن السلمي الدمشقي والذي جمع بين العلم والتصوف فكان شيخ المذهب الشافعي في زمنه وفي نفس الوقت تلميذا لواحد من أهم رجال التصوف وهو السيد أبو الحسن الشاذلي .. وقد شارك بنفسه في معركتي المنصورة وعين جالوت .. واستحق عن جدارة اللقب الذي أطلقه عليه تلميذه قاضي القضاة تقي الدين ابن دقيق العيد والذي اشتهر به وصار علما عليه وهو لقب (سلطان العلماء) .. وقد حسم الشيخ العز بن عبد السلام الجدل الذي دار في بلاط الملك المظفر قطز والذي قرر وقتها فرض ضرائب على عامة الناس وحدهم دون الأمراء لمواجهة التتار الذين كانوا على أبواب مصر .. وقد قبل السلطان بالفتوى وبدأ بنفسه فباع كل ما يملك وأمر الوزراء والأمراء أن يفعلوا ذلك فانصاع الجميع وامتثلوا لأمره وجُمعت هذه الأموال فضُربت سكاً ونقداً وأنفقت في تجهيز الجيش لمحاربة التتار في معركة عين جالوت ..
وقال حينها عبارته الحاسمة : ” إذا طَرَقَ العدوُّ بلادَ الإسلام وجب على العالَم قتالُهم .. وجاز لكم أن تأخذوا من الرعية ما تستعينون به على جهادكم بشرط أن لا يبقى في بيت المال شيء من السلاح والسروج الذهبية والفضية والكبابيس المزركشة وأسْقاط السيوف والفضة وغير ذلك وأن تبيعوا مالكم من الحوائص الذهبية والآلات النفيسة ويقتصرَ كلُّ الجند على سلاحه ومركوبه ويتساووا هم والعامة .. وأما أخذ الأموال من العامة مع بقايا في أيدي الجند من الأموال والآلات الفاخرة فلا ” ، ولم تكن هذه أول مرة يصدح فيها هذا العالم الجليل بكلمة الحق ففي الشام واجه الملك الأشرف موسى الذي كان منحازا إلى المتشددين من الحنابلة ثم واجه الصالح إسماعيل الذي تحالف مع الفرنجة حيث أفتى بالخروج عليه فتم اعتقاله وبدأت معه مساومات حيث طلب منه أن يعتذر ويقبل يد الصالح فأجاب في قوة : ” يا مسكين .. ما أرضاه أن يُقبل يدي فضلاً أن أقبّل يده .. يا قوم أنتم في وادٍ وأنا في وادٍ والحمد لله الذي عافاني مما ابتلاكم به ” .. وفي مصر واجه سطوة المماليك وأصر على إبطال معاملاتهم حتى يقوم الصالح نجم الدين ايوب بعتقهم فاستجاب السلطان للأمر وواجه نائب السلطنة الأمير معين الدين بن شيخ الشيوخ عندما بنى قاعة للهو فوق سطح أحد المساجد .. وكان ينادي على السلطان باسمه مجردا : ” يا أيوب ” رغم أن الملك الصالح هو الذي أخرجه من السجن وولاه القضاء .. ولم يقبل تولي بيبرس السلطنة ويعترف بشرعيته إلا بعد أن أحضر ما يثبت عتقه ..
وكانت السلطنة قد آلت إلى الظاهر بيبرس بعد أن قتل قطز في أعقاب معركة عين جالوت وكان لديه من الحنكة السياسية ما ثبت به أركان ملكه وقضى به على النزاعات الداخلية حيث استقبل البيت العباسي في القاهرة فصار يملك ورقة الشرعية وأسكت بذلك كل دعوى للقبائل العربية أو دعاة التشيع حيث صار يملك تفويضا رسميا من الخلافة بإدارة الأمور فضلا عن تميزه بذلك عن سائر ملوك المسلمين لأنه صار سلطانا للقاهرة التي غدت مقر الخلافة في العالم حيث الزعامة الروحية لقبيلة قريش لا تزال تتمتع بأهمية قصوى من الناحية الفقهية والعملية ، ويحكي عن ذلك السيوطي في كتابه حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة فيقول : ” فلما كان في رجب من هذه السنة قدم أبو القاسم أحمد بن أمير المؤمنين الظاهر بأمر الله وهو عم الخليفة المستعصم وأخو المستنصر وقد كان معتقلا ببغداد ثم أطلق فكان مع جماعة من الأعراب بالعراق ثم قصد الملك الظاهر حين بلغه ملكه فقدم عليه الديار المصرية صحبة جماعة من أمراء الأعراب عشرة منهم الأمير ناصر الدين مهنا وكان دخوله إلى القاهرة في ثاني رجب فخرج السلطان للقائه ومعه القاضي تاج الدين والوزير والعلماء والأعيان والشهود والمؤذنون فتلقوه وكان يوما مشهودا وخرج اليهود بتوراتهم والنصارى بإنجيلهم ودخل من باب النصر بأبهة عظيمة .. “.
ويصف السيوطي يوم البيعة والتفويض قائلا : ” فلما كان يوم الإثنين ثالث عشر رجب جلس السلطان والخليفة في الإيوان بقلعة الجبل والقاضي والوزير والأمراء على طبقاتهم وأثبت نسب الخليفة على القاضي تاج الدين فلما ثبت قام القاضي قائما وأشهد على نفسه بثبوت النسبة الشريفة ثم كان أول من بايعه شيخ الإسلام عز الدين بن عبد السلام ثم السلطان الملك الظاهر ثم القاضي تاج الدين ثم الأمراء والدولة وركب في دست الخلافة بمصر والأمراء بين يديه والناس حوله وشق القاهرة وكان يوما مشهودا ولقب المستنصر بلقب أخيه وخطب له على المنابر وضرب اسمه على السكة وكتبت ببيعته إلى الآفاق وأنزل بقلعة الجبل هو وحشمه وخدمه فلما كان يوم الجمعة سابع عشر رجب ركب في أبهة السواد وجاء إلى الجامع بالقلعة فصعد المنبر وخطب خطبة ذكر فيها شرف بني العباس ودعا للسلطان ثم نزل فصلى بالناس وكان وقتا حسنا ويوما مشهودا .. ثم في يوم الإثنين رابع شعبان ركب الخليفة والسلطان والقاضي والوزراء والأمراء وأهل الحل والعقد إلى خيمة عظيمة قد ضربت ظاهر القاهرة فألبس الخليفة السلطان بيده خلعة سوداء وعمامة سوداء وطوقا في عنقه من ذهب وقيدا من ذهب في رجليه وفوض إليه الأمور في البلاد الإسلامية وما سيفتحه من بلاد الكفر ولقبه بقسيم أمير المؤمنين وصعد فخر الدين بن لقمان رئيس الكتاب منبرا فقرأ عليه تقليد السلطان “.
وقد رأى بيبرس والمماليك من بعده أن يستفيدوا من طاقة بعض القبائل العربية وضمها إلى حوزتهم بدلا من أن يكونوا شوكة في جانبهم فضموهم إلى الجيش ومنحوهم الإقطاعيات حيث يسرد ذلك الباحث عبد المطلب فهد البخيت في كتابه (القبائل العربية في الوجه البحري في مصر في العصر المملوكي الثاني) وذلك نقلا عن القلقشندي وابن فضل الله فيقول : ” منح سلاطين المماليك الإقطاعات لزعماء القبائل العربية الداخلين في طاعتهم واعتبروهم من رجال السيف المقطعين طالما التزموا بأداء ما يوكل إليهم من واجبات نظير حصولهم على هذه الإقطاعات .. وتجلت هذه الواجبات في أمرين : الأول أدبي ويتمثل بقيام المقطع بأداء يمين الولاء للسلطان بوصفه ولي الأمر القائم والثاني مادي ويتمثل بأداء الخدمة العسكرية والقيام بأعمال حفظ الأمن والإسهام في تسهيل النقل والاتصال بين أطراف الدولة وتقديم خيول البريد وأداء الالتزامات المالية المتعلقة بالإقطاع علاوة على إرسال التقادم السنوي من الخيول والجمال .. وظلت كافة الحقوق الأدبية والمادية مكفولة لأمراء القبائل العربية شريطة وفائهم بهذه الالتزامات فكانوا يخاطبون بأسلوب معين وبألقاب خاصة مثل (يعلم مجلس الأمير) و (إلى المجلس السامي الأميري) .. وتشير المعلومات إلى أن أمراء القبائل العربية في الوجه البحري التزموا بواجباتهم وشاركوا الدولة خاصة في حروبها مع التتار والعثمانيين وقدموا فرسانهم وخيولهم وجمالهم للدولة في تلك الحروب كما قاموا بأعمال الحراسة وحفظ الأدراك ووفروا خيول البريد وساعدوا رجال الدولة في تحصيل الخراج “.
ويسرد الباحث توزيع إقطاعات القبائل العربية في الوجه البحري على النحو الآتي : في الشرقية كانت إقطاعات بني سعد في تل طنبول ونوب طريف ودقدوس ومنية غمر ودمريط وكان إقطاع بني زيد بن حرام وهم هلبا مالك وهلبا سويد وهلبا بعجة في فاقوس وتل محمد وقسم من أراضي هربيط تعرف بالأحراز .. في القليوبية إقطاع معبد بن منازل وهو من زعماء حيادرة بني الوليد بن سويد في (منى خثعم) وإقطاعات فزارة في زفيتة وسندبيس وقلقشندة .. في دمياط إقطاع بني عدي وبني كنانة في المنطقة الواقعة بين دمياط وساحل البحر وفي البرلس .. في الدقهلية والمرتاحية إقطاع الشواكرة في شنبارة بني خصيب وعدلان وفي كوم بني مراس وإقطاع الزهور في أشموم الرمان أما الحيادرة فكانت إقطاعاتهم في البرمونين وما حولها .. في الغربية إقطاع الخزاعلة في نواحي سخا ودرسة وبطرة .. في المنوفية إقطاع الأمير حجازي بن بغداد في البلدة المعروفة باسم (قصر بغداد) في جزيرة بني نصر .. كما كانت البلدة المعروفة باسم (منى واهلة) مقطعة لزعماء بني واهلة إحدى بطون لبيد .. وكانت إقطاعات القبائل من زنارة ومزاتة وخفاجة وهوارة ولبيد في المنطقة الواقعة بين الإسكندرية وبرقة فكانت إقطاعات أولاد مقدم وأولاد التركية فيما بين الإسكندرية والعقبة الكبرى من برقة وكانت إقطاعات جماعة سلام (وهم فزارة ومحارب وقطاب) ما بين العقبة الكبرى وبرقة .. وفي البحيرة كان إقطاع بني عونة إحدى بطون لبيد في العطف وفي فوة وما حولها.



