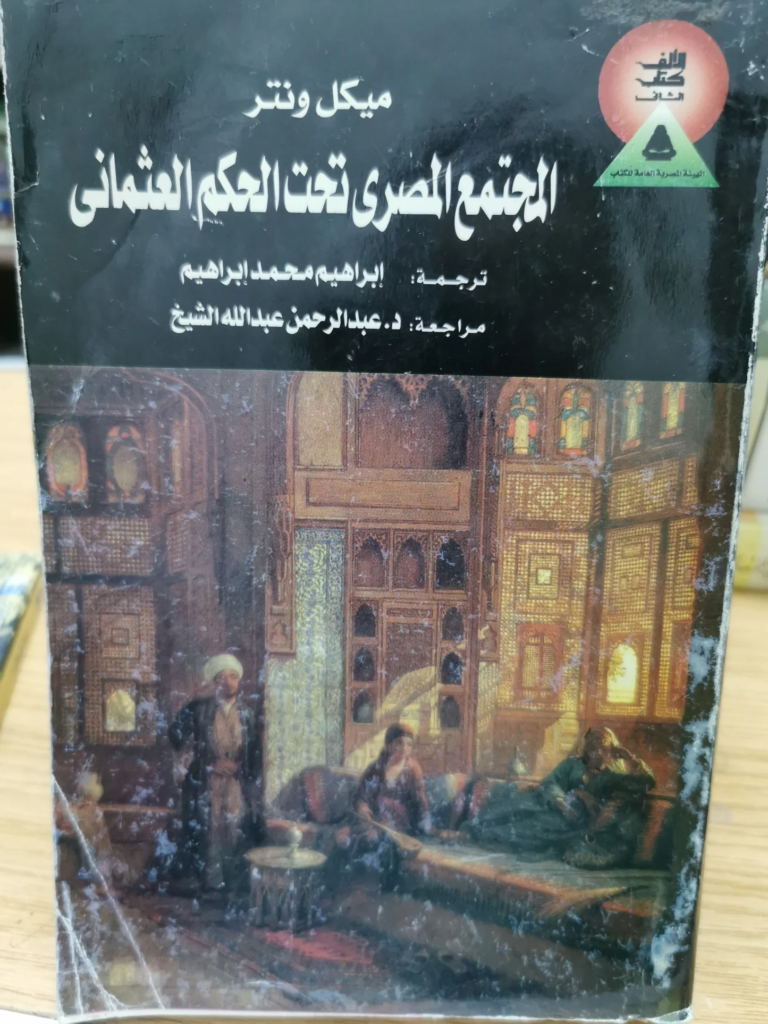
من وجهة النظر الحضارية لا يمكن مقارنة عصر المماليك بعصر العثمانيين ففي عصر المماليك كانت مصر مركزا لدولة إمبراطورية هي الأهم في العالم الإسلامي وشهدت نهضة اقتصادية ليس لها مثيل وحققت انتصارات عسكرية خلدها التاريخ وتركت آثارا معمارية هي درة القاهرة الإسلامية وشهدت حياة عدد كبير من العلماء والأدباء في كافة المجالات ، وعلى النقيض من ذلك كانت الحقبة العثمانية خالية من أي عطاء حضاري سواء في الجانب المعماري أو الثقافي أو العسكري وكانت مصر فيها ولاية تابعة لغيرها وعانت من مشكلات اقتصادية عديدة لكن من زاوية أخرى فقد كانت الأوضاع الاجتماعية لمكونات المجتمع في حالة أفضل من عصر المماليك بسبب توازن القوى بين هذه المكونات وبعضها البعض ، وسبب ذلك أن العثمانيين لم يقضوا على النظام المملوكي وإنما فقط كسروا شوكة المماليك وأخضعوهم لسلطانهم ومنحوا للعرب وضعا أفضل مما كانوا عليه في العصر المملوكي لكن بقدر لا يسمح لهم بالاتحاد ولا الاستقلال حيث أوكلت إليهم السلطات حكم الأرياف لكن تحت قيادة مملوكية في عواصم الأقاليم وبذلك تم إبعاد الطرفين معا عن القاهرة التي صارت في حماية جنود الإنكشارية العثمانيين وهو ما جعل القبائل العربية تلجأ لعمل تحالفات محلية فيما بينها للحفاظ على التوازن القائم مع قوة المماليك والعثمانيين فيضمن لهم الحماية الكافية من أي بطش يشبه ما كان يحدث من قبل في العصر المملوكي.
وذكر ابن زنبل الرمال تكليف شيوخ العرب الكبار بتولي الإمارة في نواحي مصر فيقول (خلع السلطان سليم بعد دخوله القاهرة على شيخ العرب حماد شيخ عزالة بإقليم البحيرة وجاء إليه الأمير علي بن عمر شيخ هوارة فخلع عليه بإمارة الصعيد بمدينة جرجا وخلع على علم الدين شيخ بني عدي وكتب لهم التوقيع بذلك وخلع عليهم وانصرفوا) ، وذكر بالتفصيل المراسلات العديدة والتفاويض والهدايا والمنح المتبادلة بينهما ، وكان الشيخ علم الدين بن محمود دقيلة واحدا من شيوخ معدودين تلقوا تكليف الإمارة من السلطان سليم بنفسه في أثناء وجوده في مصر حيث يستفاد من نص ابن زنبل أن شيخ بني عدي كان يحكم الصعيد الأوسط بين هوارة جنوبا وعرب عزالة شمالا أي أن حدوده كانت من أول بني عدي الشمالية (مركز بني سويف حاليا) وحتى سوهاج جنوبا عندما يبدأ نفوذ هوارة ، وكان الشيخ علم الدين العدوي قد أصدر تعليماته للقبائل التابعة له بالوقوف على الحياد بين المماليك والعثمانيين بعد أن حشد قواته لضبط الأمن في المناطق الخاضعة له تحسبا للفوضى الناجمة عن دخول العثمانيين مصر وربما كان ذلك بناء على مراسلات سرية بين زعماء العشائر والسلطان سليم كما ذكر قيت الرحبي في حديثه للسلطان طومان باي وهو يشرح له مبررات تخلي العرب عنهم وهو ما صار أمرا واقعا بتولي الشيوخ مرتبة الإمارة.
ويشرح ذلك كتاب (المجتمع المصري تحت الحكم العثماني) من تأليف مايكل ونتر وترجمة إبراهيم محمد إبراهيم حيث جاء فيه : ” وكان مجتمع العرب البدو في مصر العثمانية يتكون من تنويعة كبيرة من القبائل والعشائر ولم يكن ثمة شيء كثير تشترك فيه سوى التنظيم القبلي وادعاء الأصل العربي لذا فإن من التعميم فيما يتعلق بالعرب من السهل أن يوقعنا في الخطأ وعلى سبيل المثال بينما كانت بعض القبائل أو العشائر تشتهر بأنها من قطاع الطرق والمتمردين فإن آخرين كانوا معروفين بالطاعة والخضوع ويقدمون خدمات حيوية للحكومة بل إن القبيلة الواحدة كان يمكن أن تضم كلا من المشايخ الموالين والمتمردين والأكثر من ذلك كما سيتضح لاحقا فإن نفس القبيلة أو الزعيم يمكن أن يؤيد بالتبادل الحكومة أو بعض الأمراء أو العصبات ويعارضها وفقا للظروف وتشرح هذه البراجماتية (النفعية) التناقض الظاهر في اتجاهات البدو وسياستهم فبالرغم من العداوة بينهم وبين المماليك التي ترجع جذورها إلى استيلاء المماليك على مصر وحكمها في منتصف القرن الثالث عشر إلا أنه توجد حالات من التعاون الوثيق بين هذين المجتمعين الميالين للحرب أثناء مصر العثمانية وبالمثل فإن سلوك العرب نحو العثمانيين لم يكن متسقا ومع هذا فإن هناك قاعدة بديهية للغاية تنطبق على مصر كما تنطبق على غيرها من البلاد وهي أن قوة البدو تعد مؤشرا على قوة الدولة إذ كلما كانت الحكومة قوية كانت القبائل العربية ضعيفة والعكس بالعكس “.
وعلى مدار الحقبة العثمانية كان مركز قوة القبائل العربية يخضع للشد والجذب حسب توازن القوى وأخذ الصراع مع المماليك طابعا إداريا للسيطرة على أكبر قدر من القرى داخل كل ولاية لكنه لم يعد دمويا كما كان في السابق ووصل الأمر في بعض المناطق مثل الصعيد أن يصبح الوالي المملوكي مجرد رمز للدولة بينما السلطة الفعلية بيد مشايخ العرب الذين يغدقون عليه الأموال ويضمنون له رضا العاصمة بالعطايا والمنح ، وكان العثمانيون في أول أمرهم قد أطاحوا بمشايخ العرب المزعجين وأحلوا محلهم موالين لهم من نفس العائلات أو من عائلات أخرى داخل نفس القبيلة خاصة عرب السوالم الذين قاموا بثورة في الشرقية حيث رأى الباب العالي أن أمر الريف لن يستقر إلا إذا اشترك العرب في إدارته فأصدر الصدر الأعظم إبراهيم باشا ما عرف باسم (قانوني نامه مصر) والذي بموجبه صار لمشايخ العرب وضع رسمي في الهيكل الإداري للدولة ، وبموجب ذلك صار مشايخ العرب يعينون بأمر السلطان وليس من حق البكوات المماليك عزلهم لكنه أيضا لم يسمح لهم بامتلاك العبيد المقاتلين (ظل ذلك حكرا على المماليك فقط) وظل نفوذ القبائل العربية يزداد تدريجيا حتى صار من مهامهم جمع الضرائب نقدا أو حبوبا من كل الإقليم الخاضع لسيطرته فكان التكليف بمهمة إدارة بقعة جغرافية محددة بكل ما فيها من سكان (عرب وفلاحين وغيرهم) وليس زعامة القبيلة التي ينتمي لها بالمفهوم البدوي القديم.
وطوال القرن السادس عشر الميلادي كان شيخ العرب في ناحيته مسئولا عن الأمن العام والزراعة والأشغال العامة وبالأخص نظام الري حيث ضمان سلامة القنوات والسدود كما كان من ضمن مهامه الإشراف على إقراض التقاوي للفلاحين من مخازن الغلة العمومية والإبلاغ عن التغيرات المناخية غير المعتادة مثل العواصف الباردة وأثرها على المحصول وهو ما يعني قدرا كبيرا من الاستقلالية في القرار وامتلاك الثروات ، وفي القرن السابع عشر الميلادي حاول العثمانيون كبح جماح سلطة العرب المتعاظمة وذلك عن طريق تعيين بكوات سناجق من الجيش النظامي إلا أن الأمر فشل في النهاية بسبب الصراع بين طائفتي المماليك الفقارية والقاسمية وصار لكل منهما أنصاره من قبائل العرب واستفحل أمر المماليك حتى صاروا يعينون الوالي (الباشا) ويعزلونه واضطربت أحوال البلاد الأمنية والاقتصادية واضطر العثمانون لإلغاء هذا النظام بل والاستعانة بالعرب في الجيش النظامي ، وفي القرن الثامن عشر الميلادي ضعفت سلطة الباشا وتعاظمت سلطة المماليك في العاصمة والمدن الكبرى بينما تمتع شيوخ العرب باستقلال فعلي في الأرياف خاصة في الصعيد حيث التحكم الكامل في الاقتصاد المحلي لكن بدأت النزاعات تدب بين العرب والمماليك بسبب غياب السلطة المركزية التي كانت تحفظ التوازن بينهما فيما سبق وانتهى الأمر إلى نزاع كبير على السيادة ظهر جليا في مثال واضح عندما قامت حرب ضروس بين شيخ العرب همام وعلي بك الكبير.
وقد حافظ العرب على قوتهم طوال العصر العثماني بفضل التحالفات القبلية الواسعة التي قامت في الدلتا والصعيد على أساس جغرافي وليس على أساس عشائري وهو ما كان سببا من أسباب انتشار قبيلة بني عدي في عدد من المناطق في طول البلاد وعرضها لأن هذه التحالفات ضمنت الأمان واكتساب الأرزاق ومن ثم الزيادة العددية والاستقرار الجغرافي والتحول من الزراعة الموسمية والرعي إلى الفلاحة الدائمة وبناء القرى شأنها في ذلك شأن كافة قبائل العرب ، وكانت هذه التحالفات مرتبطة بالتغيرات السكانية في مصر في العهد العثماني والأحداث السياسية التي جرت فيه والتي رصدها الباحث الدكتور حسام محمد عبد المعطي في كتابه (العائلة والثروة البيوت التجارية المغربية في مصر العثمانية) حيث كانت مصر في القرن السادس عشر الميلادي قد تلقت سيلا من المهاجرين الأندلسيين الذين فروا من محاكم التفتيش الأسبانية بعد سقوط غرناطة ، وقد نزل عدد كبير منهم في القاهرة في مناطق طولون وباب الشعرية والفحامين وبولاق وبين القصرين بسبب الوجود السابق للمغاربة في القاهرة منذ العصر الفاطمي .. ومنهم من نزل الفيوم ومصر الوسطى على القبائل الأمازيغية ومنهم من قصد إلى مدينة طنطا وسكن بجوار مسجد الولي المغربي السيد أحمد البدوي حيث نشأ بجواره حي كبير للمغاربة (وهو الاسم الذي كان يطلقه المصريون على الأندلسيين) ..
وكان العدد الأكبر منهم قد نزل على ثغر الإسكندرية شمالي سور المدينة حيث لا يمكن استيعابهم داخلها وكانت تلك المنطقة عبارة عن طرح بحر ترسب في العصر الفاطمي حول الجسر الواصل بين الإسكندرية وجزيرة فاروس وكانت خالية من السكان بسبب وقوعها خارج السور حيث يتعذر حمايتها ليلا برا وبحرا .. ولم يكن فيها إلا القلعة التي بناها السلطان قايتباي بالإضافة إلى مقابر عدد من الأولياء الصالحين منهم أبو العباس المرسي والقباري والشاطبي وأبو الجيوش العدوي (في موضع رباطهم) ، وقد سمح للأندلسيين من أصحاب الأموال بتعمير المنطقة وإقامة ميناء وأسواق للتبادل التجاري مع مواني البحر المتوسط مما شجعهم على السكن فيها فأنشأوا خمسة حارات جديدة هي السيالة والمغاربة والبلقطري والشمرلي والنجع البحري وأطلقوا عليها اسم الجزيرة الخضراء تيمنا بموطنهم الأصلي في الأندلس لكن أهل الإسكندرية (من أهل الحارات الأربع القديمة داخل السور) أطلقوا عليها اسم (بحري) وهي الأن مناطق المنشية والجمرك والأنفوشي ورأس التين ، ومع ازدياد الأعداد بدأ النزوح شرقا إلى قرية رشيد التي كان يسكنها عرب البحيرة حيث سمح لهم بالمرابطة في أجوارها والبناء في موضعين أحدهما في الشمال وهو عزبة المغاربة (سيدي أبو الريش فيما بعد) والآخر قبالة المدينة على النيل وهي قرية الجزيرة الخضراء حيث حدث اندماج بمرور الوقت مما حول رشيد إلى مدينة كبيرة وميناء هام .. وعندما ضاقت المنطقة الساحلية بالمهاجرين قررت الإدارة العثمانية نقل الآلاف منهم إلى وسط الدلتا في منطقة الأحراش والمستنقعات.
وكانت منطقة شمال الدلتا قليلة السكان بسبب زيادة معدل انحدار مياه فروع النيل الداخلية منذ العصر البيزنطي وهي تمتد من البرلس حيث منازل قبائل كنانة وبني عدي شمالا وحتى جزيرة بني نصر جنوبا (إبيار مركز كفر الزيات حاليا) حيث تسكن قبيلة بني نصر بن معاوية من هوازن وفروع من بني عدي ويحدها النيل ودسوق غربا والبراري والحامول شرقا .. وكانت عبارة عن مراعي للقبائل العربية منذ الفتح الإسلامي فنزل العدد الأكبر من أهل الأندلس بينهم حيث بنوا عددا من القرى ذات الأسماء الأندلسية (محافظة كفر الشيخ الحالية) ، من هذه القرى الحمراء والحمراوي وإسحاقة وأريمون ومحلة موسى وسيدي غازي وسيدي سالم وأبو غنيمة والحدادي والناصرية ومحلة دياي وكفر مجر وكانت أكبر قرية لهم تلك التي نشأت حول ضريح الولي المغربي الكبير أبي سعيد طلحة بن مدين التلمساني والمعروف باسم الشيخ فأطلق عليها (كفر الشيخ) تليها قرية قديمة لهم هي قطور(محافظة الغربية حاليا) حيث كان لفظ القطوري يعني الأندلسي (لأنهم جاؤوا يتقاطرون متتابعين) ولذا سميت حارتهم في الإسكندرية بلقطري وفي طولون درب القطري وفي بولاق حوش القطورية ، وقد أسفرت هذه التغيرات عن نشأة تحالفات جديدة في وسط الدلتا شملت بني عدي التي كانت منازلها متاخمة لمنازل الأندلسيين وتداخلت معهم في منطقة البراري والبرلس وقلين ودسوق والمحلة وكذلك في منطقة مصر الوسطى ولعبت هذه التحالفات دورا كبيرا في ازدهار الحركة التجارية مع المغرب العربي.
وجدير بالذكر أن التواصل بن فروع القبيلة في مصر والمغرب زادت وتيرته في العصر العثماني حيث كان يسكن مراكش فرع هام عرف باسم الشرقي نسبة إلى ولي الله سيدي محمد الشرقي مؤسس الزاوية الشرقاوية بمدينة أبي الجعد بالمغرب والذي ينتمي إلى بني عدي كما جاء في كتاب المرقي في مناقب الشيخ سيدي محمد الشرقي للمؤلف عبد الخالق بن محمد العروسي .. ويرجع أصله إلى القبيلة العربية المشهورة بني جابر التي استقرت بمنطقة تادلة بالمغرب في النصف الأول من القرن الثالث عشر حيث ولد الشيخ سيدي محمد الشرقي بمكان يبعد عن قصبة تادلة بنحو ثلاث كيلو مترات بجوار وادي أم الربيع سنة 926هـ ثم حفظ كتاب الله ودرس العلم على يد والده سيدي بلقاسم بن الزعري دفين قصبة تادلة ومعه إخوته سيدي عبد النبي وسيدي عبد العزيز وسيدي سعيد وسيدي السموني وسيدي عبد الرحمن ولما ظهرت نجابته ومحبته للعلم أرسله والده إلى مراكش ليتتلمذ على يد بعض العلماء منهم سيدي عبد العزيز التباع وسيدي عبد الله بن الساسي وسيدي محمد الغزواني المكنى مول لقصور وسيدي عمر القصطالي الملقب بالمختار وكلهم دفيني مراكش وخلال هذه الفترة التي قضاها بمراكش اشتهر بين الناس بعلمه ونباهته وكرمه ثم رجع الى مسقط رأسه فمكث مدة قليلة وانتقل بعدها الى الأطلس المتوسط في المكان المسمى الان بغرب العلام وبقي هناك متفرغا لعبادة الله.
وانتقل منذ سنة 966هـ الى مكان يبعد عن قصبة تادلة بنحو ثلاث وعشرين كيلومترا حيث نزل بخيمته هناك وحفر بئرا وبنى مسجدا وكان المحل عبارة عن غابات كثيفة الأشجار عامرة بالوحوش والذئاب المسماة (أبو جعدة) فسمي منذ ذلك الوقت أبو الجعد وقال فيه قولته المشهورة ” إني راحل إن شاء الله إلى بلد أمورها في الظاهر معسرة وأرزاقها ميسرة هذا المحل إن شاء الله محل يمن وبركة لعله يستقيم لنا فيه السكون بعد الحركة ” .. والمكان الذي نزل به الشيخ يعرف الآن بالآبار قرب رجال الميعاد و البئر الذي حفره يسمى اليوم بئر الجامع حيث مكث الشيخ هنا مدة وقصده الزوار والمريدون وطلبة العلم ثم انتقل بعد ذلك لمحل يقال له ” ربيعة ” المعروف الآن برحبة الزرع وبنى مدرسة لقراءة العلم بالمرح لكبير الذي يعرف الآن بدرب القادريين وكان الطلبة يأتون إليها من جميع الجهات وأصبحت أبي الجعد مركز إشعاع ديني وعلمي ونقطة تجارية هامة وقد لعبت الزاوية الشرقاوية دورا هاما في نشر مختلف العلوم وتخرج منها فطاحل العلماء منهم أبو علي الرحالي و سيدي العربي بن السائح دفين الرباط والشيخ سيدي صالح دفين أبي الجعد والشيخ سيدي المعطي صاحب الدخيرة ولحسن بن محمد الهداجي المعدني ومحمد بن عبد الكريم العبدوني واللذان يعتبران مفخرة الزاوية باعتبارهما من خيرة ما أنجبت حلقات الدراسة بها.
وأصبحت هذه الزاوية محج القبائل المجاورة التي كانت تأتي بتبرعات وهدايا كثيرة كانت تصرف على طلبة العلم من قبل الشيخ محمد الشرقي الذي وافته المنية سنة 1010 عن سن يناهز 84 سنة و قد خلف 11 ولدا .. وقد حظيت الزاوية الشرقاوية بعناية فائقة من طرف الدولة العلوية فقد نزل بها السلطان مولاي إسماعيل فأمر بترميم ضريح الوالي الصالح سيدي محمد الشرقي وبنى بجانبه مسجدا وحماما لازال موجودا إلى يومنا هذا ، وقد تابع أبناؤه ومنهم سيدي صالح بن سيدي المعطي الذي درس العلم بفاس بالزاوية الناصيرية بتامكروت وولده سيدي المعطي الذي ألف الكتاب المشهور ” ذخيرة المحتاج في الصلاة على اللواء والتاج ” وبعد وفاته خلفه ابنه سيدي العربي دفين مدينة أبي الجعد وفي عهده بنى السلطان مولاي سليمان المسجد الذي يحمل اسمه هذا وقد زار هذه الزاوية السلطان مولاي الحسن الأول ومكث بها بعض الأيام فجدد بناء ضريح سيدي صالح والمسجد المجاور له لتبقى بذلك الزاوية الشرقاوية قبلة للزوار من كافة أرجاء المعمورة خاصة خلال فترة موسم الوالي الصالح سيدي بوعبيد الشرقي.
ومن التغيرات السكانية في دلتا مصر في نهاية القرن السابع عشر الميلادي الهجرة الكبرى لقبائل النفيعات من سيناء وأطراف الدلتا إلى مناطق الشرقية والدقهلية والقليوبية (وهو تحالف ضخم يضم عددا من القبائل المختلفة) وكانت منازلها الجديدة متاخمة لمنازل بني عدي المنتشرة في المنطقة حيث اشتهر من هذا التحالف فرع عرف باسم (أولاد العدوي) ويسكنون حاليا فى بلدة عرب العليقات التابعة لمركز الخانكة وبلدة عرب الصوالحة التابعة لمركز شبين القناطر محافظة القليوبية ، وتنتسب هذه العشيرة إلى سليمان غانم ربيع أبو قطيطية العدوي النفيعي وهو واحد من الفرسان المشهورين حيث وقف مع قبيلة العليقات ضد الصوالحة في الحرب التي دارت بينهم في سيناء وكانت منازلهم الأولى في ديار بني عدي بالشرقية حيث أنجب عددا كبيرا من الأولاد ثم توزعت العشيرة ما بين مناطق الزرزمون وجزيرة النفيعات بالشرقية ومناطق عربان الهضيبات بالقليوبية ثم في نهاية القرن الثامن عشر استقرت العشيرة بمساكنها الحالية ويتفرعون إلى أولاد حسن وأولاد موسى وأولاد السيد ، وأقدم نص يتوفر لدينا حول قبيلة النفيعات في الديار المصرية هو ما ذكره الحمداني (602 ــ 700هـ) الذي ذكر جد قبيلة النفيعات نافع بن مروان وذكر النفيعات باسم النفعة ونسبهم إلى قبيلة ثعلبة الطائية حيث انتقلوا من الحجاز وبادية الشام وسكنوا سيناء ابتداءا من القرن الثامن الهجري وتحالفوا مع عدد من القبائل القيسية الحجازية ثم انتقلوا إلى قلب الدلتا.
وفي جنوب الصعيد كانت قبيلة هوارة (مغربية الأصل) تشكل حلفا كبيرا من ستة وعشرين قبيلة عربية ومغاربية ومنهم قبيلة القليعات التي ترجع في نسبها إلى محمد القليعي الحمراني الهواري والذي قدم من منطقة الساقية الحمراء بالمغرب حيث تنسبه بعض الروايات إلى هوارة بينما تنسبه روايات أخرى إلى أصل قرشي مهاجر تحالف مع هوارة ، وتنسب إليه عائلات الحاجات (والتي تنتمي لها عائلة الطواب وعائلة الجحيوات وخوالد القارة وهم منتشرون في القارة والكرنك والكوم الأحمر بمركزي فرشوط وأبوتشت) وعائلات القنابرة الموجودة بالحسينات بمركز أبوتشت وعائلات التويجرات بالكرنك وعزبة ساسبان بمركزي فرشوط وأبوتشت وعائلات السلالمة بالكوم الأحمر والقارة بمركزي فرشوط وعائلات الأحمر بالنجمة والحمران بأبوتشت وعائلات أولاد حسن وهي منتشرة بنجع تركي ورفاعة والشقيفي وبهجورة ونجوع غانم والقليعية وجزيرة الدوم وبخانس والرزقة وعزبة قاسم وهذه القرى موجودة بمراكز أبوتشت وفرشوط ونجع حمادي ، وتنسب إليه أيضا عائلات العدوية وهي منتشرة بقرى الجزيرة والشقيفي والرزقة والمغاربة شرق وغرب ونجع تركي وبخانس وهم توابع لمراكز أبوتشت وفرشوط ونجع حمادي وعائلات التراكوة المنتشرة بالكوم الأحمر ونجع تركي والشقيفي بمركزي أبوتشت وفرشوط وعائلات العوايشية بالكرنك بمركز أبوتشت حيث يرجح أن تكون القليعات نفسها عبارة عن تحالف صغير من العشائر القرشية والهوارية وغيرها.
أما في شمال الصعيد فقد كانت هناك حاجة ماسة لتكاتف القبائل العربية يدا واحدة لأن أسيوط صارت مقر الكشوفية في العهد العثماني وكانت الغلبة في المنطقة لقبائل لخم وجذام وقضاعة وقريش فنزلت كل قبيلة في منازلها وتوطنت في المنطقة بشكل كامل وذلك حتى تضمن لها زماما محفوظا ومعلوما من الأرض الزراعية بشكل رسمي ، وبذلك تأسست القرى التي حملت أسماء القبائل مثل بني عدي الشمالية (محافظة بني سويف) وبني عدي الجنوبية (محافظة أسيوط) وبني مجد (بني كلب سابقا) وبني رزاح وبني مر وبني محمديات وبني شقيرة وبني رافع وبني حرام وبني خالد وبني خيار وبني يوسف وبني مهدي وبني أحمد وبني غنى وبني حدير وبني عطية وبني هارون وبني سويف (بني سيوف) وبني مزار (بني نزار) … إلخ ، وقد أسفر التجاور عن حدوث اختلاط طبيعي بين القبائل وبعضها البعض بسبب التجارة والمصاهرة وبيع وشراء الأراضي والمنازل وطلب العلم ومجاورة الأولياء فلم تعد القرية الواحدة حكرا على قبيلة بعينها وإنما صارت كل القرى خليطا من المكونات القبلية العديدة حيث يمكننا القول بلا مواربة أن كل قرية صارت عبارة عن حلف صغير يضم عددا من أبناء القبيلة التي تسمت البلد باسمها بالإضافة إلى عدد آخر من الوافدين من القبائل الأخرى ، وهذه الخطوة دعمتها الإدارة العثمانية لضمان الاستقرار لكنها أسفرت عن الانتقال من مرحلة القبلية إلى مرحلة القروية وساهمت بشكل كبير في رسم ملامح الريف المصري حتى يومنا هذا.



