
الأستاذ الدكتور إبراهيم أحمد العدوي (1923 ـ 2004 م) مؤرِّخ من طراز فريد تخرج في كلية الآداب جامعة القاهرة عام 1945م. وحصل على الدكتوراه من جامعة ليفربول بإنجلترا 1949م. ثم عمل بالتعليم الجامعي وتولى عدة مناصب منها عميد كلية دار العلوم ونائب رئيس جامعة القاهرة وعضو بمجلس الشورى وعضو بالمجلس الأعلى للثقافة ومات وقد جاوز الثمانين من عمره بعد حياة حافلة بالعطاء الفكري والثقافي ..
ومن مؤلفاته : (الصراع بين الأمة العربية والاستعمار الجديد .. المجتمع العربي ومناهضة الشعوبية .. الأساطيل العربية في البحر الأبيض المتوسط .. بلاد الجزائر تكوينها الإسلامي والعربي .. مصر والشرق العربي درع الإسلام .. الدولة الإسلامية وإمبراطورية الروم .. السفارات الإسلامية إلى أوربا في العصور الوسطى .. ابن بطوطة في العالم الإسلامي .. السودان يقظة .. الأمويون والبيزنطيون البحر الأبيض المتوسط بحيرة إسلامية .. حركات التسلل ضد الأمة العربية .. مصر الإسلامية درع العروبة ورباط الإسلام .. تاريخ العالم الإسلامي .. المجتمع المغربي ومقوماته الإسلامية والعربية مع مدخل عن بلاد الجزائر .. إقريطش بين المسلمين والبيزنطيين في القرن التاسع الميلادي .. التمثيل السياسي بين الخلافة العباسية والدولة البيزنطية .. ولاية قرة بن شريك على مصر في ضوء أوراق البردي .. مشاهير مؤرخي سيرة رسول الله .. التنمية الاقتصادية لبلدان الخليج العربي في العصر العباسي) وغيرها من الكتب والمقالات والأحاديث التليفزيونية التي أثرت الحياة الثقافية في الوطن العربي ورسمت معالم شخصية مصر الفريدة وهويتها الحضارية.
وقد كتب عنه المؤرخ الدكتور محمد الجوادي قائلا : ” الدكتور إبراهيم العدوي (1923 ـ 2004) واحد من أساتذة التاريخ الإسلامي والعصور الوسطى المتميزين الذين نجحوا أيضا في الوظائف الأكاديمية القيادية ونالوا تكريم الدولة باختيارهم لعضوية مجلس الشورى ، ونبدأ الحديث عن الدكتور إبراهيم العدوي بطرفة نصف صادقة ونصف خيالية لكنها تصور مكانة الرجل وتاريخه مع العلم والنجاح وهي أن الدكتور كمال بشر في عمادته لكلية دار العلوم كان قوي الشخصية منهجي الفكر ولم يكن من السهل على رئيس الجامعة أن يروضه ، ومع هذا فقد قضى فترة عمادته مرفوع الرأس متعاونا مهابا فلما انتهت فترة عمادته كان على رئيس الجامعة أن يختار من يخلفه في منصب العمادة لأن عدد الأساتذة العاملين غير المعارين كان أقل من عشرة ومن ثم وطبقا للقانون يصبح تعيين العميد بيد رئيس الجامعة ، ولما كان رئيس الجامعة قد أصبح متحفزا من الدرعميين ومتحسبا أن يكونوا في قسوتهم عليه كالدكتور كمال بشر فإنه طلب إلى أصدقائه أن يفكروا له عن حل يجعله يعين عميدا لدار العلوم ممن لا ينتمي لها من حيث التخرج ولأن رئيس الجامعة كان رجلا مباركا فقد أتاه الحل على طبق من ذهب فقد كان الدكتور إبراهيم العدوي أستاذا مبرزا من أقدم الأساتذة في دار العلوم لكنه تخرج في كلية الآداب.

ولد الدكتور إبراهيم العدوي في عام 1923 وحصل علي ليسانس التاريخ من كلية الآداب جامعة القاهرة (1945) ومن الطريف أن زميله في هذه الدفعة هو المؤرخ العربي الكبير الدكتور شاكر مصطفي (1921 ـ 1997) ، ويذكر للدكتور العدوي أنه حصل على درجة الليسانس الممتازة كما تخرج في هذه الدفعة الوزير العراقي أحمد عبد الستار الجواري والدكاترة عبد الكريم غلاب ومحمد العلائي ومصطفى ناصف في قسم اللغة العربية والأستاذتان صفية المهندس ومي شاهين في قسم اللغة الإنجليزية والدكتور مصطفى سويف والأستاذ محمود أمين العالم في قسم الفلسفة وابتعث الدكتور العدوي إلي إنجلترا فحصل على درجة الدكتوراه 1960 ، وقد تقدم برسالته في وقت وجيز وكان موضوع رسالته : العالقات الإسلامية البيزنطية في العصور الوسطي المبكرة.
تدرج الدكتور إبراهيم العدوي في الوظائف الجامعية حتى حصل على درجة الأستاذية وهو في الثانية والأربعين من عمره وزامل أستاذ التاريخ الإسلامي الأشهر الدكتور أحمد شلبي في القسم نفسه في كلية دار العلوم كما عمل مستشاراً ثقافياً لمصر في بغداد ، عمل الدكتور إبراهيم العدوي عميدا لكلية دار العلوم جامعة القاهرة (1975 ـ 1977) ثم اختير نائباً لرئيس جامعة القاهرة لشئون فرع الخرطوم (1977 ـ 1980) فنائباً لرئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب (1980 ـ 1983) بالإضافة إلى هذا فقد عمل الدكتور إبراهيم العدوي على مدى تاريخه الأكاديمي أستاذاً في جامعات الجزائر والخرطوم والكويت وعلى الصعيد السياسي اختير عضواً في مجلس الشورى وقد استقر به الأمر بأن صار أستاذاً متفرغاً بقسم التاريخ بكلية دار العلوم.
تعد دراسة الدكتور إبراهيم العدوي عن ولاية قرة بن شريك على مصر من خلال الاعتماد على أوراق البردي العربية أول دراسة يقوم بها مؤرخ مصري اعتمادا على أوراق البردي التي لم يكن من حظها أن تحظي بالاعتماد عليها في التاريخ الإسلامي بالدرجة التي يعتمد عليها في التاريخ الفرعوني ، وكانت دراسة الدكتور إبراهيم العدوي عن جزيرة كريت بين المسلمين والبيزنطيين أول دراسة باللغة العربية عن تلك الجزيرة ومن خلال دراسة أوراق البردي تمكن من إضافة الجديد إلى دراسة العلاقات العربية ـ البيزنطية وتاريخ الإمبراطورية البيزنطية ثم تاريخ مصر الإسلامية ، وعلى سبيل الإيجاز فقد كان الدكتور إبراهيم العدوي من أنصار القول بأهمية البحر المتوسط بوصفه حلقة اتصال بين الدول الإسلامية المتعاقبة والقوي السياسية المسيحية المعاصرة له بدءاً من الإمبراطورية البيزنطية ثم الدول الأوروبية التي نشأت فيما بعد على الضفة الأخرى من البحر مثل إسبانيا وفرنسا وإيطاليا ” ، ولا بد لنا من أن نذكر فضل الدكتور محمد مؤنس عوض في حصره لأعمال هذا العلامة في كتابه (رواد تاريخ العصور الوسطي في مصر) الذي صدر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب “.
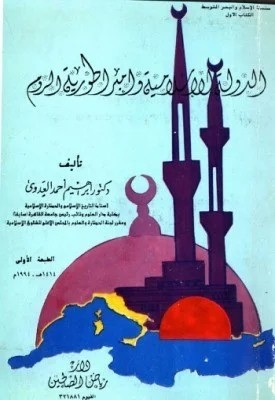
وفي كتابه (الدولة الإسلامية وامبراطورية الروم) يرصد الدكتور إبراهيم العدوي ملامح تلك العلاقة الشائكة والمتداخلة بين الشرق والغرب ودور العرب في استعادة هيبة الشرق مرة أخرى واستقلاله عن الروم فيقول : ” البحر المتوسط هو بحر الإسلام ومنارته التي تهدي العالم أجمع بحكم موقعها الجغرافي الفريد إلى شاطىء الأمن والطمأنينة والسلام حين امتدت إلى شواطئه بالشام ومصر شروق شمس الإسلام والفتوحات الإسلامية زمن الخليفة أبي بكر الصديق والخليفة عمر بن الخطاب ، وبهذا الشروق الساطع لشمس الإسلام في مطالع القرن الأول الهجري السابع الميلادي على البحر المتوسط قطعت عجلة الشرق دورة كاملة في مجرى تاريخها الطويل إذ استرد الشرق غابر مجده واستعاد سالف هيبته وسلطانه فمنذ فتوحات الإسكندر المقدوني ارتبط الشرق بركاب الغرب ثم جاءت الامبراطورية الرومانية الكبرى فشدت وثاق هذا الارتباط وأخذت تجني من بلاد الشرق ما لذ لها وطاب ، على أن مطالع القرن الرابع الميلادي آذنت بتحول عجلة القيادة صوب الشرق حين أحس أباطرة الدولة الرومانية الكبرى ضرورة نقل عاصمتهم إلى الطرف الشرقي ببلاد البحر المتوسط من إمبراطوريتهم فقد اضطرب جوف الشرق بحركات غدت منبع خطر ملح على كيان الدولة ورأى الأباطرة ضرورة إقامتهم قرب هذا المنبع لدفع غوائله عن صرح إمبراطوريتهم العتيدة وعمودها الفقري وهو البحر المتوسط الذي أطلقوا عليه اسم بحرنا “.
ويلفت الدكتور العدوي نظرنا إلى دور التنظيم القبلي للعرب في مسار الأحداث فيقول : ” الظاهرة الكبرى في تاريخ العرب قبل الإسلام هو سيطرة النظم القبلية على حياة السكان بها سيطرة تامة شملت النواحي السياسية والحضارية وكذلك العلاقات الخارجية لأولئك السكان مع القوى الكبرى المجاورة لأطراف بلادهم فقد كفلت تلك النظم للعرب نوعا فريدا من السلطان توارثوا فيما بينهم مجده ومظاهره الحضارية بحيث لا يفقده جماعة منهم حتى تتلقفه جماعة أخرى أكثر فتوة وقوة وتجلت تلك الظاهرة في العلاقات التي قامت بين العرب وجارتهم الكبرى إمبراطورية الروم حتى مشرق الدعوة الإسلامية السامية في أرض الحجاز ، ويقتضي فهم التطورات التي مرت بها تلك العلاقات الرجوع إلى شيء من أصول تاريخ العرب قبل الإسلام وتتبع مجرى الأحداث الذي انتهى بتنصيب أهل الحجاز في مركز الصدارة على سائر سكان العرب في العصر الجاهلي السابق مباشرة للبعثة النبوية ” ، ويستشهد بعبارة كاشفة لوجوب التعايش المشترك ولقاء الحضارات يقول فيها : ” إن أعظم قوتي العالم أجمع قوة العرب وقوة الروم تعلوان وتألقان كالشمس والقمر في السماء ولهذا وحده يجب أن نعيش إخوة على الرغم من اختلافنا في الطبائع والعادات والدين ” وهي نص رسالة نيقولا ميستيكوس بطريق القسطنطينية حول منتصف القرن العاشر الميلادي إلى حاكم جزيرة كريت أيام تبعيتها للمسلمين “.




