
مركز تلا
في عام 1526 م. قرر الوالي العثماني سليمان باشا الخادم إلغاء أعمال جزيرة بني نصر وتقسيم بلادها بين ولاية الغربية شمالا (مركز كفر الزيات) وولاية المنوفية جنوبا (مركز تلا ومركز الشهدا) ، وكانت البندارية وجزيرتها (كفر الشيخ شحاتة) من أكبر القرى في الجزء الجنوبي من جزيرة بني نصر حيث ذكرها ابن حوقل في أحسن المسالك فقال : ” البندارية ضيعة فيها جامع وأسواق كبيرة وبرسمها ضياع ولها عامل وفيها حمام طيب “.
وفي أقصى الغرب من جزيرة بني نصر تأسست قرية زاوية البقلي على يد الشيخ أبو الربيع سليمان بن علي بن أحمد نصر الدين البقلي المغربي وقد ذكرها المرتضى الزبيدي في تاج العروس ، وهي من ضواحي قرية بستامة (بشتامي) والتي يقول عنها محمد رمزي : ” قال ابن حوقل في المسالك ويشرع أي الفرع على بستامة وهي ضيعة عظيمة ذات منبر (أي جامع فيه خطبة) وأسواق كثيرة وبادية (عربان) تزيد على ألفي رجل وبها غلات واسعة “.
وتوزعت عشائر بني نصر بين الولايتين وكان النصف الجنوبي يشمل كلا من : جزيرة نادر وجدام وصفط جدام وساحل الجوابر والسكرية والدراجين (دراجيل) ومنية القلجي (القلشي) ومنية القرعان (العراقية) وزرقان والمحيلة (تصغير المحلة وهي كفر زرقان) وعمروس وكفر العرب البحري وكوم مازن وبابن الكنانية (بابل) وزنارة ومنية المكرم (ميت الكرام) وبمم وزاوية بمم وبرك العرب (كفر جنزور) والزعيرة وحوض عاصف (منشأة سليمان) ومنية إيما الكوم (ميت أبو الكوم) وكوم سيس (كمشيش) وكوم الشيخ عبيد والكمايشة.
وفي عام 1863 م. تقرر إنشاء مركز يجمع هذه القرى معا وعاصمته بلدة تلا (تالاو القديمة) وذلك بسبب توسطها بين هذه القرى ووقوعها في منتصف المسافة بين طنطا والشهدا ، ويقول عنها علي باشا مبارك في الخطط التوفيقية : ” قرية من مديرية المنوفية واقعة غربى ترعة البتنونية وأبنيتها ريفية وفيها ضبطية مركز تلا ومحطة فرع شيبين الموصل من شيبين إلى طندتا ، وبها ثمانية مساجد أشهرها الجامع الذى جدده المرحوم عمر بيك الأشقر ، وبها دكاكين بجوار المحطة ودكاكين من داخلها وبها بساتين ومضايف متسعة وهى مشهورة بزراعة البطيخ والكتان والقطن والبصل ، وأغلب أهلها مسلمون وتكسبهم من التجارة والزرع وري أرضها من ترعة البتنونية وغيرها “.
وينسب إلى هذه القرية كما فى الضوء اللامع محمد بن على بن مسعود بن عثمان ابن إسمعيل بن حسين الشمس بن النور التلائى ثم القاهرى الشافعى أو هو نسبة لقرية تلا من عمل الأشمونيين بأدنى الصعيد، ولد بها قبل سنة سبعين وسبعمائة تقريبا وقرأ بها القرآن على أبيه ، ثم تحول فى حياته إلى القاهرة فاشتغل أولا على مذهب أبيه مالكيا، ثم تحول شافعيا وحضر دروس الأنبلسى والبلقينى وابن الملقن والشرف بن الكوبك وغيرهم، وكتب التوقيع فى ديوان الإنشاء ، وأم بالقصر من القلعة بل ناب فى القضاء عن الجلال البلقينى ، ونزل فى خانقاه سعيد السعداء وحدث بالبخارى وغيره ، أخذت عنه أشياء وكان خيرا مديم التلاوة مع التهجد والمحافظة على الجماعة، وله نظم كتب بعضه فى المعجم ، مات فى ثانى المحرم سنة سبع وخمسين وثمانمائة بمصر القديمة انتهى.
وممن تربى منها فى ظل العائلة المحمدية ، ولحقته عنايتهم الخيرية، أحمد أفندى عبد الغفار بكباشى دخل العسكرية الخيالة نفرا فى مدة سعيد باشا وترقى إلى رتبة يوزباشا ، وفى زمن الخديو إسمعيل باشا أنعم عليه برتبة البيكباشى وقد سافر إلى حرب الحبشة فى سنة ثلاث وتسعين ومائتين وألف وعاد سالما وله إلمام بالقراءة والكتابة.

سماليج
قرية في محافظة المنوفية جاء عنها في القاموس الجغرافي : ” سماليج هي من القرى القديمة وردت في قوانين ابن مماتي من أعمال المنوفية وفي التحفة من كفور طبلوها من أعمال المنوفية ” ، وذكرها ابن الجيعان فقال : ” سماليج من كفور طبلوها مساحتها 390 فدان بها رزق 43 فدان عبرتها 900 دينار للمقطعين والعربان ورزق “.
وفي الخطط التوفيقية : سماليج قرية من مديرية المنوفية بقسم مليج ، واقعة بين ترعتى القاصد والبتنونية الصيفية ، وبجوارها قرية بتبس على نحو ألف وخمسمائة متر ، وفى غربيها على ثمانمائة متر كفر القلشى وهو قرية صغيرة ، ورى أرض سماليج من ترعتى الجردة والقاصد القديمة ، وفى زمن الصيف لا يتمكن أهلها من الزرع لقلة الماء بها وقتئذ.
وقد ذكر الجبرتى فى حوادث «سنة تسع وثمانين ومائة وألف» أن هذه القرية ولد بها الفقيه الصالح والصوفى الناجح الشيخ أحمد بن أحمد السماليجى الشافعى الأحمدى المدرس بالمقام الأحمدى بطنتدا ، قدم إلى الأزهر بعد ما حفظ القرآن ببلده ، فحضر دروس الشيخ عطية الأجهورى والشيخ عيسى البراوى والشيخ أحمد الدردير وغيرهم.
ثم رجع إلى طنتدا فاتخذها سكنا وأقام بها يقرأ دروسا ويفيد الطلبة ويفتى على مذهبه ويقضى بين المتنازعين من أهالى البلاد ، حتى راج أمره واشتهر ذكره بتلك النواحى ووثقوا بقوله واجتمع عليه الكثير من الناس بمكانه المسمى بالصف فوق باب المسجد ، ثم تزوج بامرأة جميلة الصورة من بلد الفرعونية فرزق منها بولد سماه أحمد ، وكان فى غاية من الحسن والجمال.
وبعد أن حفظ القرآن حفظ المتون وحضر فى الفقه والفنون ، وكان نجيبا جيد الحافظة يحفظ كل شئ سمعه من مرة واحدة ، ونظم الشعر من غير قراءة شئ من علم العروض.
قال الجبرتى : وقد رأيته فى أيام زيارة سيدى أحمد البدوى فى سنة تسع وثمانين ومائة وألف ، فلما حضر إلىّ وسلم علىّ جذبنى بحسن ألفاظه وسحر ألحاظه ، وطلب منى تميمة فوعدته بها وتأخرت فى إرسالها.
ثم بعد بلوغ هذا الشاب زوّجه المترجم بزوجتين فى سنة واحدة ، ولم يزل يجتهد ويشتغل حتى مهر وأنجب ودرس ، ثم اخترمته المنية فى شبابه وذلك فى سنة ثلاث ومائتين بعد الألف ، وخلف ولدا صغيرا استأنس به جده المترجم وصبر على فقد ولده النجيب ، ثم مات بعده بزمن قريب ، رحمهم الله تعالى.

بمم وكفر السادات
في وسط الدلتا منطقة عرفت قديما باسم جزيرة بني نصر نسبة إلى قبيلة بني نصر القيسية حيث يقول المقريزي في كتاب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار : ” جزيرة بني نصر منسوبة إلى بني نصر بن معاوية بن بكر بن هوازن ، وذلك أن بني حماس بن ظالم بن جعيل بن عمرو بن درهمان بن نصر بن معاوية بن بكر بن هوازن كانت لهم شوكة شديدة بأرض مصر وكثروا حتى ملؤوا أسفل الأرض وغلبوا عليها حتى قويت عليهم قبيلة من البربر تعرف بلواتة ، ولواتة تزعم أنها من قيس فأجلت بني نصر وأسكنتها الجدار (أي تركوا الخيام وسكنوا البيوت) فصاروا أهل قرى في مكان عرف بهم وسط النيل وهي جزيرة بني نصر هذه “.
وكانت أكبر إقطاعيات جزيرة بني نصر في قريتين تأسستا في العصر الفاطمي الأولى في الدلجمون (مركز كفر الزيات بالغربية حاليا) وتجاوزت سبعة آلاف فدان والثانية في قرية بمم (مركز تلا بالمنوفية حاليا) وتجاوزت خمسة آلاف فدان ، وقد اشتهرت بمم في العصر المملوكي لانتساب عدد من الشيوخ لها ثم توسعت في العصر العثماني ونشأت في ضواحيها كفر السادات ، وجاء ذكرها في القرن التاسع الهجري في كتاب التحفة السنية حيث يقول ابن الجيعان : ” بمم بالوجه البحري مساحتها بما فيها من الرزق 5777 فدان عبرتها 10000 دينار كانت باسم المقطعين والآن باسمهم وأملاك وأوقاف “.
وجاء في القاموس الجغرافي : ” بمم هي من القرى القديمة وردت في قوانين ابن مماتي وفي تحفة الإرشاد بم ومنيتها من أعمال جزيرة بني نصر وفي التحفة بمم وفي تاريخ سنة 1228 هـ برسمها الحالي ، ووردت في الخطط التوفيقية باسم بمب وهو اسمها على لسان العامة قال : وهي قرية بمديرية الغربية وإليها ينسب كما في الضوء اللامع للسخاوي الحسن بن إسماعيل البدر البنبي ، وكانت تابعة لمديرية الغربية في زمن مبارك باشا ، ويوجد ببلدة شنوان التي بمركزشبين الكوم عائلة شهيرة تعرف بعائلة البنبي ولعلها من هذه القرية ، ويشترك مع بمم في الإدارة عزبة الكوم الأحمر فيقال بمم والكوم الأحمر ، كفر السادات أصله من توابع ناحية بمم ثم فصل عنها في تاريخ سنة 1228 هـ “.
وجاء فى الضوء اللامع للسخاوى : الحسن بن اسماعيل البدر البنبى ثم القاهرى الشافعى والد البدر محمد ، قرأ على السراج البلقينى بعض تصانيفه ووصفه بالفاضل العالم وأجاز له وأرخ ذلك فى صفر سنة أربع وسبعين وسبعمائة ، وكانت وفاته بعد سنة إحدى وثمانمائة ، رحمه الله تعالى.
وأما ولده البدر فهو محمد بن الحسن بن إسماعيل البدر بن البدر البنبى القاهرى الشافعى ولد فى ذى الحجة سنة إحدى وثمانمائة ونشأ فحفظ القرآن وغيره واشتغل كثيرا وأخذ عن خاله البدر بن الأمانة والشمس البرماوى والولى العراقى ولازمه وكتب عنه ، وكذا سمع على الشهاب الواسطى وابن الجزرى والكمال بن خير والفوّى واستحضر الفقه وشارك فى غيره ، وبرع فى الشروط بحيث أنه عمل فيها مصنفا حافلا ونزل فى صوفية الأشرفية وغيرها .. وبالجملة كان فاضلا لكنه ضيع نفسه .. وقد كثر اجتماعى به اتفاقا وسمعت من فوائده وحكاياته ونوادره ، ومات فى سنة خمس وستين وثمانمائة عفا الله عنه.
داود بن سليمان بن حسن بن عبيد الله أبى زيادة أبو الجود بن أبى ربيع البنبى ثم القاهرى المالكى البرهانى ويعرف بأبى الجود ، ولد فى سنة اثنتين وتسعين وسبعمائة أو قبلها بقليل ببنب من الغربية بالقرب من جزيرة بنى نصر ونشأ بها فحفظ القرآن والعمدة والرسالة والمختصر وألفية ابن مالك ثم انتقل إلى القاهرة فلازم الاشتغال فى الفقه والفرائض والعربية وغيرها.
ومن شيوخه فى الفقه الشهاب الصنهاجى والجمال الأقفهسى وقاسم بن سعيد العقبانى المغربى والزين عبادة وغيرهم ، وأخذ العربية عن قارئ الهداية والفرائض عن الشمس العراقى وأصول الفقه عن القايانى ، وحج فى سنة ثلاث وثلاثين وصحب بعض الخلفاء بمقام البرهان إبراهيم الدسوقى فاختص به ونسب لذلك برهانيا وبرع فى الفرائض وشارك فى ظواهر العربية وغيرها.
وتصدى للتدريس والافتاء وانتفع به الطلبة خصوصا فى الفرائض بحيث أخذ عنه جمع من الأكابر وأملى على مجموع الكلائى شرحا مطولا فيه فوائد وكذا كتب على الرسالة شرحا ، ودرس بالمنكوتمرية والبرقوقية للمالكية وبغيرها وخطب ببعض الجوامع وولى مشيخة الصوفية بمسجد علم دار بدرب ابن سنقر بالقرب من باب البرقية .. وعانى تحصيل الكتب وكان خيرا دينا مأمونا متواضعا متوددا كريما مشار إليه بالصلاح على طريقة السلف – يعقد القاف مشوبة بالكاف – مات فى ربيع الأول سنة ثلاث وستين وثمانمائة وذلك بمنزله بالقرب من رحبة العيد ودفن بباب النصر رحمه الله تعالى.

زرقان
استمدت قرية زرقان بالمنوفية اسمها نسبة إلى عشيرة الزرقان المغربية التي أسست القرية في العصر المملوكي حيث ذكرها ابن الجيعان في كتاب التحفة السنية فقال : ” زرقان مساحتها 803 أفدنة بها رزق 69 فدان عبرتها 4800 دينار كانت باسم المقطعين والآن باسم الأمراء والمقطعين وأملاك وأوقاف “.
وجاء في الخطط التوفيقية : ” زرقان قرية من أعمال منوف بمديرية المنوفية ، فى شرقها مسقى ناصر على نحو اثنين وأربعين مترا ، وفى غربيها مسقى الشربينية على نحو خمسين مترا ، وفى بحريها الزرقانة على نحو اثنين وثلاثين مترا ، وفى قبليها مسقى حوض الحلفاوية على ثلاثة وستين مترا.
وأكثر أبنيتها من اللبن ، وفى شرقيها على أربعة عشر مترا مسجد جدد سنة ١٢٦٣ ، وفيها مسجد صغير للشيخ محمد بحيج جدد سنة ١٢٦٥ ونحو الثلاث زوايا ، وفى جهتها الشرقية بستانان لبعض أهاليها ، فيهما كثير من الفواكه وفيها معمل دجاج ، وبها أضرحة تزار مثل ضريح السيد محمد بحيج ، والشيخ نصير ، والشيخ إسماعيل مياح ، والشيخ شاهين الغباشى.
وأهلها مسلمون وعدتهم ثلاثة آلاف نفر ومائتان وإحدى وتسعون ، وزمامها ألف وخمسمائة وستون فدانا تروى من النيل ، وفيها سواق معينة ، وسوقها كل يوم خميس ، وفيها أنوال لنسج الصوف ، ولها شهرة بزرع القطن وقصب السكر ، غير الزرع المعتاد ، وهى من البلاد المشهورة بأكابر العلماء ، ومنها مدرسون بالأزهر ، وبمدرسة الخيرية التى كانت بالقلعة ، ومنها طلبة بالأزهر “.
وجاء في كتاب خلاصة الأثر أن من علمائها الشيخ عبد الباقى الزرقانى المالكى المشهور فقال : ” هو عبد الباقى بن يوسف بن أحمد شهاب الدين بن محمد بن علوان الزرقانى المالكى ، العلامة الإمام الحجة شرف العلماء ومرجع المالكية.
وكان عالما نبيلا فقيها متبحرا ، لطيف العبارة ، ولد بمصر فى سنة عشرين وألف وبها نشأ ، ولزم النور الأجهورى سنين عديدة ، وشهد له بالفضل ، وأخذ علوم العربية عن العلامة ياسين الحمصى ، والنور الشبراملسى ، وحضر الشمس البابلى فى دروسه الحديث ، وأجازه جل شيوخه ، ويصدر للاقراء بالجامع الأزهر.
وألف مؤلفات كثيرة منها : شرح على مختصر خليل تشد إليه الرحال ، وشرح على العزية لأبى الحسن وغير ذلك ، وكان رقيق الطبع حسن الخلق ، جميل المحاورة لطيف التأدية للكلام. وكانت وفاته ضحى يوم الخميس الرابع والعشرين من شهر رمضان سنة تسع وتسعين وألف بمصر ، ودفن بتربة المجاورين.
وابنه سيدى محمد الزرقانى فاق والده فى العلوم والمعارف ، وعلم وأفاد وألف وأجاد ، فله شرح على موطأ مالك ، جزآن كبيران ، لم ينسج على منواله ، وشرح على المواهب اللدنية للقسطلانى ، أربعة أجزاء كبار ، وشرح على متن البيقونية فى المصطلح وغير ذلك ، توفى سنة اثنتين وعشرين ومائة وألف “.

زنارة
في أوائل القرن التاسع الهجري قام السلطان المملوكي المؤيد شيخ بإعادة توزيع قبائل البحيرة على منازلها الجديدة لأسباب تتعلق بالولاء ، ومنها نقل عشائر من قبيلة زنارة إلى وسط الدلتا حيث تأسست قرية زنارة والتي حملت اسم القبيلة ، وجاء في القاموس الجغرافي : ” زنارة تكونت في العهد العثماني وذلك بفصلها من زمام بابل ووردت في وصف مصر وتاريخ سنة 1228 هـ.
وجاء تفصيل ذلك في كتاب قلائد الجمان في التعريف بعرب الزمان حيث يقول أبو العباس القلقشندي : ” قال الحمداني : وفي المنوفية أيضاً جماعة من لواته ، عد منهم : بني يحيى ، والسوه ، وعبيد ، ومصلة ، وبني مختار ، ثم قال : ومعهم في البلاد أخلاف من مُزاته ، وزنارة ، وهوارة ، وبنو الشَّعرية ، إلى قوم آخرين.
ومن لواته : زُنّارة ، بضم الزاي وفتح النون المشددة والألف ثم راء مهملة وهاء ، وهم : بنو زُنّارة بن زائر بن لواتا الأصغر بن لواتا الأكبر ، وذكر الحمداني أن زنارة : ابن بر بن قيذار بن إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام ، من امرأة العماليق تزوجها بفلسطين من الشام ، وأنه أخو هوَّاره ، ومُزاته ، ولواتة وغيرهم. وبطون زنارة بكثرة في بلاد المغرب ، وأكثرهم بالديار المصرية في بلاد البحيرة.
وقد ذكر الحمداني منهم بالبحيرة ، بني مزديش ، وبني صالح ، وزُمران ، وورديغة ، وعزهان ، ولقان ، وقد ذكر لي بعض العرب أن من بطون زُنارة أيضاً : بني حبون ، وواكده ، وفرطيطة ، وغرجومة ، ونفاث ، وناطورة ، وبني السعوية ، وبني أبي سعيد ، ومزداشة ، وطازولة.
وذكر في مسالك الأبصار : أن مساكنهم مع هوارة ، فيما بين الإسكندرية والعقبة الكبيرة ببرقة ، ، قلت : وقد تقدم في الكلام على لبيد بن سليم من العرب المستعربة : أن السلطان الملك المؤيد سلطان العصر أجلى عرب البحيرة من زُنار وغيرها عنها في سنة ثمان عشرة وثمانمائة ، وأسكنها لبيداً عوضاً منهم “.
وفي موضع آخر يشرح أسباب هذه التنقلات حيث يقول : ” قال المقر الشهابي ابن فضل الله : وكان آخر عهدي أن الإمرة على عربان البحيرة لفايد بن مقدم ، وخالد بن سليمان ، وكانا أميرين سيدين جليلين ذوي كرم وأمن إلى شجاعة وإقدام. ثم قال : ولم أعلم ما حالت به الأحوال وجرت به بعدي تصاريف الدهور.
قال : ومن جماعة فايد : زنارة ، ومزاتة ، وخفاجة ، وهوارة ، وسمال. ومنازلهم من الإسكندرية إلى العقبة الكبرى ، قلت : وقد آلت الإمرة عليهم في زماننا إلى أولاد عريف ، وقد رأيت عريفاً هذا في الإسكندرية بعد السبعين والسبعمائة ، وهو على هيئة الفقراء يحمل إبريقاً وعكازاً، وهي مستقرة بيد أولاده الآن.
قلت : وقد أجْلى السلطان المؤيد – عزّ نصره – عرب البحيرة من زنارة وغيرها عن بلادهم لتغيّرٍ أدركه عليهم سنة ثمان عشرة وثمانمائة ، وأسكنها عرب لبيد ، استدعاهم من بلادهم ، فأقاموا بها وعمروها ، وهم مقيمون بها إلى الآن “.

جزيرة قوسينا
جزيرة قوسينا (بتقديم السين وفتحها وكسر النون وتأخير الياء) من أقسام الدلتا قديما وردت في كتاب الديورة لأبي صالح الأرمني حيث ذكر أنها أنشئت أيام الدولة الفاطمية وكانت تشمل 74 ناحية ذات وحدة مالية ، وجاءت في الخطط المقريزية ضمن التقسيمات الإدارية في سنة 585 هـ ووردت في معجم البلدان جزيرة قوسنيا وبعضهم يقول قوسينا كورة بمصر بين الفسطاط والإسكندرية كثيرة القرى وافرة ، وسميت جزيرة لأنها محصورة بين فرع دمياط شرقا وترعة العطف غربا.
وذكرت في تحفة الإرشاد باسم جزيرة قوسنيا ثم تغير الاسم إلى قويسنا بعد عمل الروك الناصري عام 715 هـ حيث ألغيت أعمالها ووزعت بين الغربية والمنوفية وتشمل اليوم مركز قويسنا وبركة السبع بالمنوفية ومركز السنطة والجزء الجنوبي من مركز زفتى بالغربية ، وقد ذكرت عاصمتها قويسنا في التحفة السنية ضمن توابع الغربية حيث يقول ابن الجيعان : ” قويسنا مساحتها 6550 فدان بها رزق 108 أفدنة عبرتها كانت 20000 دينار والآن 9000 دينار كانت باسم سيدي علي بن الأشرف شعبان والآن للمقطعين ووقف “.
وقال عنها محمد رمزي في القاموس الجغرافي : ” قويسنا : قاعدة مركز قويسنا ، قرية قديمة اسمها الأصلي قوسنيا .. وردت في التحفة قويسنا بتقديم الياء على السين من أعمال الغربية وهو اسمها الحالي الذي وردت به في تاريخ سنة 1228 هـ ، وفي سنة 1896 صدر قرار بإنشاء مركز قويسنا اعتبارا من أول يناير سنة 1897 ، ولبعد قرية قويسنا عن محطتها ومجاورة هذه المحطة لقرية منشأة صبري التي على السكة الحديدية تقرر جعل منشأة صبري مقرا لمركز قويسنا من ذاك التاريخ على أن يكون المركز باسم قويسنا “.
وقال عنها علي باشا مبارك في الخطط التوفيقية : ” قويسنا : قرية من مديرية الغربية بمركز الجعفرية موضوعة غربى ترعة الخضراوية على بعد ثمانمائة متر وفى الشمال الشرقى لناحية بجيرم بنحو ألف وستمائة متر وفى شمال شبراريس بنحو ألف وخمسمائة متر ، وأغلب أبنيتها بالآجر وبها جامعان غير الزوايا ومعمل فراريج ، وينسب إليها الإمام الفاضل والعالم العامل خاتمة المحققين شيخ الإسلام السيد حسن القويسنى الشافعى تولى مشيخة الجامع الأزهر سنة خمسين ومائتين وألف بعد وفاة الشيخ حسن العطار.
وفى ذلك يقول من هنأه بالمشيخة معرّضا لسلفه : ولئن مضى حسن العلوم لربه … فلقد أتى حسن وأحسن من حسن .. يا شاذلىّ السر فى أعماله … وعلومه يا شافعى على العلن .. أنت المقدم رتبة ورياسة … وديانة من ذا الذى ساواك من ، إلى أن قال مؤرخا مشيخته : مذ صرت شيخ الأزهر الزاهى الهدى … أرّخت خير مناصب حق الحسن ، وأحسن منه قول بعضهم : إن يمض كبير عوّضنا … خلفا منه الشيخ الأكبر .. ولئن وارى عنا حسنا … فلقد أبدى الحسن الأنور.
كان رحمه الله تعالى من شرف النفس وعلو الهمة بمكان ، حتى إن العزيز محمد على أحب أن ينعم عليه بشئ من الدنيا فأبت نفسه ذلك ، واعتراه الجذب فى آخر عمره ، فكان إذا هام وغاب يسأل كل من لقيه غنيا أو فقيرا ، فإذا أعطاه شيئا فرقه من ساعته، وبعد صحوه ورجوعه إلى حاله لا يسأل أحدا شيئا، هكذا كان من شأنه فى أيام جذبه ، وكان إذا جاء وقت درسه أفاق من جذبه ، وقرأ درسه ، ولم يزل على حاله إلى أن توفى سنة أربع وخمسين ومائتين وألف ، ودفن بمسجد الشيخ على البيومى بالحسينية.
وله من التآليف رسالة صغيرة فى المواريث ، وشرح على متن السلم فى فن المنطق أملاه على بعض الأمراء فى ذلك الوقت ، ومن أجلّ من أخذ عنه شيخ الإسلام الشيخ إبراهيم البيجورى ، والسيد مصطفى الذهبى ، والشيخ أحمد المرصفى ، والشيخ محمد البنانى ، وله حفدة ، منهم : الكامل الفاضل الشيخ حسن القويسنى شيخ رواق ابن معمر بالأزهر وأحد المدرسين به “.
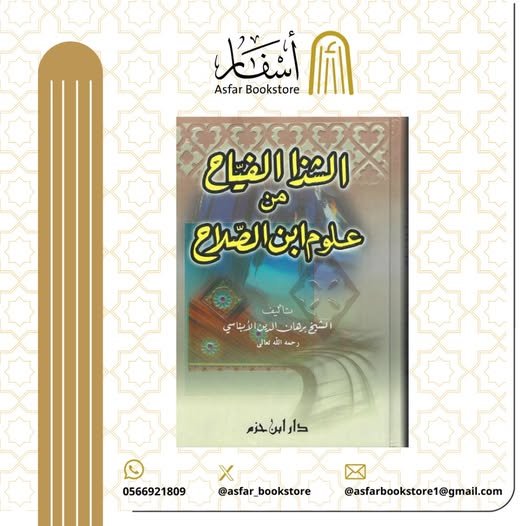
إبنهس
جاء في الخطط التوفيقية : إبناس وهى قرية من مديرية المنوفية بقسم سبك غربى السكة الحديد الطوالى من مصر إلى الإسكندرية على بعد خمسمائة متر ، وفى شمال بنها العسل بنحو اثنى عشر ألف متر وفى جنوب بركة السبع بنحو ثمانية الآف متر، وبها مساجد أحدها بمنارة ومعمل دجاج وقليل أشجار، ولها سوق فى كل أسبوع ومنها شيخ العرب أيوب فودة كانت له وقائع عديدة فى أيام الغز.
وإليها ينسب الشيخ إبراهيم الإبناسى وقد ترجمه صاحب كتاب درر الفرائد المنظمة فى أخبار الحاج وطريق مكة المعظمة» فقال : هو الشيخ برهان الدين إبراهيم بن موسى بن أيوب الإبناسى ذكره المقريزى فى «درر العقود الفريدة فى تراجم الأعيان المفيدة» فقال : ولد سنة خمس وعشرين وسبعمائة تخمينا وبرع فى الفقه وتصدى للإفتاء والتدريس عدة سنين فانتفع به كثير من الناس.
وحدث عن الوادياشى بالموطأ وعن جماعات كثيرة ، وأخذ الفقه عن الشيخ عبد الرحيم الإسنائى ، والشيخ ولى الدين الملوى ، وله زاوية خارج القاهرة وانقطع إليه جماعات كثيرة من أهل الريف وطلاب العلم ، فكان يعود عليهم بالبر وكان رفيقا لين الجانب بشوشا متواضعا ترجى بركته ، وكان يكثر من الحج.
ومن أمره أنه طلبه الأمير الكبير برقوق لقضاء الشافعية عوضا عن برهان الدين بن جماعة فوعده وقتا يأتيه فيه ، ثم توجه إلى خلوته وفتح المصحف لأخذ الفأل منه ، فأول ما ظهر له قوله تعالى ﴿رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ﴾ فتوجه من وقته إلى منية السيرج واختفى بها حتى ولى البدر بن محمد أبو البقاء.
وولى مشيخة لخانقاه الصلاحية سعيد السعداء ، ومات بطريق الحجاز وهو عائد من الحج والمجاورة فى يوم الأربعاء ثامن المحرم سنة اثنتين وثمانمائة بمنزلة كفافة ، فحمل إلى المويلح وغسل وكفن وصلى عليه يوم تاسوعاء وحمل إلى عيون القصب فدفن فى هذا الموضع على ميمن الحاج ، فى يوم الجمعة.
وترجمه الحافظ السخاوى فى تاريخه فقال : هو إبراهيم بن موسى بن أيوب البرهان أبو إسحق وأبو محمد الإبناسى ثم القاهرى المصرى المفتى الشافعى الفقيه ، ولد فى أول سنة خمس وعشرين وسبعمائة بإبناس وهى قرية صغيرة بالوجه البحرى من مصر .. ودرس بمدرسة السلطان حسن ، وبالآثار النبوية وبجامعة المنشا مع الخطابة به وغيرها.
وولى مشيخة سعيد السعداء مدة واتخذ بظاهر القاهرة فى المقس زاوية ، فأقام بها يحسن إلى الطلبة ويحثهم على التفقه ويرتب لهم ما يأكلون ويسعى لهم فى الأرزاق ، حتى كان أكثر فضلاء الطلبة بالقاهرة من تلامذته ، ووقف بها كتبا جليلة ، ورتب بها دروسا وطلبة ، وحبس عليها رزقة ونحو ذلك.

أشليم
هي من القرى القديمة وردت في قوانين ابن مماتي وفي تحفة الإرشاد من أعمال جزيرة قويسنا وفي التحفة من أعمال الغربية ، وذكر جوتييه في قاموسه اسم حات شيلاوم وقال إنها مدينة مقدسة لعبادة أوزيريس وأرجعها بروكش إلى شليمي وهو اسمها القبطي ، وذكر أميلينو ناحية باسم شيلايمي.
وقد دارت فيها معركة طاحنة سنة 216 هـ / 831 م. حيث انتصر الوالي عيسى بن منصور على قوات عرب الدلتا الثائرين بقيادة أبي ثور اللخمي وابن عبيدس الفهري (حفيد عقبة بن نافع) وأجبرهم على التراجع إلى المحلة الكبرى ، وهي أولى معارك ثورة البشموريين الكبرى التي تحالف فيها العرب والقبط ضد الحكم العباسي.
جاء في الخطط التوفيقية : ” أشليم قرية من مديرية المنوفية بقسم مليج شرقى ناحية العجايزة بنحو أربعة آلاف متر ، وفى الشمال الشرقى لناحية أم خنان كذلك ، وبها ثلاثة جوامع أشهرها الجامع المعروف بجامع أبى قدوس التى فى بحريها له منارة ، وفى بحريها على بعد ثلاثمائة متر ضريح سيدى على أبى شبكة له مولد سنوى ، وفى قبليها على بعد أربعين مترا ضريح سيدى المرزوقى له مولد سنوى أيضا ، وفى غربيها جنينة برتقان وبها معمل دجاج ولها سوق كل يوم خميس ، وتكسب أهلها من الزراعة “.
وينسب إلى هذه القرية الشيخ عبد الغنى الإشليمى الذى ترجمه السّخاوى فى الضوء اللامع حيث قال : هو عبد الغنى بن محمد بن عمر بن عبد الله الزين الإشليمى ثم القاهرى الأزهرى الشافعى ، ولد تقريبا سنة عشرين وثمانمائة بإشليم ، وقرأ بها بعض القرآن وانتقل مع أخيه إلى القاهرة فأكمله بها ، ثم حفظ المنهاج الفرعى والأصلى وألفية النحو.
واشتغل فى الفقه على الشرف السّبكى والقاياتى والونائى وجماعة ، وفى النحو على الشمنى وغيره ، وفى الفرائض على ابن المجدى ، وفى العروض على الشهاب الأبشيطى ، وسمع على الزين الشركسى وغيره ، ونزل فى صوفية سعيد السعداء وغيرها ، وعمل أرجوزة فى الفرائض ، وكان فاضلا خيرا فقيرا قانعا متعففا.
وينسب إليها أيضا كما فى الضوء اللامع محمد بن عثمان بن عبد الله ويقال : أيوب بدل عبد الله وهو أصح ، أصيل الدين أبو عبد الله بن الفخر أبى عمرو بن النجم العمرى الإشليمى ثم القاهرى الشافعى، ولد بعد سنة أربعين بإشليم ، ولما ترعرع عانى القرآن ثم اشتغل فى الفقه والعربية وتلا للسّبع.
ومن شيوخه فى الفقه ابن الملقن والبلقينى وغيرهما ، وأذن له بالتدريس والإفتاء وتكسب بالشهادة ولازم الصدر بن رزين خليفة الحكم فرقاه لنيابة الحكم ، وكان له استحضار يسير من السيرة النبوية ومن شرح مسلم، فكان يلقى درسه غالبا من ذلك لكونه لا يستحضر من الفقه إلا قليلا ، مات فى أواخر ذى الحجة سنة أربع وثمانمائة رحمه الله تعالى انتهى.

بجيرم
هي من القرى القديمة وردت في قوانين ابن مماتي وكانت تتبع أعمال جزيرة قويسنا ، وجاء عنها في القاموس الجغرافي : ” والظاهر أن وحدتها ألغيت في الروك الناصري وأضيف زمامها إلى قويسنا بدليل أنها لم ترد في التحفة ، وفي تربيع سنة 933 هـ فصلت بزمام خاص من أراضي ناحية قويسنا باسم كفر بجيرم كما ورد في دليل سنة1224 هـ ، ووردت باسمها الحالي في كتاب وقف محمد بك أبو الذهب المحرر في سنة 1188 هـ ، وفي تاريخ سنة 1228 هـ “.
وجاء عنها في الخطط التوفيقية : ” قرية من مديرية الغربية من مركز زفتة ، واقعة على ترعة الخضراوية التى فمها من بحر الشرق فى شمال فم القرينين ، على بعد ثلثى ساعة ، المنصبة فى بحر شيبين من جهة نهطاى ، وفى شرقيها على بعد ساعة قرية منية برى الواقعة على بحر دمياط ، وفى غربيها على بعد ساعتين قرية شبين الكوم ، وبقريها على الترعة المذكورة قنطرة بثلاث عيون ، وهى قرية صغيرة لكن لها اعتبار بمن نشأ منها من أفاضل العلماء “.
وذكر الجبرتى فى حوادث سنة إحدى وعشرين ومائتين وألف : ” أن منها الفقيه المحدث خاتمة المحققين ، وعمدة المدققين الشيخ سليمان بن محمد بن عمر البجيرمى الشافعى الأزهرى ، ينتهى نسبه إلى الشيخ جمعه الزبيدى ، نسبة إلى زبيد قرية بالقرب من منية ابن خصيب ، وينتهى نسب الشيخ جمعه المذكور إلى سيدى محمد بن الحنفية رضي الله عنه.
ولد المترجم ببيجيرم سنة إحدى وثلاثين ومائة وألف ، وحضر إلى مصر صغيرا دون البلوغ ، ورباه قريبه الشيخ محمد البيجيرمى ولازمه حتى تأهل للعلم ، فحضر على الشيخ العشماوى ، وحضر دروس الشيخ الحفنى ، وأجازه الملوى والجوهرى والمدابغى وأخذ عن الديربى وغيره.
وحضر أيضا على الشيخ الصعيدى والسيد البليدى، وشارك كثيرا من الأشياخ كالشيخ عطية الأجهورى. ، وكان إنسانا حسنا جميل الأخلاق، مجتنبا مخالطة الناس، مقبلا على شأنه ، وقد انتفع به أناس كثيرون ، وكف بصره فى آخر عمره ، وعمّر وتجاوز المائة.
ومن تآليفه المشهورة بأيدى الطلبة : حاشية على المنهج ، وحاشية على الخطيب ، وغير ذلك ، وقبل وفاته سافر إلى مصطيه قرية بالقرب من بجيرم فتوفى بها ليلة الإثنين وقت السحر ، ثالث عشر رمضان من السنة المذكورة ، ودفن هناك عليه رحمة الله تعالى “.

بركة السبع وجنزور
في عام 1960 م. تأسس مركز بركة السبع عن طريق استقطاع عدد من القرى من مركز السنطة بالغربية ومراكز تلا وقويسنا وشبين الكوم ودمجها مع بعضها وتحويل أكبر قرية فيهم إلى مدينة وهي بركة السبع ، وهي مدينة قديمة كانت في الأصل بحيرة صغيرة في مجرى بحر شبين تتجمع فيها مياه الفيضان في العصور الإسلامية فتم استصلاحها في العصر الفاطمي وسكن فيها الناس على ضفتيها الشرقية والغربية.
وكانت تسمية بركة شائعة في ذلك الوقت في وسط الدلتا مثل قرى البرك الشرقي والغربي برك الحجر وبرك العرب وبركة جريمة وبرك جعفر وبركة عطاف وبركة شنودة وبركة بحار ومنها بركة السبع والتي تعني البرك السبع ، ذكرها ابن الجيعان في التحفة السنية ضمن الأعمال الغربية فقال : ” بركة السبع : مساحتها 855 فدان بها رزق 18 فدان عبرتها 2100 دينار كانت للمقطعين والآن لهم وأملاك وأوقاف “.
يضم المركز 7 وحدات محلية قروية وهي كفر هلال (نفرة سابقا) وهورين وطوخ طنبشا وجنزور (زمزور سابقا) وأبو مشهور (منية أبي ثور سابقا) وشنتنا الحجر والدبايبة كما يتبعهم 27 قرية فرعية و65 كفراً ونجعاً ، وكانت المنطقة مركزا للقبائل العربية والمغربية خلال العصور الإسلامية مثل الحلامشة والحمادية وبني عليم وأبي ثور وجمزور والزعامة فيهم في عشيرة بني عامر المستقرين في جنزور.
وفي ذلك يقول علي باشا مبارك : ” جمزور قرية من مديرية المنوفية بقسم تلا فى شرقى ناحية بابل بنحو ثلاثة آلاف متر وفي قبلي صناديد بنحو ستة آلاف متر وأبنيتها بالآجر واللبن وبها مسجدان جامعان غير الزوايا أحدهما فى جهتها الشرقية وهو جامع قديم تهدّم فأنشأته الأهالى سنة أربع ومائتين وألف والآخر فى جهتها الغربية يقال له جامع سيدى يعقوب وهو قديم وله منارة وبها للدجاج معملان أحدهما غير مستعمل الآن وفيها كثير من أضرحة الصالحين ذات القباب كضريح الشيخ نصير والشيخ منصور والشيخ أبى عطاء الله وفى غربيها على ترعة القاصد ضريح الشيخ أبى النور ..
وفيها عائلة مشهورة يقال لها أولاد بنى عامر منهم حماد أبو عامر كان ناظر قسم مدة ثم عوفي وابنه السيد حماد الآن رئيس مجلس مركز منوف ولهم بها أبنية جيدة ونحو خمسة وابورات لسقى الزرع بعضها ثابت ولها سوق كل يوم اثنين يباع فيه كثير من سلع القطر ، وبينها وبين سكة الحديد المارة من مصر إلى الإسكندرية نحو ستمائة قصبة ..
ويتبعها نزلة صغيرة تسمى منشاة أولاد أبى عامر فيها بستانان يشتملان على كثير من الفواكه وفيها مسجد تقام فيه الجمعة والجماعة أنشأه حماد أبو عامر ، وأبنيتها باللبن والآجر وأكثر أطيانها على ترعة الجردة الآخذة من ترعة القاصد وأكثر أهل جمزور مسلمون وإليها ينسب الشيخ سليمان الجمزورى صاحب المتن المنظوم فى تجويد القرآن وهو متن نفيس صغير الحجم كثير العلم توفى سنة أربع وعشرين ومائة وألف رحمه الله تعالى “.
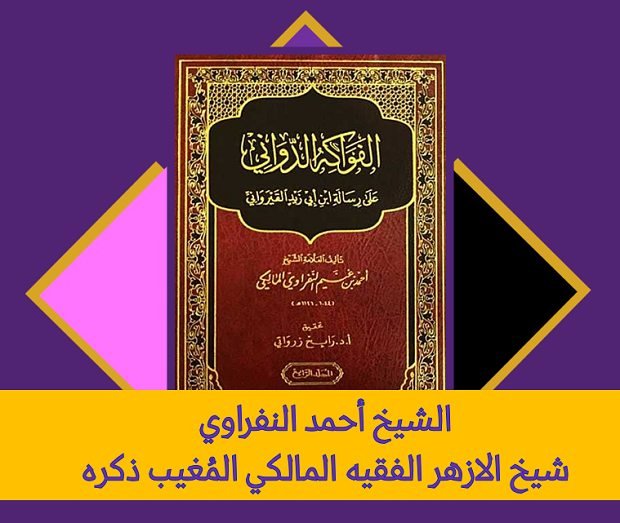
كفر هلال
جاء في القاموس الجغرافي : ” كفر هلال قرية قديمة اسمها الأصلي نفرة وردت في قوانين ابن مماتي وفي تحفة الإرشاد من أعمال جزيرة قوسينا ، وفي التحفة من أعمال الغربية وفي تاج العروس نفرى قرية من قرى جزيرة قوسنيا ، وفي تاريخ سنة 1228 هـ قسمت أراضي نفرة إلى ثلاث نواح : وهي نفرة هذه التي سميت كفر هلال نسبة إلى الشيخ محمد هلال الذي كان عمدة لها في ذلك الوقت ، وكفر نفرة البحري ، وكفر نفرة القبلي الذي يعرف اليوم بكفر الشيخ طعيمة ، وبذلك اختفى اسم نفرة وحل محله كفر هلال “.
وجاء في الخطط التوفيقية : ” قرية صغيرة من قسم الجعفرية بمديرية الغربية ، على الشاطئ الشرقى لترعة حسن ، الخارجة من ترعة العطف ، الخارجة من النيل ، فمها فى بحرى فم القرينين القديم عند ناحية العطف ، وفى البلد مساجد ومضايف ، وبستان لعمدتها عبد الواحد ، وأهلها مسلمون ومنهم العلماء والأفاضل ، إذ إليها ينسب الشيخ محمد النفراوى “.
والشيخ النفراوي هو عالم في الرياضيات والهندسة تتلمذ على يد الشيخ الجبرتي الكبير والد المؤرخ حيث ذكره في تاريخه وقال : العالم الفاضل المحقق الشيخ محمد بن إسماعيل بن خضر النفراوى المالكى ، كان والده من أهل العلم والصلاح ، عمّر كثيرا حتى جاوز المائة ، وانحنى ظهره ، وتوفي سنة ثمان وسبعين ومائة وألف ، تربى فى حجر أبيه ، وحفظ القرآن ، والمتون ، وحضر دروس الشيخ سالم النفراوى ، والشيخ خليل المالكى وغيرهما ، وحضر المعقول على كثير من الفضلاء وأنجب ودرس.
وكان جيد الحافظة ، قوى الفهم ، مستحضرا للمسائل الفقّهية والعقلية ، ولما بلغ المنتهى فى العلوم المشهورة ، مالت نفسه للعلوم الحكمية والرياضية ، فأحضره والده للشيخ الجبرتى الكبير ، والد المؤرخ ، والتمس منه مطالعته عليه ، فأجابه إلى ذلك ، ورحب به وكان عمره إذ ذاك نيفا وعشرين سنة ، فلازم الشيخ ليلا ونهارا ؛ حتى اشتهر بنسبته إليه ، وتلقى عنه فن الميقات والهيئة والهندسة ، والهداية فى الحكمة.
وعانى الرسم ، فرسم عدة بسائط ومنحرفات ، وحسب كثيرا من الأصول والدساتير ، وتصدى لتعليم الطلبة ، الذين يأتون من الآفاق لطلب معرفة العلوم الغربية ، توفى فى شهر جمادى الثانى من سنة خمس وثمانين ومائة بعد الألف.
وفى الجبرتى أيضا : أن منها الفاضل المبجل الشيخ أحمد بن الفاضل العلامة الشيخ سالم النفراوى المالكى ، نشأ فى حجر والده فى رفاهية وتنعم ، ولما مات والده ، تعصب له الشيخ عبد الله الشبراوى ، وحاز له وظائف والده ، وأجلسه للإقراء فى مكان درس أبيه ، فاشتهر أمره ، وعدّ من الكبار ، وترددت إليه الأمراء والأعيان ، وصار ذا هيبة وصولة. ولما ظهر شأن على بيك ، وتردّد عليه ، راعى له حقه، وحالته التى وجده عليها ، وقبل شفاعته ، وأحبه وأكرمه ، وكان يذهب إليه فى داره التى بالجيزة ، توفى سنة سبع وسبعين ومائتين وألف.
وينسب للقرية الشيخ أحمد النفراوي الفقيه المالكي وأحد المرشحين لمشيخة الأزهر ، جاء في كتاب الأعلام للزركلي: ” أحمد بن غانم بن سالم ابن مهنا ، شهاب الدين النفراوي الأزهري المالكي فقيه من بلدة نفرى ، من أعمال قويسنا بمصر ، نشأ بها وتفقه وتأدب وتوفي بالقاهرة ، له كتب منها (الفواكه الدواني) ثلاثة أجزاء على رسالة ابن أَبي زَيْد القيرواني ، في فقه المالكية ، ورسالة في (التعليق على البسملة) في الأزهرية ، و (شرح الرسالة النورية) للشيخ نوري الصفاقسي ، في الأزهرية ، وتوفي عام 1634 – 1714 م “.



