
العزيزية والحوامدية
في القرن الرابع الهجري قرر الخليفة العزيز بالله الفاطمي تأسيس خمس قرى لتكون سكنا وإقطاعا لأعوانه من المغاربة وكانت أكبرهم تقع إلى الشمال مباشرة من أطلال مدينة منف القديمة ، وكان اختيار هذا المكان لاعتقادهم أنه موضع قصر النبي يوسف حيث كان بجواره تل يطلق عليه العامة اسم زليخا ، وردت في قوانين الدواوين باسم الظاهرية العزيزية وذكر في صبح الأعشى أنها بلدة صغيرة تقع شمال منف.
وفي كتاب أحسن التقاسيم للمقدسي قال إن العزيزية وهي من مدينة منف القديمة التي اختلت وخربت عامتها ، وذكر ياقوت في معجم البلدان أن العزيزية خمس قرى بمصر تنسب إلى العزيز بالله بن المعز الفاطمي ملك مصر ومنها قرية في الجيزية ، وقال محمد رمزي : ” إنه لما خربت مدينة منف في آخر أيام الحكم الروماني بمصر أقيم على أطلالها وفي أراضيها قرى العزيزية ومنية رهينة والبدرشين وصقارة “.
وفي الخطط التوفيقية : ” العزيزية : خمس قرى بمصر منسوبة إلى العزيز بن المعز الذى كان متغلبا على مصر منها : العزيزية والعزيزية كلتاهما بالشرقية والعزيزية والسلنت فى ناحية المرتاحية والعزيزية فى السمنودية والعزيزية فى الجيزة .. العزيزية ويقال لها العجيزية أيضا : قرية من مديرية الجيزة بقسم ثان فى شمال منية رهينة بنحو ألف وخمسمائة متر وفى الجنوب الغربي للحوامدية بنحو ألفين وتسعمائة متر وبدائرها نخيل كثير “.
وقال عنها ابن الجيعان : ” العزيزية مساحتها 830 فدان عبرتها لم تعين كانت للديوان السلطاني والآن باسم الأمير يشبك الجمالي ” ، وفي العصر العثماني تم إلغاء النظام الإقطاعي وصارت من توابع البدرشين فسكن الناس في زمامها الزراعي حيث تأسست ضاحية جديدة ناحية الشمال الشرقي بجوار إحدى القلاع الفاطمية سميت الحوامدية نسبة إلى قبيلة عربية تعرف باسم أولاد حماد أو عرب الحوامد القاطنين في العزيزية وأجوارها.
جاء في القاموس الجغرفي : ” الحوامدية : أصلها من توابع البدرشين ثم فصلت عنها في العهد العثماني وردت في وصف مصر وتاريخ سنة 1228 هـ ” ، وتوسعت الحوامدية عمرانيا حتى ضمت عددا من القرى الصغيرة القديمة مثل أم خنان وكذلك عددا من قرى الروك الصلاحي مثل منية الأمير التي أدمجت فيها عام 1966 م. وكل من منية أندونة (كاتب من عصر ابن طولون) ومنية الشماس ومنية قادوس والتي تعرف باسم المناوات.
وجاء في موسوعة القبائل العربية عن عشائر الحوامد : ” فرجان محافظة الجيزة وهم الحوامد ونذكر منهم العائلات التالية : عائلة بركات ويقطنون كفر بركات بالعياط والحوامدية ، وعائلة عابد بالمنصورية ومنهم اللواء شرطة عزت عابد مدير أمن بني سويف الأسبق ، وعائلة نوير وهم بالبدرشين والعزبة الغربية ونذكر منهم البهنساوي عبد الحليم نوير ، وهناك بعض عائلات من الفرجان بعزبة غيضان مركز إمبابة .. يذكر بعض الباحثين أن مؤسس قبيلة الفرجان هو فراج بن حمدان وينسب إلى الأشراف الأدارسة .. وتعد قبيلة الفرجان من أكبر قبائل المرابطين في مصر وليبيا وتونس والجزائر وهم مشهورون بالورع والتقوى “.
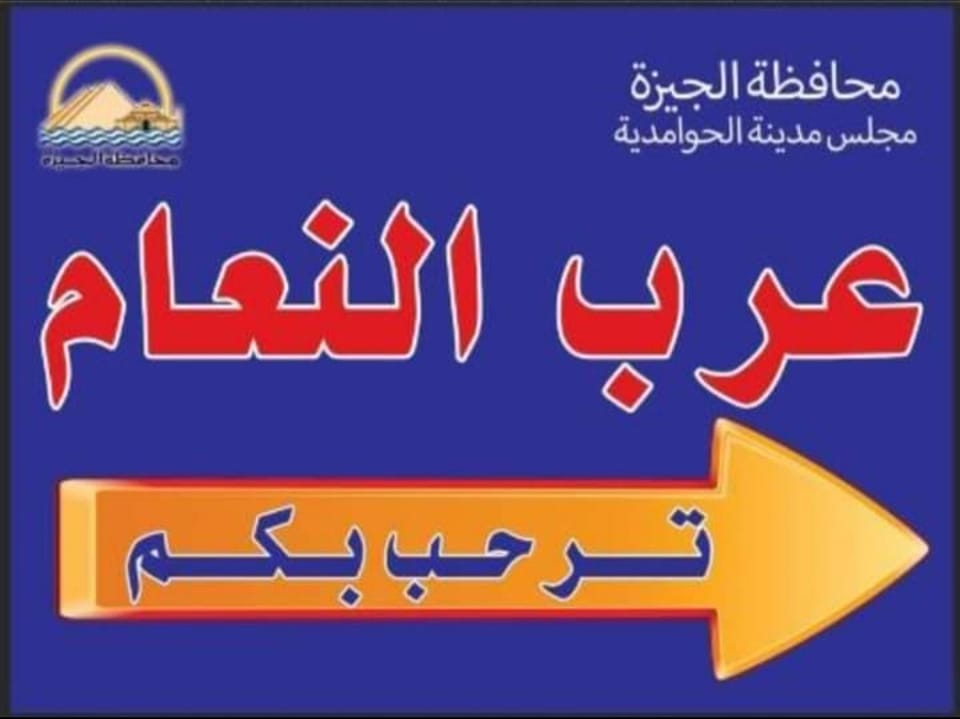
عرب النعام
في القرن الثامن عشر دارت وقائع حرب شرسة في الصحراء المتاخمة لساحل النيل الشرقي بالقرب من الصف وأطفيح وذلك بين قبائل عرب مطير وحلفائهم من عرب العيايدة ضد كل من عرب النعام وحلفائهم من قبيلة الترابين ، وانتهت هذه الوقائع بإعادة تقسيم منازل القبائل حيث سكنت مطير في القرية التي عرفت باسم عرب الحصار بمركز الصف وانتقلت الترابين إلى منطقة المعادي والساحل المقابل لها وسكنت العيايدة في بر الجيزة بينما انتقلت قبائل النعام إلى البر الغربي المواجه لضاحية حلوان.
وفي هذه المنطقة أسست فروع قبائل النعام وحلفائها عدة نجوع في المنطقة المحصورة بين ساحل النيل شرقا ونجوع عرب الحوامد غربا (والتي تحولت بعد ذلك إلى قرية عرفت باسم الحوامدية) ، وعرفت أكبر هذه النجوع باسم عرب النعام والتي توسعت ونشأ في امتدادها الساحلي كل من عرب التل ثم عرب الساحل وعرب شلهوب وعدة نجوع أخرى صغيرة.
وقد جاء في القاموس الجغرافي أن الحوامدية كانت من توابع البدرشين ثم فصلت عنها في أواخر العصر العثماني بزمام خاص وظهرت في السجلات لأول مرة في تاريخ سنة 1228 هـ وفي كتاب وصف مصر ، وفي العصر الحديث تحولت الحوامدية إلى مدينة وتوسعت عمرانيا باتجاه النيل وأضيف إلى زمامها نجوع عرب النعام والتي شكلت الجزء الساحلي من المدينة وصارت من ضمن أحيائها.
وقد نزل بنو نعام الأسديون إلى مصر في العصر الأيوبي وهم بنو جعدة والبحير ابنا عبد الله بن مرة بن عبد الله بن صعب بن أسد ، سموا باسم أمهم نعامة على عادة العرب وهم قبيلة من بني أسد بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر ، وسكنوا حول القاهرة وجزيرة النعام وهربيط (بالقرب من أبو كبير) بالشرقية وسيناء والسويس ، وتسكن قبيلة النعام اليوم في الحوامدية وأجوارها أساسا ولها فروع في ضواحي القاهرة وسيناء
ويشرح ذلك محمد الطيب في موسوعة القبائل فيقول : ” ودارت مصادمات عنيفة بين مُطَيْر وحلفائهم العيايدة من جهة وبين المكاثرة (النعام) وحلفائهم الترابين من جهة أخرى ، تغلبت فيها مُطَيْر بمساعدة العيايدة ونزح النعام إلى بر النيل الغربي والترابين إلى بلاد المعادي في صحراء الجيزة والقاهرة ، وقد أعطى القناص للعيايدة حوض من الأرض يسمى حوض أبو طويلة وهو شيخ القبيلة ، وتوطن العيايدة في بر الجيزة بعد أن كانوا في القليوبية بعد هذه الوقعة ، ورجح الرواة أن ذلك كان قبل قرنين ونصف قرن من الزمان “.
ثم استطرد في موضع آخر فقال : ” النَعَّام نسب القبيلة ، قال الزبيدي في تاج العروس : النَعَّام بطن من بني أسد وهو أسد بن خُزيْمة بن مدْركَة بن إلياس بن مُضَر بن نزار بن مَعْد بن عَدْنان ، وقد كانوا يسكنون طريقَ المدينة المنورة ، وقال أستاذ الجيل أحمد لطفي السيد ونعوم بك شقير : إن النعام من قبائل العرب قدمت من بلاد الحجاز من عدة قرون إلى الديار المصرية ، قلت : النعام ليس لهم بقية في بلادهم الآن ، بل جميع بني أسد تفرقوا في البلاد وأغلبهم في العراق في الوقت الحاضر.
التفصيل عن عشائر وفخوذ النعام في الديار المصرية : أبو علَّام وفيهم عمدة القبيلة في مصر ويدعى حسين أبو علَّام ، أبو غيث : وفيه فخوذ محسن والنوام ، المحاسنة وفيه فخوذ عبد الصَّمد وبركات ويونس ودرويش وحنبل وفزع وعويضه وحماد وجندي ، الختارشة وفيه فخوذ خلف ومفرج وجاد الله ، أبو صالح : وفيه فخوذ أبو رزق والسبتان وعطوة ومنصور وحماد ، أبو هريش : وفيه فخوذ عسكر ومبارك ونعيم ، أبو برس (البروس) : وفيه فخذ تركي ، أبو هليِّل : وفيه فخوذ إبراهيم ونصار ، أبو رحمة ، أبو جانب ، المكاثرة ، الزقالطة ، أبو عصية.
(المكاثرة : كان لهذا الفخذ صولة في بر الجيزة الشرقي وقد سيطر على القرى الواقعة من حلوان حتى أطفيح وذلك قبل قرنين ونصف من الزمان حتى نازعته قبيلتا العيايدة ومُطَير فنزح إلى غرب الجيزة ومناطق أخرى).
مساكن النعام في مصر : تقطن عائلات وفخوذ أو عشائر النعام في مجملها في الحوامدية وأبو النمرس والمناوات وإمبابة وأبو نجم وأبو صير الملق وعرب التل وطموة والناصرية في محافظة الجيزة ، وفي أحياء مصر القديمة والحلمية والنعام بعين شمس والمعادي وعرب الجسر والجبل الأخضر والعباسية والمعصرة في محافظة القاهرة ، كما هناك فروع عديدة في قنا بالصعيد المصري ، وكذلك في محافظة الشرقية وفي قرب العريش بسيناء ، وأغلب عائلات قبيلة النعام مارسوا التجارة وتقلدوا الوظائف الحكومية وقد اشتهروا بحب السلام ولين العريكة وقد كسبوا محبة المجتمع من القبائل العربية “.

أم خنان
يقول محمد بك رمزي في كتابه القاموس الجغرافي للبلاد المصرية : ” أم خنان هي من القرى القديمة ذكرها أميلينو في جغرافيته باسم موخنون والعربي مخنان وقال : إن هذه القرية وردت في قائمة الكنايس التي بضواحي القاهرة إلا أنه لم يستدل عليها لزوالها ولأنها لم تترك أثرا في مصر الحالية.
وأقول : إن مخنون هي بذاتها أم خنان هذه التي تعتبر من ضواحي القاهرة لقربها منه ، ووردت في المشترك لياقوت باسم مخنان منى الأمير لمجاورتها لناحية منى الأمير ، وفي قوانين ابن مماتي وفي تحفة الإرشاد وفي التحفة مخنان من الأعمال الجيزية ، وقد أصبحت معروفة بالتركيب الإضافي المصدر بأم من العهد العثماني فوردت باسمها الحالي في تاريخ سنة 1228 هـ “.
وجاء في الخطط التوفيقية : ” مخنان فى مشترك البلدان أنه بميم فى أوله مضمومة ثم خاء معجمة ساكنة ونونين بينهما ألف ، قريتان بمصر إحداهما : مخنان الجيزية ، والأخرى مخنان بالمنوفية ، والمتعارف بين الناس أم خنان بالتركيب الإضافى المصدر بأم ، وهذا هو الذى يناسب المستعمل فى النسب فإنهم يقولون الخنانى.
أم خنان : فأما الجيزية فهي قرية من قسم ثانى بمديرية الجيزة واقعة على الشاطئ الغربى للنيل فى مقابلة حلوان بميل إلى الشمال ، وأكثر أهلها مسلمون ، وبها أقباط أصحاب صنائع كتبييض النحاس ، فيطوفون فى البلاد لذلك ، وبها سوق فيه حوانيت قليلة تباع فيها المأكولات ونحوها “.
وقد ذكر الجبرتى فى حوادث سنة سبع ومائتين وألف : أن من ناحية أم خنان الجيزية الأستاذ الكبير والإمام الشهير الشيخ أحمد بن محمد بن جاد الله بن محمد الخنانى المالكى البرهانى ، وجده الأخير يعرف بأبى شوشة ، وله مقام يزار بالقرية المذكورة ، نشأ المترجم فى طلب العلم ، وحضر أشياخ الوقت ولازم السيد البليدى ، وصار معيدا لدروسه بالأزهر والأشرفية وانتفع بملازمته له انتفاعا زائدا ، وكتب له إجازة طويلة بخطه ونوه بشأنه.
ولما مات السيد البليدى تصدر لإقراء الحديث مكانه بالمشهد الحسينى ، فارتفع أمره واشتهر ذكره ، واجتمع عليه الناس ، وحضره من كان ملازما لشيخه من تجار المغاربة وغيرهم ، واعتقدوا صلاحه وواسوه بالصلات والهدايا ، وواظب على التدريس بالأزهر ، وكان كثير الزيارة لأضرحة الأولياء وكان يقوم دائما فى الثلث الأخير من الليل ويذهب إلى المشهد الحسينى فيصلى الصبح ويقعد هناك حتى يقرأ درس الحديث.
وفى آخر عمره اشترى دارا عظيمة بحارة كتامة المعروفة الآن بالعينية بالقرب من الأزهر وسكنها مع عياله ، وكان يخرج لزيارة قبور المجاورين فى كل يوم جمعة قبل طلوع الشمس ، فنزلت عليه العرب فى بعض الجمع بين الكيمان فأراد الهرب منهم ، وساق بغلته فسقط من على ظهرها ، وكان ضخما فانكسر زرّه وحمل إلى داره وعالج نفسه حتى عوفى قليلا ، ولم يزل تعاوده الأمراض حتى توفى فى السنة المذكورة.

أبو صير وسقارة
جاء في القاموس الجغرافي : أبو صير هي من القرى القديمة وردت في معجم البلدان بوصير السدر بليدة من كورة الجيزة وفي قوانين ابن مماتي بوصير رجب وهي بوصير السدر وفي تحفة الإرشاد بوصير رجب وهي بوصير الله وفي التحفة أبو صير السدر من أعمال الجيزية ، وفي تاريخ مصر للجبرتي ورد العجز محرفا باسم أبو صير الصدر (ص 100 ج 1) والصواب أبو صير السدر والظاهر أن هذه الناحية كان بها كثير من شجر السدر ـ وهو شجر النبق ـ قاشتهرت به وفي تاريخ سنة 1228 هـ باسمها الحالي المختصر.
صقارة هي من النواحي القديمة وردت في قوانين اين مماتي سقارة من أعمال الجيزية وفي التحفة أرض السدر قال وهي سقارة من حقوق أبو صير السدر من الأعمال المذكورة وهي تجاور أبو صير ، وورد في التحفة ناحية أخرى باسم سقارة في الأعمال الجيزية كذلك وقال إنها من صفقة طمويه (طموه) وهذه قد اندثرت وتوزع زمامها على ناحيتي منيل شيحة وأبو النمرس.
وذكر جوتييه في قاموسه قرية باسم ساكورا وقال إنها سقارة التي في منطقة أبو صير بالجيزة ثم ذكر في موضع ناحية باسم ساكت وقال إنها مدينة بقسم منفيس ولم يرجعها إلى ما يقابلها من القرى الحالية ، ومن دراستي لتكوين أسماء المدن والقرى أرجح أن ساكت هو اسم سقارة المصري وأن ساكورا هو اسمها العبري ومن هذين الاسمين أتى اسمها العربي سقارة.
وجاء في الخطط التوفيقية : وأما بوصير الجيزة فهى واقعة بين مدينة منف والأهرام فى بحرى سقارة على نحو ساعة فى رملة غربى اللبينى بنحو ألف متر وكان فيها معبد سبرابيس وبه مدفن العجل المتخذ إلها وهى موجودة إلى الآن وذكرها أبو الفداء ، وفى دفاتر التعداد فى هذه المديرية وتسمى بوصير السدر ، ولعل ذلك كان لكثرة شجر النبق هناك وذكر عبد اللطيف البغدادى أنه شاهد بها عدة أهرام ، منها هرم متهدم لكن ليس أقل فى الارتفاع من أهرام الجيزة وأطال الكلام على المدافن التى كانت تدفن فيها الناس والحيوانات هناك.
قال المقريزى وفى سنة ٥٧٩ هجرية ظهر بتربة بوصير من ناحية الجيزة بيت هرميس ففتحه القاضى ابن الشنهرزورى وأخذ منه أشياء من جملتها كباش وقرود وضفادع من حجر بازهر وقوارير من دهنج وأصنام من نحاس ، ثم قال : وقد أكثر الناس فى ذكر الأهرام ووصفها ومساحتها وهى كثيرة العدد جدا وكلها ببر الجيزة وفى بوصير منها شئ كثير وبعضها كبار وبعضها صغار وبعضها طين وبعضها لبن وأكثرها حجر وبعضها مدرج وأكثرها مخروط أملس ا. هـ.
ثم إن كلمة بوصير مركبة من كلمتين ومعناها مدفن أوزريس كما قاله جيلونسكى ويؤيده ما مرّ أن معبد سيرابيس (أوزريس) كان ببوصير الجيزة إلى الآن يقصد السياحون تلك الجهة كثيرا للاطلاع على الآثار القديمة فيمرون بناحية ميت رهينة الواقعة فى محل منفيس القديمة ، التى هى كما قال مرييت فى تاريخه مقر فراعنة العائلة الثالثة والرابعة والخامسة والسابعة والثامنة ومدة الثالثة مائتان وأربع عشرة سنة والرابعة مائتان وأربع وثمانون سنة والخامسة كذلك ومدة السابعة سبعون يوما والثامنة مائة واثنان وأربعون سنة.
ومن هناك إلى سقارة وهى بلدة بمديرية الجيزة فيها مقابر منفيس القديمة وتلك المقابر تمتد فى حدود الرمال طولها مسافة سبعة آلاف متر فى عرض ألف وخمسمائة متر ، وهناك يشاهد جملة أهرام منها : هرم يعرف بالكوم مدرج عدد درجاته ست وهو فى وسط المقابر وينسب إلى أول ملوك العائلة الأولى ، فعلى هذا هو أقدم جميع الآثار الموجودة إلى الآن ، ويكون بناؤه قبل المسيح بخمسين قرنا.
والذى يهتم السياحون بالاطلاع عليه من مشتملات تلك المقابر هو السيرابيوم وقبر الملك تى وقبر افتاة هتير ، والسيرابيوم عمارة تكلم عليها استرابون وهى مقبرة بيس وهو العجل المؤله المتخذ تمثالا حيا للإله أزريس عند نزوله إلى الأرض ، وكان مسكن العجل فى حياته معبد ابيوم فى مدينة منفيس وبعد موته كان يقبر فى السيرابيوم والذى استكشفه هو مرييت بيك مأمور أنطقخانة بولاق سنة ألف وثمانمائة وخمسين ميلادية يعنى استكشف المقبرة.

ميت رهينة
في العصر البيزنطي تراجعت مكانة مدينة منف العريقة بعد قرار أباطرة القسطنطينية هدم المعابد ووصمها بالوثنية ثم تحولت المدينة إلى أطلال وخرائب وخلت من السكان ، وفي ذلك يقول الرحالة عبد اللطيف البغدادي :
” ولما وصلت حكومة الديار المصرية إلي قياصرة الروم تضعضع حال تلك المدينة أضعاف ما كان بها قبل فصار أغلب معابدها وسراياتها خرابا فإن مهمات مبانيها العظيمة كانت تنقل لبناء الإسكندرية ، وبقيت هكذا حتى أتى المسلمون هذه الديار وبنوا مدينة الفسطاط وصاروا ينقلون ما بقى من آثارها لبناء المساجد والمنازل ونقل من آثارها أيضا إلى القاهرة وقت بنائها “.
وفي العصور التالية نزلت بها جماعات من عرب بني رهينة حيث جاء في القاموس الجغرافي : ” ميت رهينة : هي من القرى القديمة اسمها الأصلي منية رهينة وردت في قوانين ابن مماتي وفي تحفة الإرشاد وفي التحفة من أعمال الجيزة ثم حرف اسمها من منية إلى ميت فوردت به في تاريخ سنة 1228 هـ.
ميت رهينة مكونة من كلمتين عربيتين وهما ميت وأصلها منية ومعناها الموردة أو المرساة ثم حرفت إلى ميت كما وقع لجميع الأسماء التي وردت باسم منية في كتب الجغرافيا العربية والثانية رهينة وهو اسم جماعة من العرب يعرفون بعرب رهينة نزلوا بتلك الجهة وأنشأوا هذه القرية فنسبت إليهم “.
وجاء في الخطط التوفيقية : ” منية رهينة : بلدة من مديرية الجيزة واقعة فى الجانب الغربى لتلول مدينة منف التى كانت لها الشهرة فى الأزمان السالفة .. وهى اليوم في شرقي البحر اللبيني وشرقي ناحية سقارة وبقرب منها جسر سقارة الممتد من البحر إلى الجبل الغربي ، ويقابلها فى ذلك الجسر قنطرة تعرف بقنطرة الشوربجي ..
وأبنية البلد من اللبن والآجر والدبش وأكثر منازلها على دورين وفيها مساجد وطواحين ومصانع وأنوال لنسيج مقاطع الكتان وأضرحة لبعض الصالحين منها ضريح سيدي محمد الفخري مشهور يزار ، ولأغنيائها منازل عظيمة ومصاطب معدة للضيوف.
ونخيلها كثير وأطيانها جيدة المحصول وأكثر أهلها مسلمون منهم حسن أفندى خيرى بالمدرسة الخيرية التى كانت بالقلعة ومنهم عناني أفندى أبو النور برتبة ملازم بالعسكرية ، وفى تلولها آثار باقية إلى الآن وفى شمال تلك التلول صورة جسيمة غريبة الشكل يقال لها أبو الهول كثيرا ما يذهب إليه السياحون للفرجة “.
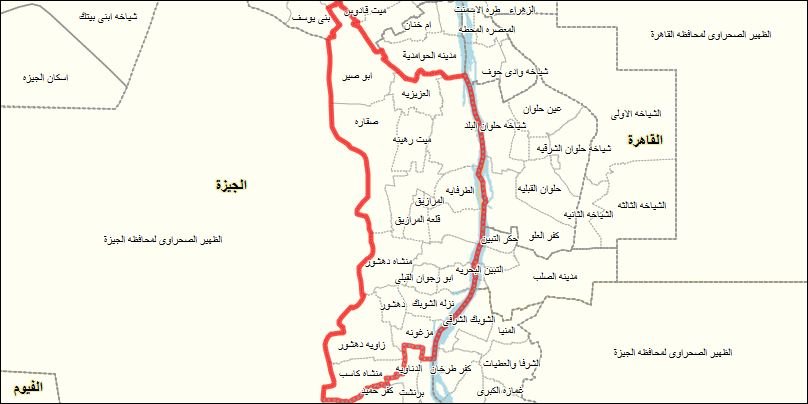
البدرشين
في أواخر العصر البيزنطي انحسر نهر النيل عن جزيرة صغيرة شرقي أطلال مدينة منف القديمة أطلق عليها اسم جزيرة بطرش وكانت الكلمة مستعمة للدلالة على نبات الكتان الذي تنسج منه ملابس الرهبان والذي كان ينمو في أجوار الجزيرة وبعد ذلك تأسست قرية عرفت باسم أم عيسى وعرفت باسم بطرش أم عيسى ثم حرف الاسم إلى بدرش.
وفي الروك الصلاحي تم ضم القريتين بعد اتصالهما باليابسة وكتبا بصيغة المثنى البدرشين ، ووردت في قوانين ابن مماتي وفي تحفة الإرشاد وفي التحفة البدرشين من أعمال الجيزية ووردت في تاريخ الجبرتي باسم أمانة البدرشين.
جاء في القاموس الجغرافي : ” ورد في تاج العروس أن اسمها الأصلي بدرش كجعفر والنسبة إليها بدرشي ويقال بدرشين قرية من أعمال الجيزة وفي الانتصار البدرشين أم عيسى قال : وهذه البلدة هي مدينة منف وكانت مصر الإقليم ، وأقول : إن هذه البلدة تقع في منطقة من مدينة منف القديمة ..
وأم عيسى المنسوب إليها البدرشين في الانتصار هي قرية أخرى كانت مجاورة للبدرشين وردت في قوانين ابن مماتي وفي تحفة الإرشاد ضمن الأعمال الجيزية ثم أضيفت مساكنها وأرضها إلى البدرشين وبذلك اختفى اسمها “.
وفي الخطط التوفيقية : ” البدرشين : هذه البلدة من البلاد المشهورة بمديرية الجيزة بالجانب الغربي للنيل تمر السكة الحديد بينها وبين النيل وفى قبليها جسر سقارة وأبنيتها بالآجر واللبن.
وبها مساجد عامرة وبها تسع عشرة مصبغة وثمان طواحين ومعصرة زيت وأنوال لنسج مقاطع الكتان وغيره وثلاث دكاكين وسط البلد يباع فيها العطارة وفندقان ينزل بهما المسافرون ، وفى جهتها البحرية معمل بارود من زمن العزيز محمد علي مستعمل إلى قبيل تولية الخديوي المعظم محمد باشا توفيق ، كان تجلب له الأسباخ من تلول منية رهينة وتلول مصر العتيقة.
وبها تجار غلال وتكسب أغلب أهلها من الفلاحة ومن مزروعاتهم الخيار وقليل من قصب السكر وقد أنشئ بها فابريقة لصناعة السكر، وبالقرب منها محطة السكة الحديد وعمدتها علي أحمد الدالى منزله فى جهتها الغربية وكان أبوه حاكم خط سابقا ..
ويقال إنه فى زمن فتح مصر حصلت بها وقعة استشهد فيها جماعة ولقبورهم آثار إلى الآن : منهم الشيخ الجنيد فى قبليها بأرض المزارع والشيخ عمران فى شرقيها وسعد وسعيد فى بحريها وفى بعض التواريخ أن محلها فى الأصل جزيرة.
وبها كثير من نخل الأمهات ولها سوق كبير كل يوم أربعاء ، ومنها رسلان أفندى نوير ومحمد أفندى الصياد وإبراهيم أفندى الدالي برتبة الملازمين بالجهادية “.

دهشور
حتى عام 1813 م. كانت المنطقة الشرقية لهرم سنفرو تحوي غابة كبيرة من شجر السنط مساحتها 268 فدان وإلى جوارها أطلال قرية أكانثوس الرومانية (ويعني اسمها شجر السنط) ، وفيها نزل عرب الدهاشرة في القرن الثالث الهجري وأسسوا قرية دهشور حيث اشتغلوا بمهمة إرشاد القوافل بسبب موقع البلدة لكن أراضيها كانت تابعة للديوان حيث يقول ابن الجيعان : ” دهشور مساحتها 3013 فدان كانت للديوان السلطاني والآن باسم سيدنا أمير المؤمنين المستنجد بالله تعالى أبي المظفر يوسف “.
وفي العصور التالية أسست قبيلة سنبس الطائية منشية دهشور وأسست عشائر من عرب الخبيري قرية زاوية دهشور (المعصرة) وأسست قبيلة مزغونة (من زنارة اللواتية) قرية العطف في الشرق على ساحل النيل (مزغونة حاليا) وفي جزيرتها (جزيرة مزغونة) ، يقول القلقشندي عن منشية دهشور : ” ومن سنبس طائفة بالجيزة حول سقارة ومنشأة دهشور وما والاهما ” ، ويقول محمد رمزي عن مزغونة : ” وفي تاريخ سنة 1228 هـ أعيد فصلها من دهشور باسم مزغونة وهم جماعة العرب المستوطنين بها “.
وفي الخطط التوفيقية : ” دهشور : هى قرية قديمة من قسم الجيزة على الشاطئ الغربى للفرع اللبيني بينها وبين الجبل الغربي نحو أربعمائة قصبة ، وأبنيتها من اللبن والآجر وبها جامع وثمان طواحين ومصبغتان ووكالة للمسافرين ، وفيها مضيفة متسعة مشتملة على مصاطب ومناظر معدة للضيوف لعمدتها إبراهيم منسي ، وبها نخيل بكثرة وأنوال لنسج مقاطع الكتان وسوقها كل يوم اثنين وأكثر تكسب أهلها من الزراعة.
وفى الجبرتى أن الفرنسيس دخلوها فى شهر الحجة سنة ثلاث عشرة ومائتين بعد الألف ونهبوها وقتلوا كثيرا من أهلها كما فعلوا فى بني عدي وقرى كثيرة ..
ثم فى غربى دهشور قرية صغيرة يقال لها الزاوية بحافة الجبل ، وشجر السنط كثير هناك ممتدّ إلى قرب سقارة وأكثر الفحم الوارد من بر الجيزة يأتى من هناك ، وكانت محطة لقافلة الفيوم قبل حدوث السكة الحديد، فكانت القافلة الواردة من الفيوم إلى مصر وبالعكس تنزل هناك، وفى وقت الفيضان كانت المحطة فى غربيها بالمحل المعروف بالفجة قبلى قرية المنشاة وليست الفجة بلدا مسكونة، وإنما هى محل به قهاو وبيع.
والعادة قديما أن القوافل لا تسير إلا بخبير من العرب يدل على الطريق ذهابا وإيابا ويخفرهم عرب من عرب الخبيري ، وهذه العادة جارية إلى الآن ولهم مرتب من طرف الديوان ..
وفى خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب لما أرسل من الصحابة والعرب جيوشا لفتح مصر وكان أمير مصر يومئذ الملك المقوقس اجتمعت الجيوش بتلك الناحية وحصل بها واقعة عظيمة واستشهد بها جملة من الأمراء العظام ولهم بها أضرحة تزار إلى الآن ولهم بها مولد سنوي ابتداؤه يوم أربعاء أيوب وانتهاؤه يوم الجمعة.
وإلى هذه البلدة ينسب الشيخ شمس الدين الدهشوري الشافعي ، قال فى ذيل الطبقات : كان شيخ وحده منعزلا عن الناس على الدوام وكان جالسا فى مقصورة الجامع الأزهر لا يستند إلى جدار قط أوقاته كلها معمورة بالعلم والعمل طول نهاره يقرأ الناس عليه العلم لا تقوم طائفة إلا وتجلس أخرى، رضي الله عنه ونفعنا به آمين “.

الشوبك
في يوم 31 مارس من كل عام تحتفل محافظة الجيزة بعيدها القومي والذي يوافق ذكرى استشهاد 12 شهيدا من أبناء قرية نزلة الشوبك بعد تصديهم لقوات الاحتلال البريطاني في أحداث ثورة 19 حيث تمت مهاجمة القرية بوحشية بعد قطع خطوط السكة الحديدية وقام جنود الاحتلال بإطلاق النار بعشوائية ثم نهبوا ممتلكات الأهالي وأحرقوا المنازل.
ويرجع تأسيس قرية الشوبك الغربي والشرقي ونزلة الشوبك إلى عرب العطيات وحلفاؤهم في العصر الفاطمي والأيوبي وكانت كلها متصلة وتقع بالبر الشرقي للنيل ثم انحسرت المياه وحدث انحراف لمجرى النهر فانفصلت الشوبك الشرقي وظلت تابعة للأعمال الأطفيحية بينما اتصلت الشوبك الغربي ببر الجيزة ومعها قرية الغفارتين التي عرفت باسم شوبك الغفارة ثم نزلة الشوبك.
جاء عنها في الخطط التوفيقية : ” شوبك الجيزة : قرية من مديرية الجيزة بقسم ثان موضوعة على الشاطئ الغربى للبحر الأعظم فى شمال ناحية مزغونة بنحو ألفين وخمسمائة وخمسين متر وفى الشمال الشرقى لدهشور بنحو أربعة آلاف وخمسمائة متر ، وأغلب مبانيها باللبن وبها زاوية للصلاة وبدائرها نخيل ، وكانت فى السابق فى البر الشرقي فأكلها البحر فانتقلت إلى البر الغربي ، ولها أطيان فى البر الغربي ولها أيضا جزيرة تجاهها فى وسط البحر صالحة للزرع ويسكنها بعض الأهالى والعرب “.
وطوال التاريخ عرف عرب العطيات بشدة البأس وثوراتهم الدائمة ضد الظلم ، ومنها ثورة الشوبك الكبرى ضد السلطات العثمانية عام 1101 هـ / 1689 م. عندما انضموا إلى عرب المغاربة في البهنسا والفيوم في تمرد كبير بزعامة شيخ العرب عبد الله بن وافي وذلك في عهد الوزير أحمد باشا الكتخدا والي مصر ، وتعرضت فيها قرية الشوبك الغربي لهجوم شرس من المماليك وعساكر الوالي استشهد فيها مائة من الأهالي وأعدم خمسة وأربعون من رجالها بعد أسرهم.
جاء في كتاب نزهة الناظرين : ” فتعين إبراهيم بك بن ذى الفقار بك ومعه جماعة من الأمراء وعساكر من الاسباهية وكبسوا هذه الجزيرة وقتلوا من أهلها ومن عرب العطيات نحو مائة نفس وطلع إبراهيم بك منها بخمسة وثلاثين رأسا وعرضها على إبراهيم باشا بقره ميدان فخلع عليه وعلى الشربجية وطلع قانصوه بك بسبعة رؤوس وثلاثة أشخاص بالحياة فخلع عليه وقطعت رءوس ثلاثة أشخاص بالديوان “.

أبو رجوان
جاء في الخطط التوفيقية : أبو رجوان من هذا الاسم قريتان بالقسم القبلى من مديرية الجيزة واقعتان غربى النيل المبارك، إحداهما البحرية فى غربى الشوبك بنحو خمسمائة متر، وبها جامع بدون منارة، والثانية القبلية فى شمال مزغونة بنحو نصف ساعة ومبانيها بالآجر وبها جامع بمنارة، وكلاهما فى شمال دهشور بنحو ساعة، وبكل منهما نخيل كثير من نخل الأمهات، وعند القبلية محطة السكة الحديد وبعدها عن المحروسة نحو خمسة فراسخ.
وكفاها شرفا أنه قد نشأ منها الأمير الجليل ذو المجد الأثيل حضرة السيد بيك صالح مجدى ، وهو كما أخبر عن نفسه محمد بن صالح بن أحمد بن محمد بن على بن أحمد بن الشريف مجد الدين، مصرى المولد مكى الأصل. ولد بقرية أبى رجوان القبلية فى منتصف شعبان سنة اثنتين أو ثلاث وأربعين من القرن الثالث عشر من الهجرة.
وكان أبوه من قرية مزغونة وهى قرية بقرب أبى رجوان ، كان قد نزل بها جده الأعلى الشريف مجد الدين- المكى المولد والأصل – عند وفوده على الديار المصرية فى أوائل القرن التاسع واستوطنها وتأهل فيها بكريمة بعض أعيانها ، واشتغل بالتجارة خصوصا فى المواشى ، وعلى منواله نسج أولاده من بعده وكان بيتهم فيها مشهورا ببيت الأشراف.
قال المترجم ولعل هذه النسبة صحيحة إن شاء الله تعالى ، قال : ثم انتقل الوالد من مزغونة إلى أبى رجوان سنة ثلاثين بعد المائتين والألف لنزاع وقع بينه وبين أخويه أحدهما العالم الفاضل الشيخ محمد صالح المتوفى سنة أربعين ، وثانيهما على صالح أحد المزارعين المتوفى سنة سبع وأربعين ولم يعقب.
قال : وقد تأهل الوالد فى أبى رجوان بكريمة من أهلها ، فرزق أولادا ووجاهة وقبولا ، لأنه كان كاسمه صالحا كريما وكان جسيما صاحب شهامة وبسالة وإقدام ، حتى إنه خرج عليه ليلا فى بعض أسفاره جماعة من قطاع الطريق فلم يكترث بهم وحمل عليهم فى ثلاثة رجال كانوا معه فبدّد شملهم وفرق جمعهم ، لكن أصيب منهم فى فخذه الأيمن برصاصة ارتهن بها فى فراشة نحو شهرين.
ولا زال منعم البال مرفه الحال إلى أن ماتت زوجته فى سنة خمسين فتكدّر عيشه وأخذت أحواله فى الاضمحلال لا سيما بهلاك مواشيه التى كان يتجر فيها ، وقد مات أولاده فى حياة أمهم ، ولم يبق سوى المترجم وكان أصغرهم : قال : فكان الوالدان يترددان بى فى كل عام بعد موت أخوتى إلى زيارة سيدى أحمد البدوى ، ويقولان لى : أنت السيد فاشتهرت بهذا الاسم من وقتئذ.
ثم تعين وهو مباشر فى طبع الكتب العسكرية لنظارة قلم الترجمة الذى كان بقلعة الجبل تابعا للمدرسة الحربية تحت نظر رفاعة بيك ، وبعد إلغاء تلك المدرسة والقلم اقتصر على مباشرة الكتب العسكرية كما كان ، وقد تم على يديه طبع عدة كتب من التى ترجمها وهو بآلاى المهندسين والكبورجية فى الفنون العسكرية.



