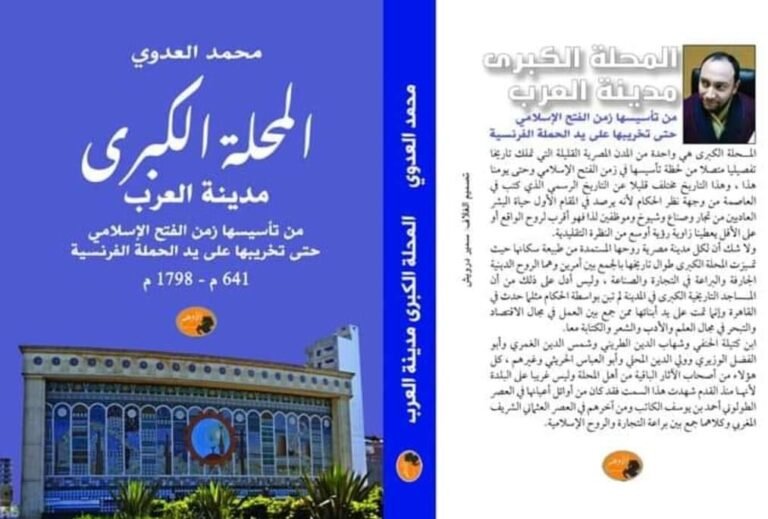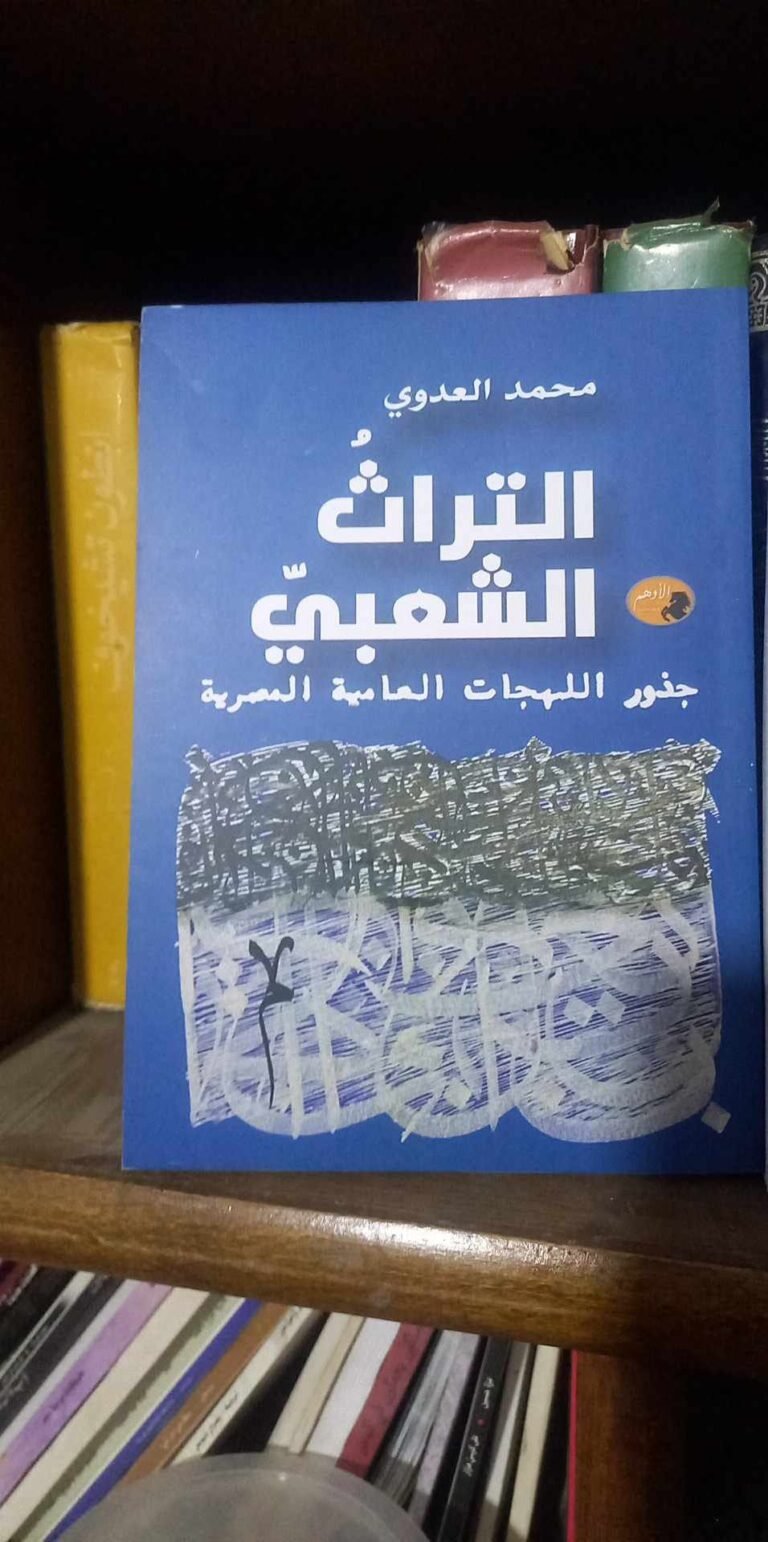عرب القليوبية
محافظة القليوبية هي الأولى على مستوى الجمهورية في أسماء القرى التي تبدأ بكلمة (عرب) والتي تدل على منازل القبائل العربية والتي يتركز معظمها في مركز شبين القناطر ثم طوخ والخانكة وبنها ، ويرجع سبب ذلك إلى حركة العمران التي شهدتها المنطقة بعد قرار السلطان محمد بن قلاوون بناء قناطر على بحر أبو المنجا في عام 735 هـ مما أدى إلى طفرة في أحوال الري والزراعة وأدت إلى إنشاء عدد كبير من القرى الجديدة.
ومن هذه القرى عرب الرواشدة وعرب الشعارة وعرب الشراقوة وعرب الصوالحة وعرب الحمامشة وعرب الحصوة وعرب صبيح وعرب غانم وعرب العراقي وعرب الخلوة وعرب أبو عيد وعرب العلوة وعرب المقابلة وعرب الغديري ونزلة عرب جهينة ونزلة عرب العبسة وعرب الحويان (الحسانية) وكفر العرب وعرب العيايدة وعرب العليقات وعرب بتمدة (نسبة لقرية بتمدة المجاورة وتسمى اليوم جزيرة بلي نسبة لقبيلة بلي العربية).
وقد تأسست تلك القرى على هيئة منازل غير دائمة للعشائر العربية طوال العصر المملوكي ثم توطنت في العصر العثماني وتمت إضافتها إلى السجلات الرسمية في العصر الحديث لأن معظمها كان متاخما للقرى العربية الأقدم التي تأسست في عصر الولاة والعصر الفاطمي على يد قبائل كنانة وبلي وتميم والجعافرة وجهينة وذلك في بلدات عرفت باسم هذه العشائر وذكرت في كل من الروك الصلاحي والروك الناصري والتربيع العثماني.
وهذه البلاد هي كل من تل بني تميم (نسبة إلى عرب تميم) ومنية كنانة (ميت كنانة نسبة لقبيلة كنانة) ومحيجة (الجعافرة) وحصة بني معن (الحصة) وديار أولاد خثعم وبني حرام الجذاميين (الدير والمنزلة) والزهويين ومنية السباع (كفر أبو زهرة) ومنية بني جعفر (السلمانية) والحزانية (كوم السمن) والحراز (الأحراز) والعطارة ومنية راضي ومنية عاصم والخريطة (كفر عامر ورضوان).
وامتدت القبائل من شبرا النجه وكفورها الستة (شبلنجة حاليا) حتى منية حلفا ومنية نما (ميت حلفا وميت نما) ومنية بني طيء (منطي) ومنية صرد (مسطرد) وبني صبرة التي عرفت باسم القصير (أبو زعبل) ، ووصلت منازلهم إلى ضواحي القاهرة القديمة مثل منية بني مطر (المطرية) وعرب أبو طويلة بجوارها وعرب بني وائل (الوايلي) وجب عميرة (بركة الحاج ونسبت إلى مؤسسها عميرة بن تميم بن جزء التجيبي الكندي).

تل بني تميم
في القرن الثاني الهجري دخلت عشائر من قبيلة بني تميم العربية إلى مصر بصحبة جيش العباسيين حيث تولى أحد زعمائها ولاية مصر وهو موسى بن كعب التميمي وكان أحد نقباء الدعوة العباسية في خراسان ، ذكره الكندي في الولاة والقضاة فقال : ” مُوسَى بْن كَعْب بْن عُيَينة بْن عَائِشَة بْن عمرو بْن سري بْن عايذة بْن الحارث بْن امرِئ القيس بْن زيد مَناة بْن تَميم بن مُرّ بْن أدّ بْن طابِخة بْن اليَأْس بْن مُضَر ، ثمَّ ولِيَها مُوسَى بْن كَعْب من قِبَل أمير المؤمنين أَبِي جَعْفَر ، وكان مُوسَى من نُقباء بني العبَّاس فدخلها لأربع عشرة ليلة بقِيَت من شهر ربيع الآخر سنة إحدى وأربعين ومائة عَلَى صلاتها وخَراجها “.
وعرفت منازلهم خارج الفسطاط باسم تل بني تميم وهي اليوم قرية تابعة لمركز شبين القناطر بالقليوبية ، وتبعتها موجات تالية في عصر الفاطميين بسبب الحروب الصليبية عرفت باسم بني مزروع وهم فرع من بني سعد بن زيد مناة من تميم ذكرها الباحث عبد العزيز مزروع التميمي في كتابه (بني تميم ومكانتهم في الأدب والتاريخ) حيث يقول : ” وكانت جمهرة الوافدين منهم تخيم في تل بني تميم من أعمال الشرقية ثم انتقل بنو سعد بن زيد مناة إلى السعديين وسعد هذا هو الأب المباشر لمزروع الأكبر فاستقروا إلى اليوم في قرية السعديين وقرية سنهوا بقرب منيا القمح “.
وجاءت تفاصيل عن منازلهم في كتاب مختصر معجم قبائل مصر حيث يقول النسابة الدكتور أيمن زغروت : ” بنو تميم قبيل عظيم من مضر وهم بنو تميم بن مر بن إد بن طابخة بن إلياس بن مضر ، وأكثرهم بالعراق ونجد والخليج ، وفي مصر قلة منهم في كفر التميمي مركز ميت غمر بالدقهلية وتل بني تميم مركز شبين القناطر بالقليوبية ، إضافة إلى قبيلة الضعفاء التي تقول مخطوطات مكتبة الأزهر الشريف أنهم من بني تميم ويقيم الضعفا في ليبيا في قرية بئر التميمي جدهم “.
جاء في التحفة السنية : ” تل بني تميم مساحتها 1804 أفدنة وبها رزق 58 فدانا عبرتها 6000 دينار كانت باسم المماليك والحلقة والآن لهم وأملاك وأوقاف ورزق ” ، وفي تاريخ ابن يونس المصري جاء ذكر أحد علماء بني تميم حيث يقول : ” الهذيل بن مسلم التميمى : كان فقيها ، سكن مصر وهو صاحب دار الهذيل التى فى طرف دار فرج يحذى فيها النّعال الصرادة توفى سنة تسع وثمانين ومائة “.
وجاء في القاموس الجغرافي : ” تل بني تميم هي من القرى القديمة وردت في قوانين ابن مماتي وفي تحفة الإرشاد من أعمال الشرقية وفي التحفة من أعمال القليوبية ، ووردت في كتاب وقف السلطان الغوري المحرر في سنة 911 هـ باسم بني تميم ولعل كلمة تل سقطت من الكاتب.
وفي سنة 1261 هـ فصل من هذه الناحية كفر سليمان الور فصار قرية قائمة بذاتها ، وفي سنة 1903 صدر قرار بإلغائه وضمه إلى تل بني تميم ولاشتراكه معه في الزمام والإدارة لا يزال يذكر اسمه مع تل بني تميم في جداول أسماء البلاد “.
وجاءت تفاصيل عن خط سير قبيلة بني تميم في موسوعة القبائل العربية حيث يقول محمد سليمان الطيب : ” جاء إلى مصر من بني طابخة القبائل الآتية : تميم ، يبدأ ظهور هذه القبيلة بمصر مع قيام الدولة العباسية سنة ١٣٢ هـ ولعلها دخلت مع جيوش العباسيين التي فتحت مصر وقضت على آخر الخلفاء الأمويين بها ، فإن أول من قدم من قواد العباسيين (شعبة بن عثمان ت ١٣٣ هـ) من بني تميم ، وربما كان تولي اثنين من تميم (موسى بن كعب سنة ١٤١ هـ) ، وسالم بن سوادة (سنة ١٦٤ هـ) حكم مصر فرصة متاحة لدخول آخرين من بني تميم.
والهذيل بن مسلم الفقيه (ت ١٨٩ هـ) الذي سكن مصر وملك فيها دارا باسمه شاهد على إقامة بني تميم بمصر في القرن الثاني ، أما القرن الثالث ففي شواهد القبور دليل على أنه – أو نصفه الأول على الأقل – كان حافلا بالتميميين الذين عاشوا في مصر وماتوا بها. ، نستطيع أن نطمئن إلى أن قبيلة تميم أقامت إقامة فعلية في مصر حيث تمتعت بمركز قوي استمدته من أبنائها الذين ولوا الحكم فيها ، بل إن من مواليها (موسى بن زريق سنة ١٦٢ هـ) من كبار الموظفين “.

شبين القناطر
جاءت كلمة القناطر في اسم مدينتين مصريتين هما القناطر الخيرية نسبة إلى القناطر التي بناها محمد علي باشا في القرن التاسع عشر الميلادي ، أما المدينة الثانية فهي شبين القناطر نسبة إلى القناطر التي بناها السلطان المملوكي محمد بن قلاوون في القرن الرابع عشر الميلادي.
وشبين القناطر مدينة قديمة جاءت في التاريخ الكنسي باسم شيبينتي (ويعني اسمها الأرض المستوية) وهو لفظ متكرر في عدد من البلاد لذا عرفت في العصور الإسلامية باسم شبين القصر (نسبة لأشهر معالمها وقتها) ، وبعد بناء القناطر تأسست ضاحية جديدة عرفت باسم المنصورة وعمرت بالسكان وعرفت عند العامة باسم منصورة شبين ثم أدمجت فيها بعد ذلك ثم تأسست حولها توسعات جديدة هي منية شبين وكفر شبين.
جاء في القاموس الجغرافي : ” شبين القناطر : قاعدة مركز شبين القناطر هي من القرى القديمة وردت في معجم البلدان شيبين من قرى الحوف بمصر بين بلبيس والقاهرة ، ولأجل تمييزها من شيبين التي في المنوفية وردت في قوانين ابن مماتي وفي تحفة الإرشاد باسم شيبين القصر من أعمال الشرقية وفي التحفة وردت محرفة باسم شبين القصر (أي بإسقاط الياء التي بعد الشين) من أعمال القليوبية والصواب شيبين ..
وورد في كتاب تاريخ مصر لابن إياس شيبين القناطر لأنها اشتهرت بالقناطر التي أنشأها على بحر أبي المنجا الملك الناصر محمد بن قلاوون في سنة 735 هـ إلا أنها كانت محتفظة باسمها القديم وهو شيبين القصر في دفاتر الروزنامة القديمة باعتبارها وحدة عقارية ومالية بهذا الاسم من قديم كما ورد في دليل سنة 1224 هـ وبما أنها كانت معروفة على لسان العامة باسم شيبين القناطر فقد قيد زمامها في تاريخ سنة 1228 هـ باسمها الحالي ..
وذكر أميلينو في جغرافيته قرية باسم Schebenti وقال إنها وردت مع ثلاث قرى أخرى في العبارة الآتية : وهي أن حاكم أتريب أمر أن يؤتى له بالمسيحيين فأتوا له بأربعة رجال من أربع قرى وهي ابليل ونانهاتي وناوي وشيبينتي ..
وفي سنة 1261 هـ فصل من شبين قرية أخرى باسم منصورة شبين ولاشتراكها مع شبين في السكن وتداخل أطيانها بين أطيان شبين صدر قرار في سنة 1903 بإلغاء وحدة منصورة شبين وإضافتها إليها كما كانت ولا يزال اسمها يذكر مع شبين باسم شبين القناطر ومنصورتها “.

قرية عرب الصوالحة
جاء في موسوعة القبائل العربية : الصوالح ، نسب القبيلة : ذكر في إحدى الوثائق القديمة الخاصة بالبدو والمحفوظة بدير سانت كاترين وبعد الاطلاع عليها أن أصل الصوالحة من مؤسسهم صالح بن حميد بن سليم من حرب الحجاز ، وأضاف الرواة من كبار الصوالحة أنهم من بني سالم كما تواتر عند أجدادهم قبل سبعة قرون.
كما ذكر نعوم شقير في تاريخ سيناء ص ١١: أن في تقاليد الصوالحة أن أصلهم من قبيلة حرب في الحجاز. ، وذكر الدكتور عباس مصطفى عمَّار عن أصل الصوالحة في المدخل الشرقي لمصر حاشية ص ٨٢ فقال : أكد لي مشايخ البدو الذين قابلتهم في صيف عام ١٩٤٣ م أن أصل الصوالحة من حرب.
نماء الصوالحة وانفصامهم من حرب وتاريخهم بسيناء : ذكر في أحد وثائق دير سانت كاترين مدوَّن فيها جلسة رسمية لشيوخ العربان برئاسة الشيخ إبراهيم بن أحمد العايدي من عرب العايد من جُذام القحطانية بتاريخ ١٨ من شهر جمادى آخر عام ٨٠٠ هـ ، وقد ذكر عن شيخ الصوالحة قويضي بن خبيزات بن منجد من العوارمة إحدى فروع الصوالحة ، لما سأله الشيخ إبراهيم العايدي عن نسب الصوالحة وتاريخهم ليُسجَّل في وثائق الدير أجاب شيخ الصوالحة قائلًا : إن جد الصوالحة هو صالح بن حميد بن سليم من حرب الحجاز وكان له أربعة أولاد هم عارم ومنه العوارمة ، وحميد منه الحميدات ، ورضوان ومنه الرضاونة ، وناصر ومنه النواصرة.
الحميدات سموا بعد ذلك في وثائق دير سانت كاترين منذ عام ٨١٥ هـ باسم المحاسنة تبعًا لجدهم محسن من الحميدات وهو ولي صالح يزاد ، وكان قليد قومه فغلب اسم المحاسنة على فرع الحميدات ، ومن المحاسنة عقيد الحرب لعموم الصوالحة ويلقَّب حتى الآن أولاده باسم العقدة أو فلان العقيد.
ينقسم الصوالحة من أبناء صالح قبل سبعة قرون إلى أربعة فروع هي : العوارمة ، والمحاسنة والرضاونة ، والنواصرة. ، ذكر نعوم شقير أن بلاد الصوالحة في قلب منطقة الطور جنوب شبه جزيرة سيناء المصرية ومعهم حلفاؤهم القرارشة وأولاد سعيد وتحيط بهم قبيلة العليقات من الشمال ومزينة من الجنوب كدائرة ، وأضاف قائلًا وإن في تقاليد الصوالحة أنهم من حرب الحجاز.
وقد هاجر قسم منهم إلى القليوبية بسبب مجاعة في سيناء ولبعض المهاجرين أملاك ظلت حتى عهد قريب في وادي فيران ، وكان كبيرهم في قليوب هندي أبو شعيرة من النواصرة ، وقد ذكر نعوم بيك بعض الفصائل من العوارمة مثل الرديسات والفوانسة وأولاد شاهين وكان شيخهم قبيل عام ١٩١٤ م يسمى غنيم فانوس من الفوانسة (العوارمة).
الصوالحة في القليوبية : أشهرهم عائلة أبو شعير من النواصرة وفيهم عمدة عرب الصوالحة ، وعائلات الهضيبي والكرت وأبو عرموش من الرضاونة ، وعائلة أبو منون من العوارمة ، وعائلات العقدة (العقيد) وأولاد عيد والحسيسي من المحاسنة وانضمت لعُمدية الصوالحة عائلات أخرى في القليوبية ، ويقول الرواة : إن الكثير من الصوالحة تفرقوا في الوجه البحري وبعضهم سكن بلاد الصعيد المصري. ، ومن أعلام الصوالحة في القليوبية الدكتور أحمد الحسيسي رئيس قسم اللغات الشرقية بكلية الآداب جامعة عين شمس.

الجعافرة والسلمانية (مركز شبين القناطر)
الجعافرة : هي من القرى القديمة اسمها القديم محيجه وردت في التحفة مع بلقس إذ قال ومحيجه وكفرها وتعرف بكوم الهوى من ضواحي مصر ، وفي تربيع سنة 933 هـ كوم الهوى وهي كفر بلقس كما وردت في دليل سنة 1224 هـ ، ولما كان سكان هذه القرية من عرب الجعافرة الذين استوطنوا في تلك الجهة فقد انتهزوا فرصة تاريخ سنة 1228 هـ وسموها الجعافرة للتخلص من كوم الهوى ، وبناء على ذلك وردت في دفتر التربيع الخاص بها باسم الجعافرة وهي كوم الهوى للإرشاد إلى اسمها القديم ثم حذف كوم الهوى وبقيت باسمها الحالي.
السلمانية : كان يوجد ناحية قديمة ذات وحدة مالية تسمى منى جعفر وردت في قوانين ابن مماتي وفي تحفة الإرشاد من أعمال الشرقية ومعها الغريرا ، وذكرها ياقوت في معجم البلدان فقال : منى جعفر جمع منية اسم لعدة ضياع في شمال الفسطاط ، وبالبحث تبين لي أن الضياع المشار إليها هي النواحي التي تعرف اليوم بأسماء المنايل والعطارة والحزانية وكوم السمن والجعافرة والسلمانية والمنية من قرى مركز شبين القناطر وزاوية النجار من قرى مركز قليوب.
وفي الروك الناصري سنة 715 هـ فصل أغلب النواحي المذكورة بزمام خاص من أراضي ناحية منى جعفر ما عدا ضيعتي السلمانية وزاوية النجار فقد بقيتا تابعتين لناحية منى جعفر التي وردت في التحفة من أعمال القليوبية ، ووردت في دفتر المقاطعات سنة 1079 هـ منا جعفر بولاية قليوب ، وفي العهد العثماني قسمت أراضي ناحية منى جعفر بين ناحيتي السلمانية هذه وبين زاوية النجار ، وبذلك اختفى اسم منى جعفر من عداد النواحي المصرية وحل محلها هاتان الناحيتان كل ناحية منهما على حدة ، وقد وردت السلمانية هذه في تاريخ سنة 1228 هـ.
المنايل : هي من القرى القديمة وقد دلني البحث على أنها كانت تسمى كوم ريحان ، وردت في التحفة من أعمال القليوبية ، ويستفاد مما ورد في دليل سنة 1224 هـ أنه في تربيع سنة 933 هـ غير اسم كوم ريحان إلى المنايل فورد في ولاية قليوب في حرف الألف : المنايل وهي كوم ريحان ترد في حرف الكاف ، وفي حرف الكاف ذكر كوم ريحان وقال : تعرف بالمنايل المعروفة بمنايل كوم ريحان ، والظاهر أن كوم ريحان كان بها حوض يعرف بالمنايل وتغلب اسمه على اسم القرية فعرفت بالمنايل ، وقد وردت باسم منايل كوم ريحان في كتاب وقف الكسوة الشريفة المحرر في سنة 947 هـ ثم حذف منها كوم ريحان فأصبحت باسم المنايل وهو اسمها الحالي.
الحزانية : أصلها من توابع كوم السمن ثم فصلت عنها في تربيع سنة 933 هـ كما ورد في دليل سنة 1224 هـ ، وفي تاريخ سنة 1228 هـ ضمت الحزانية إلى كوم السمن وصارتا بلدة واحدة باسم الحزانية وكوم السمن أي أن كوم السمن أصبح تابعا بعد أن كان متبوعا إلى أن فصل من الحزانية ، كوم السمن هو من القرى القديمة ورد في التحفة من أعمال القليوبية ، وفي سنة 1906 صدر قرار بفصله عن الحزانية من الوجهة الإدارية وفي سنة 1933 صدر قرار بفصله عنها من الوجهة المالية وبذلك أصبح ناحية قائمة بذاتها.
الحسانية : أصلها من توابع ناحية الأحراز ثم فصلت عنها من الوجهة الإدارية في سنة 1890 ويسميها العامة عرب الحويان وتنسب إلى عمدتها الشيخ حسان الحوي شيخ عرب الحويان.

كفر الصهبي
في نهاية العصر المملوكي نزلت عشائر بني سليم العربية في شمالي قرية الأحراز بالأعمال القليوبية وأسست قرية عرفت باسم القلزم وتم منحهم مساحة من الزمام الزراعي للأحراز ، وفي العصر العثماني انفصلت عنها عشيرة أولاد الصهبي وأسست قرية مستقلة تعرف اليوم باسم كفر الصهبي مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية ، ومنحت السلطات العثمانية لقب الأغوية لعدد من رجال القبيلة والتي سميت الصهبي نسبة إلى جدهم الأعلى صهب بن جابر.
جاء في القاموس الجغرافي : ” كفر الصهبي أصله من توابع القلزم ثم فصل عنها في سنة 1282 باسم كفر أولاد الصهبي ومن سنة 1891 باسمه الحالي ، وينسب إلى منشئه بشير أغا محمد الصهبي ” ، وفي القرن التاسع الهجري ذكر ابن الجيعان الزمام الزراعي الذي نشأت فيه القرية حيث يقول في كتاب التحفة السنية : ” الحراز مع القلزم قانونها 1075 فدانا عبرتها 1750 دينار باسم المقطعين “.
وجاء في موسوعة القبائل العربية : قبائل بنو سُلَيم في مصر : الصُهْب ، وتنسب هذه القبيلة إلى صُهْب بن جابر من بطون ذُباب بن مالك من بني سُلَيْم ونزل إلى مصر معظم هذه القبيلة التي كان مقرها في منطقة غرب ليبيا ، وذكرت هذه القبيلة في حصر قبائل مصر عام ١٨٨٣ م في القليوبية وجرجا في سوهاج وغيرها من الأقاليم المصرية وهم من العرب المستقرين.
وفي القليوبية يوجد قرية كبيرة مُسمَّاة باسم هذه القبيلة ” كفر الصهبي ” سكنها بعض عائلات هذه القبيلة ، وقد تفرقت هذه القبيلة في قرى القليوبية ، وبالبحث الميداني كما أخبرني أحد شيوخ القبيلة وهو الشيخ عدلي بحيري عبد الصمد البشير محمد عبد الله سليمان أبو بكر بحيري الصُّهبي من الرجالات المعروفين ، وهو مهندس على المعاش ومن أمناء حزب الوفد البارزين في القليوبية ، كالتالي :
تفرعت أفخاذ الصُّهْب في القليويبة من سليمان بو بكر البحيري الصُّهْبي وهما فخذ حمد ، وفخذ عبد الله. فمن حمد عائلات أبو القاسم وعيسى ، ومن فروع أبو القاسم : سليمان ، ومن فروع عيسى : حمد وأبو القاسم ومحمد وعلي. ومساكن حمد في عزبة أبو القاسم وعيسى في مركز طوخ بالقليوبية.
أما الفخذ الثاني عبد الله فهو أكبر عددا ومنه عائلة سليمان بعزبة العريضة بطوخ محافظة القليوبية ، وكان لهم عزبة العبسي بكفر الصهبي أيام الإقطاع في عهد الملكية في مصر ، ومن هذه العائلة علي أغا فارس مشهور أيام حكم محمد علي باشا ومُعيَّن أغا من قبل الوالي التركي على مصر (في عهد الدولة العثمانية) ، وثبَّته محمد علي في الأغاوية.
ومن فخذ عبد الله أيضا عائلة الزرُّوق بقرية نمول مركز طوخ ، وعائلة عبد القادر بعزبة الكبار في سندنهور مركز بنها بالقليوبية ، وعائلة الفقي بميت عاصم مركز بنها ، وعائلة محمد أبو البشير بعزبة البشير مركز طوخ ؛ ومن هذه العائلة أولاد عبد الله الغر في عزبة خاصة بهم جوار البشير ، ومن فخذ عبد الله أيضًا عائلة أبو خزام في عزبة أبو عريضة نواحي مركز طوخ ، وعائلة مرعي خليفة بعزبة تحمل اسمها بمركز طوخ أيضا بمحافظة القليوبية.

البرادعة
سميت قرية البرادعة بمركز القناطر الخيرية نسبة إلى عرب بني بردعة وهم فرع من قبيلة جذام ذكرهم أبو العباس القلقشندي في كتابه نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب حيث يقول : ” بنو بردعة – بطن من بني زيد بن حرام بن جذام ، مساكنهم بالحوف من الشرقية من الديار المصرية مع قومهم جذام ، ذكرهم الحمداني “.
وجاء في القاموس الجغرافي : البرادعة أصلها من توابع ناحية سندبيس ثم فصلت عنها وعن زفيتة شلقان (المنيرة) في تاريخ سنة 1228 هـ باسم كفر البرادعة ومن سنة 1259 هـ باسمها الحالي ، وفي سنة 1259 هـ فصل من البرادعة ناحية أخرى باسم خلوة البرادعة وفي سنة 1903 صدر قرار بإضافة هذه الخلوة إلى البرادعة فصارتا ناحية واحدة باسم البرادعة وخلوتها ، وأخبرني العلامة الجليل أستاذي أمين سامي باشا وهو من أهل هذه الناحية وكبير الملاك فيها أن البرادعة تنسب إلى جماعة من عرب الحجاز يعرفون بالبرادعة وهم الذين أنشأوا هذه القرية فعرفت بهم.
سندبيس : هي من القرى القديمة اسمها الأصلي دسبندس وردت في كتاب فتح مصر ضمن القرى التي نزل بها العرب في الحوف الشرقي ، وفي القرن السادس الهجري حرف اسمها إلى الاسم الحالي لسهولة النطق به فوردت به في قوانين ابن مماتي وفي تحفة الإرشاد من أعمال الشرقية وفي التحفة من أعمال القليوبية.
وجاء في الخطط التوفيقية : البراذعة قرية صغيرة من مركز قليوب بمديرية القليوبية ، واقعة على الشط الغربى لترعة القرطامية ، وفى الشمال الشرقى لعزبة بنهادة ، بنحو ألفى متر ، وفى جنوب منديس بنحو ساعة ، وأبنيتها بالآجر واللبن ، وأغلب منازلها بمقاعد ، وبها جامع بمنارة وكنيسة للأقباط تتردد إليها أقباط بلاد الجيزة ، وبها حديقة لعمدتها محمد علام ، الذى كان ناظر قسم زمن المرحوم سعيد باشا ، وجعل ابنه محمد علام مأمور مركز قليوب.
ومن هذه القرية إبراهيم أفندى سالم ، دخل مكتب قليوب سنة تسع وأربعين ومائتين وألف ، وبعد أن دخل مدرسة قصر العينى ومدرسة أبى زعبل ، وتعلم بهما مبادئ العلوم انتقل إلى مدرسة المهندسخانة سنة أربع وخمسين ، ودرس علومها وفاق أقرانه ، فكان هو الأول من فرقته.
وفى سنة ستين أخذ رتبة ملازم ، وسافر مع تلاميذ فرقته إلى عمل رسم شفالك الغربية والدقهلية تحت رياسة (لانبير بيك) وبهجت باشا. ، وفى سنة ثلاث وستين تعين للتدريس بمدرسة المهندسخانة. ، وفى سنة ست وستين جعل باشمهندس مديرية القليوبية برتبة يوزباشى ، فلم يلبث إلا قليلا وأقيمت عليه دعوى أنه أهمل فى رىّ الأرض ، فحكم عليه بحطه إلى رتبة الملازم.
ولما جلس المرحوم سعيد باشا على تخت هذه الديار ، تعين معاونا مع بهجت باشا فى مسح أراضى الفيوم ، فأقام فى ذلك سنة ، ثم بأمر كريم تعين فى ضمن من تعينوا لعمل رسومات وموازين لعمل ترعة القنال المالحة ، فأقام فى ذلك أربع سنين.
وفى سنة ست وسبعين تعين مع أخينا محمود بيك الفلكى لرسم الخريطة الفلكية للأقاليم البحرية من ديار مصر ، فأقام معه حتى تمت هذه الخرط جميعها ، ثم اشتغل معه فى خرط الوجه القبلى ، وترقى إلى رتبة صاغقول أغاسى ، ثم إلى البيكباشى وهو فى تلك الأشغال.
ولما أراد الخديوى إسماعيل باشا عمل السكة الحديد فى البلاد السودانية ، واقتضى الحال استكشاف الطرق من سواكن إلى بربر ليتخير أسهل طريق منها ، عين المترجم وجملة من المهندسين بمعية إسماعيل بيك الفلكى لاستكشاف ذلك ، وعمل ما يلزم من الرسومات والموازين ، فتوجهوا وأجروا ذلك ، وحضروا بعد ثمانية أشهر.
ثم صار من رجال ديوان الأشغال المعتمدين ، تحال على عهدته المشكلات الهندسية والأمور الدقيقة ، فيقوم بها لما فيه من الاستعداد والتثبت فى فنونه ، وهو إنسان خيّر حسن السمت والسير والسيرة.

طحانوب
قرية بمركز شبين القناطر اسمها الأصلي طحا ونسبت إلى قرية نوب المجاورة لها ، جاء عنها في التحفة السنية : ” طحانوب وكفورها مساحتها 2836 فدان وبها رزق 55 فدانا عبرتها 7000 دينار كانت للمماليك والحلقة والآن باسمهم وأملاك وأوقاف ” ، وفي القاموس الجغرافي : طحانوب قرية قديمة وردت في قوانين ابن مماتي وفي تحفة الإرشاد طحا من أعمال الشرقية وفي التحفة طحانوب من أعمال القليوبية وعرفت باسمها الحالي لمجاورتها لناحية نوب ولتمييزها من سمياتها التي بمديريات الدقهلية وبني سويف والمنيا “.
وكانت تتبع قبل ذلك قسم قليوب حيث ذكرها علي باشا مبارك في الخطط التوفيقية فقال : ” طحانوب قرية من مديرية القليوبية بقسم قليوب في شمال نوب طحا بنحو ألفى متر وفى غربى كفر سندوة كذلك ، وبها جامع بمنارة وحواليها نخيل ، وسوقها كل يوم ثلاثاء ، ومنها شيخ العميان وخطيب جامع الإمام الشافعى الشيخ (أحمد الطحاوى) ، كان عالما جليلا مهيبا متقنا لتجويد القرآن على طريقة حفص جسيم الجسم جهورى الصوت توفى سنة ألف ومائتين وخمسة وثمانين ، وفى الجنوب الشرقى لطحا هذه كفر يقال له كفر طحا “.
ومن أشهر أعلامها أحمد باشا حمزة (1891 ـ 1977) الذي كان وزيرا للتموين ثم الزراعة في حكومة مصطفى النحاس باشا ، وهو أول من بنى مصنعا لإنتاج الزيوت العطرية مصر وذلك بعد عودته من دراسة الهندسة في انجلترا ، وهو أول من أضاء المسجد النبوي الشريف بالكهرباء ، وحينما زار الملك عبدالعزيز آل سعود مصر في عام 1946 حرص على زيارة أحمد باشا حمزة في منزله بقريته طحانوب بمحافظة القليوبية حيث قدم له الشكر والإمتنان على قيامه بإدخاله الكهرباء إلى المسجد النبوى الشريف وإنارته على نفقته الخاصة.
أصدر أحمد حمزة باشا مجلة لواء الإسلام في عام 1947 والتي حفلت بكتابات أعلام الفكر الإسلامي ، وقد عمل على استمرار صدورها حتى في الفترات التي عانى فيها من مصاعب اقتصادية بسبب القرارات التي واجهها في عهد الثورة فكان يقتطع من دخله المحدد بإجراءات التأميم ما يمكنه من تمويل طباعتها وإصدارها ، وقد استمرت المجلة في الصدور من بعده وقد تولت أمرها من بعده ابنته السيدة فاطمة حمزة حتى توقفت عام 1989 ، وظل على مدار ثلاثين عاما يكتب افتتاحيات المجلة متحدثا عما يشغل العالم الإسلامي من أحداث.
وذكر الدكتور محمد علي شتا (مدير مكتب أحمد حمزة باشا) في مذكراته قصة سفره للحج منتصف الأربعينيات وكيف حزن لرؤيته للمسجد النبوي مظلما حيث جاء فيها : توجه أحمد حمزة باشا لأداء مناسك الحج بصحبة مدير مكتبه الدكتور محمد علي شتا وفوجئا بأن المدينة المنورة منورة بمن فيها وما فيها ولكنها لم تكن مضاءة بالكهرباء حتي المسجد النبوي الشريف كان بدون إضاءة كهربائية حيث كان المسجد النبوي الشريف في أول تأسيسه يضاء بسعف النخيل حتى قام تميم بن أوس الداري اللخمي والذى كان يكنى بأبي رقية أحد أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم بإضاءته بالزيت.
وقد ظل الحال هكذا في المسجد النبوى الشريف ولذا فقد كانت إضاءة المسجد خافتة حتى أنه يكاد يكون مظلما خاصة بعد عملية التوسعة التي تم تنفيذها في عهد السلطان العثماني عبد المجيد الأول والتي تعد أكبر عمليات عمارة وتوسعة المسجد النبوى الشريف في العهد العثماني وذلك في عام 1265 هجرية الموافق عام 1849م والتي إنتهت في عام 1277 هـجرية الموافق عام 1860م والتي زادت من حدة الظلام داخل المسجد علي الرغم من زيادة عدد المصابيح الزيتية من 600 مصباح ليصبح عددها 2427 مصباح فتملك أحمد حمزة باشا الحزن ولم يحتمل أن يكون ثاني الحرمين وثاني أطهر مكان علي وجد الأرض مظلم وبدون إنارة كافية.
فأسر الرجل في نفسه شيئا وبدأ تنفيذه فورا عقب عودته إلي مصر حيث قرر شراء عدد من المحولات والكابلات والأسلاك والمصابيح الكهربائية وكلف مدير مكتبه الدكتور شتا بإصطحاب عدد من المهندسين المتخصصين ومرافقة هذه المهمات وأرسلهم على نفقته الخاصة عبر ميناء السويس ومنه إلي ميناء جدة ثم إلى المدينة المنورة وتولي هؤلاء المهندسون تركيب المصابيح وتشغيل المولدات لإضاءة الحرم النبوي الشريف وإستمرت هذه العملية أربعة أشهر كاملة وبعدها تلألأ المسجد النبوي الشريف بنور الكهرباء وأقيم بهذه المناسبة إحتفال كبير وبذلك كان أحمد حمزة باشا المصرى الوفدى هو أول من أضاء الحرم النبوي الشريف بالكهرباء.

كفر الحارث وأرض اللخميين
في عهد أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز نزلت عشائر من العرب اليمانية بزعامة الحارث بن ثابتة بن ذاخر الأصبحي الحميري في منطقة رأس الدلتا حيث كانت المنطقة تتكون من عدة جزر فقام بإصلاحها حتى عمرت المنطقة بين باسوس جنوبا وصنافير شمالا (كفر الحارث حاليا) ، وجذب العمران عشائر لخم اليمنية فاستقرت في جنوبها وعرفت منازلهم باسم أرض اللخميين (قرية الأخميين حاليا) ثم اقتطع من جانبها الشمالي مساحة لرعاية الخيول وسميت منية شلقان ويعني اسمها مربط الفرس (قرية شلقان الحالية).
وفي أقصى الجنوب انتزع من أرض اللخميين مساحة لصالح الديوان السلطاني عرفت باسم الخاقانية (قرية الخرقانية حاليا) ثم فصلت جزيرة اللخميين أيضا بعد اتصالها بالبر وسميت على اسم عشيرة أبو الغيث (قرية أبو الغيط حاليا) ، وقد وصف الإدريسي في كتابه نزهة المشتاق كلا من شلقان والخاقانية فقال : ” شلقان قرية كبيرة عامرة .. الخرقانية وهي قرية عامرة بها مزارع وضياع وبساتين كثيرة للملك ” ، وفي العصر الحديث انتزع الجانب الساحلي من أرض اللخميين لبناء مدينة القناطر الخيرية.
جاء في القاموس الجغرافي : ” كفر الحارث : هو من الكفور القديمة ورد في التحفة مع صنافير من أعمال القليوبية محرفا باسم الحادث والصواب الحارث وفي تاريخ سنة 1228 هـ كفر الحارس ومن سنة 1259 هـ كفر الحارث ، وورد في الخطط المقريزية ما يفيد بأنها منسوبة إلى منشئها الحارث بن ثابتة كان من أثرياء مصر في زمن خلافة عمر بن عبد العزيز وولاية حيان بن شريح وكان حيان في حاجة إلى المال فاقترض من الحارث عشرين ألف دينار أتم بها عطاء أهل الديوان ..
الأخميين : هي من القرى القديمة اسمها الأصلي اللخميين نسبة إلى جماعة من بني لخم أنشأوها وكان يتبع هذه القرية جزيرة كبيرة وردت في مباهج الفكر باسم جزيرة اللخميين من أعمال القليوبية ووردت في التحفة مع الخاقانية وجزائرها من أعمال القليوبية وفي الانتصار الجزائر بالخاقانية ، وفي تربيع سنة 933 هـ توزعت جزائر الخاقانية (الخرقانية) على نواحي اللخميين (الأخميين) وأبو الغيث (أبو الغيط) وبيسوس (باسوس) وفي العهد العثماني حرف الاسم من اللخميين إلى الأخميين وقد وردت به في تربيع سنة 933 هـ وتاريخ سنة 1228 هـ ..
أبو الغيط : أراضي هذه الناحية أصلها جزيرة كبيرة قديمة وردت في مباهج الفكر باسم جزيرة اللخميين (الأخميين) ثم وردت في التحفة مع الخاقانية (الخرقانية) باسم الخاقانية وجزيرتها من أعمال القليوبية ، وفي تربيع سنة 933 هـ فصلت هذه الجزيرة عن ناحيتي الخرقانية والأخميين باسم أبو غيث كما ورد في دفتر المقاطعات سنة 1079 هـ ثم وردت بعد ذلك باسم أبو الغيث كما ورد في دليل سنة 1224 هـ ثم حرف الاسم إلى أبو الغيط وهو اسمها الحالي الذي وردت به في تاريخ سنة 1228 هـ “.
وجاء في الخطط التوفيقية : اللّخميين قرية بالقليوبية ، أنشأ بها الأمير عثمان كتخدا جامعا ومكتبا ، ووقف أراضيه التى بناحيتها وغيرها على هذا الجامع وغيره كما فى حجة وقفيته المبين فيها أوقافه وجهات صرف ريعها المؤرخة بسنة تسع وأربعين ومائة وألف.

مدينة القناطر الخيرية
في عام 1847 م. قرر محمد علي باشا البدء في إنشاء سد كبير في منطقة رأس الدلتا حيث يتفرع نهر النيل إللى فرعي رشيد ودمياط ، وكان السدود تعرف وقتها باسم القناطر أي الجسور ووصفت بالخيرية بسبب ما حملته من خير للبلاد في أحوال الري والزراعة ، ونتج عن ذلك وجود تجمعات سكانية تأسست في الأرض التي كانت تعرف وقتها باسم أرض اللخميين (نسبة إلى قبيلة لخم) ..
وذكر علي باشا مبارك في الخطط التوفيقية أن هذه التجمعات كانت عزب خصصت لسكن عساكر البحرية وجوارها ورش صناعة الحديد وورشة ضرب الطوب ووابور الحمرة ومخزن العموم والطواحين ومخبز العساكر ومساكن الإفرنج المهندسين والصناع موزعة على الانتظام بين قنطرتى الشرق والغرب ولكثرة العساكر الشغالة والمستخدمين بها كان هناك أسواق دائمة يباع فيها جميع ما يلزم للمقيمين بها ..
وفي أول حكم الوالي سعيد باشا تقرر إزالة كل هذه التجمعات وتأسيس القلعة السعيدية فانتقل الجنود والحرفيون والباعة إلى جوار قرية شلقان وعرف موضعهم الجديد باسم عزبة شلقان وانتقل البعض الآخر إلى غرب النيل وعرف موضعهم باسم المناشي ، وبعدها بخمس سنوات تم عمل استحكامات المناشي فانتقل سكانها إلى عزبة شلقان فازدادت أهلها وكثرت مبانيها حتى صارت بلدة كبيرة مشتملة على أسواق وحوانيت ..
وصار يوجد بها جميع البضائع ويأتى إليها أهل البلاد المجاورة لقضاء حوائجهم منها وترسو عندها المراكب فيجد المسافرون جميع لوازمهم ، لكن في عام 1860 م. صدر أمر الوالي سعيد باشا لمحافظ القلعة وقتئذ قاسم باشا بنقل عزبة شلقان إلى جهة الجنوب بنحو ثلاثة آلاف متر وعين لها قطعة أرض من شفلك اللخميين (زمام أرض اللخميين) وأمهل الناس لضرب الطوب وتجهيز اللوازم فاشتغل كثير منهم بذلك ..
وعندما تولى الخديوي إسماعيل عين على نظارة القناطر الخيرية علي باشا مبارك فاهتم بالقرية ورتب لها مشايخ وخفراء وجعل إدارتها تابعة لديوان القناطر الخيرية ، ويقول عن ذلك في الخطط التوفيقية : ” ولحسن موقع تلك القرية والاحتياج إليها فى مصالح القناطر والعمائر التى هناك قد استحصلنا من الخديوى إسماعيل باشا على أمر بإعطاء أهلها ثلاثين فدانا إنعاما يتملكونها ويبنون فيها المساكن برسم عملناه لذلك وأن لا يتعرض لهم بشئ من مطلوبات المديريات بل يعاملون معاملة القاهرة ونحوها “.
ويقول عنها محمد بك رمزي : ” وفي سنة 1914 أثناء انتدابي لأعمال تفتيش المالية بمديرية القليوبية أشرت على عمدتها محمود أفندي عزمي أن يطلب تغيير اسمها على أن تسمى القناطر الخيرية لمجاورتها لهذه القناطر الشهيرة وقد عمل بمشورتي ووافقت نظارة الداخلية على تسميتها القناطر الخيرية بقرار أصدرته في 4 يونيو سنة 1914 “.

أبو الغيط وشلقان
قرية أبو الغيط بالقليوبية اسمها الأصلي أبو غيث وكانت جزيرة وسط النيل تابعة للخاقانية وعرفت باسم جزيرة اللخميين نسبة إلى قبيلة لخم العربية ، وفي العصر العثماني اتصلت بالبر وعرفت باسمها الحالي ، وأما شلقان فكانت في الأصل مرابط للخيول في العصر المملوكي ثم منحت للعربان في العصر العثماني ثم بنيت بها قلعة في العصر الخديوي ، وجاء عنهما في الخطط التوفيقية :
أبو الغيط : قرية من أعمال قليوب فى الجانب الشرقى لبحر دمياط وفى جنوب الخرقانية بنحو ألفى متر ، وبها جامع بمنارة ومعامل دجاج ودار مشيدة لبعض كبرائها ولها سوق كل أسبوع ، ويزرع فى أرضها البطيخ والشمام كثيرا ويكون غاية فى صدق الحلاوة وطيب الرائحة ، وأكثر ما يباع منه بالقاهرة والإسكندرية ونحوهما مجلوب من هذه القرية ، ومن قرية بيسوس وما جاورهما من القرى.
والظاهر أن الشيخ العلامة نجم الدين الغيطى ينسب إلى هذه القرية ، وكان إماما ذا أخلاق حسنة وأوصاف جيدة ، قال الشعرانى فى ذيل الطبقات : صحبته نيفا وأربعين سنة ، فما رأيت عليه شيئا يشينه فى دينه ، بل نشأ فى عفة وعلم وأدب وحياء وكرم نفس وحسن أخلاق.
أخذ العلم عن جماعة من الفضلاء منهم : الشيخ زكريا الأنصارى ، والشيخ عبد الحق السنباطى ، وابن أبى شريف ، والشهاب والرملى ، وأفتى ودرس فى حياة أشياخه بعد الإجازة وانتهت إليه الرياسة فى الحديث والتفسير والتصوّف ، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ، لا تأخذه فى الله لومة لائم ، ولما وقعت فتنة أخذ وظائف الناس بغير حق انتدب لها وكان خمود الفتنة على يديه وشكره أهل الروم والحجاز والشام على ذلك.
وتولى مشيخة الصلاحية والخانقاه السرياقوسية وكتب على بعض مؤلفاتى كتابة حسنة لم يسبق إليها أحد، لأنى جمعت فيه نحو ثلاثة آلاف علم ، لا يكاد يصدق بتلك العلوم إلا من رآه ، وله تهجد عظيم فى الليل وبكاء وتضرع وخشية يصبح فى بعض الليالى وجهه يضئ كالكوكب لا ينكر ذلك إلا عدوّ أو حاسد ، وكانت وفاته رضي الله عنه نهار الأربعاء سابع عشر صفر سنة إحدى وثمانين وتسعمائة انتهى باختصار ، ومن مؤلفاته قصة المعراج المشهورة فى عدة كراريس ، نفعنا الله بعلومه آمين.
شلقان : قرية من مديرية القليوبية بمركز قليوب ، فى شرقى بحر دمياط ، وفى شمال القناطر الخيرية بنحو ثلث ساعة ، وفى جنوب زفيتة شلقان بأقل من ساعة ، وهى بلدة قديمة كانت عامرة وكان بها أشجار وأبنية صالحة ومساجد عامرة ، وكانت جفالك المرحوم عباس باشا ثم اشتراها لجانب الديوان المرحوم سعيد باشا من ورثة المرحوم عباس باشا أيام جلوسه على التخت ؛ ليجعلها قلعة من قلاع القطر ، ولصيرورتها ملكا للميرى أمر الخديوى إسماعيل باشا بانتقال السكان منها وأمر بهدمها ليبنيها قلعة ، فهدمت وبنيت قلعة حصينة “.

أجهور الصغرى والحويطات
ذكر الجبرتي في تاريخه واحدا من أهم زعماء الحويطات في القليوبية وهو ابن شديد حيث قال عنه : (وهو من أوائل الحويطات في مصر نزلها حوالي عام ١١٠٥ هـ) وأقطع أرضًا كثيرة قرب السويس باعها أولاده. ، وقد منح الشيخ منصور شديد مائة فدان ناحية الصالحية وأجهور الصغرى بالقليوبية. ، وفي سنة ١٢٤٠ هـ/ ١٨٢٤ م صدر أمر بإعفاء الشيخ شديد من الضرائب على ١٤٨ فدان يزرعونها في صنافر وكفر أبو جمعة بالقليوبية.
وقد فصل ذلك محمد سليمان الطيب في كتابه موسوعة القبائل العربية حيث يقول أنه قد نزل الكثير من حويطات الحجاز إلى الديار المصرية منذ ما يزيد على قرنين ونصف قرن من الزمان ، وللحويطات دور بارز ونشاط حيوي مع الوالي محمد علي باشا وأحفاده منذ أوائل القرن التاسع عشر الميلادي وحتى منتصف القرن العشرين الميلادي ، وقد كان تقدير محمد علي باشا للحويطات كبيرًا لصدق ولائهم له ضد منافسيه من الغُز المماليك ومن عاون هؤلاء المماليك من الأعراب ، ثم زاد إعزازه للحويطات بعد تأييدهم الرسمي والعلني لمحمد علي في بقائه بحكم مصر رغم عزله من السلطان العثماني بفرمان عال من إسطنبول بتركيا في بداية حكمه (أوائل القرن التاسع عشر الميلادي).
وقد تجلَّى أعلى مراتب التشريف لوفد شيوخ الحويطات عندما نزل محمد علي باشا حاكم مصر بنفسه إليهم في إمبابة وهي ما بين القاهرة والجيزة وذلك في عام ١٢٢٠ هـ ، وقد ضرب لهم المدافع تقديرًا وتحية وإجلالًا لموقفهم ومؤازرتهم له ، ولأنه كان في حاجة لفرسان البادية شديدي المراس مثل الحويطات الذين لعبوا دورا هاما مع قواته في الصحراء الشرقية وغيرها ، وقد أقطع محمد علي باشا عائلة الشدايدة (عشيرة الموسة) أرضًا كبيرة في محافظة القليوبية من أجود الأراضي الزراعية في الديار المصرية ، واعتبر ابن شديد عُمدة الحويطات في بر مصر كلها ، وصار أولاده يسمون الشدايدة وتوارثوا العُمديَّة على الحويطات ، وكان منهم متصرف في الأمور التجارية بميناء السويس مع حويطات التَهَم بالحجاز وبالتعاون مع أبو طقيقة الشيخ العام.
ومن أقدم الفخوذ النازلة من بر الحجاز إلى الديار المصرية هي فخوذ الموَسة مثل العِمَّاني والهليْمي إلى جانب فخوذ من العمران مثل السياحة والحميدات ، وكذلك فخوذ من السلالمة والطقيقات والجواهرة وغيرهم قد نزلوا تباعًا من جميع العشائر بالتَهَم ، وكان الحويطات يشاركون في سلاح الفرسان المصري أيام محمد علي وقد قُتل كثير منهم في معارك الجيش المصري خارج وداخل مصر ، ولا تزال رفات الفرسان الذين قتلوا من الحويطات قابعة في مقابر قيتباي في القاهرة قرب قلعة صلاح الدين الأيوبي التي غيَّر اسمها محمد علي وأسماها باسمه ، وهذه المقابر تشهد لعنصر الحويطات الفعَّال في تاريخ مصر الحديث.
وكان بدو الحويطات من سكنوا الصحراء الشرقية لمصر يشتهرون باقتفاء الأثر ويساهمون مساهمة فعَّالة مع سلاح الحدود الذي ظهر فيما بعد في عهود أحفاد محمد على باشا ، كما كان يملك الحويطات الإبل الأصيلة التي جلبوها معهم من الحجاز بالمملكة العربية السعودية ، وما زال الحويطات في البوادي المصرية يملكون الإبل والأغنام الكثيرة وغير ذلك ممن مارس الفلاحة والزراعة في الأرياف المصرية والقليل من تحضر في المدن على رأسها القاهرة والسويس وبلبيس وحلوان والجيزة وقليوب.
وفي عام ١٢٢١ هجري حدثت مشاحنة ما بين جماعة من الحويطات وأخرى من العيايدة بنواحي الخانكة بمحافظة القليوبية ، وبعد أن انقطعت السُّبُل بين الطرفين وبدأ القتال بينهما وعلم شيخ البلد بذلك أسرع محمد علي باشا والي مصر بنفسه بعد أن وصله الخبر إلى تجهيز قوة عسكرية ونزل العدلية للتدخُّل إلى جانب الحويطات ، ولكن زعماء مصر وعلى رأسهم عمر مكرم قد دخلوا بسرعة للصلح بين العربان حرصًا على دمائهم ؛ ولأن البلاد المصرية في حاجة إليهم ، ولما نجحت الوساطة المصرية من كبراء البلد وبعض شيوخ الأزهر أمر محمد علي بسحب قواته من العدلية إلى القلعة.

القلج وشبرا شهاب
عدد كبير من قرى محافظة القليوبية تأسس في العصر العثماني بسبب إعادة تقسيم الأرض على القبائل بعد إلغاء نظام الإقطاع المملوكي ثم نشأة نظام الالتزام ومنح الأراضي لطبقة جديدة من الأعيان والشيوخ ، كما أن هناك قرى تأسست حول أضرحة عدد من الأولياء بسبب التبرك بالسكن جوارهم ووجود أوقاف ممنوحة لهم في تلك المنطقة ، وقد فصل ذلك محمد بك رمزي في كتابه القاموس الجغرافي للبلاد المصرية فقال :
القلج : دلني البحث على أن هذه القرية كانت تسمى قديما الزيات فصلت عن ناحية المرج ، وفي تربيع سنة 933 هـ قيد زمامها في دفاتر المكلفات باسم القلج نسبة إلى الشيخ قلج الرومي الأدهمي شيخ زاوية السلطان قايتباي بالمرج والزيات المتوفي سنة 891 هـ كما ورد في تاريخ مصر لابن إياس (ص 239 ج 2) ، وللاحتفاظ بالاسم القديم لهذه القرية وهو الزيات لسهولة الاسترشاد إلى زمامها القديم ضم اسمها في تاريخ سنة 1228 هـ إلى اسم القلج وصارت القرية تعرف باسم القلج والزيات ، وفي مساحة سنة 1275 هـ قيد زمامها باسم القلج وهو اسمها الحالي وحذف الاسم القديم.
شبرا شهاب : هي من القرى القديمة وردت في نزهة المشتاق باسم قشيرة الأبراج وقال إنها قرية عامرة وفيها غلات وعمارات كثيرة ، وفي كتاب وقف السلطان قايتباي المحرر في سنة 879 هـ باسم شبرا الأبراج ، وفي العهد العثماني عرفت بشبرا شهاب نسبة إلى الشيخ شهاب صاحب المقام الذي كان بها في ذاك الوقت ، كفر الحوالة : أصله من توابع شبرا شهاب ثم فصل عنها في تاريخ سنة 1268 هـ.
القشيش : أصلها من توابع نوب طحا ثم فصلت عنها في تربيع سنة 933 هـ كما ورد في دليل سنة 1224 هـ ، ويستفاد مما ورد في كتاب التبر المسبوك أن هذه القرية تنسب إلى الشيخ محمد الشامي السطوحي الشهير بالقشيش أحد المعتقدين ، مات يوم 23 ربيع الأول سنة 850 هـ ، ودفن بهذه القرية من أعمال القليوبية ، ووردت في خريطة الحملة وفي تاريخ سنة 1228 هـ.
كفر عليم : اسمها القديم الزيادية ورد في تاج العروس من قرى القليوبية ، وأصل هذه الناحية من توابع ناحية شبرا شهاب ثم فصلت عنها في العهد العثماني ، وفي تاريخ سنة 1228 هـ وردت باسمها الحالي ، ولا يزال هذا الكفر يتكون من نزلتي الزيدية الشرقية والزيدية الغربية وهو اسم محرف عن الزيادية الأصلية وهي بخلاف ناحية الزيدية التي بمركز إمبابة بمديرية الجيزة.
كفر سليم : أصله من توابع ناحية الخرقانية ثم فصل عنها في تاريخ سنة 1260 هـ باسم كفر الشيخ سليم نسبة إلى منشئه الشيخ سليم المرصفي من علماء الأزهر.
وجاء في الخطط التوفيقية : شبرى شهاب قرية من مديرية القليوبية بمركز قليوب ، على حافة البحر الشرقى ، فى مقابلة فم ترعة النعناعية التى فى بلاد المنوفية ، قبلى كفر الحمى ، وفيها جامع بمنارة ، وعليها معدية للمارين إلى الشرق أو الغرب ، وفى شرقها جنينة على مسافة ثلاثة آلاف متر فيها فواكه وبعض خضر وجملة من شجر الأثل ، وبها بعض نخيل بجوار جسر البحر الأعظم ، ولها سوق ينصب يوم الثلاثاء وزراعاتها كالمعتاد ، وتكسب أهلها من الزرع وغيره.