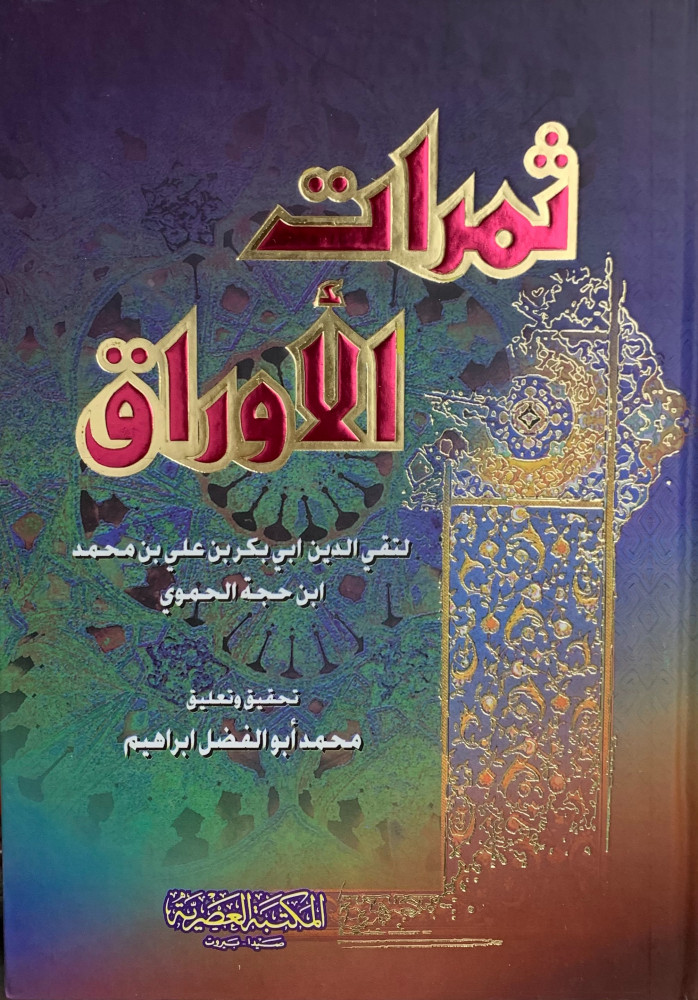
الصعيدي والإفرنجية
جلس والي القاهرة الأمير شجاع الدين محمد الشيرازي في إيوانه ليستقبل الموظف المختص بالتعامل مع شيوخ القبائل العربية في الديار المصرية والمعروف بلقب (مهمندار العرب) وهو الأمير بدر الدين أبو المحاسن يوسف المهنمدار ، وبعد الانتهاء من الأعمال التقليدية بدأت جلسة السمر وتبادل الرجلان الحديث حول نوادر الحكايات وغرائب الروايات وفي النهاية طلب يوسف من الأمير أن يروي له عن أكثر الأشياء غرابة فيما عايشه بنفسه وليس مما سمعه فذكر الأمير قصة لا ينساها حدثت بين رجل صعيدي وامرأة أفرنجية.
وحكى الأمير أنه في زمن الملك الكامل نزل إلى الصعيد وقضى ليلة في ضيافة واحد من كبار التجار هناك حيث أكرمه ومن معه ، وكان رجلا مسنا أسمر شديد السمرة بينما أولاده من حوله بيض الوجوه مشربين بالحمرة حسان الأشكال فتعجب الأمير من ذلك وسأل الصعيدي عن سببه فضحك ولم ينكر على الأمير دهشته ، ثم أخبرهم السبب ببساطة وهو أن والدتهم إفرنجية تزوجها بعد أن حدثت له معها حكاية عجيبة ترجع إلى زمن السلطان صلاح الدين وحروبه مع الفرنجة فطلب منه الأمير أن يحكي له هذه الحكاية.
حكى الصعيدي أنه في شبابه كان يعمل بالزراعة في قريته قبل أن يصير تاجرا ، وفي أحد الأعوام زرع كمية كبيرة من الكتان وأنفق على قلعها ونفضها مبلغا كبيرا من المال يقدر بخمسمائة دينار ثم عرضها للبيع لكن لم يجد مشتريا فقرر أن يحمله إلى القاهرة ، وهناك وجد وفرة في البضاعة وعرض عليه ثمن بخس لا يغطي التكاليف التي أنفقها ونصحه الناس بالسفر إلى الشام وبيع الكتان هناك لأن الحرب تسببت في غلاء الأسعار ، ومن هناك توجه إلى مدينة عكا بعد أن عرف أنها تعاني من قلة البضائع وكانت في ذلك الوقت تحت حكم الفرنجة.
وفي عكا بدأت حكايته بعد أن استأجر حانوتا في سوق المدينة لأنه اتفق على بيع جزء من الكتان بالآجل في مدى ستة شهور وبقيت كمية أخرى اضطر لبيعها بنفسه ثم استأجر بيتا في أطرف البلدة يطل على البحر ليقضي فيه مدة إقامته المقررة ، وفي صباح أحد الأيام مرت عليه هذه المرأة لتشتري منه الكتان فرأى من جمالها وحسنها ما أبهره وخطف بصره حيث كان من عادة النساء الإفرنجيات كشف الوجه وعدم التستر بالنقاب فأطلت عليه بوجه شديد البياض وجسد رشيق متناسق وشعر ذهبي مثل شعاع الشمس ومشية متدللة تخطف الأقلوب قبل الأبصار ، وقد تساهل معها في البيع فعادت إليه اليوم بعد اليوم وكررت مجيئها إليه وقد أدركت أنه قد أحبها وهام بها عشقا.
بدأ الصعيدي يبحث عن طريقة للتواصل مع المرأة ولاحظ أنها تسير في السوق دوما بصحبة امرأة عجوز فكلمها وطلب منها أن تتوسط بينه وبين محبوبته الجميلة وألح عليها مرارا وقد عرض كل غال ونفيس حتى ينال مراده ، وبعد مراسلات وافقت المرأة الإفرنجية على لقائه بشرط أن يظل الأمر سرا جتى لا يتعرض أي من الثلاثة للخطر وأن يدفع لها خمسين دينارا ، فقام الصعيدي بوزن الدنانير المطلوبة وسلمها للعجوز التي وأخبرته أن الموعد سيكون الليلة القادمة في بيته فمضى وجهز ما قدر عليه من مأكول ومشروب وشمع وحلوى وأعد موضعا على سطح البيت وفرشه بفراش جيد ليكون صالحا لهذا الحدث السعيد.
وجاءت المرأة الإفرنجية في موعدها بكامل زينتها فأكلوا وشربوا وتحادثوا وتسامروا وسادت البهجة والسعادة أجواء المكان حتى إذا جن الليل ولم يبق إلا النوم سرح الصعيدي بفكره وتأمل ما هو فيه وتذكر مراقبة الله وحدثته نفسه كيف لا يستحي من الله عزو وجل وهو غريب وتحت السماء وعلى بحر ويعصي الله مع نصرانية ويستوجب عذاب النار ، ثم أشهد الله على نفسه أنه قد عف عن المرأة هذه الليلة حياء منه وخوفا من عقابه ، ثم إن الصعيدي نام إلى الصبح ونامت المرأة قليلا ثم قامت في السحر وهي غاضبة ومضت.
وفي اليوم التالي ذهب الصعيدي إلى حانوته فجلس فيه وإذا المرأة قد عبرت عليه هي والعجوز والغضب ظاهر في وجهها يزيدها جمالا ودلالا كأنها القمر لكنها تجاهلته وأشاحت بوجهها عنه فزاد ذلك في رغبته فيها وأشعل نار الوجد مرة أخرى في فؤاده ، وخفق قلب الرجل وحدثته نفسه كيف يترك هذه البارعة في حسنها ثم لحق العجوز وطلب منه التوسط مرة أخرى فحلفت بحق المسيح ألا تعود إليه إلا بمائة دينار فرضي وووزن الدنانير المطلوبة وأعطاها للعجوز ، وفي الليلة التالية حضرت المرأة الإفرنجية وتكرر ما حدث في الليلة الأولى من بدايات اللهفة والشوق ثم لحقته مرة ثانية فكرة العفاف عنها والحياء من الله تعالى فانصرفت من بيته وهي تتساءل عما يحدث له أول الليل وآخره.
وفي اليوم الثالث مرت عليه المرأة وكانت في هذه المرة مستغربة مما بدر منه تجاهها وتبادل معها الحديث فحلفت له بحق المسيح أنه لن يذوق الفرح معها بعد ذلك إلا بخمسمائة دينار أو يموت كمدا بحبها ، وعزم الرجل أن يصرف عليها ثمن الكتان جميعه فبينما الحل بينهما كذلك ظهر المنادي من قبل الفرنجة ينادي معاشر المسلمين أن الهدنة التي بيننا وبينكم قد انقضت وقد أمهلوا من هنا من المسلمين إلى سبعة أيام يرحلون بعدها من المدينة ، وفي هذه الساعة فارقته المرأة وفي قلبها رغبة إليه وفي عقلها حيرة من أفعاله بينما أصابه الجزع إذ حرم فجأة من حلم جميل عاش فيه أياما كأنها من جنة الخلد.
وأخد الصعيدي خلال الأسبوع المتبقي في تحصيل ثمن الكتان الذي له والمصالحة على ما بقي منه وأخذ معه بضاعة حسنة وخرج من عكا متوجها إلى دمشق وفي قلبه من الإفرنجية ما فيه ، وعندما وصل إلى دمشق باع البضاعة بأوفى ثمن بسبب فراغ الهدنة ومنّ الله عليه بكسب وافر وقرر أن يتاجر في الجواري لعل ذلك أن يذهب ما بقلبه من حب الإفرنجية والتعلق بها ، ومضت ثلاث سنين وهو في دمشق على هذه الحالة إلا أن طيف خيالها لم يذهب من خياله وظل قلبه معلقا بها يعيش على أمل لقائها يوما ما ولم تفلح كل نساء الأرض في انتزاع ذكراها من عقله ولا استطاعت امرأة أخرى أن تحتل مكانها في قلبه.
ثم جرى للسلطان الملك الناصر ما جرى من وقعة حطين وأخذه جميع ملوك الفرنجة وفتحه بلاد الساحل بإذن الله تعالى ومنها مدينة عكا التي تحررت من الفرنجة ، وانقلبت الأحوال بعد انقضاء الحرب وتحولت نساء الفرنجة في عكا جميعا إلى سبايا وتم اقتيادهن إلى خيمة كبيرة في معسكر المسلمين ومن بينهن تلك المرأة الإفرنجية التي كانت على موعد مع التغيير الأكبر في حياتها التي خطتها يد القدر مع زوجها المستقبلي.
وفي أحد الأيام طلب الجند من الصعيدي أن يبيعهم جارية للملك الناصر فخرج إلى المعسكر وأحضر معه جارية حسناء وطلب مائة دينار ثمنا لها فدفعوا له تسعين دينارا كانت معهم وبقيت له عشرة دنانير ولم تعد هناك أموال يومها في الخزانة بسبب إنفاق جميع أموال السلطان في الحرب ، وتم التشاور على ذلك وأخبروه أن يذهب معهم إلى الخيمة التي فيها السبي من نساء الإفرنج ليختار منهم واحدة يأخذها مقابل الدنانير العشر التي تستحق له.
وصل الصعيدي إلى الخيمة فعرف غريمته الإفرنجية من بينهن وهي لا تعرفه وهي يومئذ امرأة فارس من فرسان الفرنجة فاختارها فأعطوها إياه ومضى بها إلى خيمته وخلا بها وسأله إن كانت تعرفه فلم تتبن الأمر من هول الموقف لكنه ذكرها بنفسه وما كان بينها في الماضي ، وقد كانت في الماضي قد توعدته بأنه لا يبصرها بعد ذلك إلا بخمسمائة دينار وها هو الآن قد أخذها بعشرة دنانير وجمعت بينهما الأقدار في صدفة نادرة الحدوث إذ قامت الحرب وانتهت بين الطرفين ليكون لقاؤهما في هذه الخيمة بعد الذي فات من الزمن وهما مفترقين.
تفكرت المرأة في كل ما جرى وأخبرته أن ما حدث له من مصادفات إنما هي من ثمرة دينه الصحيح وتذكرت صنيعه معها في تلك الليالي والتي شعرت فيها أولا بالغضب وثانيا بالدهشة ، وقد هالها تلك المفارقة التي حدثت لهما حيث التقيا ثم افترقا وهي ناقمة عليه ثم عادت إليه أسيرة بعشرة دنانير بعد كانت قد حلفت أنها لا تراه إلا مقابل ثمن تجارته كلها فأيقنت أن هناك ترتيبا علويا لحياتها وأن شيئا ما قد جمع بينها وبينه للأبد.
وفي وقتها طلبت منه أن يمد يده إلى يدها إليها وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فأسلمت وحسن إسلامها ، لكن الرجل قرر عرض أمرهما على القاضي بهاء الدين ابن شداد فذهب إليه وحكى له ما جرى فتعجب وعقد له عليها عقد زواج صحيح بعد أن أعتقها وباتت عنده تلك الليلة فحملت منه ثم رحل مع المعسكر إلى دمشق ، ولما كانت قد أسلمت فقد بطل زواجها من الفارس الإفرنجي إلى غير رجعة وعاشت حياتها الجديدة في سعادة وهناء في دمشق لكن لمدة يسيرة لأن القدر كان يدخر لهما الاختبار الأخير.
في صباح أحد الأيام تواترت أنباء عن قدوم رسول ملك الفرنجة يطلب الأسارى والسبايا باتفاق وقع بين الملوك فردوا من كان أسيراً من الرجال والنساء ولم يبق إلا زوجة الصعيدي وأرسل السلطان الناصر صلاح الدين في طلبه لأجل هذا الغرض ، ذهب الرجل إلى لقاء السلطان وقد تغير لونه واضطرب خاطره وإلى جواره تمشي زوجته وهو لا يدري ما يخفيه القدر حتى إذا دخل وجد رسول الفرنجة حاضرا فأسقط في يده.
فسألها الملك الناصر بحضرة الرسول إن كانت تريد الرجوع إلى بلادها أو إلى زوجها فقد فك أسرها وأسر غيرها وهي اليوم على الخيار وفق ما تحب وتريد ، فأجابت المرأة أنها قد أسلمت وتزوجت وحبلت وأشارت إلى بطنها المنتفخة وأنها لم تعد تصلح لحياة الفرنجة وليس لها رغبة في العودة ، فسألها رسول الفرنجة أيما أحب إليها هذا المسلم أو زوجها الإفرنجي فلان فأعادت عبارتها الأولى فأكد الرسول لمن معه من الإفرنج أن يسمعوا كلامها ليستوثقوا ثم أشار للصعيدي إشارة تعني السماح له بأخذ زوجته فخرج معها عائدا إلى بيته.
تنفس الرجل الصعداء وشكر لزوجته صدق قولها وحسن اختيارها ووقع في قلبه موضع المسرة والتكريم لها ، وبينما يسيران في طريق العودة طلبهما الجند مرة أخرى لمجلس السلطان ففزع قلبه ورجف صدره لكن نفسه هدأت حين عرف السبب ، كانت أمها قد أرسلت وديعة إلى ابنتها الأسيرة واشتهت أن توصل لها كسوة من القماش مربوطة على هيئة صرة كبيرة فتسلمها من رسول الفرنجة ومضى إلى الدار وفتح القماش فإذا هو قماشها بعينه قد سيّرته لها أمها ووجد الصرتين الذهب الخمسين دينار والمائة دينار كما هما بربطته لم يتغيرا فحمد الله حمدا كثيرا.
وبعد انتهاء الحكاية ضحك الصعيدي وأخبر الأمير شجاع الدين أن النهاية السعيدة قد امتدت من الشام إلى مصر لأنه عاد بها إلى قريته في الصعيد وأنجبت له البنين والبنات وعاشوا في تبات ونبات وأمد الله في عمرها وهي الآن قائمة تسمع كلامهم هذا من خلف ستار وهي التي صنعت لهم الطعام فتعجب الحاضرون من حكايته وما حصل له من الحظ.
(من كتاب ثمرات الأوراق في المحاضرات لابن حجة الحموي وكتاب صورة الصعيدي في كتاب ألف ليلة وليلة دكتور مؤمن أحمد محجوب).
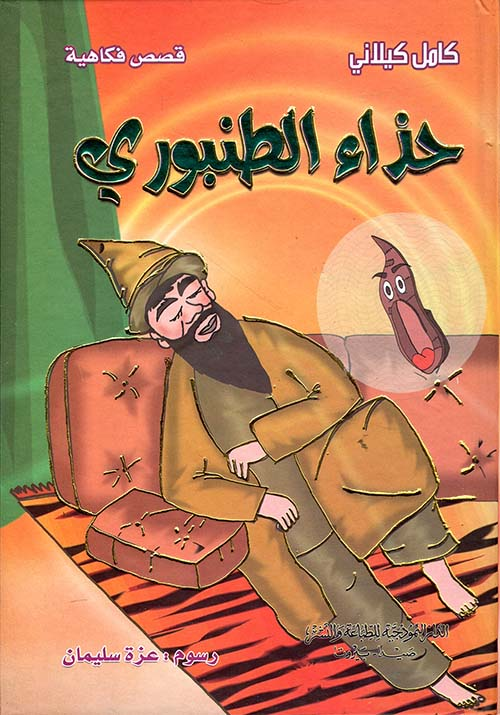
حذاء الطنبوري
اشتهر أبو القاسم الطنبوري بالبخل الشديد وعرف عنه في ذلك النوادر والحكايات فكان يحب المال حبا عظيما ولا ينفق منه شيئا إلا إذ اضطر لذلك أشد الاضطرار حتى ذاع صيته وعرفه كل سكان المدينة ، وكان أبو القاسم يجتهد في ادخار المال دون أن يخطر بباله أن يتصدق مرة واحدة على فقير أو مسكين وكلما ازداد ماله ازداد بخله حتى إنه كان من شدة حرصه يقوم بترقيع حذائه كلما تشقق جلده دون أن يفكر في شراء حذاء آخر ، وظل على هذا الحال سبع سنوات حتى بدا هذا الحذاء كأنه أحذية كثيرة بسبب ما أثقله من ترقيع وصار مضرب الأمثال في الحل والترحال وصار يضرب به المثل فيقال أثقل من مداس أبي القاسم الطنبوري.
وفي صباح أحد الأيام ذهب أبو القاسم إلى سوق الزجاج ووجد تاجرا من حلب يحاول بيع أوعية زجاجية مذهبة دون جدوى حيث عزف التجار عن بضاعته لغلو ثمنها وعدم حاجة الناس إليها في الوقت الحالي ، وقابله أحد السماسرة وأقنعه أن يشتري هذه البضاعة الكاسدة ثم يخزنها لفترة من الوقت وتعهد السمسار بأنه سوف يبيعها بعد ذلك بضعف ثمنها ، وأدرك الطنبوري حاجة التاجر الغريب إلى المال العاجل فانتهز الفرصة وساوم التاجر وأقنعه بكساد تجارته حتى اشتراها منه بمبلغ ستين دينارا وهو ثمن بخس.
ثم ذهب الطنبوري إلى سوق العطارين بصحبة سمسار آخر ووجد تاجرا من نصيبين يحاول بيع كمية من ماء الورد المعطر ويستعجل العودة فعرض بضاعته بأرخص الأسعار رغم أنها حسنة الصناعة ، واتفق الطنبوري مع السمسار على شراء الكمية كلها بمبلغ ستين دينارا أيضا ليقوم بتخزينها حتى إذا زاد الطلب عليها يقوم السمسار ببيعها بأضعاف مضاعفة ، ثم حمل الطنبوري ماء الورد وعبأه في الزجاجات المذهبة ونقلها بحرص وعناية إلى ساحة داره حيث وضعها على رف كبير في صدر مخزنه وهو في غاية السعادة والفرح بما حقق اليوم من مكاسب وأرباح.
وبعد عناء اليوم ذهب الطنبوري إلى الحمام العمومي ليستحم ويزيل عنه غبار السوق ، وعلى باب الحمام قابله أحد أصدقائه وتحدث معه بشأن حذائه القديم وقال له : لقد يسر الله لك وأغناك وليس يليق بمثلك أن يحتفظ بمثل هذا الحذاء المرقع البالي فماذا عليك إذا غيرته ولن يكلفك ذلك إلا مبلغ صغير من المال وأنت بحمد الله تكسب أضعاف ثمنه كل يوم ، فاستحسن منه هذا القول ونوى أن يشتري واحدا جديدا عندما يبيع بضاعته المخزنة لكنه أصيب بالدهشة عندما خرج من الحمام ليجد ذلك الحذاء الجميل الشكل الحسن الصنعة فظن أن صاحبه قد تعجل الأمر واشتراه له وأهداه إليه فوضع قدميه فيه ومضى خارجا وترك الحذاء القديم على باب الحمام.
وعلى باب الحمام وقف قاضي المدينة يبحث عن حذائه الجديد وهو غاضب بشدة لأنه ظن أن لصا سرقه وأرسل أتباعه يبحثون عنه في كل مكان إلا أنهم لم يجدوا غير حذاء الطنبوري فأحضروه للقاضي ، وشاع في الحضور أن الطنبوري قد سرق الحذاء فأصدر القاضي أمره للجند بالهجوم على بيت الطنبوري فكبسوه وأثبتوا التهمة عليه إذ وجدوا حذاء القاضي عنده ، وقد حاول الطنبوري أن يدافع عن نفسه ويعتذر عما حدث إلا أن القاضي حكم عليه بالجلد والحبس والغرامة معا ثم أعطاه الحذاء القديم على مشهد من الناس.
وعندما مضت أيام الحبس خرج الطنبور غاضبا وقد عزم على التخلص من هذا الحذاء الذي جلب له النحس فخرج به إلى شاطىء النهر وألقاه فيه وشاهده وهو يغوص في الماء وظن أنه بذلك قد تخلص منه إلى الأبد ، وفي الصباح وقع الحذاء في شبكة الصيادين فلما سحبوه وأخرجوه عرفوه على الفور لأنه كان مضرب الأمثال وظنوا أنه قد وقع من الطنبوري ولم يتمكن من الغوص لإحضاره ، وقام أحد الصيادين بحمل الحذاء واتجه به إلى بيت الطنبوري وراح ينادي عليه دون جدوى فاتجه إلى السوق يبحث عنه فلم يجده ثم عاد إلى البيت مرة أخرى ودق الباب طويلا دون أن يلقى إجابة ، وعندما يأس الصياد من محاولاته قام بقذف الحذاء عبر النافذة ليسقط في ساحة الدار ويجده الطنبوري عندما يعود.
وعندما عاد الطنبوري في المساء وجد الحذاء قد وقع بثقله على آنية الزجاج المذهبة فكسرها جميعا وانسكب ماء الورد المعطر فلما رأى ذلك أدرك ما حل به من الخسارة الفادحة فلطم على وجهه وصاح وافقراه أفقرني هذا المداس ، ثم راح يتكلم إلى الحذاء ويوبخه قائلا : شد ما أشقاني سوء حظي بك أيها الملعون فإنك تأبى أن تفارقني وكأنما كتب علي أن أصاحبك مدى الحياة فما أتعسني وأشقاني بصحبتك التي كبدتني من الغرامات ما لا سبيل إلى احتماله أما والله لأتخذن لك في جوف الأرض قبرا أدفنك فيه فلا ترى وجه الشمس بعد ذلك أبدا.
ثم أخذ الحذاء وتناول الفأس واتجه إلى طرف البيت وبدأ يحفر في الأرض بجوار الجدار ليدفن الحذاء تحت ساحة البيت ، وشعر الجيران بصوت الفأس وهو يضرب في الأرض فظنوا أن لصوصا ينقبون جدار بيتهم لسرقته فنادوا على جنود العسس الذين أحاطوا بالبيت ثم اقتحموه ووجدوا الطنبوري متلبسا بالحفر فقبضوا عليه وساقوه إلى الوالي ، وحاول الطنبوري الدفاع عن نفسه لكن الوالي لم يقتنع بما قال واتهمه بمحاولة سرقة جيرانه وثقب حائط بيتهم بالليل وهم نيام ، ثم وقع عليه عقوبة الحبس وتغريمه مبلغا كبيرا من المال.
ولما خرج الطنبوري من الحبس بلغ به الغيظ كل مبلغ وقرر أن يعاقب الحذاء بإلقائه في أقذر مكان فحمله واتجه إلى طرف البلدة حيث الخان الكبير الذي ينزل فيه التجار والمسافرون ثم ألقى الحذاء في مستراح الخان في موضع قضاء الحاجة وهو يظن أنه الفراق الأكيد ، لكن بعد أيام قليلة اشتكى صاحب الخان من انسداد قصبة المرحاض والمستراح والتي تصرف فيها المياه والفضلات حتى فاضت وتسببت في أذى الناس فأحضر الصناع لإصلاح ذلك وطال بحثهم عن سبب ما حدث حتى بلغوا موضع الانسداد ووجدوا حذاء الطنبوري فعرفوه في الحال وأنه هو سبب النكبة ، وحمل الناس الحذاء إلى الوالي فأمر بالقبض عليه وتغريمه مبلغا من المال ثمن الإصلاح ومبلغا آخر تعويضا لصاحب الخان ومبلغا ثالثا يؤديه غرامة للوالي على سبيل العقاب والتأديب.
وأيقن الطنبوري أخيرا أن الحذاء لن يفارقه فاستسلم ورضي بقسمته وترك التفكير في الأمر بعد أن عجزت حيلته فقام بغسل الحذاء ثم وضعه على سطح بيته ليجف وقد ظن أنه بذلك قد أمن شره ، ولكن خاب ظنه فلم يكد يمر يوم واحد حتى قفز أحد الكلاب الضالة على سطح البيت وأطبق بفمه على الحذاء وقد ظنه طعاما أو رمة بالية ثم هرب به ، وعندما قفز من السطح إلى السطح المجاول أفلت الحذاء من فمه فسقط بثقله على امرأة حامل فارتجفت وأسقطت حملها واجتمع الناس حولها وعرفوا أن الحذاء هو مصدر البلاء.
ورفع الأمر إلى القاضي فأمر بتغريمه مبلغا كبيرا على سبيل الدية للجنين المفقود ومبلغا آخر لعلاج المرأة ومبلغا ثالثا عقابا له وتأدبا حتى استنفذ ذلك كل ماله وأصبح فقيرا لا يملك دينارا لا درهما ، وهنا ضج أبو القاسم الطنبوري بالشكوى للقاضي وحكى له كل ما حصل من أول أمره وحتى ساعة مثوله أمامه فضحك القاضي وسأله عما يريد فطلب منه كتابة براءة من هذا الحذاء وأن يعلن ذلك على الناس.
وقال الطنبوري للقاضي : أريد أن أشهدك على أن الصحبة بيني وبين هذا الحذاء قد انتهت ولا سبيل إلى عودتها كما أشهدك على براءتي منه طول الحياة فأعفني بالله من صحبته ولا تؤاخذني بما يقع من حوادثه ومصائبه فبالله عليك إلا ما أعلنت بين الناس جميعا أنني برئت من هذه النعل وأنني لا أعرفها ولا تعرفني ولا صلة بيني وبينها منذ اليوم ، فأشفق عليه القاضي ورثى لحاله ووصله ببعض المال وأقره على ما طلب وسجل براءة بذلك وأذاعها على أهالي المدينة.
وفي الليلة التالية نام أبو القاسم الطنبوري هانئا سعيدا لكنه رأى في منامه حلما عجيبا إذ تمثل له الحذاء في هيئة إنسان يحدثه كما يحدث الصاحب صاحبه ويعاتبه باكيا ويقول : لقد أغضبك مني ما جلبته عليك من النكبات والمصائب وحسبت أنني تعمدت ذلك وعزيز علي أن تغضب على صاحبك القديم وقد علم الله أن ليس لي في هذا البلاء كله يد ولم يكن لي في دفعه حيلة ، ومن يدري فلعله عقاب إلهي أراد الله سبحانه أن يطهرك به من ذنوبك لعلك تقلع عن بخلك وتقتيرك وتكف عن حرصك على جمع المال الذي وقفت حياتك عليه دون أن تنفق منه درهما زاحدا في سبيل الله ، ولست أذكر على طول صحبتي لك أنك أعطيت فقيرا واحدا شيئا وإن قل مما رزقك الله به من خير عميم.
وقد مرت على صحبتنا سبع سنوات أو تزيد وما أذكر أنني رأيتك يوما تهم بإسداء معروف أو إغاثة ملهوف ، فهل تعجب إذا عاقبك الله على جحودك وجعل من المداس الذي أخلص لك الخدمة وسيلة لحلول نقمته وأداة لتحقيق عدالته وباعثا على شقائك ومصدرا لبلائك وسببا لتبديد مالك وجلب ما حل بك من المهالك ، فهلا عاهدتني أن تحسن إلى الفقراء والبائسين وتتصدق على الفقراء والمعوزين ، فإنك إن عاهدتني على ذلك انفرجت نكبتك وزالت كربتك وسعدت أيامك وتحققت أحلامك فإن من شكر الله على نعمائه نجاه الله في بأسائه ووسيلة الغني إلى شكر الله هي أن يحسن إلى عباد الله فيستديم بذلك رضاءه ويستبقي نعماءه.
فارتاح أبو القاسم لهذه النصيحة الغالية وعاهد صاحبه على اتباع مشورته وأشهد الله على صدق نيته وحسن طويته ، وبينما هو مستغرق في هذا الحلم سمع طرقا عنيفا على باب بيته فاستيقظ مذعورا ورأى الشرطة على بابه يستدعونه لمقابلة السلطان وراح يتساءل عما تسببه الحذاء من نكبات جديدة لكنه تذكر الحلم وهدأت نفسه قليلا ، ثم مثل في ديوان السلطان وقبل الأرض بين يديه وهو متهيب وجل لكن السلطان تلقاه مبتسما وسأله متوددا أن يروي بنفسه قصته مع الحذاء.
وكانت قصة الحذاء قد ذاع صيتها وانتشرت بين الأفواه حتى تناقلها رجال الحاشية السلطانية ووصلت إلى مسامع السلطان ، وكان في تلك الليلة يشعر بالسآمة والملل فلما سمع القصة سري عنه وأعجبته القصة وحل به الأنس والابتهاج محل الوحشة والانقباض واشتاق إلى رؤية الطنبوري فأرسل في طلبه ، وقص عليه الطنبوري كل ما حدث ثم ختمها بذلك الحلم العجيب الذي رآه في تلك الليلة.
واستمع السلطان إلى القصة من بدايتها إلى نهايتها وقد اشتد عجبه وضحك مع كل نكبة مر بها الطنبوري وفضى الليلة كلها في مسامرة مع الطنبوري وتبسط معه فقد أزالت القصة ما كان به من أرق وضيق صدر ، وعندما حان موعد الفجر أعلن السلطان رضاه عن الطنبوري وأمر له بعشرة أمثال ما فقد من مال وشمله بعطفه ورعايته ، وقد وفي الطنبوري بعهده الذي أخذه على نفسه في المنام وأصبح مثالا نادرا للإحسان والكرم والنجدة والمروءة والإيثار بعد أن كان مثالا للحرص والتقتير ، وقد تركه البؤس والشقاء وختمت حياته بالسعادة والهناء.
(من كتاب ثمرات الأوراق لابن حجة الحموي وكتاب حذاء الطنبوري كامل كيلاني)

حمار زينب
انتهى الشيخ من درسه الأسبوعي بالجامع الأزهر وتفرق عنه الطلاب بعد تحلقهم حوله ساعات طويلة يستمعون إلى شروحه وحواشيه ثم خرج من باب المزينين ولاحظ شخصا فقيرا يجلس بالقرب من الباب يشتغل بصناعة الخوص وقد ارتدى أسمالا بالية وبدا على جسده الضعف والهزال ، ورغم ذلك اندهش الشيخ من وجود المريدين حول هذا الفقير يتحلقون حوله ويستمعون إلى قصصه الغريبة حول كرامات الأولياء وعلامات أهل الطريق وما فيها من خرافات وتهويمات تختلف عن دراسته التي تعتمد على الكتب والمرويات الموثقة.
وعلى مشهد من الجميع وقف الشيخ بالقرب من مجلس الخواص وقال يخاطب المريدين بصوت ساخر قائلا : يا خواص ما اتخذ الله من ولي جاهل ، فرفع الخواص عينه إليه وتأمله مليا ولم يرد عليه وإنما واصل الاشتغال بصناعة الخوص ثم التفت يحدث مريديه وكأن شيئا لم يكن ، وكان رأي الشيخ الذي يعتقده هو أن الخواص رجل جاهل ليس له من العلم نصيب وأن الولاية الحقيقية هي لأهل الفقه والحديث بما لهم من دراسة وقراءة ، وهكذا كان الشيخ يكرر هذا القول الساخر كل أسبوع ولا يرد عليه الخواص وإنما يكتفي فقط بأن ينظر إليه تلك النظرة الخاوية.
ثم إن الشيخ غاب عن درسه الأسبوعي بسبب عزمه على الزواج لأن بيته عند باب الشعرية ويبعد عن الأزهر مسافة كبيرة وفي غمرة احتفاله بذلك نسي الشيخ كل ما دار مع الخواص ومريديه وانشغل مع أهله وضيوفه في العرس ، وكانت عروسه الجديدة تدعى زينب وهي فتاة صغيرة السن ساذجة العقل مدللة من أبيها وأمها فلما دخل بيته واختلى بها لم يحسن معها شيئا فأراد أن يتلطف بها ويداعبها بما يناسب عقلها ، وقد طلبت منه أن يحملها على ظهره ويدور بها كما يفعل الآباء مع أطفالهم الصغار ففعل ذلك في صحن مخدعه وهي تضحك في سعادة.
وفي اليوم التالي عاد الشيخ إلى درسه الأسبوعي وخرج كالمعتاد من باب المزينين ومر على الخواص ومريديه وخاطبهم بكلامه الساخر كالمعتاد فاقترب بوجهه من الخواص وقال له : يا خواص ما اتخذ الله من ولي جاهل ، وهنا اختلف رد فعل الخواص فلم ينظر إليه صامتا وإنما ضحك ضحكة كبيرة وقال للشيخ على رؤوس الأشهاد : بل اتخذه وعلمه يا حمار زينب ، وهنا صعق الشيخ لأن ما حدث بينه وبين زينب كان سرا لم يطلع عليه قريب أو بعيد وهي في منزلها لم تغادره من يوم العرس ولم تأتهم زيارات الأهل بعد فلا يمكن لإنسان أن يعرف ما دار بينهما.
والتزم الشيخ بالصمت الطويل وأخذ نفسه بالتفكير حتى كانت صلاة الجمعة في اليوم التالي فتقدم ليصلي بالناس كعادته وكان في الخواص يصلي في الصف الأول خلفه فسلبه القرآن الذي يحفظه ، وأرتج على الشيخ إذ نسي الفاتحة وأصابه الضيق والحرج وتضرع إلى الله أن يقبل توبته من الوقيعة في فقراء الطريق ، وفي الحال رد الخواص إليه الفاتحة وسورتين ليقرأ بهما ولما قضيت الصلاة التفت الشيخ يبحث عن الخواص فوجده أمامه ونظر إليه في لهفة كأنه طوق النجاة للغريق أو كأنه صدر الأم لولدها الرضيع.
ثم انكب الشيخ على يد الخواص يقبلها وقد تبدل حاله مما حدث وأيقن أن الخواص يملك علما يفوق ما تعلمه هو في أروقة الشيوخ والعلماء وسأله أن يقبل به مريدا من المريدين ، لكن الخواص اشترط عليه أولا أن يتخلص من كل مؤلفاته وكتاباته السابقة لأنها منقولة من ميت إلى ميت بينما العلم اللدني يتلقاه الصوفية عن الحي الذي لا يموت ، وأسرع الشيخ إلى بيته وتخلص من كل الكتب التي كتبها سابقا ما عدا كتابه الأخير لأنه اجتهد فيه اجتهادا كبيرا.
وفي المساء نام الشيخ ورأى في منامه أنه في بحر عميق وقد شعر بالعطش الشديد وإذا برجل ملثم يرتدي زي جنود المماليك يتناول كأسا ويسقيه حتى ارتوى فقام من نومه وهو فرح مسرور ، ثم ذهب في اليوم التالي إلى الخواص حافيا وقد خلع عمامة الأزهر ولبس رداء الفقراء وأراد أن يسأل الخواص عن شيء ولكن الخواص عاجله وقال له أثناء حديثه مع المريدين : أسقوك حتى ارتويت ؟ ، فأجابه وقال : نعم ، فأمره أن يتخلص من الكتاب الباقي من كتبه وأن يبدأ منذ اليوم في كتابة تاريخ الأولياء والأقطاب وطلب منه أن يلحق به الليلة في مقابر الصوفية خارج باب النصر.



